47/05/11
الاستصحاب الكلي/الاستصحاب الكلي /الأصول العملية
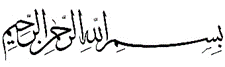
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب الكلي /الاستصحاب الكلي
انتهى الكلامُ في استصحابِ الكلّي من القسمِ الثالث، وقد تقدَّم أنّ أقسامَ استصحابِ الكلّي ثلاثةٌ، والصحيحُ أنّ الاستصحابَ لا يجري في القسمِ الثالث مطلقاً، خلافاً لما ذهبَ إليه الشيخُ الأعظمُ (قده) من التفصيل، وخلافاً لما ذهبَ إليه السيّدُ اليزدي (قده) ـ كما في حاشيته على الفرائد ـ والشيخُ الحائري (قده) من القولِ بالجريانِ مطلقاً.
وأمّا الإشكالُ الذي أُثيرَ على الشيخِ الأعظم (قده) في مثالِ الحدثِ الأصغرِ مع احتمالِ الجنابة، فالصحيحُ في جوابِه ما أفاده المحقّقُ النائيني (قده)، من أنّ هذا الإشكالَ غيرُ واردٍ على الشيخِ الأعظم، لخصوصيّةٍ في المثالِ نفسه، كما بيّنّاه سابقاً من خلالِ الآيةِ الشريفة.
التنويهُ إلى مسألةٍ مهمّةٍ: إنّ لهذه المسألةِ منشأً، وهو أنّ الآياتِ التي تناولت الأحكامَ الشرعيةَ غالباً ما تكونُ ناظرةً إلى أصلِ التشريعِ لا إلى تفاصيلِه، وأمّا بيانُ التفاصيلِ الدقيقةِ فقد أُوكلَ إلى السُّنّةِ المطهّرة. نعم، في بعضِ المواردِ الخاصةِ ـ كآياتِ المواريث وردت الإشارةُ إلى بعضِ الجزئيات، أمّا سائرُ الآياتِ التشريعيةِ فالغالبُ فيها أنّها تُبيّنُ أصلَ
الحكمِ ومبدأَ التشريعِ دون تفاصيلِ الكيفية.
ومن هنا، فإنّ الآيةَ الشريفةَ التي كنّا بصددِها تشتملُ على جنبتين: جنبةٍ تشريعيةٍ أصليةٍ، وهي بيانُ أصلِ وجوبِ الطهارةِ عند القيامِ إلى الصلاة، وجنبةٍ أخرى بيّنت عدمَ اجتماعِ الوضوءِ مع الجنابة، كما تقدَّم بيانُه.
أمّا بالنسبةِ إلى الجهةِ الأولى، وهي جنبةُ أصلِ التشريع، فالبحثُ فيها: هل للآيةِ إطلاقٌ من حيثُ كيفيةُ الغسل؟ أي هل يُستفادُ من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ…﴾ إطلاقٌ يشملُ الغسلَ من الأعلى إلى الأسفل، ومن الأسفلِ إلى الأعلى معاً، كما ذهبَ إليه السيّدُ المرتضى (قده)؟ والجوابُ: لا يُستفادُ من الآيةِ هذا الإطلاق، لأنّها ليست في مقامِ بيانِ كيفيةِ الغسلِ تفصيلاً، بل هي في مقامِ بيانِ أصلِ التشريع، أي بيانِ وجوبِ الغسلِ والمسحِ إجمالاً، لا بيانِ حدودهِ وكيفياتِه. فالآيةُ إنّما أرادت أن تُعلِّمَ المسلمين أنّ الطهارةَ للصلاةِ تكونُ بغسلِ الوجهِ واليدينِ ومسحِ الرأسِ والرجلين، لا أن تُحدّدَ لهم كيفيةَ الغسلِ أو اتجاهَه، وهذه التفاصيلُ موكولةٌ إلى السُّنّةِ الشريفة. وكذلك في مسألةِ التيمّم، فلا إطلاقَ في الآيةِ من هذه الجهةِ أيضاً، إذ ليست الآيةُ في مقامِ بيانِ كيفيةِ التيمّم وخصوصيّاته، وإنّما هي في مقامِ أصلِ التشريعِ لبدليّتهِ عند فقدانِ الماء، فاقتصرَ البيانُ القرآنيُّ على أصلِ وجوبِ التيمّمِ بالصعيدِ الطيّبِ بمسحِ الوجهِ والأيدي منه، دون التعرّضِ لتفاصيلِ الكيفية، وأُوكلَ بيانُها إلى السُّنّةِ الشريفة.
وأمّا أنّ الآيةَ التي نحن بصددِها قد فَصَلَت بين الوضوءِ والغسل، وبيّنت عدمَ اجتماعهما، فلا مانعَ من الاستشهادِ بها في هذا المعنى، إذ تدلُّ بظاهرِها على أنّ الوضوءَ لا يُشرعُ مع الجنابة، وأنّ لكلٍّ من الحدثين حكماً مستقلّاً. وعلى هذا، فالرواياتُ الواردةُ في عدمِ جوازِ الجمعِ بين الغسلِ والوضوءِ تكونُ من هذه الجهةِ مؤكِّدةً لمضمونِ الآيةِ الشريفة، لا مؤسِّسةً لحكمٍ جديدٍ.
بقي هنا أمرٌ، وهو أنّ بعضَ الأعلامِ (قدّس الله أسرارَهم) ذكروا ـ كما مرّ ـ أنّ الرواياتِ الشريفةَ الواردةَ في بابِ الأحداثِ لم تُرتِّبِ الأثرَ على كُلّيِّ الحدث، بل رتّبتهُ على خصوصيّاتِ كلِّ حدثٍ بعينِه، كالحدثِ بالنومِ أو البولِ أو الغائط، فكلُّ واحدٍ منها له أثرُه الخاصّ، دون أن يكونَ هناك أثرٌ لكُلّيِّ الحدثِ بما هو هو.
وللبحثِ في تماميّةِ هذا القولِ وعدَمِها، لا بأسَ بالإشارةِ هنا إلى ما أفاده سيّدُنا السيستاني (دام ظلّه) في هذا المقام.
قال (دام ظلّه): "إنّ جريانَ استصحابِ الكُلّيِّ متوقّفٌ على أن يكونَ الأثرُ مترتّباً على نفسِ الكلّيّ."([1] )
وتوضيحُ كلامِه (دام ظلّه): قد مرّ سابقاً في أوائلِ هذا التنبيه ـ استصحابُ الكلّيّ ـ أنّ البحثَ إنّما يتّجهُ فيما إذا كان الأثرُ الشرعيُّ مترتّباً على الكلّيِّ نفسِه لا على خصوصِ أفراده، لأنّ الاستصحابَ لا يجري إلا فيما له أثرٌ شرعيٌّ معتبر.
ومثالُه: ما إذا قيلَ: "أتصدّقُ لو كان في الدارِ إنسانٌ". فإنّ موضوعَ الأثرِ هنا هو الكلّيُّ ـ أي عنوانُ الإنسان ـ لا خصوصَ زيدٍ أو عمرو، فوجودُ أيِّ فردٍ من أفرادهِ كافٍ لترتّبِ الأثرِ، وهو وجوبُ التصدّق.
فحيثُ إنّ الاستصحابَ قضيّةٌ تعبّديّةٌ مأخوذةٌ من النصوصِ والروايات، وهي إنّما دلّت على ترتّبِ اللوازمِ الشرعيّةِ دون العقليّةِ أو العرفيّةِ التي لا أثرَ لها، فمتى ما كان الكلّيُّ بنفسِه مورداً للأثرِ الشرعيِّ، جرى فيه الاستصحاب، وإلّا فلا وجهَ لعقدِ هذا البابِ فيه.
أمّا مسألةُ الحدث، فقد تقدّم عن سيّدِنا الأستاذِ السيّدِ الحكيمِ (قده)، والشيخِ مجتبى الطهرانيِّ (قده)، والميرزا الزنجانيِّ (قده) في تحرير الأصول، أنّهم ذهبوا إلى أنّ الأثرَ لا يترتّبُ على كُلّيِّ الحدث، بل على خصوصيّاته من الحدثِ الأصغرِ أو الأكبر. وعليه، فالمثالُ المتقدّمُ لا يكونُ مثالاً عمليّاً تجري فيه الثمرة، بل هو مثالٌ فرضيٌّ أو علميٌّ، لا لوجودِ موردٍ عمليٍّ يترتّبُ عليه الأثرُ الشرعيُّ فعلاً. وهذا هو تمامُ ما تقدّم بيانُه في المقام.
لذلك قال سيّدُنا السيستاني (دام ظلّه): إنّ جريانَ استصحابِ الكلّيِّ متوقّفٌ على أن يكونَ الأثرُ مترتّباً على نفسِ الكلّيّ، لتكونَ هناك ثمرةٌ عمليّةٌ في استصحابه. ثمّ قال (دام ظلّه) بتصرّفٍ: "وكونُ الأثرِ مترتّباً على الكلّيّ يمكنُ استظهارُه في بعضِ المواردِ من آياتٍ أو رواياتٍ، وباعتبارِ أنّ الاستصحابَ قضيّةٌ شرعيّةٌ، فنرجعُ إلى الجاعلِ ونسأله: هل المجعولُ أمرٌ كلّيٌّ أم أمرٌ جزئيٌّ؟ بوضوحٍ، كما إذا كان الكلّيُّ موضوعاً للحكمِ في لسانِ الشارع، كقولِه (عليه السلام): «لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيبِ نفسِه»، فإنّ العنوانَ هو مالُ امرئٍ مسلمٍ، وهو عنوانٌ كلّيٌّ يشملُ المالَ المملوكَ ملكيّةً جائزةً أو لازمةً على حدٍّ سواء، وكذلك قولُه تعالى: «إلّا على أزواجِهم»."
حيثُ رُتّبَ الحكمُ على عنوانٍ كلّيٍّ، فالنصوصُ الشريفةُ دلّت على ترتّبِ الأثرِ على الكلّيِّ بما هو عنوانٌ عامٌّ، لا على خصوصِ الأفراد. ثمّ قال (دام ظلّه): "«إلّا على أزواجِهم» فإنّ جوازَ الاستمتاعِ مأخوذٌ فيه عنوانُ الزوجيّة، وهو عنوانٌ كلّيٌّ، سواءٌ أكانتِ الزوجيّةُ دائمةً
أم منقطعةً."
غيرَ أنّ هذا لا يعني أنّ كلَّ ما يثبتُ للدائمةِ يثبتُ للمنقطعة، بل إنّ النظرَ في الآيةِ إنّما هو إلى كُلّيِّ الزوجةِ في موردِ جوازِ الاستمتاع، لا في سائرِ الأحكامِ والآثار. ففي الزوجةِ الدائمةِ تجبُ النفقةُ، ولها أحكامٌ خاصةٌ، بينما المنقطعةُ تفقدُ بعضَ تلك الأحكامِ كعدمِ الميراث، وذلك يُفهمُ من الرواياتِ الشريفةِ المبيّنةِ لتفاصيلِ أحكامِ النكاح.
ثمّ قال (دام ظلّه): "إلّا أنّه في أغلبِ المواردِ تشخيصُ كونِ الموضوعِ كلّيّاً في غايةِ الإشكال." فإنّ ما ذكرناه وإن كان ممكناً في نفسه، إلّا أنّه لو أراد بعضُ الباحثين أن يتصدّى لعقدِ بحثٍ مستقلٍّ في هذا الباب ـ كما لو تصدّى بعضُ الإخوةِ وقال مثلاً: ما دامَ البحثُ في استصحابِ الكلّيِّ الذي عقدهُ الشيخُ الأعظمُ (قده)، فلا مانعَ من عقدِ بحثٍ مماثلٍ لحصرِ المواردِ التي جعلَ الشارعُ المقدّسُ فيها الأثرَ على الكلّيّ، سواءٌ أكانت في الآياتِ أم في الروايات ـ فإنّ ذلك ممكنٌ من حيثُ الفرض. فيُصنَّفُ هذا البحثُ كما تُصنَّفُ آياتُ الأحكام، فيُقالُ: إنّ آياتِ الأحكامِ مثلاً بعددٍ معيّنٍ، وكذلك يمكنُ أن يُحصَرَ ما وردَ من الآياتِ أو الرواياتِ التي دلّت على ترتّبِ الأثرِ على الكلّيّ.
غيرَ أنّ هذا البابَ لا يُغني الباحثَ الأصوليَّ إلّا من حيثِ الاستئناسِ والتطبيق، فإن
وُجدت أمثلةٌ واضحةٌ أمكنَ توظيفُها في تقويةِ المطلب، وإن لم تُوجدْ، بقي البحثُ فرضيّاً بحتاً لا ثمرةَ عمليّةَ له، وإنّما يُفيدُ في توضيحِ الجهةِ العلميّةِ للمسألةِ دون الجانبِ التطبيقيِّ منها.
ولو سُلِّمَ بذلك، نأتي إلى محلِّ كلامِنا، وهو موضوعُ الحدث، حيثُ تقدّمتْ أقوالُ بعضِ الأجلّاءِ في أنّ عنوانَ الحدثِ لم يُؤخذْ في لسانِ الشارعِ المقدّسِ بعنوانٍ كُلّيٍّ، بل وردَ التعبيرُ عنهُ بخصوصيّاتهِ كالنومِ والبولِ والغائطِ ونحوِها، من غيرِ أن يُرتّبَ أثرٌ شرعيٌّ على الكلّيِّ بما هو هو.
وعليه، فالبحثُ في استصحابِ كُلّيِّ الحدثِ لا تكونُ له ثمرةٌ عمليّةٌ، إذ لا أثرَ شرعاً للكليِّ في هذا الباب، فيكونُ الكلامُ فيه بحثاً علميّاً محضاً لا مورداً لهُ في مقامِ العمل.
فالآن نتحدّثُ عن كبرى الموضوع، إذ بعدَ التأمّلِ في بعضِ المواردِ والمصاديقِ التي وردتْ في النصوص، نلحظُ أنّ الشارعَ المقدّسَ قد رتّبَ فيها الأثرَ على العنوانِ الكلّيِّ نفسِه، لا على الأفراد.
فمن ذلك مثلاً عنوانُ المسلمِ في قولِه (عليه السلام): “لا يحلّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيبِ نفسِه”، فإنّ الحكمَ متعلّقٌ بعنوانِ المسلمِ بما هو عنوانٌ كُلّيٌّ، لا بزيدٍ أو عمرو بعينِه.
وكذلك عنوانُ الزوجيّةِ في قولِه تعالى: “إلّا على أزواجِهم”، فإنّ جوازَ الاستمتاعِ مترتّبٌ على عنوانِ الزوجةِ بما هو عنوانٌ عامٌّ يشملُ الدائمةَ والمنقطعةَ، وإنِ اختلفتا في بعضِ الأحكامِ التفصيليّة.
فهذان المثالانِ وغيرُهما يُمثّلانِ مواردَ نُلاحظُ فيها بوضوحٍ أنّ الأثرَ الشرعيَّ قد جُعلَ على الكلّيِّ بما هو كلّيٌّ.
قال (دام ظلّه): "إلّا أنّه في أغلبِ المواردِ تشخيصُ كونِ الموضوعِ كلّيّاً في غايةِ الإشكال؛ إذ المذكورُ في لسانِ الرواياتِ في غالبِ المواردِ مواردُ خاصةٌ، والحكمُ مترتّبٌ عليها ـ أي المواردِ الخاصةِ -."
بيانُ المرادِ من عبارتهِ (دام ظلّه): أنّ اشتراكَ بعضِ الأفرادِ في أثرٍ واحدٍ لا يقتضي أن يكونَ الأثرُ مترتّباً على الكلّيِّ بما هو كلّيٌّ. فمثلاً، الحدثُ الأصغرُ والحدثُ الأكبرُ يشتركانِ في أثرٍ واحدٍ كحرمةِ مسِّ كتابةِ القرآن، إلّا أنّ هذا الاشتراكَ لا يعني أنّ الأثرَ ثابتٌ للكلّيِّ بعنوانِ الحدث، بل إنّ الأثرَ ثابتٌ لكلِّ واحدٍ من الخصوصيّتينِ بخصوصِه.
فالأحكامُ الشرعيّةُ إمّا أن تكونَ ناظرةً إلى الخصوصيّاتِ والأفراد، وإمّا أن تشتركَ بعضُ تلك الخصوصيّاتِ في أثرٍ واحدٍ، ولكن من دونِ أن يترتّبَ الأثرُ على الكلّيّ. فكما أفادَ المحقّقُ الزنجانيُّ (قده): المحدثُ بالأصغرِ لا يمسُّ الكتاب، والمحدثُ بالأكبرِ كذلك لا يمسُّه، ولكن لا يوجدُ عندنا عنوانٌ مستقلٌّ باسمِ من كان محدثاً مطلقاً لا يمسُّ الكتاب، لأنّ الأثرَ لم يُجعلْ على هذا العنوانِ الكلّيِّ، بل على كلِّ واحدٍ من الخصوصيّتين.
فالمحدثُ بالأصغرِ لا يصلّي ولا يمسُّ الكتاب، والمحدثُ بالأكبرِ كذلك لا يصلّي ولا يمسُّ الكتاب، لكن لا يمكنُ انتزاعُ مفهومٍ ماهويٍّ بعنوانِ من كان محدثاً لا يصلّي ولا يمسُّ الكتاب. نعم، يمكنُ انتزاعُ عنوانٍ انتزاعيٍّ من هذين الموردين، ولكن هذا المفهومُ الانتزاعيُّ ليس مورداً للأثرِ الشرعيّ، كما تقدّمَ نظيرُه في مثالِ نجاسةِ أحدِ الإناءين؛ فإنّ النجاسةَ مترتّبةٌ على الإناءِ الأحمرِ أو الأزرقِ بخصوصِه، لا على عنوانِ أحدِهما بما هو أحدُهما، لأنّه عنوانٌ انتزاعيٌّ لا أثرَ له في نفسه.
وعليه، فالتعبيرُ الصحيحُ أن يُقال: إنّ المحدثَ لا يجوزُ له أن يصلّيَ ولا أن يمسَّ الكتاب، لا بمعنى أنّ الأثرَ مترتّبٌ على عنوانِ الحدثِ الكلّيّ، بل لأنّ الأثرَ ثابتٌ لكلٍّ من خصوصيّتي الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ بحدِّ ذاتهما.
وبهذا يتبيّن أنّ الآثارَ إمّا مترتّبةٌ على الخصوصيّات، أو مشتركةٌ بين خصوصيّتين، ولكن لا على الكلّي بما هو كلّي، وهذه النتيجةُ هي التي يُنتهى إليها عند تتبّع أغلب الموارد.
ثمّ ذكر (دام ظلّه) الفارقَ بين الرواياتِ الواردةِ في مقامِ الإفتاء والرواياتِ الواردةِ في مقامِ التعليم.
وقد ذكر هذا المطلبَ سيّدُنا السيستاني (دام ظلّه) في مبحثِ التعارض، بقلمِ المرحومِ السيّدِ هاشم الهاشمي([2] )، وكذلك في المنهج في علم الأصول الذي طُبع مؤخّرًا بقلمِ الشيخِ مرواريد([3] ).
كما أشار (دام ظلّه) إليه ـ باختصار ـ هنا في بحثِ الاستصحاب.
ولكنّ أوّلَ من فتح البابَ في هذا المطلب هو الشيخُ مهدي الإصفهاني (قدّه)، وتجدون إشاراتٍ إليه أيضًا في ثنايا كلماتِ الشيخِ الوحيدِ الخراساني (دام ظلّه) في بعضِ المباحث.
غيرَ أنّ سيّدَنا السيستاني (دام ظلّه) أسّس المطلبَ تأسيسًا آخر، فاستغرق في بيانِه وتفصيلِه، لما فيه من فوائدَ جليلةٍ، خصوصًا في بابِ التعارض؛ فبابُ التعارض قائمٌ في أساسِه على وجودِ تنافٍ بين الرواياتِ في مقامِ البيان، ومن هنا أُسِّسَت فيه القاعدةُ الأوّلية، وهي التساقطُ عند عدمِ إمكانِ الجمع، ثمّ يُرجَع بعد ذلك إلى الأصلِ العملي. أمّا القاعدةُ الثانوية فهي ما عُبِّر عنه بـ"الأخبارِ العلاجيّة"، وهي الرواياتُ التي عالجت طريقةَ التعارضِ وكيفيّةَ الترجيحِ بين الأخبار.
وعمدةُ هذه الأخبارِ هي "مقبولةُ عمرَ بنِ حنظلة"، التي قبلها الاصحاب واعتمدها السيّدُ السيستاني (دام ظلّه)، وهي من أهمّ الرواياتِ التي رسمت منهجَ الترجيحِ عند تعارضِ الأخبار. وقد اشتملت المقبولةُ على مجموعةِ مراحلَ من الأسئلةِ التي كان السائلُ يوجّهها للإمامِ (عليه السلام)، فيُجيبُه الإمامُ في كلّ مرحلةٍ بجوابٍ يُحدّد فيها ضابطَ التمييزِ بين الأخبارِ المتعارضة.
كما وردت إلى جانبِها مجموعةٌ أخرى من الروايات تُعرف أيضًا بـ"الأخبارِ العلاجيّة"، كلُّها واردةٌ لمعالجةِ مواردِ التعارض.
أمّا بالنسبة إلى أصلِ التعارض، فوجهُه واضح، إذ يكون منشؤُه التنافيَ بين الدليلَين أو بين مدلولَيهما. فلو كانت روايةٌ تدلّ على الوجوب، وأخرى لا تدلّ عليه أو تدلّ على نفيِه، فحينئذٍ يقعُ التعارضُ بينهما.
لكن قبل الحكمِ بوجودِ التعارض، لا بُدَّ من استنفادِ مرحلةِ الجمعِ الدلالي، وهي المرحلةُ السابقةُ على التعارض، حيث يُسعى فيها إلى التوفيقِ بين الدلالاتِ بالجمعِ العرفيّ المقبول، أو الاستنباطيّ الذي أشار إليه سيّدُنا السيستاني (دام ظلّه) في مبحثِ التعارض، لا الجمعِ التبرّعيّ.
فإذا فُرِغ من هذه المرحلة، ولم يتيسّر الجمعُ العرفي، حينئذٍ ننتقل إلى بابِ التعارض، ونُجري أحكامَه وقواعدَه.
فسيّدُنا السيستاني (دام ظلّه) أفاد أنّ طريقةَ الأئمّةِ (عليهم السلام) في التخاطبِ مع أصحابِهم تنقسمُ إلى قسمين:
الأوّل: ما يكون في مقامِ التعليم، أي إنّ الإمامَ (عليه السلام) يُعلِّمُ أصحابَه ـ كزرارةَ ونظرائه ـ منهجَ الفهمِ والاستنباطِ وكيفيّةَ التعاملِ مع النصوص.
فكثيرٌ من المسائلِ كمسألةِ التمسّكِ بالعموم، أو التمسّكِ بالمخصّصِ المنفصل، أو التمسّكِ بالإطلاقِ والمقيِّد، إنّما وردت في مقامِ التعليم لا الإفتاء.
فإذا وردت روايةٌ لا يُعمَلُ بها رأسًا، فإنّ ذلك لا يعني طرحَها، بل لأنّها صادرةٌ في سياقٍ تعليميٍّ يُراد منه تربيةُ الفقيهِ على منهجيّةِ الفهم، لا بيانُ الحكمِ الفعليّ في نفسه.
ومن هنا يمكن أن نُشبّه أحاديثَ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بالقرآنِ الكريم؛ فكما أنّ في القرآنِ ناسخًا ومنسوخًا، فكذلك في أحاديثِه (صلّى الله عليه وآله) ناسخٌ ومنسوخ، وكذلك في أحاديثِ الأئمّةِ (عليهم السلام)، فقد يتكلّمون بكلامٍ يحتملُ وجوهًا عديدةً تصلُ إلى سبعينَ وجهًا، ويكون لهم فيه المخرجُ بحسبِ المقامِ والظروف، فهذه كلّها من طُرُقِ التعليمِ والإرشادِ إلى كيفيّةِ فهمِ النصوص.
الثاني: ما يكون في مقامِ الاستفتاءِ والفتوى، لا في مقامِ التعليم.
وذلك كما لو جاء أحدُهم إلى الإمامِ (عليه السلام) فيسأله عن واقعةٍ خارجيّةٍ وقعت له، كأن يقول: واقعتُ زوجتي في الحجّ، فما هو حكمي؟
فالإمامُ (عليه السلام) في هذا المقام يُجيبُه جوابَ المفتي للمستفتي، فيقول له مثلًا: لا شيء عليك.
ثمّ قد ينقل ـ مثلًا ـ هذا السائلُ الجوابَ إلى بعضِ أصحابِه، فيقولون له: لقد اتّقاكَ الإمامُ، وأعطاك من عينٍ كدِرةٍ، فيرجعُ إلى الإمامِ ثانيةً ويُخبرُه بما قالوا. فيجيبُه الإمامُ (عليه السلام): إنّي لم أتّقِكَ، ولكنّكَ لم تكنْ عالمًا بالحكمِ حين المواقعة، فلا شيء عليك. أمّا غيرُك ممّن علمَ بالحكمِ وواقعَ زوجتَه في الحجّ، فعليه كفّارةُ بدنةٍ.
فإذا وردت لدينا روايتان: إحداهما تقول: "لا شيء عليه"، والأخرى تقول: "عليه بدنة"، فلا يصحّ إجراءُ قواعدِ العمومِ والخصوصِ أو التناقضِ بينهما، لأنّه لا يوجدُ في الحقيقةِ تنافٍ ولا تضادّ بين الحكمين، إذ إنّ موضوعَ كلِّ روايةٍ يختلفُ عن الأخرى: فالأولى ناظرةٌ إلى الجاهلِ بالحكم، والثانيةُ إلى العالمِ به.
ففي مقامِ الفتوى، يكونُ المستفتي هو مَن يطلبُ بيانَ حكمِ واقعةٍ خاصّةٍ تخصّه، وأمّا المستفتى منه فيُرجِعُ القواعدَ إلى ذهنِه ويُفتي بما يُناسبُ موردَ السؤال، لا بقصدِ بيانِ ضابطٍ عامٍّ أو قاعدةٍ أصوليّةٍ في العمومِ والخصوص، كما هو الحالُ في مقامِ التعليم.
وعليه، فالتفاوتُ بين المقامين جوهريٌّ؛ إذ في مقامِ التعليم يُرادُ تربيةُ الفقيهِ على القواعدِ العامّة، وأمّا في مقامِ الفتوى فالمقصودُ بيانُ الحكمِ الفعليّ لموردٍ خاصٍّ بحسبِ خصوصيّاته.
ولذلك عقدَ السيّدُ السيستاني (دام ظلّه) بابًا مهمًّا للغايةِ في هذا المطلب، لما له من تطبيقاتٍ كثيرةٍ ومتنوّعة.
ثمّ حاول (دام ظلّه) أن يُقرّبَ المسألةَ إلى محلِّ البحث، فنَبّه إلى أنّ هذا التفصيلَ بين مقامِ التعليمِ ومقامِ الفتوى وإن كان في الجملةِ صحيحًا، إلّا أنّ تطبيقَه في المقامِ غيرُ تامّ؛ لأنّ كلامَه (دام ظلّه) صريحٌ في أنّ تشخيصَ كونِ الموضوعِ كلّيًّا أو جزئيًّا "في غايةِ الإشكال".
وعليه، فالتفصيلُ المذكورُ ـ وإن كان نافعًا ومُثمرًا في مواردَ أخرى، وخصوصًا في بابِ التعارض ـ إلّا أنّه لا ينفعُ في محلِّ بحثِنا هذا، لأنّ المقامَ هنا من شؤونِ بيانِ الموضوعِ الكلّيِّ والأثرِ المترتّبِ عليه، لا من شؤونِ مقامِ التعليمِ أو مقامِ الفتوى.
ثمّ خلصَ السيّدُ السيستاني (دام ظلّه) إلى أنّ في المقامِ خصوصيّةً تقتضي أنَّ الأثرَ يكونُ على الكلّيّ، فخالفَ بذلك ما أفادَه سيّدُنا الأستاذُ السيّدُ الحكيمُ (قدّه)، والمحقّقُ الزنجانيُّ (قدّه)، والشيخُ مجتبى الطهرانيُّ (قدّه).
ولذلك قال (دام ظلّه): "لِما في صحيحةِ إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ الأشعريّ قال الإمامُ (عليه السلام): (لا ينقضُ الوضوءَ إلّا حدثٌ، والنومُ حدثٌ)،([4] ) ومن ناحيةٍ أخرى قد دلّت رواياتٌ صحيحةٌ على أنّ المنيَّ من نواقضِ الوضوء؛ فمن هذه الكبرى الكلّية ـ وهي قولُه (عليه السلام): "لا ينقض…" إلى آخره ـ نستكشفُ أنّ ناقضَ الوضوءِ منحصرٌ بالحدث، وعدَّ المنيَّ في الرواياتِ الصحيحةِ ناقضًا يُعلَمُ منه أنّه مصداقٌ للحدث، فيظهر أنّ الجامعَ بين الحدثِ الأكبرِ والأصغرِ هو الموضوعُ ـ أي موضوعُ الأثر ـ فلا وجهَ للقولِ بأنّ الحدثَ بعنوانِ الجامعِ ليس موضوعًا لحكمٍ من الأحكام".
[سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ * وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ]


