47/05/06
الاستصحاب الكلي/الاستصحاب الكلي /الأصول العملية
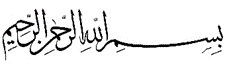
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب الكلي /الاستصحاب الكلي
لا زال الكلام في ما ذكره الشيخ مجتبى الطهراني (قده)-في حاشيته على رسالة الاستصحاب لاستاذه السيد الخميني (قده) - حيث ناقش ما أفاده المحقق النائيني(قده) بمناقشتين . ولتقريب مناقشته الأولى لابد من اعادة بيان ما ذكره المحقق النائيني ولو إجمالا فنقول قد أفاد(قده) أنّ موضوع الوضوء مركّبٌ من أمرين:
أحدهما وجوديّ، وهو النوم وهو مستفاد مما دلّت عليه موثقة ابن بُكير التي فسّرت قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ بمعنى القيام من النوم،
والآخر عدميّ، وهو عدم الجنابة، وهو مستفاد من الآية الكريمة بحسب المقابلة فيها ما بين النوم والجنابة والوضوء والغسل وإذا ثبت أن موضوع الوضوء مركب من هذين الأمرين النوم وعدم الجنابة فلا يجتمع الغسل والوضوء في موردٍ واحد، لأنّ تحقّق الجنابة يرفع موضوع الوضوء رأسا .
وعلى هذا فما ذُكر من مثال في مقام الإشكال على الشيخ الأعظم (قده) لا يتمّ، سواء قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من استصحاب الكلي أم لم نقل به؛ فان في المثال المذكور خصوصيةً تخرجه عن محلّ الكلام. وقد تقدّم بيان تلك الخصوصية مفصّلاً فيما سبق، فراجع.
وبعد هذا نعود إلى ماذكره الشيخ الطهراني (قده) من اعتراض وحاصله : إنّ القاعدة التي اعتمدها المحقق النائيني (قده) وهي" كون التفصيل قاطعٌ للشركة" في غير محلّها في المقام، لأنّ الآية المباركة ليست بصدد بيان التفصيل والمقابلة ما بين، النوم والجنابة من جهة والوضوء والغسل من جهة اخرى بل هي ناظرةٌ إلى بيان أسباب الطهارة.
فالآية في مقام افادة أنّ سبب الوضوء هو الحدث الأصغر، وسبب الغُسل هو الجنابة ، فلكلّ سببٍ مسبَّبُه الخاص، ولا مانع من اجتماعهما في شخصٍ واحد. فإذا اجتمعا كان الوضوء رافعا للحدث الأصغر، وكان الغسل رافعا للجنابة.
وعليه، فلو قصرنا النظر على الآية الشريفة وحدها، لما كان هناك ما يمنع من أن يتوضّأ المكلّف ويغتسل معاً، إذ لا تنافِي بين رفع الحدثين بطهارتين مختلفتين.
فالآية المباركة إذن في مقام بيان السببية والمسببية لكلٍّ من الحدثين، لا في مقام بيان تركب موضوع الوضوء من أمر وجودي وآخر عدمي كما ذهب إليه المحقق النائيني (قده). وهذه هي المناقشة الأولى التي ذكرها الشيخ الطهراني (قده) .
وأمّا المناقشة الثانية فلابد أيضا قبل بيانها من الرجوع إلى عبارة المحقق النائيني قال(قده) :
"فإن النائم الذي احتمل الجنابة قد أحرز جزئي الموضوع لوجوب الوضوء، وهو النوم بالوجدان وعدم الجنابة بالأصل، فيجب عليه الوضوء، وإذا وجب عليه الوضوء لا يجب عليه الغسل، لما عرفت من أنه لا يجتمع على المكلف وجوب الوضوء والغسل معاً… إلى أن قال: فإن من أجزاء سبب وجوب الوضوء عدم الجنابة، فلا يعقل أن يجتمع مع الجنابة التي هي سبب وجوب الغسل، فإنه يلزم اجتماع النقيضين، ففي المثال لا يجب على المكلف إلا الوضوء"([1] ).
وحاصل مراده (قده): أنّ وجوب الوضوء يتوقّف على تحقق أمرين:
الأول: القيد الوجودي وهو النوم.
والثاني:القيد العدمي وهو عدم الجنابة.
فموضوع وجوب الوضوء مركّب من هذين القيدين، ولا يمكن أن يتحقق الوضوء مع الجنابة؛ لأنّ تحقق الجنابة يرفع القيد العدمي الذي هو جزء الموضوع، فيلزم حينئذٍ اجتماع النقيضين — أي اجتماع "الجنابة" مع "عدم الجنابة" — وهو محال.
وعليه، فالمكلف إن كان جنباً فلا معنى لوجوب الوضوء عليه؛ إذ قد انتفى أحد جزئي الموضوع، وهو عدم الجنابة، وبانتفائه ينتفي الحكم بوجوب الوضوء .
وقد اعترض عليه الشيخ الطهراني ايضا وهذه هي المناقشة الثانية فقال(قده) "لو سلمنا ان عدم الجنابة أخذ في موضوع وجوب الوضوء وانه مركب من جزءين وان أحد جزئيّ الموضوع في المثال قد أحرز بالوجدان والجزء الآخر بالأصل ولكن لا نسلم ان اجتماع النقيضين في المثال يوجب عدم جريان استصحاب الحدث في حقه لأن امتناع اجتماع النقيضين انما يكون في الأمور الواقعية لا الأمور التعبدية والاعتبارية"([2] )
ولتوضيحُ هذا المطلب بشكل يتضح به ما أفاده المحقق النائيني ثم نرى هل أن ما ذكره الشيخ الطهراني من اعتراض في المقام يرد على المحقق أم لا؟
فنقول أنّ مسألة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وكذلك مسالة اجتماع الضدّين، من المسائل التي اتّفق الأعلام على أنّها من المستحيلات العقلية التي يدركها العقل بالبداهة. إلا أن الخلاف في أنّ إدراك العقل لاستحالتها هل هو في خصوص الأمور التكوينية ام يشمل كذلك الامور الاعتبارية كالاحكام الشرعية.
فإنه لا خلاف في أن العقل يحكم باستحالة اجتماع النقيضين ـ كالقول بأنّ "النظارة موجودة "والقول "ليس النظّارة موجودة " في الوقت نفسه ـ إذ يلزم منه اجتماع النقيضين في الواقع اي الوجود والعدم . وكذلك يحكم باستحالة ارتفاع النقيضين، كما لو قيل: " النظّارة غير موجودة" وقيل " ليست النظارة غير موجودة " في نفس الوقت إذ يلزم ارتفاع النقيضين في الواقع ، وهو أمرٌ غير معقول، لأنّ العقل يدرك أنّ كلّ موضوعٍ إمّا أن يكون متّصفاً بالصفة أو بنقيضها.
وهذه القضية في الأمور التكوينية من البديهيّات الأُولى التي يدركها العقل من دون حاجة إلى برهان، بل لا يُنكرها إلّا من كانت سليقته منحرفة عن الفطرة العقلية. حتى قيل إنّ الصبيان يدركونها بالفطرةِ، فهي من المسائل التي تُعدّ أصلًا في المنطق والفلسفة.
حتى إنّ كثيراً من المباحث العقلية الأخرى ـ كاستحالة وجود المعلول بلا علّة، وبطلان الدور والتسلسل ـ ترجع في حقيقتها إلى هذا الأصل، أي إلى امتناع اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. فاستحالة وجود المعلول بلا علّة، ترجع إلى استحالة اجتماع النقيضين او ارتفاعهما (إذ فرض وجود المعلول يلزمه فرض وجود العلة فلو فرض عدمها يلزم فرض وجود الشيء وعدمه وهو اجتماع للنقيضين).
وكذلك القول بالدور، فهو يرجع إلى ارتفاع النقيضين، لأنّه يستلزم أن يكون الشيء موجوداً ومعدوماً في آنٍ واحد كما هو محرر في محله .
إذن فهذه المحاذير العقلية في التكوينات مما لا تقبل النقاش .
أمّا بالنسبة إلى الأُمور الاعتبارية، والمقصود منها ما ليس لها واقع وراء الاعتبار، بل وجودها قائمٌ بنفس الإنشاء والاعتبار، لا بوجودٍ تكوينيٍّ . فحينما نُطلق عليها عنوان "اعتبارية" نعني أنّ منشأها اعتبار المعتبر، وليست من سنخ الأمور التكوينية التي يدركها الحسّ أو العقل .
ومن هنا قالوا: إنّ جعل صلاة الصبح مثلا ركعتين، لا لأنّه في واقع الأمر هناك "ركعتان" بحدّهما التكويني، بل لأنّ الشارع اعتبر هذا المقدار مبرئًا للذمّة، ولو شاء لجعلها ثلاث ركعات أو أكثر، فالأمر تابعٌ لاعتبار الشارع.
وقد وقع الكلام بين الأعلام: في ان القواعد العقلية الجارية في الأمور التكوينية — كامتناع اجتماع النقيضين أو الضدّين — هل تجري بعينها في دائرة الأمور الاعتبارية ، أو أنّ الاعتبار بابٌ مستقلّ وسهل المؤنة فلا تجري فيه تلك المحاذير العقلية؟
ذهب بعضهم إلى جريانها في الاعتبارات ايضا ، فلا يمكن أن يعتبر المعتبر مثلا وجوب
الشيء وعدم وجوبه في آن واحد، أو يُعتبر وجوده وعدم وجوده في آنٍ واحد، فإن استحالة التناقض أمرٌ عقليّ لا يختص بالتكوين .
ولكن ذهب آخرون إلى خلاف ذلك، وقالوا إنّ الاعتبار سهل المؤنة، ولا يلزم منه ما يلزم من الأمور التكوينية ؛ وبوسع المعتبر أن يعتبر ما شاء، فليس في باب الاعتبار محذورٌ من حيث التناقض العقلي ، لأنّ الاعتبار ليس وجودًا حقيقيًّا حتى يتقابل فيه الوجود والعدم بنحوٍ واقعي.
وعلى ضوء هذا ، يرى الشيخ مجتبى الطهراني (قده) أنّ ما ذكره المحقق النائيني (قده) من لزوم اجتماع النقيضين بين "الجنابة" و"عدم الجنابة" غير وارد؛ لأنّ الحدث بجميع أنواعه أمرٌ اعتباريٌّ محض، والشارع هو الذي اعتبر عنوان "الحدث" سببًا لوجوب الطهارة. فإذا شاء أن يجعل الجنابة وعدم الجنابة مجتمعين في شخصٍ واحد من حيث الاعتبار الشرعي — بأن يوجب عليه الغسل من جهة، والوضوء من جهة أخرى — فلا مانع من ذلك عقلًا، لأنّ الاعتبار بيد المعتبر، وهو الذي يُحدّد موضوعاته وأحكامه كيف شاء .
والحاصل ان ملخّص ما أفاده الشيخ مجتبى الطهراني (قده) في المناقشتين:إنّ مفادها الآية الكريمة — في نظره — ليس كما فهمه النائيني من كونها بمعونة الموثقة دالة على تركب
موضوع الوضوء من أمرٍ وجوديٍّ واخر عدميٍّ .
فالآية الكريمة ـ بحسب فهم الشيخ الطهراني ـ تشبه في مدلولها مثال الشرطيتين المستقلتين، كما لو قيل:"إن جاء زيدٌ فأكرمه، وإن جاء عمرو فأهنه" فإنّ مجيءَ زيدٍ سببٌ مستقلٌّ للإكرام، ومجيءَ عمرو سببٌ مستقلٌّ للإهانة، ولا يتوقّف أحد السببين على عدم الآخر، ولا أحد المسببين على ارتفاع الثاني، بل كلٌّ منهما موضوعٌ مستقلّ لحكمٍ مستقل.
وعليه، فمفاد الآية الشريفة : ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم… وإن كنتم جنباً فاطّهّروا﴾ أنّ القيام من النوم سببٌ لوجوب الوضوء، والجنابة سببٌ مستقلٌ لوجوب الغسل، فكلٌّ من الحدث الأصغر والأكبر علّة مستقلة لمسبَّبٍ خاصٍّ به، ولا دلالة فيها على توقف موضوع احدهما على عدم الاخر.
فلو فرضنا أنّ المكلّف قام من النوم وهو جنبٌ، فإنّ قيامه من النوم يقتضي الوضوء، وكونه جنباً يقتضي الغسل، فيكون مقتضى ظاهر الآية جواز اجتماعهما معاً، بأن يتوضأ ويغتسل، ولا مانع من الجمع بين الطهارتين بحسب مفاد الآية نفسها.
أمّا القول بعدم اجتماعهما، فهو مستفاد من دليلٍ آخر خارجٍ عن الآية.
وبذلك يرى الشيخ الطهراني أنّ ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) — من دعوى أنّ
موضوع الوضوء مركّب من قيدٍ وجوديٍّ وقيد عدميٍّ — غير مطابقٍ لمفاد الآية الشريفة، لأنّ الآية على غرار الشرطيتين المستقلتين، لا على غرار تركب سببية احد الحكمين من سببه الوجودي وعدم الاخر كما توهّمه المحقق النائيني.
ثم ذكر انه لو سلّمنا بمقالة المحقّق النائيني، فما هو المحذور أن يجتمع الشيء وعدمه؟ وحديث اجتماع النقيضين، إنّما يكون في الأمور التكوينيّة ، أمّا في ما نحن فيه من الأمورٍ الاعتباريّةٍ التعبّديّةٍ فلا مانع منه.
وهكذا خَتَمَ الشيخ الطهراني المناقشة مع المحقّق النائيني، فلم يرضَ بفهمه للآية المباركة، ولا بمسألة جريان استحالة اجتماع النقيضين في المقام .
هذا ولكن ما ذكره الشيخ الطهراني من المناقشة بقسميها غير تام كما أفاد سيدنا السيستاني (دام ظلّه): اما ما يخص المناقشة الثانية ، فقد أفاد سيدنا (دام ظله) ما حاصله : إنّ مسألة استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما من المسائل المفروغ عنها في جميع العلوم، ولا يُتصوّر فيها امكان الاجتماع ولا الارتفاع للنقيضين بحالٍ من الأحوال. والقاعدة ليست مختصّة بالأُمور التكوينية، بل تجري كذلك في الأُمور الاعتبارية، لأنّ الاعتباريات وإن لم يكن لها وجودٌ خارجيّ، إلّا أنّها تابعة في نظامها العقليّ للواقعيات.
وقد فصّل (دام ظله) هذا المطلب في الجزء الأوّل من كتاب التعارض عند تعريفه للتعارض بأنّه "التنافي بين الدليلين أو المدلولين"، حيث بيّن هناك بما فيه الكفاية أنّ محذور اجتماع النقيضين وارتفاعهما يشمل حتّى الأحكام الشرعية الاعتبارية.
فأنّه لا يُعقل أن يقول الشارع للمكلّف في آنٍ واحد: افعلْ ولا تفعلْ، أو أن يطلب منه الجمع بين الضدّين؛ لأنّ هذا تناقضٌ حتى في عالم الاعتبار. فالأحكام التكليفية الخمسة — الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة — متضادّة فيما بينها من جهة الجعل والمضمون، ولا يُمكن اجتماعها في موردٍ واحدٍ بنحوٍ حقيقيّ.
إذ المقنّن ـ وهو الشارع المقدّس ـ حين يسنّ أحكامه ويُلزم أتباعه بها، لا يمكن أن يجعل في منظومته التشريعية ما هو متناقضٌ أو متضادّ في ذاته، لأنّ ذلك ينقض غرض التشريع ويُبطل نظام التكليف.
وعليه، فبناءً على ما قرّره سيدنا السيستاني (دام ظلّه)، لا يتم كلام الشيخ مجتبى الطهراني (قده)، لأنّ الاعتبار الشرعي لا يخرج عن ضوابط العقل في باب التناقض، بل هو تابعٌ له في امتناع اجتماع النقيضين أو الضدّين، سواء في التكوينيات أو في التشريعات الاعتبارية . ثم لابد من ملاحظة إنّ ما افاده السيد السيستاني (دام ظلّه) لا يختص بدفع ما أفاده الشيخ مجتبى الطهراني (قده) فحسب، بل هو رد على كلّ من ذهب إلى أنّ الأمور الاعتبارية لا يجري فيها ما يجري في الأمور التكوينية من ضوابط عقلية كاستحالة اجتماع النقيضين أو الشرط المتأخّر أو نحو ذلك.
ولأجل ان يتضح المطلب أكثر ، نذكر بما دار بين الأعلام من كلام في كتاب المعاملات، حول مسألة الإجازة في العقد الفضولي: حيث اختلف الفقهاء هناك في أنّ الإجازة هل هي ناقلة أو كاشفة؟فإن قلنا إنّها ناقلة، فمعنى ذلك أنّ العقد لم يكن مؤثِّراً قبل الإجازة، وإنّما انتقل المبيع من حين صدور الإجازة.
وإن قلنا إنّها كاشفة، فهي تكشف عن أنّ العقد كان صحيحاً من حين صدوره، وأنّ ملكية المبيع انتقلت من ذلك الوقت لا من حين الإجازة، فيكون النماء للمشتري لا للبائع.
وهنا وقع الإشكال المعروف: كيف تكون الإجازة ـ وهي أمرٌ متأخّر عن العقد ـ مؤثّرة في صحّة العقد من حينه؟ أليس هذا من باب الشرط المتأخّر؟
وقد قال بعض الأعلام إنّ تاخر الشرط من المستحيل، لأنّ المعلول لا يمكن أن يتقدّم على علّته، والشرط لا يمكن أن يتأخّر عن المشروط. ولكن البعض أجازوا ذلك في الأمور الاعتبارية، لأنّها ليست من سنخ التكوينيات، ومنهم صاحب الجواهر (قده) حيث افاد إنّ استحالة الشرط المتأخر إنما يكون في القضايا التكوينية، واما في القضايا الاعتبارية والأحكام الشرعية فلا مانع منه.
ومنهم شيخنا الاستاذ الفياض (دام ظلّه) حيث قال:"وأما الأمور الاعتبارية كالاحكام الشرعية، فحيث إنه لا وجود لها إلا في وعاء الاعتبار والذهن، فلا تُتصور المضادة بينها ولا اتصافها بالشدة والضعف، فإنهما إنما يتصوران في الموجودات الخارجية من الجواهر والأعراض"([3] ).
ثمّ استدرك قائلاً:"نعم، إن مبادئ الأحكام الشرعية وملاكاتها حيث إنها من الأمور الواقعية، فيُتصور فيها التضادّ".
أي إنّ الأحكام نفسها اعتباراتٌ ذهنية، لا يُعقل فيها تضادّ أو تمانع، وأما مبادؤها وملاكاتها (أي المصالح والمفاسد الواقعية التي تكون منشأ لجعل الحكم) فهي أمورٌ واقعية خارجية يمكن فيها التضادّ. لكنّ السيد السيستاني (دام ظلّه) خالف هذا الاتجاه وقال:إنّ الأمور الاعتبارية لا تخرج عن ضوابط العقل الكليّة، بل هي تابعة لنفس القوانين التي تحكم في عالم الواقع والتكوين؛ فكما لا يُعقل اجتماع النقيضين في التكوين، كذلك لا يُعقل اجتماع الأحكام المتناقضة في الاعتبار، لأنّ الاعتبار وإن لم يكن له وجود خارجي إلا أنّه موجود وتابع لنظام العقل، والعقل لا يُجيز الجمع بين المتناقضين حتى في مرحلة الاعتبار.
ومن هنا، فمبناه (دام ظلّه) أنّ الاعتبارات الشرعية ليست بمعزلٍ عن القواعد العقلية، بل محكومةٌ بها تماماً، لأنّ الشارع نفسه حكيمٌ، وحكمه ـ وإن كان اعتبارياً ـ لا يمكن أن يتضمّن تضادّاً أو تناقضاً ذاتياً.
والنتيجة : فأنّ السيد السيستاني(دام ظله) يرى أنّ القول بإمكان اجتماع النقيضين أو الضدّين في عالم الاعتبار، كما ذهب إليه الشيخ الطهراني وغيره، قولٌ غير صحيح، لأنّ الاعتبار لا يُخرج الشيء عن حكم العقل، بل يظلّ تابعاً لقوانينه في الامتناع عن الجمع بين المتناقضين أو المتضادّين .
ولذلك قال سيدُنا السيستاني (دام ظلّه) "فإنّ استحالة اجتماع النقيضين في الواقعيات والتعبديات من الواضحات، أفهل يمكن إنشاء وجوب شيء وعدم وجوبه؟! أو حرمة شيء وعدم حرمته؟! واستحالة اجتماع النقيضين من المبادئ العامة لجميع العلوم"([4] ). ومراده (دام ظلّه): التنبيه إلى أنّ محذور اجتماع النقيضين لا يختصّ بعالم التكوين والواقعيات فحسب، بل هو أمرٌ عقليٌّ كلّيٌّ جارٍ في جميع مجالات الإدراك، حتى في عالم الاعتبار والتشريع، لأنّ جميع العلوم ـ سواء كانت من العلوم الواقعية أو الاعتبارية ـ تقوم على مبادئ عقلية عامة لا تتخلّف ولا تتخصّص بعلمٍ دون علم.
فكما لا يمكن في علم النحو مثلًا أن يُقال: هذا فاعل وهذا ليس بفاعل في آنٍ واحد، كذلك لا يمكن في علم الأصول أو الفقه أو أيّ علمٍ آخر أن نعتبر الشيءَ واجباً وغير واجب، أو حراماً وغير حرام في الوقت نفسه، بدعوى أنّها أمور اعتبارية. فالعقل لا يُفرّق في هذا الحكم بين التكوين والاعتبار؛ إذ الامتناع ناشئ من نفس بنية العقل والمنطق، لا من طبيعة المعلوم.
ولذلك استغرب (دام ظلّه) من قول بعضهم: إنّ الأمور الاعتبارية لا مانع فيها من اجتماع النقيضين، وأشار بأنّ هذا القول غريبٌ وغير مقبول، لأنّه ينقض الأسس العقلية الأولى التي تُبنى عليها سائر العلوم، كاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، واستحالة وجود معلول بلا علّة، واستحالة كون الممكن علّةً لنفسه. فهذه كلّها من القضايا البديهية السيّالة في كلّ علمٍ من العلوم، لا تنفكّ عنها .
ثم عقّب (دام ظلّه) قائلاً:"لا بدّ وأن يُحمل هذا على سهو القلم أو استعجاله".
أي أنّه يرى أنّ صدور مثل هذا القول من بعض الأعلام القائلين بإمكان اجتماع النقيضين في الاعتباريات لا يمكن تفسيره إلّا على نحو السهو أو العجلة، إذ لا يمكن لعقلٍ منضبط أن يلتزم بمضمونه.
وعليه، فإنّ ما أفاده سيدنا السيستاني (دام ظلّه) لا يردّ على الشيخ مجتبى الطهراني وحده، بل يشمل جميع القائلين بأنّ الأمور الاعتبارية خارجة عن ضوابط القوانين العقلية العامة، ويؤكّد (دام ظلّه) أنّ هذه القوانين مبادئ أولية شاملة لجميع العلوم، سواء كانت تعبدية أو واقعية.
وهذا هو تمام الكلام في رد المناقشة الثانية للطهراني (قده) .
وللكلام بقية…
[ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ]


