47/05/05
الاستصحاب الكلي/الاستصحاب الكلي /الأصول العملية
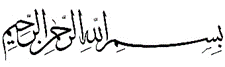
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب الكلي /الاستصحاب الكلي
تقدّم الكلامُ في المثالِ الذي أُورِدَ نَقضاً أو إشكالاً على ما اختاره الشيخُ الأعظمُ(قده) في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وكما تقدّم ذكر ما أجاب به الاعلام عن الإشكال المذكور. وبيّنا أيضاً أنَّ المحقّقَ النائيني(قده) قد حرّرَ المطلبَ بدقّةٍ، مستفيداً من دلالةِ الآيةِ الشريفة، وبيّنَ أنَّ الاشكال لا يَرِدُ سواءٌ قلنا بجريانِ الاستصحابِ في القسمِ الثالث أو لم نقل؛ لأنَّ المكلّفَ إذا أتى بالوضوء في المثال المذكور في الاشكال جازَ لهُ الإتيانُ بكلِّ عملٍ مشروطٍ بالطهارة. كما ذكرنا أنَّ بعضَ تلامذته، كالميرزا محمّد باقر الزنجاني(قده)، حاولَ الاعتراضَ عليه، وقد تقدّمَ ما يمكنُ أن يُعَدَّ جواباً عن هذا الإعتراض المذكور .
وتقدّم منّا أيضاً بيانُ ما أفادهُ السيّدُ الخميني(قده)، ولم يكن رأيهُ في المقام واضحاً تماماً؛ حيث أرجعَ أصلَ المطلبِ إلى مسألةِ وحدةِ القضيّةِ المتيقَّنة والمشكوكة، ثمّ عقّب قائلاً: إنّ الموضوعَ لا يزالُ بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التأمّل؛ لوجودِ خدشةٍ ومناقشةٍ فيما ذكرهُ(قده)، ممّا يُشيرُ إلى أنّ نظرَهُ في المسألة لم يستقرّ على وجهٍ نهائي .
ثم إنَّ للسيّدَ الخميني(قده) كتابٌ معروفٌ باسم "الرسائل"، وهو في الحقيقة مجموعةُ رسائلَ أصوليّةٍ ألّفها في مراحلَ مختلفةٍ من دراستهِ وتدريسهِ، وقد طُبِعَ بعضها على نحوٍ مستقلٍّ، مثل رسالة الاستصحاب ورسالة لا ضرر ورسالة التعادل والتراجيح. وقد جُمِعَت هذه الرسائلُ في حياته(قده) في مجلّدين بتحقيقٍ وتحريرٍ من تلميذه الشيخ مجتبى الطهراني.
وقد نقل السيد الرباني في تقريرات بحث الاستصحاب للسيّد السيستاني(دام ظلّه) مطلبا سنُشير إليه لاحقاً، وعبّر عن قائله بـ "صاحب الرسائل"، والظاهر أنّه أراد بذلك الإشارةَ إلى السيّد الخميني(قده). غير أنّ الملاحظ أنّ التقرير الآخر لبحث الاستصحاب والذي حرّره السيّد المهري لم ينسب ذلك الرأي إلى أحد، وإنْ كان قد بيّن نفس المطلب بحسب المضمون .
ولكن الظاهر – بل المتيقَّن – أنّ المقرر اعني السيّد الربّاني قد اشتبه في النسبة؛ لأنّ ما نقلهُ من مطلب لا يعود إلى السيّد الخميني نفسه، بل هو مأخوذٌ من حاشيةٍ على رسائله كتبها تلميذه الشيخ مجتبى الطهراني، المقرّرُ الأوّلُ لدروس السيّد الخميني(قده). والشاهدُ على ذلك أنّ الطبعة المنفردة اللاحقة لرسالة الاستصحاب – بعد فصلها عن بقية الرسائل – خَلَت تماماً من حواشي الشيخ مجتبى الطهراني، واقتُصر فيها على نصِّ الرسالة الأصلية
فقط.
وعليه، فإنّ ما سنذكره من مطلب لاحقاً وما يرد عليه لا يُعدّ من آراء السيّد الخميني(قده) نفسه، بل هو من آراء تلميذه ومقرّر بحثه الشيخ مجتبى الطهراني(قده). وعلى كلّ حال، فالأمرُ في هذا سهلٌ بعد بيان تصحيح النسبة.
والحاصل، فإنّ تلميذَ السيّد الخميني(قده)، الشيخ الطهراني(قده)، ذكرَ في حاشيته على رسالة الاستصحاب للسيد الخميني رأيه الخاص في جواب الإشكال، وناقش المحقّق النائيني(قده)، وتعرّض لما ذكره بالنقد في موارد متعدّدة، سنقتصر منها على وجهين بعد أن نُبيّن رأيه أوّلاً.
وفي الحقيقة فأنّ رأيه في الجواب عن أصل الاشكال لا يختلف في جوهره عن رأي الميرزا محمّد باقر الزنجاني(قده) ورأي سيّدنا الأستاذ الحكيم(قده)، وحاصلُ ما أفاده : هو أنّ الكُلّي في محلّ البحث لم يكن هو الموضوعَ للآثار الشرعيّة أصلاً، ولذا فإنّ المثال الذي أورده الأعلامُ نقضاً على الشيخ الأعظم(قده) لا يَرِدُ عليه؛ لأنّ الحدثَ المأخوذٌ في لسان الأدلّة بلحاظ أفرادهِ الجزئية، كحدثِ الجنابة، والنوم، والبول، والغائط، والريح، وهي كلّهاأحداثٌ شخصيّةٌ جزئيّة، رَتَّبَ الشارعُ المقدّس الاثار على هذه الخصوصيّات الفرديّة
ولم يرتب الأثر على العنوانٍ الجامعٍ بينها.
فلا يوجد في لسان الشارع عنوانٌ مستقلّ بعنوان "كليّ الحدث" تترتب عليه الأحكام، نعم يمكن انتزاع كليٍّ عقليٍّ من مجموع هذه الأحداث، لكن هذا الكليّ الانتزاعي لا يترتّب عليه أثرٌ شرعي؛ لأنّ الكليّات الانتزاعية محلّها الذهن، ولا واقعيّةَ لها في الخارج تُناط بها الأحكام.
ثمّ أنّ هناك فرق بين الكليّات الانتزاعية والكليّات الماهويّة، فالكليّ الماهوي هو ما له حقيقةٌ نوعيّةٌ قائمةٌ بفردها او بنفسها في الخارج على النزاع في وجود الطبيعي في محله، كعنوان "الإنسان" المنتزع من زيدٍ وعمرو، فإنّ الشارع يمكنه أن يُرتّب الأثر على نفس الماهية؛ لأنّها حقيقةٌ تَحمل أثراً شرعياً بنحو الكليّ الطبيعي، وهذا بحثٌ كبرويٌّ له مجاله في باب الأحكام.
أمّا الكليّ الانتزاعي فهو من قبيل قولنا: "أحد الإناءين تنجّس"، فإنّ عنوان "أحدهما" ليس موضوعاً حقيقيّاً للنجاسة، بل هو محض تعبيرٌ مختصر عن قضيتين منفصلتين، مفادُهما: إمّا أن يكون الإناء الشرقيّ قد تنجّس، أو الإناء الغربيّ قد تنجّس، وعليه فـ العنوان الانتزاعي "أحدهما" ليس هو محلّ النجاسة ولا تترتّب عليه الآثار الشرعية.
فالمتحصّل من رأيه: أنّ الحديث عن "كليّ الحدث" لا معنى له من جهة الأثر الشرعي، إذ لا
أثر للجامع الانتزاعي بين الأحداث، وإنما الأثر يترتّب على أفرادها الخاصّة التي هي موارد جعل الأحكام الشرعية. هذا ما يتعلق ببيان رأيه في جواب الإشكال. قال (قده) "لم يكن مجعولا من قبل الشارع ولم يكن موضوعا ذا أثر شرعي حتى يستصحب ويترتب الآثار المشتركة بينهما عليه بل كلما يتصور انما هو جامع انتزاعي عقلي ولا يترتب عليه أثر شرعي"([1] ).
توضيحُ كلامِه(قده): إنّ تعبيره "كلّ ما يُتَصوَّر إنّما هو جامع" يُراد به الجامعُ الانتزاعي لا الجامعُ الماهوي؛ المعبر عنه بالطبيعي لأنّ الجامع الماهوي، كعنوان طبيعي الإنسان المنتزع من زيدٍ وعمرو وخالد، له حقيقةٌ نوعيّةٌ واقعيّة في الخارج، بحيث يمكن إنشاءُ الأحكام والآثار الشرعيّة عليه، كما في قولنا: إذا رأيت إنساناً فسلِّم عليه، فإنّ هذا إنشاءٌ صحيحٌ؛ لأنّ الجامع بين الأفراد (زيد وعمرو وخالد) هو جامع ماهوي حقيقي قابلٌ لتعلّق الحكم به. أمّا الجامعُ الذي يتحدّث عنه (قده) فهو من سنخ الجامع الانتزاعي، وهو ما لا واقعيّة له في الخارج، وإنّما يُنتزع من ملاحظةِ جهة وحدة لأفرادٍ متعدّدةٍ فيجمعها الذهنُ بعنوانٍ ذهنيٍّ صرفٍ، لا حقيقةَ له إلا في منشأ انتزاعه.ثمّ أنّ هناك فرقاً بين الأمر الانتزاعي والأمر
الاعتباري، وهو فرقٌ جوهريّ:فـ الأمر الانتزاعي لا حقيقةَ له سوى منشأ انتزاعه، والعقلُ لا يجعلُ له وجوداً مستقلاً، فهو مجرّد لحاظٍ ذهنيّ.
أمّا الأمر الاعتباري، فله حقيقةٌ في عالم الاعتبار، إذ يقوم على جعلٍ وإنشاءٍ عقلائيٍّ تترتّب عليه الآثار عرفاً وشرعاً، كالقوانين والعقود والعلامات المرورية والرموز اللغوية، فكلّها أمور اعتباريةٌ يعتدّ بها العقلاء ويُنشئ الشارعُ أو المجتمعُ آثاراً حقيقيةً مترتّبةً عليها.
وعليه، فمقصودُ الشيخ مجتبى الطهراني(قده) من قوله: "كلّ ما يُتصوَّر جامع فهو أمرٌ انتزاعي" هو أنّ الجامع الملحوظ بين الأحداث (كالجنابة والنوم والبول والغائط) ليس جامعاً ماهوياً ذا حقيقةٍ نوعيّةٍ ، بل هو جامع انتزاعي ذهنيّ، وحيث إنّ الأمر الانتزاعي لا يكون محلاً للآثار، فـ الآثار الشرعيّة لا تُرتّب إلا على الأفراد المشخَّصة دون الجامع الانتزاعي بينها.
ثمّ تصدى (قده) لدفعَ ما يمكن أن يرد عليه بطريق قريب ممّا ذكره الميرزا الزنجاني(قده)، فقال: "وأمّا اشتراكُ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ في بعضِ الأحكام — كما في عدمِ جوازِ الدخولِ في الصلاة، أو مسِّ كتابةِ المصحفِ الشريف، ونحو ذلك — فليسَ ذلك موجباً للحكمِ بأنّ الحدثَ الجامعَ بين الحدثين هو موضوعُ الحكمِ الشرعي. ألا ترى أنّ ما ورد في رواياتِ بابِ الوضوء من عدِّ البولِ والغائطِ والريحِ والنوم عللاً أربعاً، مع اشتراكِها في الأثر".
وحاصلُ كلامه(قده): إنّ اشتراكَ الأحداثِ المختلفة — كالنوم، والبول، والريح، والغائط — في بعضِ الآثار الشرعيّة لا يكشفُ عن وجودِ جامعٍ واحدٍ بينها، يترتَّبُ عليه الأثر بعنوانِ "كليّ الحدث"، بل العبرةُ في ترتّبِ الحكم ليست عنوان "الحدث الأصغر" أو "الحدث الجامع"، وإنّما بكلٍّ من هذه الأسباب الخاصّة بنفسها، فهي كالعللٌ المستقلّة وإن اشتركت في معلولٍ واحدٍ.
وبيانُ ذلك: أنّ الشارعَ رتّبَ الأثرَ الشرعي — كوجوب الوضوء أو المنع من الصلاة ومسّ الكتاب — على نفسِ النوم بما هو نومٌ، وعلى البول بما هو بولٌ، وعلى الغائط بما هو غائطٌ، فهذه الأسبابُ وإنِ اتّحدت في الأثر، إلا أنّها مختلفةُ الحقيقة والماهية، فليس بينَها جامعٌ ماهويٌّ يُسمّى "كليّ الحدث"، بل كلٌّ منها موضوعٌ مستقلٌّ لحكمٍ واحدٍ اشتركَت فيه وغيرُها اتّفاقاً . وكأنّه(قده) أراد بهذا المثال أن ينقضَ على من توهّم وجودَ كليٍّ للحدث، ويُبيّنَ أنَّ اشتراك مايشبه العللٍ المتباينةٍ في أثرٍ واحدٍ لا يقتضي وحدةَ والمعلول ووحدة الموضوع ، فالموضوعاتُ باقيةٌ على تباينها الذاتيّ، وإن اتّحدت في الحكمِ المترتّب عليها.
فالنتيجة: أنّ الشيخ مجتبى الطهراني(قده) يتّفقُ في هذا المضمون مع كلٍّ من الميرزا الزنجاني(قده) وسيّدنا الأستاذ السيّد محمّد سعيد الحكيم(قده)، في أنّ ما يُسمّى بـ"كليّ الحدث" ليس محطّاً للآثار الشرعية، بل الأحكامُ مجعولةٌ على الأحداث الجزئيّة المعيّنة، لا على جامعٍ انتزاعيٍّ بينها. وهذا هو رأيه الشريف في المقام. ثم انه تعرض لما أفاده المحقق النائيني في الجواب عن الإشكال وناقش فيه حيث ذكر أنّ المحقّق النائيني بنى جوابه في المقام على قاعدةٍ دقيقةٍ مفادها: " أن التفصيلُ قاطعٌ للشركة".
بيانُ ذلك: أنّ النائيني(قده) استند في جوابه إلى المقابلة الواردة في الآية الشريفة بين الوضوء والغسل، فقال: إنّ قوله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ …﴾ وفي مقابلها قوله تعالى:﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾،﴾ يدلّ على أنّ هناك مقابلةً بين النوم والجنابة، كما أنّ هناك مقابلةً بين الوضوء والغسل، فكلٌّ منهما ذُكر على نحوٍ يقطع الشركة بين الموردين، أي يُثبت أنّ لكلٍّ منهما خصوصيّةً مستقلّةً في الحكم والموضوع.
فالمعنى أنّ التفصيلَ بين الأمرين في الآية الكريمة يدلّ على أنّ الوضوء له أثرٌ مخصوصٌ لا يجتمع مع أثر الغسل، والغسل كذلك له أثرهُ الخاصّ، ومن هذه المقابلة في الاية يستفاد أنّ وجوب الوضوء مقيّدٌ بعدم الجنابة، لأنّ التفصيلَ بين الموردين — في قوله تعالى: "وإن كنتم جنباً فاطّهروا" — يقطع الشركة في الحكم بينهما.
ولهذا، كما يقول الشيخ مجتبى الطهراني(قده)، فإنّ المحقّق النائيني(قده) أقام جوابه على أساس هذه القاعدة "التفصيل قاطع للشركة"، فجعلها أساساً دلالياً لاستظهار خصوصية كلٍّ من الموردين، وأنّ الشارع جعل الوضوء مشروطاً بعدم تحقق الجنابة، في مقابل جعل الغسل حكماً يختصّ بالجنابة نفسها، فلكلٍّ من الموردين حكمُه الخاصّ الذي يمنع من الاشتراك .
ولكن الشيخَ الطهراني(قده) توجّه بالنقد إلى ما أفاده المحقّق النائيني(قده) في استظهاره القاعدة المذكورة اي "التفصيل قاطع للشركة" من الآية الشريفة، بدعوى أنّ المقابلة في الآية تدل على كونَ الوضوء مشروطاً بعدم الجنابة (شَرطاً عدمياً). ويرى الطهراني أنّ هذا الاستظهار غيرُ تامّ؛ لأنّ ظاهر الآية ــ على ما يُستفاد من تفسير الرواية ــ ليس جعلَ شرطٍ عدميّ، بل إبرازُ الأسباب المتعددة : فـالنوم سببٌ لوجوب الوضوء (الحدث الأصغر)، والجنابة سببٌ لوجوب الغُسل (الحدث الأكبر). فالمقام مقامُ تعدّدِ الأسباب وتعدّدِ المسبَّبات، لا مقامُ قيديةِ عدمِ أحدهما في موضوع الآخر.
ويُقرّب(قده) ذلك بمثالٍ عرفيٍّ: وهو "إذا جاء زيدٌ فأكرِمْه، وإذا جاء عمرو فأهِنْه". فمجيءُ زيدٍ سببٌ للإكرام، ومجيءُ عمرو سببٌ للإهانة، من غير توقّفٍ لأحد الحكمين على عدم سبب الحكم الآخر؛ فقولنا: إذا جاء زيد فأكرمه ليس معناه: إذا جاء زيد ولم يأتِ عمرو فأكرمه. بل كلُّ جملةٍ شرطيّةٍ هنا مستقلّةٌ شرطأ وجزاءا : لها مقدّمٌ (المجيء) وتالٍ (الحكم)، وسببٌ ومسبّبٌ، من دونِ اشتراطٍ عدميّ بين الجملتين.
وعلى هذا القياس، يُخاطِب الطهرانيُّ النائينيَّ في تفسير الآية: إنّ فيها سببين مستقلّين: النومُ سببُ الوضوء، والجنابةُ سببُ الغُسل. فـوجوبُ الوضوء غيرُ مشروطٍ بعدمِ الجنابة، تماماً كما أنّ وجوبَ الإكرام غيرُ مشروطٍ بعدمِ مجيءِ عمرو في المثال المذكور. ولذا بناءً على الاقتصار على مدلول الآية وحدها ــ مع غضّ النظر عن روايات عدم اجتماع الوضوء والغسل ــ يلزم القولُ بإمكان الاجتماع: فمَن أحدث بالأصغر يتوضّأ، ومَن أجنب يغتسل، وحيث قد يفرض اجتماعهما فلا مانع من ثبوت الحكمين معاً بحسب قانون السببيّة المستفاد من ظاهر الآية. وعليه، فتصويرُ المقام بأنّ فيه شرطاً عدمياً ــ كما صوّره النائيني(قده) ــ غيرُ صائب؛ والصحيح أنّ لدينا جملتين شرطيتين مستقلّتين، لكلٍّ منهما مقدّمٌ وتالٍ، وسببٌ ومسبّب، من غير اشتراطِ عدمِ أحدهما في موضوع الآخر. هذا خلاصةُ
ردِّ الشيخ مجتبى الطهراني(قده) على تقرير المحقّق النائيني(قده).
لذلك قال في معرض نقد المحقق النائيني "ولكنه يقال أولاً انما قاله من التفصيل بين النوم والجنابة والوضوء والغسل في الآية الشريفة قاطع للشركة في غير محله؛ لأن من الواضح ان التفصيل في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه وإذا جاءك عمرو فأهنه لا يدل على أن المجيء الذي هو سبب في وجوب اكرام زيد مقيد بعدم مجيء عمرو، أو ان موضوع الإكرام مركب من مجيء زيد وعدم مجيء عمرو وهكذا، الأمر بالنسبة إلى إهانة عمرو بل التفصيل هنا يدل على أن مجيء زيد سبب مستقل لوجوب إكرامه وان مجيء عمرو سبب مستقل آخر لوجوب إهانته فإذا اجتمع السببان يؤثر كل منهما في مسببه و ( عليه ) فمجرد ذكر الغسل عقيب الوضوء والجنابة عقيب النوم لا يدل على ما ذكره رحمه الله ، على أن العطف في الآية الشريفة بالواو دون ( أو ) شاهد على ما قلنا، - ونتيجة ما أفاد - فعلى هذا لو لم يكن دليل غير هذه الآية على اكتفاء الغسل عن الوضوء لكنا نحكم بأن الواجب عند اجتماع النوم والجنابة بالجمع بين الوضوء والغسل ".
وللكلام تتمة...
[ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ]


