47/05/03
الاستصحاب الكلي/الاستصحاب الكلي /الأصول العملية
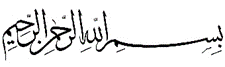
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب الكلي /الاستصحاب الكلي
لا يزال البحث في ذكر الأجوبة التي طُرحت في مقام دفع الإشكال الموجَّه إلى الشيخ الأعظم (قدّه) وكل من قال بجريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث، وحاصل الإشكال كما تقدم بيانه مرارا: إنّ المكلف إذا استيقظ من نومه وشكّ في صدور حدث الجنابة منه أثناء النوم، فيكون حينئذٍ متيقِّناً بحدوث الحدث الأصغر ــ وهو النوم ــ ومحتَمِلاً لحدوث الحدث الأكبر ــ وهو الجنابة ــ، فلو توضأ يشك في بقاء الكلي - من القسم الثالث - فعلى ضوء من قال بجريان الاستصحاب فيه يلزم المكلف استصحاب كلي الحدث، فيحكم حينئذٍ ببقاء الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر، ويجب عليه الغُسل ولا يكفيه الوضوء.
غير أنّ هذه النتيجة لم يلتزم بها أحد من الأعلام، إذ اتفقت فتاوى الفقهاء على كفاية الوضوء في مثل هذا الفرض، وجواز مباشرة المكلف لما يشترط فيه الطهارة من الصلاة والمكث في المسجد وغيرهما، من دون حاجة إلى الغسل.
ومن هنا تصدّى جماعة من الأعلام ــ كصاحب الأوثق، وسيدنا الأستاذ الحكيم (قدّه)،
والسيد عبد الله الشيرازي (قدّه) ــ للإجابة عن هذا الإشكال، وقد تقدّم الكلام في بيان أجوبتهم ومناقشاتها تفصيلاً.
ثمّ وصلت النوبة إلى ما أفاده المحقق النائيني (قدّه) في هذا المقام، وقد ابتدأ بتقديم مقدّمةٍ أوضح فيها أنّ لهذا المثال خصوصيّةً، وقد اسهب في تحليل نفس المثال دون أن يتعرّض إلى أصل الإشكال الذي أورده القوم، بل انحصر جوابه في خصوص المورد التطبيقي.
فقال (قدّه) "سواء قلنا بجريان الاستصحاب في هذا القسم من الكلي أو لم نقل…"([1] )
وحاصل ما أفاد (قدّه) أنّ المثال ــ أعني ما إذا استيقظ المكلّف من نومه واحتمل حدوث الجنابة أثناء نومه ــ له خصوصيّة تخرجه عن دائرة الإشكال النظري؛ إذ إنّ المكلّف في مثل هذا المورد يجوز له أن يباشر الصلاة وسائر ما يشترط بالطهارة، ولا يجب عليه الغسل، بل يكفيه الوضوء فقط.
والدليل على ذلك ما صرّح به (قدّه) في عبارته المتقدّمة من الفوائد، حيث فصّل الكلام في وجه هذا الجواز وبيّن أنّ هذا المورد لا ينطبق عليه مبنى استصحاب الكلي الذي بنى عليه الشيخ الأعظم، بل له حكمٌ خاصّ مستفاد من النصوص والارتكاز العملي بين المتشرعة .
ثمّ بيَّن المحقق النائيني (قدّه) بعد ذلك أنّ الآية الشريفة في سورة المائدة قد تضمّنت بيان الطهارة المائية والطهارة الترابية؛ فالطهارة المائية اشتملت على تفصيلٍ بين الوضوء والغُسل، ثم عُقّبت ببيان الطهارة الترابية، أي التيمم.
ومورد الحاجة في المقام هو الطهارة المائية بنوعيها، أعني الوضوء والغسل، لما لهما من ارتباطٍ مباشر ببحث الحدثين الأصغر والأكبر.
وقد تقدّم ــ منه (قدّه) ــ أنّ المراد من القيام إلى الصلاة في الآية(بمعونة موثقة ابن بكير) القيام من النوم فالمراد من قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ أي إذا قمتم من النوم، فالنوم هو الموضوع لوجوب الطهارة، وحينئذٍ يكون مفاد قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ هو الأمر بالوضوء عند تحقق هذا الموضوع.
وأمّا قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطَّهَّروا﴾ فهو موضوعٌ آخر يقابل الأول، وموضوعه الجنابة، وحكمه الغسل.
وعلى هذا الأساس، يظهر أنّ الآية الكريمة قد أقامت مقابلةً بين موضوعين: النوم والجنابة، ومقابلةً أخرى بين حكمين: الوضوء والغسل. فصار التفصيل الوارد في الآية تفصيلاً بين موضوعين متغايرين وحكمين مختلفين. ومن هنا قال (قدّه): "والتفصيل قاطع للشركة"، أي إنّ التفصيل الوارد في الآية يقطع اشتراك أحد الموضوعين في حكم الآخر؛ لأنّ اختلاف الموضوع يستلزم اختلاف الحكم، فموضوع النوم غير موضوع الجنابة، فحكم النوم ــ هو الوضوء ــ وحكم الجنابة ــ هو الغسل.
ومن هذا البيان يتضح أنّنا نستفيد من الآية قيدين: قيداً وجودياً، وهو تحقق النوم، المستفاد من قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) بمعونة الموثقة.
وقيداً عدمياً، وهو عدم الجنابة، المستفاد من مقابلة الوضوء للغسل في الآية ومبدأ " أن التفصيل قاطع للشركة".فبمعونة الرواية والتفصيل في الآية يصبح المراد من الآية هو التالي:"يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم ــ ولم تكونوا جنباً ــ فتوضؤوا".
وعليه، فموضوع الوضوء مركّب من قيدين: أحدهما وجوديّ (النوم)، والآخر عدميّ (عدم الجنابة).
ومن ثمّ، فإنّ المكلف في المثال الذي هو مورد الإشكال ــ وهو من استيقظ من نومه فاحتمل الجنابة ــ لا يمكن أن يكون مكلفا بالوضوء والغسل معا بمقتضى التفصيل وقطع الشركة بل هو مكلف بالوضوء فحسب بعد احراز موضوعه وهو النوم المتحقق في المثال وجدانا وعدم الجنابة المتحقق في المثال بالأصل كما سيأتي. وأما الغسل فموضوعه الجنابة
وهي لم تحرز في المقام
فتكون النتيجة ــ كما خلص إليها المحقق النائيني (قدّه) ــ أنّ هذا الإشكال الموجَّه إلى الشيخ الأعظم (قدّه) من خلال مثال النائم المحتمل للجنابة غير واردٍ ؛ لأنّ هذا المثال ذو خصوصيةٍ شرعيةٍ بيّنتها الآية الشريفة والروايات المفسِّرة لها.
نعم، يمكن توجيه الإشكال إلى الشيخ الأعظم من طريق مثالٍ آخر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وهذه خلاصة ما أفاده المحقق النائيني (قدّه) في دفع هذا الإشكال وبيان وجه خصوصية هذا المورد.
ثمّ تممّ المحقق النائيني (قدّه) بيانه بتوسعةٍ توضِّح الأساس الذي ابتنى عليه حكمه في هذا المثال، فقال (قدّه) "والحاصل: أنه يُستفاد من الآية الشريفة كون الموضوع لوجوب الوضوء مركباً من النوم وعدم الجنابة، فيكون المثال المتقدّم من صغريات الموضوعات المركبة."([2] )
وحاصل مراده (قدّه): أنّ الموضوعات المركّبة هي ما يتألّف من جزأين أو أكثر، أحدهما قد يكون وجودياً والآخرعدمياً، ويُحرَز كلّ جزءٍ منهما بوجهٍ من الوجوه: فربّما يُحرز أحد
الأجزاء باليقين الوجداني، والآخر بأصلٍ شرعيٍّ تعبّدي.
وبيان ذلك: أنّ المكلَّف في المثال المذكور ــ وهو من استيقظ من النوم فاحتمل الجنابة ــ قد أحرز الجزء الأول من الموضوع، وهو النوم، بالوجدان؛ إذ هو كان نائماً حقيقة، فثبت بذلك تحقق الحدث الأصغر.
وأمّا الجزء الثاني، وهو عدم الجنابة، فلم يحرزه بالعلم، بل شكّ في تحققه، وهنا يجري استصحاب عدم الجنابة لإحراز هذا القيد العدمي تعبّداً.
وعليه، فقد أُحرز مجموع الموضوع المركّب بكلا جزأيه:الجزء الوجودي (النوم) أُحرز بالوجدان.والجزء العدمي (عدم الجنابة) أُحرز بالأصل، أي بالاستصحاب.
ومن هنا قال (قدّه) إنّ هذا المثال من صغريات الموضوعات المركبة، أي من الموارد التي يتحقق فيها أحد جزئي الموضوع بالوجدان، والآخر بالأصل.
وهذا المنهج مطابق للقاعدة في باب الأصول العملية، لأنّ جريان الأصل لا يتوقف على العلم، بل يجري في موارد الشك، وقد ترتّبت الثمرة هنا ــ وهي الحكم بوجوب الوضوء دون الغسل ــ نتيجة لإحراز الجزئين بهذا النحو.
لذلك قال(قده): " فان النائم الذي احتمل الجنابة قد أحرز جزئي الموضوع لوجوب
الوضوء وهو النوم بالوجدان وعدم الجنابة بالأصل ، فيجب عليه الوضوء ، وإذا وجب عليه الوضوء لا يجب عليه الغسل لما عرفت : من أنه لا يجتمع على المكلف وجوب الوضوء والغسل معا، لان سبب وجوب الوضوء لا يمكن أن يجتمع مع سبب وجوب الغسل ، فان من أجزاء سبب وجوب الوضوء عدم الجنابة ، فلا يعقل أن يجتمع مع الجنابة التي هي سبب وجوب الغسل ، فإنه يلزم اجتماع النقيضين ، ففي المثال لا يجب على المكلف إلا الوضوء" وعليه فالإشكال على الشيخ الأعظم غير وارد.
وتأكيداً لما تقدّم بيانه نقول: إنّ الإشكال الموجَّه إلى الشيخ الأعظم (قدّه) من خلال هذا المثال بالخصوص قد تصدّى له الأعلام في مقام الجواب، وذلك لأنّ المثال المذكور من الموارد الابتلائية ، فاقتضى توجيه العناية إليه وبيان وجه الحكم فيه.
غير أنّه بالتحقيق يتبيّن أنّ كثيراً من تلك الأجوبة لم تتعرض لأصل الإشكال العلمي المرتبط باستصحاب الكلي من القسم الثالث، بل اقتصرت على الجواب عن نفس المثال التطبيقي، لما له من خصوصيةٍ شرعيةٍ دلّ عليها النص القرآني والرواية المفسِّرة، كما أفاده المحقق النائيني (قدّه).
ومن هنا يمكن القول: إنّ هذا المثال خارجٌ عن مورد الإشكال تخصصاً، لورود النص
الشرعي فيه، فليس داخلاً في محل النزاع الأصولي ابتداءً، بل له حكمٌ خاصّ مستقلّ، كما في الآية والرواية اللتين دلّتا على أن المستيقظ من النوم إن لم يحرز الجنابة فوظيفته الوضوء، لا الغُسل، كما مرّ بيانه تفصيلاً.
وأمّا سائر الأمثلة التي يمكن أن تُتخذ مورداً للإشكال على مبنى الشيخ الأعظم (قدّه)، فهي من الموارد التي لا يوجد فيها نصّ شرعي خاصّ، بل يدور الأمر فيها بين احتمالين عقلائيين يترتب عليهما الأثر العملي.
ففي مثل هذه الموارد، يمكن الالتزام بجريان الاستصحاب على مبناه الشريف في القسم الثالث من الكلي.
ومن أمثلة ذلك ما لو دار أمر المكلّف بين أن يكون مديوناً بعشرة دنانير أو بعشرين ديناراً، فهنا قد علم إجمالاً بثبوت أصل الدين، لكن يشكّ في مقدار الاشتغال: هل هو عشرة أو عشرون؟ فبناءً على مسلك الشيخ الأعظم، لو أدى العشرة يجري استصحاب كلي الدين في حقه لإثبات بقاء الاشتغال بالدين مطلقاً، وإن شك في مقداره.
وقد ذكر السيد اليزدي (قدّه) ــ كما تقدّم في حاشيته على الرسائل ــ أنّه لا مانع من جريان
الأصول الحكمية الحاكمة في مثل هذا المورد وان أمكن معارضته بالأصل الحكمي الآخر
وبعد التعارض والتساقط يبقى استصحاب الكلي سليما على تفصيل مذكور في حاشيته فراجع.
إذن، يتلخّص من مجموع ما تقدّم أنّ الأقوال في مقام الجواب عن الإشكال المتوجَّه إلى الشيخ الأعظم (قدّه) ــ في مثال من استيقظ من النوم واحتمل الجنابة ــ قد تفرّعت إلى ثلاثة آراءٍ رئيسة، يمكن بيانها على النحو الآتي:
الرأي الأوّل: رأي سيدنا الأستاذ (قدّه) ذهب (قدّه) إلى أنّ عنوان الحدث لم يُؤخذ في الروايات بعنوانٍ كلّي، بل أخذ بعنوانٍ جزئيٍّ، كعنوان النوم أو الجنابة أو البول ونحوها.
وعليه، فليس عندنا في لسان الأدلّة ما يدلّ على جعل حكمٍ لكلي الحدث، بل الأحكام إنّما تعلّقت بالاحداث الخاصة بخصوصياتها، ومن ثَمّ لا وجه لجريان استصحاب الكلي في باب الحدث؛ إذ لم يُؤخذ في موضوع الحكم إلا العنوان الخاص، لا الجامع بين الأحداث.
وبذلك يُرفع الإشكال رأساً، لأنّ مورد الاستصحاب ــ أي كلي الحدث ــ غير متحقّق موضوعاً في لسان الأدلة.
الرأي الثاني: رأي السيد عبد الله الشيرازي (قدّه) حيث ذهب إلى أنّ الطهارة هي الشرط في
الصلاة وسائر المشروطات، لا مجرد انتفاء الحدث.
ومن ثمّ، لا يمكن إحراز الطهارة إلا بإحراز تمام أجزائها وأسبابها، أي بضمّ الغسل إلى الوضوء عند احتمال الجنابة، وذلك لتحصيل اليقين بحصول الطهارة الشرعية التامّة.
فإذا احتمل المكلف الجنابة بعد نومه، وجب عليه الغسل ليحرز الطهارة المعتبرة في المشروطات؛ لأنّ مجرد الوضوء لا يكفي في إحراز الطهارة الكاملة المحتملة الارتفاع بالغسل.
فالمبنى هنا يقوم على قاعدة وجوب إحراز الشرط، لا على أصل الاستصحاب.
الرأي الثالث: رأي المحقق النائيني (قدّه) وقد ذهب الى أنّ موضوع وجوب الوضوء مركّب من قيدٍ وجودي (وهو النوم) وقيدٍ عدمي (وهو عدم الجنابة).
فالمكلف إذا استيقظ من نومه فقد أحرز القيد الوجودي بالوجدان، لأنه كان نائماً بالفعل، وأمّا القيد العدمي فيُحرز بالاستصحاب، لأنّ الأصل عدم الجنابة.
وبذلك يكتمل الموضوع المركّب تعبّداً ووجداناً، فيثبت وجوب الوضوء دون الغسل لعدم اجتماع سببهما بمقتضى التفصيل الثابت في الاية.
وقد استُشهِد على ذلك بـسيرة المتشرعة، فإنّ الناس دأبوا على الوضوء عند الاستيقاظ من النوم، ولم يُعرف من الشرع إلزام بالغسل في مثل هذا الفرض، مع احتمال الجنابة فقط .
ثمّ جاء في كتاب تحرير الأصول للمحقق الميرزا محمد باقر الزنجاني (قدّه) ــ وهو من أبرز تلامذة المحقق النائيني (قدّه) ــ ما يُعدّ رأياً جديداً في هذا المقام، إذ نقل كلام أستاذه وناقشه بإيرادٍ دقيقٍ يُظهر استقلالية نظره العلمي، فبيّن رأيه الخاص في المسألة، ووجّه إشكالاً على أستاذه المحقق النائيني فيما أفاده .
وعليه، فإنّ رأي الشيخ الزنجاني (قدّه) يُعدّ الرأي الخامس في سلسلة الأجوبة عن الإشكال المتوجَّه إلى الشيخ الأعظم (قدّه)، بعد الآراء الأربعة السابقة:
الأول: رأي صاحب الأوثق.
الثاني: رأي سيدنا الأستاذ (قدّه).
الثالث: رأي السيد عبد الله الشيرازي (قدّه).
الرابع: رأي المحقق النائيني (قدّه).
وقد أضاف الميرزا الزنجاني (قدّه) في تحرير الأصول بُعداً جديداً في معالجة المسألة.
فقد ذكر في تحرير الأصول مطلبين أساسيين:الأول: بيان رأيه في المثال الذي دار حوله
الإشكال، والثاني: مناقشة أستاذه المحقق النائيني (قدّه) فيما أفاده في تفسير هذا المثال.
أفاد (قدّه) أنّ المثال الذي ذكره الأصحاب ــ وهو مورد من استيقظ من النوم فاحتمل
الجنابة ــ لا تترتب عليه ثمرة ، لأنّه لا يوجد أثر شرعي مترتّب على القدر المشترك بين الحدثين، أي على كلي الحدث.
وبيّن أنّ الأثر الشرعي إنّما هو مترتّب على الخصوصية والنوع الخاص من الحدث، أعني خصوص الحدث الأصغر أو خصوص الحدث الأكبر، لا على الجامع بينهما.
فلو لاحظنا موارد الأحكام، لوجدنا أنّ الشارع قد جعل لكلٍّ من الحدثين أثراً خاصاً، وإنْ اتّفق أحياناً أن يشترك الحدثان في أثرٍ واحد، إلّا أنّ هذا الاشتراك لا يدلّ على كون الأثر مترتباً على الكلي الجامع بينهما، بل هو مجرد تشابهٍ في الأثر، لا اشتراكٍ في العلّة أو الموضوع.
ولذلك يمكن أن نذكر مثالاً توضيحياً،: إنّ المحدث بالأصغر لا يجوز له مسّ كتابة القرآن الكريم، كما أنّ المحدث بالأكبر كذلك لا يجوز له المسّ، إلّا أنّ هذا لا يعني أنّ الحكم مترتب على كلي الحدث، بل إنّ لكلٍّ من الحدثين علّته الخاصة، غاية الأمر أنّ الأثر اتّحد صورةً في الخارج.
فاجتماع الأثرين في موردٍ واحدٍ لا يدلّ على وحدة العلّة أو الموضوع، بل هو من قبيل نسبة العموم والخصوص المطلق، أي أنّ الحدث الأكبر يشمل الأصغر من حيث الحرمة في بعض الموارد، لكنّ الأحكام الشرعية لم تُنشأ على عنوان "الحدث بما هو كلي"، وإنّما على
خصوصيّات أفراده.
ولذلك قال (قدّه) ، ما نصّه: "غاية الأمر أنّهما قد اشتركا في بعض الآثار، نحو ما ذُكر من عدم جواز المسّ والدخول في الصلاة ونحو ذلك، وهذا غير ترتّب الأثر على القدر المشترك والعنوان الجامع، وحينئذٍ لا يصحّ جريان الاستصحاب بالنسبة إلى كلي الحدث في المثال المذكور، من جهة عدم كونه موضوعا للأثر الشرعي "([3] )
وحاصل مقصوده (قدّه): إنّ الاستصحاب لا بدّ في جريانه من تحقق أثرٍ شرعيٍّ يترتب على المستصحب، سواء كان ذلك الأثر حكماً شرعياً بنفسه، أو كان المستصحب موضوعاً لِما له أثر شرعي.
فالأصل العملي ــ كاستصحاب الطهارة أو الحدث ــ ليس قضية عقلية، بل هو قضية
تعبدية شرعية، يدور مدار ما يتعلق به الشارع المقدس من حكمٍ أو موضوعٍ لحكم.
أما إذا لم يكن هناك أثر شرعي يترتب على المستصحب بعنوانه، فلا يصحّ إجراء الاستصحاب فيه؛ لأنّ حجية الاستصحاب ــ المستفادة من النصوص، كقوله (ع): "لا تنقض اليقين بالشك" ــ مختصّة بما إذا كان المستصحب ذا أثر شرعي، بحيث يكون الشارع
قد ربط به حكماً أو جعل له مدخليةً في موضوع الحكم.
وعليه، فـكلي الحدث الذي يتكلم عنه الأصحاب ليس له أثرٌ شرعيٌ بنفسه، لأنّ الشارع لم يجعل أثراً على عنوان "الحدث بما هو حدث"؛ بل جعل الآثار على الحدث الأصغر بخصوصه، وعلى الحدث الأكبر بخصوصه، وإن اشتركا في بعض الآثار كما في حرمة مسّ الكتاب والدخول في الصلاة.
لكن هذا الاشتراك في الأثر لا يساوق ترتّب الأثر على الكلي الجامع، بل هو اتفاق عرضي ناشئ من تلاقي الحكمين في بعض الموارد، لا من وحدة الموضوع.
فنتيجة كلامه (قدّه): أنّ الاستصحاب بالنسبة إلى كلي الحدث في المثال المذكور لا يجري، لأنّ المستصحب لا أثر له شرعاً، والاستصحاب ـ بحكم طبيعته التعبدية ـ لا يُجرى في غير ما له أثرٍ شرعيٍ معتبرٍ في نظر الشارع .
نعم فلو قلنا بصحة الاستصحاب وجريانه في القسم الأخير مع قطع النظر عن الاشكال السابق لم يصح مع ذلك جريانه في خصوص المثال إلا على القول بالأصل المثبت .
ثمّ بعد ذلك انتقل(قدّه) إلى طرح مثالٍ بديل.
فقال (قدّه): "فيما إذا علم بنجاسة موضعٍ معينٍ من الثوب، واحتمل مع ذلك تنجّسَ
الموضعٍ الآخر منه"
أي أنّ المكلّف قد علم يقيناً بنجاسة موضوع من الثوب وبعد تطهيره شك في بقاء النجاسة في ثوبه ، لاحتمال أنّ الموضع الآخر أيضاً قد تنجّس في الوقت نفسه، فغسل الموضع الأوّل المتيقَّن نجاسته، فارتفعت نجاسته قطعاً، غير أنّ الشك بقي في نجاسة الموضع الثاني.
وعلى هذا الفرض، يحتمل أن تكون النجاسة الكلية ــ بمعنى وجود نجاسةٍ ما في الثوب ــ قد بقيت؛ فيصدق أنّه كان هناك كلي النجاسة ووقع الشك في بقائه بعد تطهير الموضع الأول.
وعندئذٍ : بناءً على مبنى الشيخ الأعظم (قدّه) القائل بجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، يلزم القول بأنّ المكلّف يستصحب بقاء كلي النجاسة، فيحكم ببقاء النجاسة في الثوب تعبّداً، فيجب عليه تطهير الموضع الآخر المحتمل النجاسة؛ لأنّ استصحاب الكلي
يقتضي ذلك.
وأمّا على رأي من يمنع جريان الاستصحاب في هذا القسم مطلقاً ــ كصاحب الكفاية (قدّه) ومن وافقه ــ، فلا يجب على المكلّف تطهير الموضع الثاني، إذ لا يُحرز بقاء النجاسة شرعاً بعد ارتفاع المتيقَّن، ولا يجري استصحاب الكلي لإثباتها .
قال (قده):"لأجل الاحتمال المذكور ، وهو احتمال حدوث النجاسة في الموضع الآخر مقارنا لحدوثها في الموضع المعلوم ، فإنه لو قلنا بجريان الاستصحاب في المقام يلزم الحكم بعدم جواز الصلاة في ذلك الثوب "
ملخّص ما أفاده الميرزا (قدّه): إنّ المثال الوارد لا تترتب عليه ثمرة أصولية؛ لأنّه لا يوجد في لسان الشارع ما يُسمّى بـ كليّ الحدث ليكون موضوعاً لحكمٍ شرعي. فالأحكام إنّما تعلّقت بالخصوصيات، لا بالجامع بينهما.
وعليه، فإنّ استصحاب كلي الحدث في هذا المورد يكون استصحاباً لِما لا أثر له شرعاً، والاستصحاب لا يجري إلا فيما يكون له أثر شرعي إمّا حكماً أو موضوعاً لحكمٍ شرعي.
وبالتالي، فالمثال المذكور خارجٌ تخصّصاً عن موارد جريان الاستصحاب، لأنّ مناط الجريان ــ وهو وجود الأثر الشرعي للمستصحب ــ غير متحقق فيه.
والحاصل: أنّه لا يمكن استصحاب كلي الحدث لعدم وجود أثرٍ شرعيٍ مترتبٍ عليه، والقاعدة تقتضي أنّ ما لا أثر له شرعاً لا يُستصحب تعبداً.
ثم انتقل الميرزا الزنجاني (قدّه) إلى مناقشة أستاذه المحقق النائيني (قدّه) فيما أفاده، فذكر كلامه ثمّ اعترض عليه من وجهين. وسنتعرض إن شاء الله تعالى إلى تفصيل هذين الوجهين اللذين أوردهما الزنجاني (قدّه)، مع توضيح مقصوده منهما، وبيان مدى تمامية مناقشته لأستاذه المحقق النائيني .
وللكلام تتمة ..
[ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ]


