47/04/29
الاستصحاب الكلي/الاستصحاب الكلي /الأصول العملية
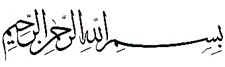
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب الكلي /الاستصحاب الكلي
قد تقدَّمَ الكلامُ في بيانِ ما اختارَهُ الشيخُ الأعظمُ (قده) ومن تبعَهُ في القولِ بجريانِ الاستصحابِ في القسمِ الثالث، سواءٌ على نحوِ التفصيلِ أو على نحوِ الإطلاق، وذكرنا ما يَرِدُ عليهم من الإشكالِ المتقدِّم. كما أشرنا إلى أنّ جماعةً من الأعلامِ قد تصدّوا للجوابِ عن ذلك الإشكال، ومنهم الشيخُ موسى التبريزي ـ أحدُ تلامذةِ الشيخِ الأعظم ـ في كتابِه الأوثق، وكذلك سيّدُنا الأستاذُ (قده)، والسيدُ عبد الله الشيرازي.
وإذا لاحظنا هذه الأجوبةَ نجدُ أنّ كلَّ واحدٍ منها يختلفُ عن الآخرِ في وجهةِ النظرِ وطريقةِ المعالجة، ولذلك كان من اللازمِ تسليطُ الضوءِ عليها؛ لأنّ الوقوفَ على مناهجِهم المختلفة في دفعِ الإشكالِ يُعينُ على فهمِ المأخذِ بدقّةٍ، ويُوضّحُ جوانبَ الإشكالِ والجوابِ معاً على نحوٍ أعمق وأتمّ.
أمّا الآن، فننتقل إلى الجواب الرابع، وهو الجواب الذي أفاده المحقّق النائيني (قده).
حيث قرّر (قده) أنّ منشأ الإشكال الوارد على الشيخ الأعظم (قده) إنّما هو المثال الذي
بُني عليه الاشكال، لا نفس المبنى في حدّ ذاته.
وبيان ذلك: أنّ المثال الذي دار عليه الإشكال هو ما إذا استيقظ المكلّف من نومه،
واحتمل أنّه قد صدر منه حدث الجنابة أثناء نومه. فهذا المثال ـ كما يقول النائيني (قده) ـ له خصوصية تميّزه عن سائر الموارد.
ثمّ أوضح (قده) أنّ هذه الخصوصية، سواء قلنا بجريان الاستصحاب أو لم نقل به، تبقى مؤثّرة في الحكم الفقهي، سيتّضح المطلب أكثر عند الاستشهاد بالآية المباركة التي سيُبيّنها لاحقاً.
وخلاصة ما أفاده: أنّ من استيقظ من نومه واحتمل صدور الحدث الأكبر منه، فوظيفته أن يتوضّأ فقط، ويكفيه ذلك في أن يأتي بجميع الأفعال المشروطة بالطهارة، كقراءة القرآن، والمكث في المسجد، ونحو ذلك؛ ولا حاجة إلى الغُسل في هذه الصورة.
وهذا الرأي يقابل ما ذهب إليه السيّد عبد الله الشيرازي (قده)، الذي رأى أنّه يجب على المكلّف أن يأتي بالغُسل ليحقّق الطهارة من الحدث الأكبر.
إذن، يظهر أنّ المحقّق النائيني (قده) قد حوّل مسار البحث من المعالجة العلميّة النظريّة للإشكال إلى الجواب العملي المتعلّق بنفس المثال، لِما للمثال من أهميّةٍ ابتلائيّةٍ عامّة؛ إذ إنّ
كلَّ مكلَّفٍ قد يتعرّض لمثله عند استيقاظه من النوم، حيث يحتمل الاحتلام أثناء نومه.
فبناءً على مبنى من يقول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث، تكون النتيجة أنّه يجب على المكلّف أن يغتسل؛ للشك في بقاء كلي الحدث البقاء، فيجري في حقه استصحاب
الحدث الكلي .
غير أنّ المحقّق النائيني (قده) خالف هذا المسلك، وقرّر أنّ لصورة الاستيقاظ من النوم خصوصيّةً ، تُخرِجها عن دائرة تطبيق استصحاب الكلي.
وبيان هذه الخصوصيّة: هي أنّ النوم من نواقض الطهارة الصغرى دون الكبرى، فالشارع جعل النوم سبباً لوجوب الوضوء فقط، لا الغسل. ومن ثَمّ، فالمكلّف إذا استيقظ من نومه يكفيه الوضوء، ولا يجب عليه الغسل، وإن احتمل صدور الجنابة أثناء نومه، لأنّ هذا الاحتمال لا يُعتنى به شرعاً في مقام العمل.
لذلك قال (قده) ما نصّه:
"أنه يجوز للمكلف في المثال فعل كلِّ مشروطٍ بالطهارة وإن لم يغتسل، سواء قلنا بجريان الاستصحاب في هذا القسم من الكلي أو لم نقل، لا لان الاستصحاب في المثال ليس من القسم الثالث بل لأن في المثال خصوصيةً تقتضي عدم وجوب الغسل وجواز فعل كل مشروط بالطهارة.([1] )"
توضيح مراده (قده): إنّ كلامه هذا لا يُراد به بيان الحكم العلمي في أصل مسألة جريان الاستصحاب وعدمه، بل هو تعرّضٌ لخصوص المثال المبحوث عنه. وأمّا أصل المطلب العلمي فقد فرغ منه سابقاً، حيث إنّه لا يذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (قده) من القول بالتفصيل في جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، بل تبنّى ما أفاده أستاذه صاحب الكفاية، من أنّ الاستصحاب في هذا القسم لا يجري. ووجه ذلك عنده أنّ العلاقة بين الكلي وأفراده ليست علاقة الأب الواحد بأبنائه المتعددين، بل هي علاقة الآباء المتعددين لأبناء متعددين، بمعنى أنّ الكلي يتعدد بتعدد أفراده؛ فالفرد الذي علمنا بارتفاعه يغاير الكلي الذي شككنا في بقائه، إذ الكلي الأول قد ارتفع بخروج ذلك الفرد، وأمّا الكلي المشكوك فحادثٌ جديد لم يتيقن بثبوته سابقاً. وعليه فمحل الشك هو الحدوث لا البقاء، فلا يجري فيه الاستصحاب.
وبعد أن حرّر (قده) المطلب العلمي بهذا البيان، التفت إلى المثال التطبيقي، وهو ما لو
استيقظ المكلف من نومه فاحتمل الجنابة، فقال: إنّ لهذا المثال خصوصيةً توجب الحكم بجواز الاكتفاء بالوضوء، وعدم لزوم الغسل، سواء قلنا بجريان الاستصحاب في هذا القسم أم لم نقل. فالتفصيل في المثال لا يرتبط بالمبنى العلمي في جريان الاستصحاب، بل بلحاظ خصوص المورد الذي يكتفى فيه بالوضوء دون الغسل.
ثم إنّ المحقق النائيني (قده) بعد ذلك استشهد بالآية الكريمة التي شُرِّع فيها الوضوء والغُسل، فقال: "وذلك لأنّ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾" [2] ، فهذه الآية قد جمعت بين الطهارة المائية والطهارة الترابية.
وبيّن (قده) أنّ الآية المباركة فصلت في بيان تفاصيل الطهارة الصغرى (الوضوء) بذكر أعضاء الغسل والمسح على الترتيب، فقالت: "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"، بينما اكتفت في بيان الطهارة الكبرى (الغُسل من الجنابة) بمجرد الإشارة إليها بقولـه تعالى: "وإن كنتم جنبًا فاطَّهَّروا"، من
غير تفصيلٍ لكيفية الغسل.
وقد قال: السيد السيستاني (دام ظلّه) ولعل الوجه في عدم ذكره سبحانه كيفية الغسل هو انّ العرب - كما في بعض الروايات - كانوا يعرفون غسل الجنابة قبل الإسلام ، فكانوا يغتسلون منه ، فاقتصر الخطاب القرآني على الإشارة الإجمالية اليه من دون الحاجة إلى البيان التفصيلي.
ومن هنا يرى المحقق النائيني (قده) وجود علاقةٍ خاصّة بين الوضوء والغسل من الجنابة، لعلّه باعتبار أنّ كليهما طهارتان مائيتان شرّعتهما الآية في سياقٍ واحد، أو أنّ بينهما جهة ارتباطٍ وبدليةٍ في بعض الموارد.
نعم، هذه الفقرة من كلام المحقّق النائيني (قده) تُعدّ من الموارد الدقيقة التي تحتاج إلى تأمّل في طريقة استفادته من الآية الكريمة.
فقد قال (قده) بعد أن استشهد بالآية المباركة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ… وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وهي ـ كما أفاد ـ تدلّ على وجوب الوضوء على من كان نائماً (مستفيداً ذلك من رواية ابن بكير المتقدّمة) ولم يكن جنباً.
تحليل مراده (قده): يُلاحظ أنّ عبارة "ولم يكن جنباً" لم ترد في نصّ الآية الكريمة، وإنّما
هي قيدٌ أضافه المحقق النائيني (قده) استظهاراً وتقييداً مستفاداً من الآية كما سيأتي ومن ضمّ الروايات إلى الآية، وعلى رأسها صحيحة ابن بكير التي فسرت القيام إلى الصلاة بالقيام من النوم.
فهو يرى أنّ الخطاب القرآني وإن كان مطلقاً في قوله "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم"، إلّا أنّ ملاحظة السنّة الشريفة ـ بلسان تلك الروايات ـ وبحسب فهمه للاية يدل على أنّ موضوع الوضوء مركب من النوم وعدم الجنابة، فضمّ الرواية إلى الآية ينتج عنده هذا القيد.
فنتيجة ذلك: أنّ وجوب الوضوء يتوقّف على شرطين: الأول- شرط وجودي: وهو تحقّق النوم، إذ النائم قد انتقض وضوؤه فيستحب أو يجب عليه الوضوء بعد الاستيقاظ.
الثاني- شرط عدمي: وهو عدم الجنابة، لأنّ الجنب لا يكفيه الوضوء، بل يجب عليه الغُسل.
وبذلك يكون موضوع وجوب الوضوء مركّباً من أمرٍ وجوديٍّ (النوم) وأمرٍ عدميٍّ (عدم الجنابة).
ثمّ أنّه لو أردنا تنقيح المناط وعدم الاقتصار على خصوص النوم في المورد، لكان مقتضى القاعدة التعميم إلى سائر الأحداث الصغرى كالخارج منه الغائط أو البول أو الريح، لأنّ الجامع بينها هو الحدث الأصغر.
ثم إن ماذكره (قده) في مقام الثبوت ممكن غير أنّ هذا يحتاج إلى دليلٍ إثباتيٍّ ينهض به، إذ الكلام ليس في مقام الثبوت فحسب، بل يتوقف على قيام الدليل وإثبات تركب الموضوع من النوم و القيد العدمي ـ وهو عدم الجنابة ـ .
لذلك قال (قده) : "فقد أُخذ في موضوع وجوب الوضوء قيد وجودي، وهو النوم، وقيد عدمي، وهو عدم الجنابة. وهذا القيد العدمي وإن لم يُذكر في الآية الشريفة صريحاً…"، وهذه العبارة جواب عن سؤالٍ مقدّر، حاصله: أنّ الآية لم تذكر هذا القيد، إذ لم يقل سبحانه وتعالى: "﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ولم تكونوا جنباً فاغسلوا وجوهكم﴾…"، فكأنّ الآية ـ بحسب تفسيره ـ أرادت أن تقول: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم"، وذلك استناداً إلى رواية ابن بكير المتقدمة التي فسّرت القيام إلى الصلاة في الآية بالقيام من النوم، فيكون اللازم ذكر القيد العدمي في الموضع التالي لذكر القيام من النوم والذي هو الموضوع للوضوء في الاية حتى يكون موضوع الوضوء مركّب من أمرين: أحدهما وجودي، وهو الاستيقاظ من النوم، والآخر عدمي، وهو عدم الجنابة، فتصير الآية ـ بحسب تفسير المحقق النائيني (قده) ـ بهذا البيان: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي من النوم ولم تكونوا جنباً فاغسلوا وجوهكم…". فالقيد الوجودي مأخوذ من رواية ابن بكير، وأما القيد العدمي فهو من استظهار المحقق النائيني،
وبما ان الرواية لا مجال للمناقشة فيها لأنها صادرة عن الإمام الصادق (عليه السلام) ونقلها ابن بكير، الثقة وهي نص في كون القيام المقصود بالاية هو القيام من النوم فهي تامة سنداً ودلالة، وأما تفسير المحقق النائيني، فحيث إنه بنفسه (قده) صرّح بأن هذا القيد لم يُذكر في الآية صريحاً، فالسؤال: من أين استفاد أنّ الآية متضمنة لهذا القيد؟ وهل ورد القيد تلميحاً، أو أنّ هناك قرينةً اعتمد عليها في هذا الاستظهار.
ثم قال (قده) مبيِّناً وجه الاستفادة: "إلّا أنّه من مقابلة الوضوء للغُسل"، وحاصل مراده في بيان وجه المقابلة أنّ الآية الكريمة بعد أن قالت: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا…﴾ إلى أن قالت: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، يظهر أنّ بين الوضوء والغُسل مقابلةً في مقام
التشريع، أي أنّ الوضوء في مقابل الغُسل.
ثم أردف (قده): "والنومُ للجنابةِ يُستفادُ منها ذلك"، أي مقابلةَ النومِ للجنابةِ ويستفاد من مقابلة الوضوء الغسل والنوم للجنابة اخذ عدم الجنابة قيدا في موضوع الوضوء، فكأنّ الآية في تحليلها البياني تقول: إذا قمتم من النوم فتوضؤوا،وتفسير "القيام" بالنوم مأخوذ من رواية ابن بكير، وأمر "فاغسلوا" مأخوذ من نفس الآية، وأمّا قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ فمعناه: استعملوا الماء في التطهير بالغُسل، كما استُعمل في الوضوء غسلاً ومسحاً.
فتكون المقابلة حينئذٍ بين الوضوء والغُسل من جهة الحكمين، وبين النوم والجنابة من جهة الموضوعين، فكما أنّ الوضوء في مقابل الغُسل، كذلك النوم في مقابل الجنابة، ومن هذا الوجه جرى الاستظهار الذي ذكره (قده) .
قال (قده): "إلّا أنّه من مقابلة الوضوء للغُسل، والنوم للجنابة – يعني قابلنا الحكمَ بالحكم، والموضوعَ بالموضوع – يُستفاد منها ذلك، أي القيد العدمي، فإنّ التفصيل بين النوم والجنابة، والوضوء والغُسل، قاطعٌ للشركة".
توضيح وملخّص مراده (قده): إنّ قوله قاطعٌ للشركة معناه أنّ هذا التفصيل يمنع من الاشتراك في الحكم، أي إنّ كلّ مورد من الموردين صار له حكمٌ مستقلّ يغاير حكم الآخر. فحينما تُفصَل الموضوعات في الخطاب الشرعي، كأن يقال: إذا جاء محمد فأعطه كتاب المكاسب، وإذا جاء علي فأعطه كتاب الجواهر، فإنّ هذا التفصيل يدلّ على أنّ الحكمين المتغايرين، ولا يشتركان في حكمٍ واحد، بخلاف ما لو قيل: إن جاء أحدهما فأكرمه، إذ لا تفصيل هنا، فيكون الموضوعان مشتركين في حكمٍ واحد.
وعلى هذا، فالتفصيل الوارد في الآية بين النوم والجنابة من جهة الموضوع، وبين الوضوء والغُسل من جهة الحكم، يدلّ على تعدّد التكليفين وتغاير موردهما، فلا يشتركان في حكمٍ واحد، بل لكلٍّ منهما حكمٌ يخصّه.
ومن هنا يتّضح أنّ هذا التفصيل لم يُؤتَ به لمجرّد البيان، بل له دلالة تشريعية على قَطع الاشتراك، أي على استقلال كلّ موضوعٍ بحكمه الخاصّ، وإلاّ لكان ذكره مؤونةً زائدةً لا موجب لها، كما في قولنا: إن لم تفقدوا الماء فتوضؤوا واغسلوا، وإن فقدتم الماء فتيمموا، فإنّ هذا التفصيل يقطع الشركة لا بين الغُسل والوضوء، بل بين الماء والتراب، لأنّ كلاً منهما صار مناطاً لتكليفٍ مغايرٍ للآخر.
ثم قال (قده): "بمعنى أنّه لا يشارك الغُسلُ الوضوءَ، ولا الوضوءُ الغُسلَ، كما يُستفاد نظير ذلك من آية الوضوء والتيمم – أيضاً قاطعٌ للشركة – فإنّ قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ يدلّ على أنّ وجدانَ الماءِ قيدٌ في موضوع وجوب الوضوء، وإنْ لم يُذكر ذلك في آية الوضوء صريحاً، إلّا أنّه من مقابلة الوضوء للتيمم يُستفاد ذلك، لأنّ التفصيل قاطعٌ للشركة".
ثم أضاف (قده): "ومن هنا نقول: إنّ القدرةَ على الماء في باب الوضوء قدرةٌ شرعية، لأنّها أُخذت في موضوع الدليل".
توضيح المقصود وبيان موضوع استطرادي.
القدرة – كما هو مقرر في علم الأصول – شرطٌ في التكليف، إذ لا يُكلَّف الإنسان بما لا يقدر عليه، وهذه القدرة في أصلها قدرة تكوينية يدركها العقل استقلالاً، فالعقل يحكم بأنّ تكليف العاجز قبيح. ولكن في بعض الموارد، نجد أنّ الشارع نفسه يذكر القدرة في لسان الدليل، كما في قوله تعالى في الحج: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، فهنا لم يكتفِ الشارع بالقدرة العقلية المفهومة ضمناً، بل جعلها بنفسها قيداً في موضوع الوجوب، فتصبح قدرةً شرعية مأخوذة في لسان الدليل، لا مجرد شرط عقلي.
فالفرق بين القدرة التكوينية والقدرة الشرعية أنّ الأولى يحكم بها العقل من دون حاجة إلى بيان شرعي، بينما الثانية تُستفاد من نفس النص الشرعي إذا جعلها الشارع قيداً للحكم. فكلّ موردٍ يُصرّح فيه الدليل بقيد القدرة أو ما يدلّ عليها، تكون القدرة فيه شرعية، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، إذ إنّ «عدم الوجدان» بمعنى العجز عن استعمال الماء أُخذ في لسان الدليل نفسه، فدلّ على أنّ القدرة على الماء شرطٌ شرعي في وجوب الوضوء.
تطبيق هذا الفهم على مورد الآية. وبناءً على هذا البيان، فإنّ قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ… وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾قد فُصِّل فيه بين موضوعين: النوم والجنابة، وبين حكمين: الوضوء والغسل. وهذا التفصيل – كما نبّه (قده) – قاطعٌ للشركة، أي يدلّ على استقلال كلّ من الوضوء والغُسل بحكمه الخاص، فلا يشارك أحدهما الآخر لا في الموضوع ولا في الحكم. فالنائم إذا استيقظ ولم يُجنب، يكفيه الوضوء، وله أن يأتي بجميع الأفعال المشروطة بالطهارة. أمّا الجنب، فوظيفته الغُسل، ولا يجزئه الوضوء.
إذن فمقتضى هذا التحليل أنّ الآية الكريمة من سورة المائدة قد بيّنت نظاماً تشريعياً قائماً على مقابلةٍ دقيقةٍ بين الوضوء والغُسل من جهة الأحكام، وبين النوم والجنابة من جهة الموضوعات، وأنّ هذا التفصيل ليس لمجرد البيان اللغوي، بل لحكاية تعدّد الموضوعات وتغاير التكاليف، وهو ما أراده المحقق النائيني (قده) من قوله إنّ التفصيل قاطع للشركة، ومنه أيضاً استُفيد أنّ القدرة على الماء – كما في آية التيمم – قدرة شرعية مأخوذة
في موضوع الحكم. وللكلام تتمة.


