47/04/28
الاستصحاب الكلي/الاستصحاب الكلي /الأصول العملية
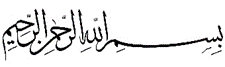
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب الكلي /الاستصحاب الكلي
قلنا أنَّ ما أفادهُ سيّدُنا الأستاذُ (قده) هو أنَّ رواياتِ الأحداثِ كلَّها ناظرةٌ إلى الحدث بعنوانه الجزئيّ، لا بعنوان كُلِّيِّ الحدث، إذ لا يُستفاد منها جعلُ أثرٍ شرعيٍّ يترتّب على الكلي بما هو كلي، بل الآثارُ إنّما تترتَّب على الأفرادِ الخاصّة من الحدث كالخارج من البول أو الغائط أو النوم ونحوها.
وعليه، فقد تبيّن أنَّ هذه المسألة تبقى علميّةً، لا ثمرةَ عمليّةَ لها، إذ إنَّ الإشكالَ الذي وُجِّه إلى الشيخِ الأعظمِ (قده) إنّما بُنيَ على افتراضِ أثرٍ مترتِّبٍ على كليِّ الحدث، ومع انتفاء هذا الأثر من الناحية العمليّة لا يبقى مجالٌ لذلك الإشكال.
ثمّ ذيَّل (قده) كلامَه بقوله:
"وهو راجعٌ إلى أنَّ موضوعَ المانعيّة مركَّبٌ من كلِّ حدثٍ بنفسه؛ - بمعنى أنَّ هذا الحدثَ بعينه هو المانعُ عن الصلاة. فإذا أُحرزَ عدمُ بعضِها بالأصل، جرتِ الأصولُ الموضوعيّةُ من دون مانعٍ من ذلك، كأصلِ عدمِ الجنابة، وعدمِ مسِّ الميّت، وهكذا. - ومع إحرازِ عدمِ الآخر بالوجدان يمكن ترتيبُ أثرِ ارتفاعِ الأحداث. وليس موضوعُ المانعيّة هو كُلِّيَّ الحدثِ ليُبتنى على جريانِ استصحابِ الكلّيِّ في المقام.([1] )"
وحاصلُ مراده (قده): أنّ المانعيّةَ ليست أمراً منتزعاً من جامعٍ واحدٍ هو كُلِّيُّ الحدث، بل هي قائمةٌ بالأفرادِ الخاصّةِ منه، فكلُّ حدثٍ بعنوانه الخاصّ هو المانع عن الصلاة. وبناءً على ذلك، تجري الأصولُ الموضوعيّةُ لإحرازِ عدمِ كلِّ واحدٍ من تلك الأحداث على حدة، ولا حاجةَ إلى استصحابِ كُلِّيِّ الحدث؛ لأنّه ليس موضوعاً للأثر الشرعيّ، بل الموضوعُ هو الحدثُ الجزئيّ، وعليه فلا موقعَ لجريانِ استصحابِ الكلّيِّ في هذا الباب.
ثمّ ننتقل إلى جوابٍ آخرٍ يحمل نكتةً دقيقة في المقام، وهو ما أفاده المرحوم السيّد عبد الله الشيرازي (قده) ، حيث قال: "إنّ الالتزامَ بجريانِ الاستصحابِ في هذا المورد – أي في القسم الثالث – ليس من جهةِ القولِ بحفظِ الحصّة المشتركة بين الفردين اللذين أحدُهما مقطوعُ الزوال والآخرُ مشكوكُ الحدوث.([2] )"
توضيحُ مراده (قده):يبدو أنّ السيّدَ الشيرازيَّ (قده) أراد أن يحملَ كلماتِ الأعلامِ على
نكتةٍ أُخرى غيرِ النكتةِ التي بُيِّنتْ سابقاً، إذ إنّهم لم يبنوا كلامَهم على مسألةِ وحدةِ القضيّةِ المتيقَّنةِ والمشكوكِ فيها كما قد يُتوهَّم، بل كان مدارُ بحثِهم في أمرٍ آخرَ تماماً.وهو: بعد العلمِ بخروجِ الفردِ الأوّل وارتفاعِه، فهل يكونُ الشكُّ في الكلّيّ – أعني بقاءَ الطبيعيّ – شكّاً في البقاء أو شكّاً في الحدوث؟فهذا هو محطُّ كلامِ الأعلام:فالشيخُ الأعظمُ (قده) ذهب إلى أنّه شكٌّ في البقاء،وكذلك الشيخُ الحائري (قده) وكرّر الإصرارَ على ذلك،بينما صاحبُ الكفاية (قده) رأى أنّه شكٌّ في الحدوث،وأمّا المحقّقُ النائيني (قده) فقد وافقَ في النتيجةِ على عدمِ الجريان، وسيأتي تفصيلُ كلامِه لاحقاً.
وعليه، فالمسألةُ ليست مبنيّةً على القولِ بحفظِ الحصّة المشتركة، بل على تحقيقِ منشأ الشكّ: هل هو شكٌّ في استمرارِ الكلّي بعد ارتفاعِ الفردِ المعلوم، أو في تجدّدِ فردٍ آخرَ يحقّقُ بقاءَه؟وهذا هو الذي دار عليه كلامُهم جميعاً، كما أشرنا إليه مراراً، إذ إنّ الشكَّ هنا وجدانِيٌّ لا يمكن رفعُه أو نفيُه، وإنّما الكلامُ في تعيين متعلَّقه: أهو البقاءُ أم الحدوثُ؟. فالأعلامُ إنّما أوردوا الإشكال على الشيخ الأعظم (قده) من جهةٍ مخصوصة، إذ بَنَوا على أنّ الكليّ الطبيعيّ لا يكون وجودُه واحداً شخصيّاً، بل هو بمنزلة آباءٍ متعدّدين لأبناءٍ متعدّدين، فكلّ فردٍ من الأفراد الخارجيّة يُمثّل وجوداً خاصّاً للكليّ، وبذلك تكون الوجوداتُ متعدّدةً بتعدّد الأفراد، لا أنّ للكليّ وجوداً واحداً مشتركاً محفوظاً بينها.
ومن هنا جاء المرحوم السيّد عبد الله الشيرازي (قده) لِيُبيِّن أنَّ ما نسبه بعضُهم إلى الأعلام من القولِ بحفظِ الحصّة المشتركة بين الفردين، ليس هو نكتةَ كلامهم الحقيقية، بل إنّ كلامهم ناشئٌ عن عدمِ اتحادِ القضيّة المتيقَّنة مع القضيّة المشكوكة، وهذا أعمُّ من محلّ النزاع في المقام؛ لأنّ اتحادَ القضيّتين من شرائطِ جريانِ الاستصحاب، وسيأتي التنبيهُ عليه في محلّه لاحقاً.
ولأجل ذلك قال (قده): "ليس من جهة القول بحفظ الحصّة المشتركة بين الفردين اللذين أحدهما مقطوع الزوال والآخر مشكوك الحدوث."
أي إنّ مرادَه بالحِصّة المشتركة هو الكليّ الطبيعيّ نفسه، فالبحثُ عندهم ليس في حفظ تلك الحصّة بين فردٍ وآخر، بل في أنّه هل الكليّ نفسه باقٍ ببقاء الاحتمال، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم (قده) القائل بأنّ الشكّ في بقاء الكليّ هو شكّ في البقاء فيُستصحب،أو أنّ هذا الشكّ راجعٌ إلى حدوث كليٍّ جديدٍ مباينٍ للأوّل، كما أفادهُ غيرُه من الأعلام القائلين بعدم الجريان، باعتبار أنّ الكليّ يتعدّد بتعدّد أفراده، فلا يكون الثاني بقاءً للأوّل، بل وجوداً جديداً له.
وعليه، يكون مدارُ الخلاف بين الأعلام في حقيقة منشأ الشكّ: هل هو شكّ في البقاء بلحاظ وحدة الوجود الطبيعيّ،أو شكّ في الحدوث بلحاظ تعدّد الوجودات بتعدّد الأفراد؟. ثمّ أردف (قده) قائلاً:"بل من جهة اتحادِ القضيّةِ المشكوكةِ فيها مع القضيّةِ المتيقَّنةِ في الوجود."
وبناءً على هذا، يتّضح أنّ محطَّ الخلاف بين الأعلام ــ بحسب ما فهمه السيّد الشيرازي (قده) ــ إنّما هو في تحقّقِ اتحاد القضيّتين وجوداً، لا في حفظِ الحصّة المشتركة أو الكلّيّ بين الأفراد.
فقد نقل (قده) محلَّ البحث إلى زاويةٍ مغايرةٍ لما طرحه سائرُ الأعلام، وجعل المدارَ على وحدة الوجود بين القضيتين: هل المشكوكُ فيه هو عينُ ما تيقّن بوجوده سابقاً أو لا؟ومن الواضح أنّ هذا تفسيرٌ خاصٌّ انفرد به (قده)، إذ لعلَّ سائرَ الأعلام لم يُصرِّحوابهذا الوجه في كلماتهم، غير أنّ السيّد الشيرازي أصرّ على أنّ هذا هو مقصودهم الواقعيّ، وبهذا وجّه البحث في مسلكٍ جديدٍ، مفاده أنّ الاختلافَ إنّما يدور حول وحدة الوجود بين المتيقَّن والمشكوك، لا حول بقاء الحصّة أو تعدّد الأفراد.
ثمّ قال (قده) بعد ذلك: "وأمّا المثالُ المذكور – الذي أوردناه وصار منشأً للإشكال على الشيخ الأعظم (قده) – فإن كان حدثُ البولِ والجنابةِ من قبيلِ الضدّين، فلا يجري الاستصحاب."
توضيحُ مراده (قده): إنّ مورد البحث هو ما إذا اجتمع في المكلّف حدثان: أحدهما حدث البول، والآخر حدث الجنابة. فهل العلاقة بينهما علاقةُ الضدّية بحيث يمتنع اجتماعهما، أو لا؟ فبيّن (قده) أنّه لو فُرض أنّهما من الضدّين، فلا مجال لجريان الاستصحاب.
إلّا أنّه قد يُقال: إنّ الحدث من الأمور الاعتباريّة التي أنشأها الشارعُ المقدّس، فإطلاق عناوين الضدّية عليها ــ بمعناها المنطقيّ ــ ليس على وجه الحقيقة، بل هو من باب التسامح والتماشي . ومع ذلك، لا مانع من تطبيق قواعد التضادّ على القضايا الاعتباريّة ما دامت تُعامَل معاملة التنافي في الآثار الشرعيّة.
وحاصل المعنى حينئذٍ: أنّ الضدّية هنا بمعنى عدم الاجتماع؛ أي لا يجتمع ارتفاع
الحدث الأصغر وارتفاع الحدث الأكبر في آنٍ واحد، فلكلٍّ منهما رافعٌ خاصّ:
فـحدث البول يرفعه الوضوء، وحدث الجنابة يرفعه الغُسل.
ومن ثمّ، لو فرضنا أنّ المكلّف قد استيقظ من نومه – وهو حدثٌ أصغر – وكان في الوقت نفسه جنباً، فإنّ الحدث الأصغر لا أثر له، لأنّ المكلّف لا يكلّف بالوضوء مع وجود الجنابة، بل يكفيه الغُسل الذي يرفع الحدث الأكبر، فيرتفع معه الأصغر قهراً.
وعليه، فإنّ تعبيرهم عن الحدثين بأنّهما ضدّان إنّما هو بلحاظ عدم اجتماع ارتفاعهما في زمانٍ واحد، لا بمعنى التضادّ المنطقي أو الفلسفيّ التامّ، أي بمعنى أنّ الغسل والوضوء لا يجتمعان في مورد الجنابة، فمَن اغتسل غُسل الجنابة لم يُشرّع له ضمّ الوضوء إليه.
إذن، يتّضح أنّ السيد عبد الله الشيرازي (قده) بعد أن بيَّن أنّ محلَّ البحث ليس في استصحاب الحصّة المشتركة أو استصحاب الكليّ بما هو كليّ، أعاد توجيه المسألة إلى جهةٍ أخرى، وهي العلاقة بين الحدثين: هل هي علاقة الضدّية أو الشدة والضعف؟
فبحسب ما أفاده (قده)، إذا كانت العلاقة بين حدث البول وحدث الجنابة علاقةَ ضدّين، فإنّ اتحاد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة لا يتحقّق، لأنّ الضدّين لا يجتمعان وجوداً، فلا يمكن أن يُتَيقَّن بأحدهما ويُستصحب الآخر، كما لا يمكن أن يُتَيقَّن بالبياض ويُستصحب السواد؛ فكلٌّ منهما نقيض الآخر. ومن يرى هذه العلاقة الضدية بين الحدثين يمنع حينئذٍ من جريان الاستصحاب، لعدم إمكان فرض الوحدة بين القضيتين المتيقّنة والمشكوكة.
ولذلك قال (قده): "فإن كان حدثُ البول والجنابة من قبيل الضدّين فلا يجري الاستصحاب." ثمّ أردف قائلاً: "وهو ظاهر، لعدم اتحاد القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة، إذ يكون أحدُهما غيرَ الآخر، فكيف يُستصحب؟" فبيّن (قده) أنَّ مناطَ الجريان هو تحقّقُ الاتحاد بين القضيتين، وحيث إنّ الضدية تمنع هذا الاتحاد، فلا يبقى مجالٌ للاستصحاب.
ثمّ أضاف (قده):"وإن كان من قبيل الأشدّية والأضعفيّة…" ومقصودُه (قده) من الشدة والضعف: أنّ الحدثَ الأصغر يُمثّل مرتبةً ضعيفةً من الحدث، يُرفع بالوضوء، بينما الحدث الأكبر (كالجنابة) هو مرتبةٌ شديدةٌ منه، لا يزول إلّا بالغُسل، إذ لا تكفي فيه طهارةُ الوجه واليدين فحسب، بل يُشترط فيه تعميمُ الماءِ لجميع البدن.
فإذا كانت العلاقة بين الحدثين على نحو الشدة والضعف لا على نحو الضدية، فلا مانع
من جريان الاستصحاب حينئذٍ؛ لأنّ الضعيفَ لا ينافي الشديد، ويمكن فرضُ الاتحاد بين القضيتين في مثل هذا الفرض، بخلاف ما لو كانت العلاقة بينهما تضادّاً حقيقيّاً يمنع من الجمع بينهما أو من استصحاب أحدهما في مورد الآخر.
لذلك قال (قده): "وإن كان من قبيل الأشدّية والأضعفيّة فيجري فيه الاستصحاب لاتحاد القضيتين؛ لأنّ العرف لا يفرّق بين الشديد والضعيف، بل يراهما أمراً واحداً، ومن هنا حين ارتفاع أحدهما يُحكم ببقاء أصل الموضوع وهو الحدث في المقام، فيكون الاستصحاب فيه من قبيل الاستصحاب من القسم الثاني من استصحاب الكليّ، أي إنّ الكليّ واحد وإن اختلف بالشدة والضعف."
حاصلُ مراده (قده): إنّ السيّد الشيرازي (قده) بعد أن بيّن أنّ الضديّة تمنع من جريان الاستصحاب لعدم تحقّق الاتحاد بين القضيّة المتيقّنة والمشكوكة، عاد ليقرّر أنّه إذا كانت العلاقة بين الحدثين ليست من سنخ التضادّ، بل من سنخ الشدة والضعف، فحينئذٍ يتحقّق الاتحاد بين القضيتين عرفاً. وذلك لأنّ العرف يرى الحدث الأصغر والحدث الأكبر أمرين متّحدين في الحقيقة، غايتهما أنّ أحدهما أشدّ من الآخر، لا أنّهما حقيقتان متقابلتان أو متباينتان، فهما عنده من مراتب أمرٍ واحدٍ هو "الحدث".
وعليه، فحين يرتفع الحدث الأصغر لا يرى العرف أنّ أصل الحدث قد ارتفع، بل يراه باقياً بمرتبةٍ أشدّ هي الجنابة مثلاً، فيحكم ببقاء أصل الموضوع، أي بقاء الكليّ الحدثيّ، فيكون جريان الاستصحاب من القسم الثاني من استصحاب الكليّ، حيث يُستصحب وجود الكليّ مع احتمال بقائه في ضمن فردٍ آخر أشدّ من السابق.
ومن هنا قال (قده) في ختام بيانه: "فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل الاغتسال عن الجنابة."
أي إنّ المكلف وإن كان قد توضأ – فارتفع الحدث الأصغر – إلّا أنّ الحدث الأكبر باقٍ، وبقاءه يُثبَت بالاستصحاب لكونه من مراتب الحدث الواحد، لا من الأضداد المتقابلة، فـ لا تصحّ صلاته ما لم يغتسل.
فهذا هو تحقيق مراد السيّد الشيرازي (قده)، حيث بنى جريان الاستصحاب في المقام على وحدة الموضوع عرفاً من جهة الشدة والضعف .
فمُختارُه (قده) هو أنّ شرطَ الدخولِ في الصلاة أن يكونَ المكلّفُ متطهِّراً، بمعنى أنّ الشرط ينحلّ إلى شرطٍ وجوديٍّ وشرطٍ عدميٍّ. وهذه المسألة قد دار حولها كلامٌ واسعٌ بين الأعلام، وقد سبقت الإشارة إليها في بعض روايات الاستصحاب، وهي:هل الشرطُ في الصلاة هو إحرازُ الطهارة (بما هي أمرٌ وجوديٌّ)، أم مانعية النجاسة (أي عدمُ الحدث)؟ وبتعبيرٍ آخر: هل النجاسة مانع أو أنّ الطهارة شرط؟وللتقريب، يُمثَّل لذلك بما يُذكر في المسائل الفقهية الأخرى، كقولنا: إذا أراد المكلَّفُ أن يأتمّ بإمامٍ، أو يُجري طلاقاً بحضور الشهود، فما هو المعتبر في الإمام أو في الشاهد؟فنقول: إن قلنا إنّ المعتبر هو أن يكون الإمام عادلاً، فحينئذٍ يلزم إحرازُ العدالة، والعدالةُ تُحرَز بحُسنِ الظاهر، كما دلّت عليه رواية عبد الله بن يعفور وغيرها، فيكون المطلوب شرطاً وجوديّاً.
أمّا إذا قلنا إنّ المعتبر هو عدمُ الفسق، فحينئذٍ يكون الفسقُ مانعاً لا أنّ العدالة شرطٌ وجوديّ، فيكفي في تحقّق الشرط عدمُ ثبوتِ الفسق، ولا يُشترط إحرازُ العدالة فعلاً، كما هو الحال في باب الشهود أيضاً.
وهذا الفرق الدقيق بين الشرط الوجوديّ والشرط العدميّ له تطبيقاتٌ متعدّدة؛فكما في باب الإمامة والشهادة، كذلك يُتصوّر في باب الولاية على القاصرين مثلاً، فهل الواجب على الوليّ مراعاةُ المصلحة الفعلية في كلّ تصرّفٍ ماليٍّ على الطفل، أو يكفي
عدمُ المفسدة؟ إذ ليس من اللازم تحصيلُ الربح ما دام لا ضرر ولا فساد في التصرف.
وعليه، ففي محلّ كلامنا يَرِد السؤال نفسه: هل المطلوب في الصلاة هو إحرازُ الطهارة ـ أي الأمر الوجوديّ المعنويّ المترتّب على الوضوء أو الغسل ـ، أو أنّ المطلوب هو عدمُ الحدث ـ أي نفيُ المانع لا تحصيلُ الشرط؟. فبناءً على الأول، يجب على المكلَّف إحرازُ الطهارة الواقعية قبل الدخول في الصلاة، وبناءً على الثاني، يكفي عدمُ إحراز الحدث، إذ المدار حينئذٍ على نفي المانع لا على تحصيل الوجوديّ.
وهذا التفصيل هو الذي ينبني عليه اختلافُ المباني في جريان الاستصحاب في موارد الشكّ في الطهارة أو الحدث .
لذلك قال (قده): "والصحيحُ عدمُ جوازِ الدخولِ في الصلاة بناءً على اشتراطِ الطهارةِ في الصلاة، وإن كان الحدثُ الأصغرُ والأكبرُ من قبيل الأضداد."
ومراده (قده): أنّنا لسنا في مقام استصحاب الحدث حتى يُقال إنّ الحدثَ الأصغرَ والأكبرَ ضدّان، وأنّ استصحابَ أحدهما يتنافى مع وجود الآخر، لأنّ الكلام في شرط الصلاة لا في موضوع الحدث. فالمكلّف حين يريد الدخول في الصلاة لا ينظر إلى وجود الحدث أو عدمه بما هو حدث، بل نظره متوجّه إلى تحصيل إحراز الطهارة التي
هي شرطُ الدخول في الصلاة.
ومن هنا قال (قده): "وإن كان الحدثُ الأصغرُ والأكبرُ من قبيل الأضداد، وذلك لعدمِ اليقينِ بالطهارة في مفروض المثال، فإنّه وإن توضّأ، إلّا أنّه لم يتيقّن بحصول الطهارة به، ومع ذلك فكيف يجوز له الدخول في الصلاة وهو شاكٌّ في حصول الطهارة بذلك؟" فبيّن (قده) أنّ العبرة في المقام بإحراز الشرط الوجوديّ – أي الطهارة – إذ الطهارة أمرٌ وجوديٌّ يُشترط تحقّقه في الصلاة.
فمادام المكلّف لم يحصل له العلم بالطهارة، فدخوله في الصلاة يكون مع الشكّ في تحقّق الشرط، والشكّ في الشرط الوجوديّ يساوق الشكّ في صحة المأمور به، فيحكم حينئذٍ بعدم الجواز، لأنّ الطهارة المشكوكة لا تُحرز بها صحةُ الصلاة.
فمفاد كلامه (قده): أنّه وإن سلّمنا جدلاً أنّ الحدثين متضادّان، إلّا أنّه لا أثر لذلك في المقام؛ لأنّ جهة البحث ليست في رفع الحدث باستصحابه، بل في تحصيل الطهارة المعتبرة في الصلاة، ومادام لم يحرزها المكلّفُ واقعاً، فلا يجوز له الدخول في الصلاة المشروطة بها.
يبقى هنا وجهٌ آخر للنقاش، وهو ما يتعلّق بـ الثمرة العمليّة لما أفاده (قده).
فقد يُقال: إنّ الاستصحاب الموضوعيّ عادةً يتقدّم على الاستصحاب الحكميّ؛ غير أنّه
في المقام لا يوجد عندنا استصحاب حكمٍ، لأنّ المورد ليس مورداً لليقين السابق بالحكم الشرعيّ كي يُستصحب، بل أقصى ما في البين أنّ المكلّف شاكّ في حصول الطهارة بعد الوضوء، ولم يحرزها وجداناً، فلا مورد للاستصحاب الحكميّ بالطهارة، وإنّما الواجب عليه إحرازها فعلاً قبل الدخول في الصلاة.
لكن يمكن أن يُقال في المقابل: إنّ مورد البحث يدور بين النوم وخروج المنيّ، فهنا يُسأل: هل حصلت الجنابةُ حقيقةً أو لا؟ فإذا لم يحرز حدوثها، فهل يمكن إجراء استصحاب عدم الجنابة لإثبات الطهارة أو نفي الحاجة إلى الغسل؟ الجواب: إنّ الأعلام صرّحوا في غير موردٍ بأنّ الإحراز على نوعين: إحرازٌ وجدانيّ، وهو ما يحصل بالعلم المباشر.
وإحرازٌ تعبّديّ، وهو ما يثبته الشارع بالأصول الشرعية كأصالة الطهارة واستصحاب العدم.
وعلى هذا الأساس، يمكن أن نوجّه سؤالاً إلى السيّد الشيرازي (قده): ما المانع من أن يُجري المكلّف استصحاب عدم الجنابة تعبّداً؟ فهو قد توضّأ وجداناً، فيُحرز الوضوء بالوجدان، ويُحرز عدم الجنابة بالأصل، فيكون قد جمع بين إحراز الطهارة الوجودية من ناحيةٍ (بالوجدان) ونفي الحدث الأكبر من ناحيةٍ أخرى (بالاستصحاب الموضوعيّ).
وعليه، فاستصحاب عدم الجنابة لا يثبت أنّ المكلّف متطهّرٌ من كلّ حدثٍ، بل يثبت أنّ الجنابة – وهي سبب الغسل – غير موجودة، فلا يجب عليه الغُسل شرعاً.
ومقتضى ذلك أنّه يكفيه الوضوء فقط، إذ لا أثر عمليّ لكلّ احتمالٍ غير مقرونٍ بعلمٍ إجماليٍّ موجبٍ للاحتياط، لأنّ الاحتمالات المجرّدة لا يترتّب عليها أثرٌ شرعيٌّ ما لم يُحرز موضوعها أو يُنهض دليلٌ على الاعتناء بها. فبذلك يمكن أن يُقال: إنّ في المقام موردَ استصحابٍ موضوعيٍّ نافذ، يثبت به عدمُ الجنابة، فيبقى الوضوء كافياً، ويجوز له الدخولُ في الصلاة بلا حاجةٍ إلى الغُسل .
وللكلام بقية..
[ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ]


