47/04/26
الاستصحاب الكلي /الاستصحاب الكلي /الأصول العملية
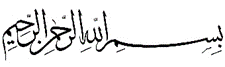
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب الكلي /الاستصحاب الكلي
تقدَّم الكلامُ في تشييدِ الأساسِ الّذي بنى عليه الشَّيخُ الحائريُّ (قده)في ما ادعاه من جريانَ الاستصحابِ مطلقاً، وقد مرّ بيانه تفصيلا، وإجماله: أنّ المطلوبَ في المقامِ هو صرفُ الوجودِ، وفي مقابلهِ العدمُ المطلقُ، فلابدَّ حينئذٍ من إحرازِ هذا العدمِ المطلقِ ليُحكم بارتفاعِ الكلي المتيقن سابقا. والحالُ أنّ هذا العدمَ لم يُحرَز لنا، ومع عدمِ إحرازِه لا مانعَ من جريانِ الاستصحابِ؛ إذ يتعلق الشكُّ حينئذ في بقاء الكلي بعدَ تحققِ اليقينِ بحدوثه، فتتحققُ أركان الاستصحاب.
وتقدّم أيضاً أنّ السيّدَ السيستانيّ (دام ظلّه) حاولَ أن يُبيّنَ المسألةَ من جهتين: الجهةِ العقليّة والجهةِ العرفيّة.
أمّا الجهةُ العقليّة فقد تقدّم بيانُها، وقلنا إنّ الأصوليّين يرون ان الامتثال في الأوامر يتحقق بالإتيان بالمأمور به بنحو صرفُ الوجودِ فيكفي الإتيان بالفرد، بينما الامتثال في النهي لا يتحقّق إلّا بانعدامِ جميعِ الأفراد.
وقد أوضحنا أنّ هذا كلَّه إنّما هو في مقام الإثبات، لا في مقام الثبوت ؛ إذ إنّ البحث هناك ناظرٌ إلى كيفيةِ إحرازِ الوجود أو العدم بحسب ما يقتضيه مقامُ الإثبات، لا إلى حقيقةِ الوجود والعدم في أنفسِهما.
وكذلك بالنسبة إلى المناطقة، فإنّهم عندما قرّروا أنّ نقيضَ الموجبةِ الجزئيةِ هو السالبةُ الكلّية، لم يكن نظرُهم إلى الوجودِ وعدمهِ خارجاً، وإنّما كان نظرُهم إلى عدمِ اجتماعِ صدقِ القضيتين في موردٍ واحد؛ أي إنّهما متقابلتان في الصدق لا في الوجود، بمعنى أنّه لا يمكن أن تصدق كلتاهما على موضوعٍ واحدٍ في آنٍ واحد، لا أنّ إحداهما تستلزم وجوداً والأخرى تستلزم عدماً في الخارج.
وتقدم أيضاً الكلام في الجهة العرفية، حيث قال السيّدُ السيستانيّ (دام ظلّه) "إنّ انقراضَ النوع عندهم لا يصدق إلّا بانعدامِ جميعِ الأفراد، ويصدق عندهم بقاءُ النوع ببقاءِ الأفرادِ المتعاقبةِ في الوجود"([1] ). وبيّن (دام ظلّه) أنّه بحسب النظر العرفي يُقال: إنّ الإنسان باقٍ من زمن آدم (عليه السلام) إلى يومنا هذا، مع أنّ الأفرادَ قد تتابعوا وجوداً وعدماً، فمِنهم من وُلد، ومِنهم من مات، ومِنهم من خرج، ومِنهم من دخل، وهكذا..، وهذا يعني عند العرف أنّ الكلّي واحدٌ مستمرّ، وإن تبدّلت أفراده، فهو بقاءٌ بالنظر العرفي المسامحيّ .
إلّا أنّه (دام ظلّه) ذكر : أنّ هذا الذي يراه العرف مبنيٌّ على المسامحة، بينما المسائلُ العلميّةُ لا تُؤخَذ من العرف إذا تسامح ، بل إنّما تُؤخَذ منه إذا كان دقيقاً في ملاحظاته.
ولذلك قال (دام ظلّه): "وأمّا تأييدُ العرف في المقام فهو ممنوعٌ أيضاً، فإنّ المراد بالبقاء هو استمرارُ الوجود".
وحاصلُ كلامه (دام ظلّه): أنّ تعريفَ الاستصحاب هو إبقاءُ ما كان، أو بقاءُ ما تيقّنّا بثبوته، فمعنى البقاء هنا هو استمرارُ الوجود نفسه، لا مجرّدُ تعاقبِ أفرادٍ متعدّدةٍ على الوجود. فكأنّ قول المعصوم(عليه السلام):"لا تنقضِ اليقينَ بالشك" يُراد به أن الشارعَ يأمرُنا تعبّداً بأن نجعل ما تيقّنّا بثبوته مستمراً في الوجود حكماً، ما لم يثبت ارتفاعُه، بغضّ النظر عن اختلاف البحث السابق في
تفسير الجملة.
وعليه، فالمتّفقُ عليه عندهم أنّ المقصود من البقاء هو الوجودُ الاستمراريّ الحقيقيّ، لا البقاء المسامحيّ العرفيّ.
ومن هنا قال (دام ظلّه): "وهو غيرُ ممكنٍ بعدَ تعدّدِه". أي إنّ القولَ ببقاء الكلّي مع تعدّد الأفراد لا يمكن برهاناً؛ لأنّ زيداً وجودٌ مغايرٌ لوجود عمرو، وعمراً مغايرٌ لبكر، فكلّ واحدٍ منهم وجودٌ مستقلّ، ولا يصحّ إرجاعُ هذه الوجودات المتعدّدة إلى وجودٍ واحدٍ مستمرٍّ بنحو الحقيقة، وإنّما هو مسامحة عرفيّة لا تصحّ علميّاً.
ثم أردف السيّدُ السيستانيُّ (دام ظلّه) قائلاً: "وأمّا بقاءُ النوعِ مع تعاقبِ الأفرادِ فهو مبنيٌّ على المسامحةِ، نحوٌ من الاعتبارِ الأدبيّ".
توضيحُ مراده (دام ظلّه): قد مرّ علينا سابقاً أنّ السيّدَ (دام ظلّه) يُفرّق بين الاعتبارِ الأدبيّ والاعتبارِ القانونيّ، وبيّن ذلك بوضوحٍ في مباحثٍ متعدّدة، كمسألة الحكومة والورود والتخصيص والتخصّص.
فالاعتبارُ القانونيّ هو ما يكون فيه المُشرِّعُ بصددِ التقنينِ الجِدّيّ، حيثُ تكون له إرادةٌ جديّةٌ في إنشاء الحكم وإرادةٌ استعماليّةٌ في التعبير عنه، فيُنشئ حكماً تشريعياً حقيقيّاً يُراد امتثاله.
أمّا الاعتبارُ الأدبيّ، فهو ما يكون المشرّعُ فيه بصدد التوسعةِ، لا إنشاءَ حكمٍ قانونيٍّ مُلزم، فيرتبط هذا الاعتبارُ بالأحاسيس والمشاعر أكثر من ارتباطه بالآثار التشريعية الدقيقة. وقد يلجأ إليه المشرّعُ أو المتكلّم لنكتةٍ بيانيةٍ أو تربويةٍ، لا لتأسيسِ حكمٍ واقعيّ.
وعليه، فقولُه (دام ظلّه): "إنّ هذا النوعَ باقٍ" إنّما هو بناءٌ على المسامحة، أي على اعتبارٍ أدبيٍّ محضٍ، لا على واقعٍ قانونيٍّ دقيقٍ، ولهذا يمكن الاستشهادُ على هذا اللون من التعبير بما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة:
"العلماءُ باقونَ ما بقيَ الدهرُ، أعيانُهم مفقودةٌ وأمثالُهم في القلوبِ موجودةٌ".
فهذا البقاءُ المنسوبُ إلى العلماء ليس بقاءً وجوديّاً حقيقيّاً، بل هو بقاءٌ أدبيٌّ معنويٌّ توسّع فيه اللفظُ عن معناه الحقيقيّ إلى معنىً اعتباريٍّ قائمٍ في النفوس والآثار.
وعليه: فالمقصودُ من مثل هذا البقاء هو التوسعةُ في المفهوم، لا تحقّقُ الوجودِ الاستمراريّ الواقعيّ الذي هو المعتبرُ في باب الاستصحاب.
إذ إنّ البقاءَ المأخوذَ في الاستصحاب هو نفسُ الوجودِ التعبّديّ من سنخِ الوجودِ السابق، بمعنى أنّ الشارعَ يُبقي ذلك الوجودَ السابقَ تعبّداً بفرضِ استمرارهِ ما لم يثبت ارتفاعُه، لا أنّه يُنشئ بقاءً أدبياً أو توسّعياً.
كما أنّ هذا الاعتبارَ الأدبيَّ — بما هو توسعةٌ وجدانيةٌ في المفهوم — لا يُصحّح وحدةَ القضيةِ المتيقَّنةِ والمشكوكَة، وهي الوحدةُ التي جعلها الأعلامُ شرطاً أساسياً في جريانِ الاستصحاب؛ لأنّ هذه الوحدةَ ينبغي أن تكون وحدةً حقيقيةً واقعيةً بين القضيتين، لا وحدةً اعتباريّةً أو وجدانية.
وقد مرّ الحديثُ عن هذه الجهةِ سابقاً، وسيتّضحُ تفصيلُها لاحقاً؛ لما لها من أثرٍ مهمٍّ في تحديدِ مدى تحقّقِ أركانِ الاستصحابِ وموضوعِه على وجه الدقّة.
ولذلك قال السيّدُ السيستانيّ (دام ظلّه): "والنظرُ العرفيُّ إنّما يُتَّبَعُ إذا لم يكن مبنيّاً
على المسامحة"([2] ). وحاصلُ مراده (دام ظلّه): إنّ الأصوليّين متّفقون على أنّ النظرَ العرفيَّ يُتَّبع ما دام غيرَ مبنيٍّ على المسامحة، أمّا إذا كان العرفُ في نظره متسامحاً غيرَ دقيقٍ، فلا يمكن بناءُ الأحكامِ العلميّةِ أو الشرعيّة عليه. وبيّن (دام ظلّه) أنّ محلَّ اتّباعِ العرف إنّما هو في المفاهيم لا في المصاديق، إذ في المفاهيم يُرجع إلى العرف لمعرفةِ المعاني اللغويّة أو العرفيّة للألفاظ، بخلاف المصاديق، فإنّ الأغلبَ أنّ العرف لا يُشخِّص المصاديقَ بدقّةٍ علميّةٍ أو شرعيّة.
وبيانه: أنّه لو قال العرفُ — مثلاً — إنّ هذا الشيءَ من مصاديق الكرّ، أو إنّ المسافةَ الفاصلةَ بين الموضعين تُعدّ مسافةً شرعيّةً، فلا يُعتَمد على نظره، لأنّ انطباقَ العنوانِ على المعنونِ في مثل هذه الموارد أمرٌ عقليٌّ دقيق، لا يُناطُ بالنظر العرفيّ.
فالمسافةُ الشرعيّةُ — مثلاً — يجب أن تكون بنفس المقدار الذي عيّنه الشارعُ المقدّسُ بالفرسخ أو الكيلومتر، ولا يُكتفى بتقريبٍ أو تسامحٍ عرفيٍّ فيها. وكذلك الكرّ في الماء، إذا كان مقدارهُ ناقصاً عن الحدّ الشرعيّ بمقدارٍ يسيرٍ، كالربع شبرٍ مثلاً، فالعرفُ قد لا يُفرّق في مثل هذا النقص، ولكنّ هذا العرفَ غيرُ معتبرٍ، لأنّ التحديدَ هنا تعبّديٌّ شرعيٌّ دقيق، فلا يصحُّ الأخذُ بتسامحِ العرفِ فيه.
ومن هذا القبيل ما يقال: إنّ العرفَ يرى أنّ الطبيعةَ الواحدةَ باقيةٌ مع تعاقبِ الأفرادِ وتبدّلِهم، فيحكم بأنّ الإنسانَ واحدٌ مستمرٌّ من زمنِ آدم (عليه السلام) إلى اليوم. فهذا أيضاً من المسامحات العرفيّة، لأنّ الواقعَ أنّ الوجوداتِ متعدّدةٌ ومتصرّمة، فلا وحدةَ حقيقيةَ بينها.
وعليه، فمثلُ هذا العرفِ المسامحيّ لا يُمكنُ أن يُصحّحَ وحدةَ القضيةِ المتيقَّنةِ والمشكوكة في باب الاستصحاب؛ لأنّ تلك الوحدةَ يجب أن تكون وحدةً واقعيّةً حقيقيّةً، لا وحدةً اعتباريةً أو تسامحيّةً، إذ عليها يبتني تمامُ أركانِ الاستصحاب وجريانُه في مقام الإثبات.
إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ (قده)، وهو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي.
فهرسةٌ لما مرّ سابقاً: ابتدأ الشيخُ الأعظم (قده) تنبيهاتِ الاستصحاب بذكر التنبيه الأوّل، وهو ما سمّاه بـ استصحاب الكلّي، وبيّن أنّه إذا كان للكلّي أثرٌ شرعيٌّ، فإنّ استصحابَه يجري على وفق أقسامٍ ثلاثة، باعتبارِ كيفيةِ وجودِ الكلّي في ضمنِ الأفراد.
وعليه يكون تقسيم الاستصحاب في الكلّي دائراً مدارَ الفرد الذي تحقّق فيه ذلك الكلّي.
أمّا القسمُ الأوّل، فهو ما قِيل بجريان الاستصحاب فيه بلا إشكال، كما في المثال الذي ذكره الشيخُ الأعظم:
إذا قلنا: "هذا زيد، وهذا إنسان"، فوجودُ الكلّي (الإنسان) متحقّقٌ في ضمن زيدٍ. فلو شككنا بعد ذلك في أنّ زيداً قد مات أم لا، فحينئذٍ يجري استصحاب الكلّي، لأنّ الشكَّ في بقاء زيدٍ عينُه الشكُّ في بقاء الإنسان الذي تحقّق بوجوده، فاستصحاب الكلّي هنا إنّما هو باستصحاب الفرد الذي كان متيقَّنَ الوجود سابقاً، مشكوكَ البقاء لاحقاً، فتتحقّق فيه أركانُ الاستصحاب التامّة.
وأمّا استصحاب القسم الثاني، فقد ذهب الشيخ الأعظم (قده) إلى جريانه، وكذلك جمهور الأعلام من بعده أجرَوه أيضاً، فبنوا على تماميّة أركانه وعدم المانع من إجرائه في هذا القسم.
غير أنّ قلةً من الأعلام خالفوا في ذلك، ومنهم المحقّق العراقي (قده)، وكذلك المحقّق الداماد ـ صهرُ الشيخ الحائريّ ـ حيث ذهبوا إلى عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم، وقد صرّح بذلك المحقّق الداماد في كلامٍ له أورده في كتابه المحاضرات في الأصول، مبيناً أنَّ أركان الاستصحاب لا تتمّ في هذا المورد.
وأمّا القسم الثالث من استصحاب الكلّي، فقد ذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ (قده) فيه إلى التفصيل، فاختار جريان الاستصحاب في قسمه الأوّل دون الثاني؛ لتماميّة الأركان في الأوّل دون الآخر.
ثم جاء صاحب الكفاية (الآخوند الخراسانيّ) فاختار عدم الجريان مطلقاً؛ لأنّ الشكّ في هذا القسم ـ بنظره ـ لا يرجع إلى الشكّ في بقاء الكلي الموجود في السابق بعينه، بل إلى احتمال وجود كلي جديد في ضمن الفردٍ المحتمل الوجود مغايرٍ للكلي المتيقَّن، فلا تتحقّق وحدة القضيّة المتيقَّنة والمشكوكة، وهي ركن أساس في الاستصحاب.
أمّا الشيخ الحائريّ (قده) فقد خالفهما، فذهب إلى جريان الاستصحاب مطلقاً في القسم الثالث، سواء كان من الشقّ الأوّل أو الثاني، مستنداً إلى أنّ المطلوب في وجود الكلي هو صرف الوجود، وأنّ العدم المقابل له هو العدم المطلق، فإذا لم يُحرز هذا العدم فلا يحرز انعدام الكلي السابق فلا مانع من استصحابه.
وعليه، فالغالبُ من الأعلام بعد الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية قد مالوا إلى عدم الجريان في استصحاب الكلّي من القسم الثالث، وعدّوه من موارد اختلال أركان الاستصحاب، إمّا لفقدان الوحدة بين القضيتين، أو لعدم إحراز بقاء الموضوع حقيقةً.
الى هنا قد انتهينا من أقوال العلماء في استصحاب الكلي من القسم الثالث ولعل الصحيح من هذه الأقوال هو القول بعدم الجريان مطلقاً لما أفاده الأعلام من أن الشك فيه ليس شكا في البقاء بل هو شك في الحدوث ثم بعد ذلك ننتقل إلى جملةٍ من الإشكالات التي أوردها الأعلام على هذا المبنى، ومن باب الاختصار نذكر إشكالاً واحداً منها، وهو من أهمّ الإشكالات التي وُجِّهت إلى الشيخ الأعظم (قده) والى من من قال بالجريان مطلقا كالشيخ الحائري (قده) .
وحاصل الإشكال: إنّ الشيخ الأعظم (قده) قال: إذا علمنا بوجود الكلّي من خلال فردٍ معيّن، ثم ارتفع الفرد يقينا إلا أننا احتملنا وجود فردٍ آخر مقارنٍ لوجود ذلك الفرد المرتفع ، فلا مانع من جريان الاستصحاب.
و لكن أُورد عليه بأنّ هذا القول يلزم منه نتائج غير مقبولة فقهياً، ويمكن تقريب الإشكال بمثالٍ واضح: لو ان شخصٌ استيقظ من نومه، فهو محدث بالحدث الأصغر قطعا (أي النوم الموجب للوضوء)، ثمّ احتمل أنّه في أثناء نومه قد خرج منه المنيّ، فيحتمل أنّه قد أصابته الجنابة (أي الحدث الأكبر).
فحينئذٍ، إذا توضّأ بعد الاستيقاظ فقد ارتفع الحدث الأصغر جزماً، لكن يبقى احتمال بقاء الحدث الأكبر؛ لأنّه لم يتيقّن بعدم الجنابة.
فعلى مبنى الشيخ الأعظم (قده) ومن قال بالجريان مطلقا كـالشيخ الحائري
(قده)، يكون هذا الشخص متيقّناً بحدوث كليّ الحدث، وشاكا في بقائه، لاحتمال وجود فردٍ آخر من الكلي (وهو الحدث الأكبر) مقارناً للفرد المتيقَّن (الحدث الأصغر) وبناءً على ذلك، يجري استصحاب الكلي في حقه، فيُحكم ببقاء الحدث تعبّداً، وبالنتيجة يكون هذا الشخص ـ على مقتضى هذا الأصل ـ محكوماً بالحدث، فلا يصحّ له الاكتفاء بالوضوء، بل يجب عليه الغُسل لتصحيح عباداته من الصلاة و المكث في المسجد وغيرها.
لكن هذه النتيجة غير معمولٍ بها عند الأعلام، بل اتّفقوا على خلافها، وقالوا:
إنّ من استيقظ من نومه ولم يتيقّن بالاحتلام، فإنّه ليس عليه إلاّ الوضوء، ويُعامل بعد الوضوء معاملةَ المتطهّر، فيصلّي ويطوف ويدخل المسجد، ولا يُطالب بالغُسل ما لم يتيقّن بالجنابة.
فمن هنا صار هذا الإشكال محطّ تساؤلٍ علميٍّ دقيقٍ: إذ كيف نُوفّق بين ما يقتضيه
استصحاب الكلّي على مبنى الشيخ الأعظم والشيخ الحائري، من لزوم الحكم
ببقاء كلي الحدث تعبّداً، وبين سيرة الفقهاء والأدلّة العمليّة التي لا تلتزم بذلك
ولا توجب الغُسل في الفرض المذكور؟ فالإشكال إذاً ينقض أصل المبنى، لأنّه يُفضي إلى لوازم غير مقبولة فقهياً، فيكون من العُقَد الأصوليّة العويصة التي تحتاج إلى تحليلٍ دقيقٍ في كيفية تصوير موضوع الاستصحاب هنا.
وقبل الشروع في مناقشة الإشكال الموجَّه إلى الشيخ الأعظم (قده) ومن تبعه في القول بجريان الاستصحاب مطلقاً، لا بُدّ من الإشارة إلى مقدّمةٍ تمهيديةٍ تتعلق ببيان العلاقة بين غُسل الجنابة، والوضوء وبين الحدث الأصغر والحدث الاكبر لما لها من ارتباطٍ وثيقٍ بمحلّ الكلام، إذ إنّ المثال الذي ورد في الإشكال يتوقف فهمه الدقيق على تحديد طبيعة هذه العلاقة.
المقدّمة: العلاقة بين غُسل الجنابة والوضوء.
اختلف الأعلام في تحديد العلاقة بين غُسل الجنابة والوضوء وبين الحدث الأكبر والاصغر على ثلاثة آراء رئيسة:
الرأي الأوّل: أن العلاقة هي علاقة التضاد:يرى فريقٌ من العلماء أنّ العلاقة بينهما هي علاقة التضادٍّ الحقيقيّ، بمعنى أنّ غسل الجنابة يضاد الوضوء وان تحقق
الغسل يرفع موضوع الوضوء، فلا يجتمعان في موردٍ واحد.
فإذا أتى المكلّف بغُسل الجنابة، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر معاً، ولا معنى لإضافة الوضوء إليه؛ لأنّ الغسل يُجزي عن الوضوء، كما نصّ على ذلك الفقهاء.
فالغُسل هنا بمنزلةِ وجودٍ يرفعُ موضوع الوضوء، فلا يجتمعان، تماماً كما لا يجتمع الضدّان في محلٍّ واحد.
الرأي الثاني: علاقة الشدّة والضعف: وذهب آخرون إلى أنّ العلاقة بين غسل الجنابة والوضوء وبين الحدث الأكبر والاصغر ليست كعلاقة التضاد ، بل هي علاقة شدّةٍ وضعفٍ؛ لأنّ كلًّا من الوضوء والغسل من سنخٍ واحدٍ، وهو ما يرفع الحدث شرعا ، لكنّ الجنابة تمثّل رفع المرتبة الشديدة من الحدث، في حين أنّ الوضوء يرفع المرتبة الضعيفة منه. فالغُسل يرفع الحدث الشديد، والوضوء يرفع الحدث الضعيف ، فالعلاقة بينهما هي علاقةُ مرتبتين من حقيقةٍ واحدة فحقيقة الحدث واحدة إلا أنها تختلف بالمرتبة ، كما هو الحال في مراتب النور والضوء.
الرأي الثالث: علاقة التخالف:
وهو رأيٌ ثالثٌ يقول إنّ الوضوء وغسل الجنابة وكذا الحدث الاكبر والاصغر حقيقتان مختلفتان نوعاً، فلا تضادّ بينهما ولا اتحاد بالحقيقة واختلاف بالمرتبة، بل هما متخالفان يمكن اجتماعهما، كما تجتمع الحلاوة والرطوبة في محلٍّ واحد.
فعلى هذا المبنى، يمكن للمكلّف أن يكون محدثاً بالحدث الأصغر ومحدثاً بالحدث الأكبر في آنٍ واحدٍ، ولكلٍّ منهما أثره الخاصّ:
فيتوضّأ لرفع الأصغر، ويغتسل لرفع الأكبر، بلا مانعٍ من اجتماعهما، لأنّ مناط أحدهما غير مناط الآخر.
ولا شكّ أنّ هذا التعدّد في الأقوال له منشأٌ عقليٌّ واعتباريّ، يرتبط بإمكانية تحقّق التضادّ أو التعارض في الأمور الاعتبارية، وهل الأحكام الوضعية والاعتبارات الشرعية تخضع لمبدأ التضادّ كما في الموجودات التكوينية، أم يمكن فيها التعدّد والاجتماع؟
وسيأتي بيان هذه المسألة بدقّة لاحقاً، عند تحليل الملاك الاعتباري في وحدة
الحدث وتعدّده.
وبعد هذه المقدّمة، نرجع إلى الإشكال الموجّه الى الشيخ الأعظم (قده) بناءً على ما ذهب إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، لنرى كيف يمكن الخروج من هذا الإشكال، وما هي الأجوبة التي قدّمها الأعلام في مقام الدفاع عن المبنى.
وسنتناول في ذلك آراء عددٍ من الأجلاء ممّن تصدّوا للجواب عن هذا الإشكال، وفي مقدّمتهم المحقّق النائينيّ (قده)، لما حظي به كلامه من اهتمامٍ بالغٍ عند الأعلام، فقد صار موضع نظرٍ وتحليلٍ دقيقٍ في كلمات من جاء بعده، وسنشير إلى تلك الآراء قبله وبعده في موضعها المناسب لاحقاً إن شاء الله تعالى.
أما الآن فمن جملة مَن أجاب عن الإشكال المذكور أحد طلاب الشيخ وهو الشيخ موسى التبريزي .
قال(قده) "أنّه لا أثر للحدث الأصغر مع وجود الأكبر .."([3] ).
وبيانه: إنّ مرادهُ (قده) من قولهِ: "أنّه لا أثرَ للحدثِ الأصغر مع وجودِ الأكبر" هو بيانُ العلاقةِ بين الحدثين من جهةِ التأثير الشرعيّ في الطهارة. فمفادُ كلامه أنّ الحدثَ الأكبر – كالجنابة – متى ما تحقّق في الإنسان، استتبعَ رفعُهُ بالغُسلِ أثرَ الحدثِ الأصغر، بحيث يُغني الغُسلُ عن الوضوء ولا يجتمعان في موردٍ واحدٍ، لأنّ الغُسلَ حينئذٍ يَسدُّ مسدَّ الوضوء تماماً.
فمن كان محدثاً بالأصغر، ثم أجنب، يكفيه غسلُ الجنابة ولا يحتاج إلى وضوءٍ قبله أو بعده، إذ إنّ الغُسلَ رافعٌ للحدثِ الأكبر والأصغر معاً. بل إنّ إتيانَ الوضوء بعد الغُسل بعنوان التشريع يُعَدّ محرّماً؛ لأنّه تشريعٌ في موردٍ لم يُشرِّعه الشارع، وهذا من المسلّمات عند الطائفة الإماميّة.
وعليه، فقولُه (قده) "أنّه لا أثرَ للحدثِ الأصغر مع وجودِ الأكبر" يرادُ به أنّ الحدثَ الأكبر يَستوعبُ أثرَ الأصغر ويرفعُ موضوعَه، فلا يبقى للأصغر حكمٌ مستقلّ ولا أثرٌ عمليّ في ظرفِ تحقّقِ الأكبر، لأنّ الغُسلَ الواحد يُرتّبُ جميعَ آثار الطهارة.
ثمّ قال (قده): "فمع احتمالِ مقارنةِ وجودِ الأصغرِ بالأكبرِ يؤولُ الأمرُ إلى القطعِ بتحقّقِ حدثٍ تترتّبُ عليه أحكامُه، أي إنّ هذا الحدثَ لا يمكنُ الجمعُ بينهُما – الشكُّ في أنّه الأصغرُ أو الأكبر – لأنّه مع عدمِ حدوثِ الأكبرِ تترتّبُ عليه أحكامُ الأصغر، ومع حدوثِ الأكبرِ تترتّبُ عليه أحكامُ الأكبر خاصّة، فيدخلُ الفرضُ في القسمِ الثاني دون الثالث".
بيانُ مراده (قده): أنّه إذا احتملنا وجودَ الحدثِ الأصغرِ مقارناً للحدثِ الأكبر، فإنّ هذا الاحتمالَ لا يُنتجُ إلاّ العلمَ بتحقّقِ حدثٍ واحدٍ على أيِّ حالٍ، غايته أنّنا نشكُّ في نوعِهِ: هل هو الأصغرُ أو الأكبر؟ لكن لا يمكن فرضُ اجتماعهما في آنٍ واحدٍ؛ لأنّ الأكبرَ – كما تقدّم – يستوعبُ الأصغرَ ويرفعُ أثرَه، فيكونُ المكلّفُ متيقّناً بحدوثِ حدثٍ ما، وشاكّاً في تحديدِ نوعِه، لا في أصلِ تحقّقه. ومن هنا عدّ (قده) هذا الفرضَ من القسمِ الثاني من أقسامِ استصحابِ الكلّي، دون الثالث.
والحاصل: أنّ هذا المبنى متفرّعٌ على القول بعدمِ اجتماعِ الحدثين، أي على القولِ بأنّ بينَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ مضادّةً ذاتيّةً تقتضي ارتفاعَ أحدِهما بوجودِ الآخر، فبوجودِ الأكبر لا يبقى للأصغر أثر. غيرَ أنّ هذهِ المضادّةَ ليست مستفادةً من حكمِ العقل، بل من الشارع المقدّس الذي رتّبَ الغُسلَ عن الحدثِ الأكبر مُغنياً عن الوضوء، فدلَّ على أنّ بينَهما تقابلاً شرعياً. أمّا من لا يرى ثبوتَ هذهِ المضادّة، ويجوّزُ اجتماعهما بأن يكون المكلّفُ محدثاً بالأصغرِ والأكبرِ معاً، فيغتسلُ للجنابة ويتوضّأ للحدثِ الأصغر، ولا يرى أحدُهما رافعاً للآخر.
إذن، وعليه، إذا كانت المضادّة مستفادة من الشارع، فبناءً على ذلك ومع غضّ النظر عنها، لا يمكن إرجاع هذا الفرض إلى القسم الثاني من استصحاب الكلّي؛ لأنّ في القسم الثاني يكون هناك يقين بالكلي ابتداءً، والشكّ في بقائه، أمّا هنا فنعلم بوجود الكلي، لكن لا نعلم أنّه من الفرد القصير أو الطويل، أي أنّ الشكّ في مقارنة فردٍ آخر للفرد المتيقَّن الحدوث، وهما غير متحدين. فالقضية هنا قسم مستقل، لا ترجع إلى القسم الثاني.
وأمّا وأمّا ما جاء في عبارته (قده): "فمع احتمال وجود الأصغر يؤول إلى القطع بتحقّق حدث"، فالمقصود منها عنده أنّنا نقطع بتحقّق أصل الحدث، لكنّ هذا التعبير غير دقيق؛ لأنّ احتمال المقارنة لا يوجب القطع، بل القطع حاصل بالحدث الأصغر نفسه، وأمّا الكلي الجامع فثبوته إنّما يكون تعبّدياً بالاستصحاب لا قطعياً.
وعليه، فإذا كانت بين الحدثين مضادّة، فلا اتحاد بين القضيّة المتيقّنة والمشكوكة؛ لأنّ الموضوع في الأولى هو الحدث الأصغر، وفي الثانية هو الأكبر، ومع فرض التضادّ يمتنع اتحادهما، فلا يجري الاستصحاب لانتفاء وحدة القضيّة.
لكن يمكن أن يُقال: إنّ هذا الفرضَ وإن لم يكن من القسم الثاني حقيقةً، إلّا أنّه يدخل فيه حُكماً؛ بمعنى أنّ (قده) أراد إخراجه من القسم الثالث وإلحاقه بالثاني من جهة الحكم، فيُعامل معه معاملة القسم الثاني، فيجري فيه الاستصحاب على أساسه.
غير أنّ هذا الإلحاق إنّما هو بلحاظ أحد وجهين: إمّا فراراً من مخالفة الشيخ الأعظم (قده)، إذ الشيخ يرى جريان الاستصحاب في النوع الأول من القسم الثالث، فأُلحق المقام بالثاني لتصحيح الجريان، أو بناءً على القول بالمضادّة بين الحدثين، حيث لا يمكن فرض اجتماع الأصغر مع الأكبر، فيلزم إدخاله حُكماً في القسم الثاني.
وعلى كلّ حال، فقد ذهب بعض الأعلام إلى هذا الاتجاه، فقالوا إنّ هذا الإشكال يرجع في حقيقته إلى القسم الثاني، لا إلى الثالث، كما سيأتي تفصيل القول في ذلك لاحقاً.وللكلام تتمة .


