47/04/22
الاستصحاب الكلي /الاستصحاب /الأصول العملية
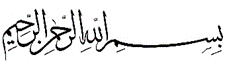
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب /الاستصحاب الكلي
تقدّم الكلامُ في تشييدِ رأيِ الشيخِ الحائريّ (قده)، وقد ذهبَ إلى القولِ بجريانِ الاستصحابِ مطلقاً.
وبيّنا أنّ السيّدَ السيستانيّ (دام ظلّه) قد تناولَ هذا المطلبَ بالتحليلِ والتفصيل، مبيّناً وجهَه من خلالِ جهتين: إحداهما: بلحاظِ العقل،والأخرى: بلحاظِ العرف. أمّا بلحاظِ العقل، فله نظران: الأوّلُ: ما قرّرهُ أهلُ المنطقِ في بابِ الكليّاتِ وأفرادِها، والثاني: ما قرّرهُ الأصوليّونَ .
وأيضاً تقدّمت النكتةُ الأساسُ في محلِّ النزاعِ بين الأعلام في هذه المسألةِ المهمّة، وهي: هل إنّ هذا الشكَّ يُعدُّ من الشكِّ في البقاء أو من الشكِّ في الحدوث؟
ذلك أنّ كلَّ واحدٍ من الأعلام حاولَ أن يصوّرَ هذا الفرضَ الذي ذكره الشيخُ الأعظم (قده)، وهو ما يُعرفُ بـ القسم الثالث من استصحابِ الكلّي.
وملخّصُ الفرض: أنّه بعد خروجِ زيدٍ من الغرفة، كنّا نحتملُ وجودَ فردٍ آخرَ مقارنٍ معه، أو احتمالَ دخول شخصٍ آخرَ مقارنٍ لخروجه.
وهذا الشكُّ – كما تقدّم في أوائلِ البحث – شكٌّ واقعيٌّ لا يمكنُ إنكارهُ ولا الإغفالُ عنه؛ لأنّ احتمالَ وجودِ فردٍ آخرَ مقارنٍ لزيدٍ أمرٌ معقولٌ في نفسه.
إلّا أنّ محلَّ النزاعِ هو: هل هذا الشكُّ يُعدُّ شكّاً في حدوثِ كلّيٍّ جديد، أي في أصلِ وجودِ طبيعةٍ أخرى مغايرةٍ لما تيقّنّا به أوّلاً، أو أنّه شكٌّ في بقاءِ نفسِ الكلّيِّ الذي تيقّنّا بوجودِه سابقاً؟
فمدارُ البحثِ بين الأعلامِ إنّما هو على تحديدِ طبيعةِ هذا الشكّ: أهو من سنخِ الشكِّ في الحدوثِ، أم من سنخِ الشكِّ في البقاء؟.
الشيخُ الحائريُّ (قده) قد ذكرَ هذا المطلبَ في كتاب الدرر، وقد بيّنا عبارته هناك تفصيلًا.
وخلاصةُ ما أفاده (قده): أنّ الشك تعلق ببقاء الكلي فبعد أن علمنا بوجود الكلي بوجود زيد ثمّ شككنا بعد خروج زيد في وجود فرد آخر وهو عمرو اما مقارن لزيد في الوجود أو وجد حين خروجه ، فإنَّ هذا الشكَّ قد تعلق بنفس الكلي الذي تيقّنّا به أوّلًا، أي أنّ الشكَّ متعلّقٌ بنفسِ الطبيعةِ الكليّة التي حصلَ لنا اليقينُ بوجودِها سابقاً.
إلّا أنّهُ يفرّق بين صورتين: فإنّا إنْ علمنا بعدمِ وجودِ أيِّ فردٍ من أفرادِ الكلِّيِّ على نحوِ السالبةِ الكليّة، ثمّ شككنا في وجودِ فردٍ جديدٍ، كان هذا الشكُّ شكّاً في الحدوث، لأنّ المفروض أنّ الكلّيَّ قد ارتفعَ بارتفاعِ جميعِ أفراده، فالتردّدُ في فردٍ جديدٍ يكونُ تردّداً في حدوثِ وجودٍ آخرَ للطبيعة.
وأمّا إذا لم نُحرز العدمَ المطلقَ ولم نصل إلى حدِّ السالبةِ الكليّة، فإنّ الشكَّ حينئذٍ يكون شكّاً في البقاء، لأنّ احتمالَ وجودِ فردٍ آخرَ مقارنٍ أو متعاقبٍ مع الفردِ السابق معناه احتمالُ استمرارِ وجودِ الكليّ في الخارج.
وهذه هي النكتةُ الدقيقةُ التي أرادَ الشيخُ الحائريُّ (قده) بيانَها، وهي أنّ منشأَ تمييزِ الشكِّ بين الحدوثِ والبقاءِ يتوقّفُ على إحرازِ العدمِ المطلقِ أو عدمِ إحرازِه.
أمّا السيّدُ السيستانيّ (دام ظلّه) فقد حاول أن يُفكّك مطلبَ صاحب الدرر، ويعرضهُ بطريقةٍ تُشعرُ بأنّه يريدُ تشييدَه وتقريبه في بادئ الأمر، ثمّ يتعرّضُ لموضعِ الإشكال عليه لاحقاً. وقد تقدّم بعضُ البيان لذلك سابقاً.
وبيانُ ما أفاده (دام ظلّه): أنّ العبارةَ المشهورةَ القائلةَ بأنّ نقيضَ الموجبةِ الجزئية هو السالبةُ الكليّة ليست على ما يُفهم منها بظاهرِها، فإنّ وجودَ الكلّيّ الطبيعيّ ليس وجوداً واحداً بسيطاً قائماً في الخارج بحيثُ يُعدمُ بعدمه، بل هو وجودٌ بتعدّد أفراده؛ إذ إنّ الكلّيَّ يوجدُ بوجودِ هذا الفرد، ويوجدُ أيضاً بوجودِ ذاك الفرد، وتتعدّدُ وجوداته بتعدّدِ الأفراد.
وعليه، فكما تتعدّدُ وجوداتهُ بتعدّدِ الأفراد، يجب أن تتعدّدَ أعدامهُ أيضاً بتعدّدِ تلك الأفراد، إذ ليس عندنا وجودٌ واحدٌ وأعدامٌ كثيرة، بل المقابلةُ تامّة: وجوداتٌ متعدّدةٌ في مقابل أعدامٍ متعدّدة. فلو افترضنا أعداماً كثيرةً، فلابدّ أن يكون في مقابلها وجوداتٌ كثيرةٌ أيضاً، لا أنّ هناك وجوداً واحداً يقابله أعدامٌ متكثّرة، وهذا هو الأساسُ المنطقيُّ في تحليلِ السيّدِ السيستانيِّ (دام ظلّه) لمطلبِ صاحبِ الدرر.
ولأجلِ توضيحِ هذا المطلبِ أكثر، قالَ السيّدُ السيستانيُّ (دامَ ظلّه) كما في كتاب الاستصحاب: "ولابدّ لتوضيحِ المقامِ من التنبيهِ على أمرٍ، وهو أنّ لقولِنا (وجودُ الطبيعة) إطلاقين:
فقد يُطلقُ ويرادُ به صرفُ وجودِ الطبيعيّ — لا الوجودُ الاستيعابيُّ لكلّ الأفراد — وهو وجودُه بوجودِ فردٍ له أو أكثر، وهذا هو الذي يتكثّرُ بتكثّرِ الأفراد، ويتكثّرُ عدمُه أيضاً بعدمِ كلّ فرد.
وقد يُطلقُ ويرادُ به الوجودُ الشاملُ لجميعِ الوجودات، ويُقابله العدمُ الشاملُ لجميعِ الأعدام، بمعنى أنّ عدمَ الطبيعيّ بانعدامِ جميعِ الأفراد يقابلُ وجودَه بوجودِ جميعِ الأفراد.([1] )"
توضيحُ كلامِه (دامَ ظلّه): إنّ للوجودِ إطلاقين، والتمييزُ بينهما دقيقٌ في مقامِ التحليل: الإطلاقُ الأوّل: صرفُ الوجود.
وهو الوجودُ المتحقّقُ بوجودِ فردٍ واحدٍ أو أكثر، فكلّما وُجد فردٌ للطبيعة، تحققَ وجودُها، وإذا ارتفعَ الفردُ ارتفعَ ما تحقّقَ به من الوجود. وعليه، يتكثّرُ الوجودُ بتكثّرِ الأفراد، كما يتكثّرُ العدمُ أيضاً بانعدامِ كلِّ فردٍ على حدة.
الإطلاقُ الثاني: الوجودُ الشاملُ لجميعِ الأفراد.
وهو ما يُرادُ به وجودُ الطبيعة بتمامِ أفرادها، أي الوجودُ الاستيعابيّ الذي لا يتحقّقُ إلّا بوجودِ جميعِ الأفراد، ويُقابلهُ في العدمِ العدمُ الشاملُ لجميعِ الأفراد، أي بانعدامِها كلّها.
فالفارقُ بين الإطلاقين من جهتين: من جهةِ الوجود: الأوّل يتكثّرُ بوجودِ الأفراد، بينما الثاني لا يتحقّقُ إلّا بوجودِها جميعاً.
ومن جهةِ العدم: الأوّل ينعدمُ بانعدامِ كلّ فردٍ على نحوِ التعدّد، أمّا الثاني فلا ينعدمُ إلّا بانعدامِ جميعِ الأفراد على نحوِ العدمِ الاستيعابيّ.
فإذاً، الإطلاقُ الأوّل ناظرٌ إلى صرف الوجود، والإطلاقُ الثاني ناظر إلى الوجود الشامل، وبهذا يظهرُ أنّ لكلٍّ منهما دائرةً خاصّةً في مقامِ التصوّرِ والحكم.
ثم عقّبَ (دام ظلّه) في مقامِ التطبيقِ والبيان العمليّ فقال: "فإذا قلنا: العنقاءُ موجودةٌ مثلاً، فالمرادُ به الوجودُ بالمعنى الأوّل، أي صرف وجود الطبيعة. وأمّا إذا قلنا: العنقاء معدومةٌ، فالمقصود غير ذلك…".
توضيحُ كلامِه (دام ظلّه): إنّ الحديثَ هنا ينتقلُ من مقامِ الثبوت إلى مقامِ الإثبات، ومن دائرةِ التحليلِ المفهوميّ إلى مقامِ الإنشاءِ والحكايةِ والدلالة.
ففي مقامِ الثبوت – أي في مقامِ التصوّرِ والتحليلِ العقليّ – كنّا نقول إنّ الوجودَ يُطلقُ على نحوين:إطلاق صرف الوجود، وإطلاق الوجود الشامل.
وأمّا الآن، فالكلامُ في مقام الإنشاء والإثبات، أي حينما ننسبُ الوجودَ أو العدمَ إلى الطبيعةِ في مقامِ الخطابِ والبيان.
فإذا قلنا: العنقاء موجودةٌ، فلابدّ أن نُلاحظ أيَّ الإطلاقين نريد: هل نريدُ صرف الوجود، أي أنّ لهذه الطبيعةِ فرداً ما موجوداً في الخارج؟ أم نريدُ الوجود الشامل لجميعِ الأفرادِ التي وُجدت وتوجد وستوجد؟ فإن أردنا الوجودَ الشاملَ، فلابدّ أن نأخذَ بعين الاعتبار جميعَ الأفرادِ الممكنة، حتى تلك التي لم تتحقّق بعد، وهذا أمرٌ غيرُ متحصّلٍ في الخارج، لأنّ استيعابَ جميعِ الأفرادِ أمرٌ غيرُ مقدورٍ في مقام الإثبات. إذن، حين نقول في مقام الإيجاب: العنقاء موجودةٌ، فالمقصودُ أنّنا نحملُ الوجودَ على الطبيعةِ بلحاظِ صرف الوجود، أي بمقدارِ تحقّقِ فردٍ ما منها في الخارج، لا بلحاظِ الوجودِ الشاملِ لجميع الأفراد.
وبعبارةٍ أخرى: الوجودُ في مقامِ الإثبات يُرادُ به الوجودُ الساذجُ أو الصرفُ، لا الوجودُ الاستيعابيّ؛ لأنّ المتكلّمَ حين يحكمُ بوجودِ العنقاء، لا يريدُ أن يثبتَ وجودَ كلّ أفرادها المفترضة، بل يريدُ أن يُخبرَ عن تحقّقِ أصلِ الطبيعةِ بوجودِ فردٍ منها، وهذا هو صرف الوجود لا غير.
ثمّ أردفَ السيّدُ السيستانيّ (دام ظلّه) قائلاً: "فالمرادُ به الوجودُ بالمعنى الأوّل، أي صرفُ وجودِ الطبيعة، وأمّا إذا قلنا: العنقاء معدومةٌ، فالمرادُ به العدمُ بالمعنى الثاني، أي انعدامُ جميعِ الأفراد".
بيانُ كلامِه (دام ظلّه): إنّ الحديثَ هنا انتقلَ من الجانبِ الإيجابيّ — أي مقامِ الإثباتِ للوجود — إلى الجانبِ السلبيّ، أي مقامِ نفيِ الوجود. فحين نقول: العنقاء غيرُ موجودةٍ أو العنقاء معدومةٌ، فليس المرادُ من هذا الإطلاق هو العدمُ المقابلُ لصرفِ الوجود، أي عدمُ فردٍ معيّنٍ من أفرادِ الطبيعة فحسب، كما لو قيل: إنّ العنقاء التي كانت في البيت قد عُدمت.
بل المقصودُ من هذا الإطلاق هو العدمُ الشاملُ لجميعِ الأفراد، أي أنَّه لا يوجدُ أيُّ فردٍ من أفرادِ الطبيعةِ أصلًا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل.
فـ "العنقاء معدومةٌ" بمعنى أنّ هذه الطبيعةَ من حيثُ هي طبيعةٌ لا وجودَ لها في الخارج على الإطلاق، وهذا هو العدمُ بالمعنى الثاني، أي العدمُ الاستيعابيّ أو الشامل الذي يقابلُ الوجودَ الشاملَ لجميعِ الأفراد.
فخلاصةُ الفرق: في مقامِ الإثباتِ الإيجابيّ: إذا قلنا العنقاء موجودةٌ، فالمرادُ صرف الوجود، أي تحقّقُ فردٍ ما.
وفي مقامِ النفيِ والعدميةِ: إذا قلنا العنقاء معدومةٌ، فالمرادُ العدمُ الشامل، أي انتفاءُ جميعِ الأفراد بلا استثناء .
ثمّ بعد ذلك جاء (دام ظلّه) ليُجيبَ عن سؤالٍ مقدّرٍ قد يُورد في المقام، وهو: هل إنّ هذا التفصيلَ بين الوجودين والعدمَين إنّما هو بلحاظِ جهةِ التقابل، باعتبارِ أنّ الأوّلَ من سنخِ الموجبة الجزئية، والثاني من سنخِ السالبة الكليّة؟ وكأنّ القائلَ يريدُ أن يقول: إذا قلنا "العنقاء موجودة" فذلك من الموجبة الجزئية، وإذا قلنا "العنقاء معدومة" فذلك من السالبة الكلية، فهما متقابلان من هذه الجهة.
وعلى هذا التقدير، فكأنّنا رجعنا إلى ما فرغنا منه من التفسيرِ المنطقيّ للتقابل بين الوجود والعدم.
لكنّ السيّدَ السيستانيّ (دام ظلّه) نفى ذلك بقوله: "لا من جهةِ تقابلِ هذا العدمِ مع ذاك الوجود، وأنّ نقيضَ السالبةِ الكليّة هو الموجبةُ الجزئية، بل من جهةٍ أخرى راجعةٍ إلى مقامِ الإثبات — وهو مقامُ الدلالةِ والإثباتِ والكشفِ —، وهو أنّ المتكلّمَ الحكيمَ إذا قال: العنقاءُ موجودةٌ لا يمكن أن يُريدَ به الوجودَ بالمعنى الشاملِ لجميعِ الوجودات؛ إذ لا يمكنُ أن يتحقّقَ ذلك خارجاً، فإنّ أفرادَ الطبيعيّ التي يمكنُ أن تكونَ أفراداً له لا يمكنُ حصرُها، فكلّما وُجد للعنقاء أفرادٌ خارجيةٌ مهما بلغت من الكثرة، لا يُوجِبُ ذلك تضييقاً في صدقِ "العنقاء" على فردٍ آخرَ لم يتحقّق بعد".
فالنكتةُ الأساسُ إذن في كلامِه (دام ظلّه): أنّ الاختلافَ بين الوجودين والعدمَين ليس تقابلاً منطقيّاً بين موجبةٍ وسالبة، بل هو تغايرٌ إثباتيٌّ عرفيٌّ في مقام الدلالة والكشف. ولذلك قالَ (دام ظلّه): "ولذلك يجبُ حملُ هذا الكلامِ على صرفِ وجودِ الطبيعة، ونفسُ هذه القرينةِ توجبُ حملَ الكلامِ الثاني على إرادةِ العدمِ الشامل، إذْ صرفُ العدمِ ضروريٌّ لعدمِ إمكانِ تحقّقِ جميعِ الأفراد كما ذكرنا"([2] ).
حاصلُ مقصوده (دام ظلّه):
إنّ المرادَ من قوله "صرف العدم ضروري" أنّ أصلَ عدمِ بعضِ الأفراد أمرٌ بديهيٌّ لا يحتاجُ إلى بيانٍ أو إلى إنشاءٍ خاصّ. فحين نقول: العنقاء معدومة، نحن نمتلكُ في داخلِنا قرينةً وجدانيةً تدلّ على أنّ بعضَ أفرادِ العنقاء غيرُ موجودةٍ قطعاً، إذ لا يُتصوَّر تحقّقُ جميعِ الأفرادِ لها في الخارج.
فبهذا اللحاظ، إذا قلنا: العنقاء معدومة، لا نريد صرفَ العدم (أي عدمَ فردٍ ما من أفرادها)، لأنّ هذا أمرٌ معلومٌ بالضرورة، بل المرادُ العدمُ الشاملُ لجميع الأفراد، أي أنّ طبيعةَ العنقاء بتمامها من حيث جميعُ مصاديقِها غيرُ موجودةٍ في الخارج.
وكذلك المثال بالإنسان: فلو قلنا الإنسان معدومٌ، لا نريد بذلك صرفَ العدم؛ إذ من الواضح أنَّ بعضَ الأفراد قد ماتوا أو لم يولدوا بعد، وهذا النحو من العدم أمرٌ ضروريٌّ لا يحتاجُ إلى إثبات. بل المرادُ أنَّ جميعَ أفرادِ الإنسان من حيث الطبيعة غيرُ موجودين أصلاً، أي نفيُ الطبيعة من أساسها في الخارج. وبناءً على ذلك، في مقام الوجود: إذا قال المتكلّمُ الحكيمُ "الإنسان موجود"، فهو يريد صرف الوجود، أي وجودَ الطبيعة في الجملة، لا الوجودَ الشامل لجميع الأفراد، لأنّ استيعابَها كلّها متعذّر.
وفي مقام العدم: إذا قال "الإنسان معدوم"، فهو لا يريد صرف العدم، لأنّه أمرٌ معلومٌ بالضرورة كما قلنا، بل يريد العدمَ الشاملَ، أي انتفاءَ الطبيعة بتمامها وجميع أفرادها.
فالوجهُ في هذا الحمل ليس ما قد يُتوهم من جهةِ التقابلِ المنطقيّ — أي أنّ نقيضَ الموجبة الجزئية هو السالبة الكلية —، بل لأنّ المتكلّمَ الحكيمَ في مقام الإثبات تكون له قرينةٌ داخليةٌ عقلائيةٌ تدلّ على أنّه: إذا أراد إثباتاً، قصدَ صرفَ الوجود.
وإذا أراد سلباً، قصدَ العدمَ الشامل.
إذ إنّ صرفَ العدمِ لا يُقصَد عادةً، لكونه أمراً ضرورياً مفروغاً عنه، فهو ليس مورداً للبيان ولا للتشريع ولا للإخبار؛ لأنّه مجرّد عدمٍ مقابلٍ لوجودٍ، والوجوداتُ متكثّرةٌ كما أنّ الأعدامَ متكثّرة، فالمقصودُ من السلب دائماً هو السلبُ التامّ أو العدمُ الشامل لا صرفُ العدم.
وهكذا يتّضح أنّ التفصيلَ بين الإيجابِ والسلب في استعمالاتِ الوجودِ والعدمِ مبنيٌّ على القرائن العقلائية في مقام الإثبات، لا على قواعدِ التقابلِ المنطقيّ بين الموجبةِ الجزئية والسالبةِ الكليّة.
لذلك قال (دام ظله): "هذه القرينة توجب حمل الكلام الثاني على ارادة العدم الشامل إذ صرف العدم ضروري لعدم امكان - هذا تنبيه منه (دام ظله) لا دليلاً لكونه من البديهيات - تحقق جميع الافراد كما ذكرنا فلا بد من أن يكون المراد بهذه الجملة معنىّ مفيداً غير ضروري - أي غير بديهي - وهو العدم الشامل".
ثم قال (دام ظلّه): وهذا المعنى الذي ذكرناه أوجبَ التوهّمَ السابقَ — إشارةٌ إلى رأيِ الشيخِ الحائريّ (قده) الذي قالَ بالجريان مطلقا —، وهو أنّ الطبيعةَ توجدُ بوجودِ فردٍ واحدٍ وتنعدمُ بانعدامِ جميعِ الأفراد، فتكونُ المقابلةُ بين صرفِ الوجود والعدمِ الشامل، إذ إنّ هذه المقابلةَ خاطئةٌ، مع وضوحِ فسادِ ذلك، وقد بيّنّا أنَّ مقابلَ كلِّ وجودٍ عدمُه".
خلاصةُ مقصوده (دام ظلّه):
إنّ السيّدَ السيستانيّ (دام ظلّه) أرادَ بهذا الكلامِ أن يُبيّن فسادَ المبنى الذي اعتمده الشيخُ الحائريّ (قده) في تقريرِه لجريانِ الاستصحاب. فالشيخُ الحائريّ كان يرى أنّ الطبيعةَ توجدُ بوجودِ فردٍ واحدٍ وتنعدمُ بانعدامِ جميعِ الأفراد، وبناءً على هذا، جعلَ المقابلةَ بين صرف الوجود والعدم الشامل، أي إنّ وجودَ الطبيعةِ يتحقّقُ بوجودِ فردٍ واحدٍ منها، وينتفي بانعدامِها كلّها.
لكنّ السيّدَ السيستانيّ يرى أنّ هذا التصويرَ غيرُ صحيحٍ من جهةِ المنطقِ التحليليّ، لأنّ المقابلةَ الحقيقيةَ لا تكونُ بين صرفِ الوجود والعدمِ الشامل، بل بين صرفِ الوجود وصرف العدم، أي العدمِ المقابلِ لذلك الوجودِ بعينه، كما أنَّ الوجودَ الشاملَ يُقابله العدمُ الشامل، لا غير.
فالتقابلُ في بابِ الوجودِ والعدمِ هو تقابلٌ بين المتكافئين في المرتبة، لا بين وجودٍ جزئيٍّ وعدمه الكلّيّ. ومن هنا يرى (دام ظلّه) أنَّ الجمعَ بين "صرف الوجود" و"العدم الشامل" في مقام المقابلة مغالطةٌ منطقيّةٌ، لأنّه جمعٌ بين طرفين غيرِ متكافئين في النسبة.
فالنتيجة التي خلص إليها (دام ظلّه):
إنّ الشيخَ الحائريّ (قده) بنى تصوّره على مقابلةٍ غيرِ دقيقةٍ بين صرفِ الوجودِ والعدمِ الشامل، مع أنّ المقابلةَ الصحيحةَ إنّما تكونُ: بين صرف الوجود وعدمه الخاصّ، وبين الوجود الشامل والعدم الشامل.
وأمّا أن يُجعل صرفُ الوجود في قبالِ العدمِ الشامل، فذلك خطأٌ ومغالطةٌ كما صرّح به السيّدُ السيستانيّ (دام ظلّه)، لأنّ كلَّ وجودٍ لا يقابله إلّا عدمه المماثل له في السعةِ والضيق، لا أوسعُ منه ولا أضيق.
فبهذا البيان، يظهر أنّ المبنى الذي اعتمدَه الشيخُ الحائريّ في تصوير جريان الاستصحاب وبُنِيَ على أساسٍه تصور غيرِ دقيقٍ في تحديدِ جهةِ المقابلة بين الوجودِ والعدم، ولذلك حكمَ السيّدُ السيستانيّ (دام ظلّه) بفساده وعدمِ إمكانِ المساعدةِ عليه.
ثم نُرجِع الكلامَ إلى ما أفاده الشيخُ الحائريّ (قده) في أصلِ المطلب، فنقول: إنه لو خرجَ زيدٌ من الدار، واحتملنا عند خروجه أنّ هناك فرداً آخرَ مقارناً لوجوده، فقد قال (قده): إنّه إذا خرج زيد من الدار فلابدّ من إحرازِ العدم المطلق، ولكنَّنا لا نُحرزُ العدم المطلق، بل نحتمل وجودَ فردٍ آخرَ من الكلّي، فحينئذٍ نستصحبُ الكلّي، فيكون الشكُّ شكّاً في البقاء.
وبعبارةٍ أخرى، يرى الشيخُ الحائريّ (قده) أنّه مادام لم يُحرز العدمُ المطلقُ لجميع الأفراد، فاحتمالُ وجودِ فردٍ آخرَ من الكلّي كافٍ لجريان الاستصحاب، لأنّ الكلّيَّ من حيث هو كليّ لا يُعلم ارتفاعُه بارتفاعِ الفردِ الأول، ما دام يحتمل أن يكون له فردٌ آخرُ مقارن.
إلا أنّ السيّدَ السيستانيّ (دام ظلّه) بيّنَ موضعَ الخلل في هذا التصوير، فقال إنّنا عندما نُحرزُ أنّ زيداً خرج، فنحن نعلم بارتفاعِ وجوده الخاصّ، أي صرف وجوده، وبذلك نُحرز أيضاً صرف العدم المقابل له، لأنّ زيداً كان موجوداً ثم عُدم، فالعدمُ هنا عدمٌ خاصٌّ مقابلٌ لوجودٍ خاصّ، لا عدماً شاملاً لجميع أفراد الإنسان أو لجميع أفراد الكلّي.
فحين خرج زيد، فإنّ الذي ارتفع هو وجود زيد بعينه، والمقابل له هو عدمه الخاصّ، لا العدمُ الشامل لجميع أفراد الطبيعة، لأنّ ارتفاع زيد لا يلازم ارتفاع عمرو أو خالد.
إذن المقابلة هنا بين صرف الوجود وصرف العدم، لا بين صرف الوجود والعدم الشامل.
ومن هنا قال (دام ظلّه): إنّ هذا هو الذي أوقع المتوهَّم — أي الشيخ الحائريّ (قده) — في الخطأ، إذ تصوّر أنّ الكلّيَّ الطبيعيَّ ما زال باقياً في ضمن فردٍ آخر، فبنى على أنّ الشكّ في المقام شكٌّ في البقاء، بينما الواقع أنّه ليس شكّاً في البقاء، بل في الحدوث، لأنّ ما تيقّنا به أوّلاً هو وجودُ زيدٍ الخاصّ، ومقابله عدمُ زيدٍ الخاصّ، لا عدمُ جميع أفراد الكلّي.
فبعبارةٍ أوضح:
زيدٌ وُجدَ بوجودٍ خاصٍّ هو صرف وجوده، وارتفعَ بعدمهِ الخاصّ صرف العدم، ولا يصحّ أن يُقال إنّ بخروج زيدٍ ارتفعت جميعُ أفرادِ الإنسان أو جميعُ أفرادِ الكلّي.
فلو شككنا في وجودِ عمرو بعد زيد، فهذا وجودٌ جديدٌ لطبيعةٍ أخرى في ضمن فردٍ آخر، لا استمرارٌ لوجودٍ واحدٍ سابقٍ.
وعليه، فإنّ توهّمَ الشيخ الحائريّ (قده) في بقاءِ الكلّي بالاستصحاب ناشئٌ من الخلط بين صرف الوجود والوجود الشامل، فجعل مقابِل صرف الوجود العدمَ الشامل، مع أنّ المقابلَ الحقيقيَّ له هو صرفُ العدم، وهذا هو وجهُ نقدِ السيّد السيستانيّ (دام ظلّه) الذي أوضح أنّ الاستصحابَ في مثلِ هذا الفرضِ لا يجري، لأنّ الشكَّ ليس في البقاء، بل في حدوثِ وجودٍ جديدٍ للكلّي في ضمن فردٍ آخر.
ثم إنتقل كلامه (دام ظله) إلى كلام الأصوليين، فقال:"وهكذا الكلام في الاوامر والنواهي فاذا قال المولى (تكلّم) فلا يمكن ان يريد به طلب ايجاد جميع الافراد إذ ليس ذلك ممكناً فلابد من حمله - فهذا حمل على نحو الإثبات والدلالة - على صرف الوجود، وأما اذا قال (لا تتكلم) فالمراد به طلب العدم الشامل لان صرف العدم ضروري - أي بديهي لا نظري - لا يتعلق به طلب."
ثمّ انتقلَ السيّدُ السيستانيّ (دام ظلّه) إلى ما أفاده المناطقة، فقال: "وأمّا ما ذُكر في المنطق من أنّ نقيض السالبة الكلّيّة هو الموجبة الجزئيّة، فليس المرادُ به النقيضَ الاصطلاحيّ، وهو رفعُ الشيء؛ فإنّ رفعَ جميعِ الأفراد ليس مقابلاً لوجودِ بعضها بالضرورة، بل المرادُ التنافي في صدقِ القضيتين، بمعنى أنّ هاتين القضيتين لا تصدقان معاً في موردٍ واحد، من جهةِ اشتمالِ كلٍّ منهما على لازمِ نقيضِ الأخرى."
توضيحُ مقصوده (دام ظلّه):
يُريد (دام ظلّه) أن يُنبّه إلى أنّ ما يذكره المناطقة في باب النقيضين لا علاقة له ببحث الوجود والعدم الخارجيين، ولا بسعةِ الوجودِ وضيقه، بل هو بحثٌ قضويّ منطقيّ محض، ناظرٌ إلى التقابل في مقام الصدق والكذب لا إلى التقابل في مرتبة التكوين والوجود.
فالمناطقة حين يقولون: نقيض الموجبة الجزئية هو السالبة الكلية، لا يقصدون أنّ بعض الوجود يقابله العدم التام، بل يقصدون أنّ هاتين القضيتين لا تصدقان معاً في موردٍ واحدٍ بعينه.
فلو قلنا: بعض الإنسان كاتبٌ، فهذه موجبة جزئية. ونقيضها المنطقي هو: لا شيء من الإنسان بكاتبٍ، وهي سالبة كلية. ومعنى النقيض" هنا ليس أنّ أحدهما وجودٌ والآخر عدمٌ في الخارج، بل إنّهما لا يمكن أن يصدقا معاً في قضيةٍ واحدةٍ عن موضوعٍ واحد، لأنّ كلّاً منهما تتضمّن لازماً يناقض لازمَ الأخرى.
فالمناطقة لا ينظرون إلى سعة الوجود، بل إلى سعة الصدق: متى يمكن أن تصدق القضيتان معاً، ومتى يمتنع ذلك.
فمثلاً، يمكن أن تصدق القضيتان في مواردَ مختلفة، كما لو كان بعض الأفراد كاتباً وبعضهم غير كاتب، فلا تناقض هنا، لأنّ عدم الصدق إنما يكون في موردٍ واحدٍ بعينه لا في موارد متعددة.
ومن هنا، فإنّ هذا التحليل المنطقيّ ينقض على بعض الفقهاء أو المتكلّمين الذين خلطوا بين التقابل في مقام الصدق المنطقيّ والتقابل في مقام الوجود الخارجيّ، فتوهّموا أنّ الموجبة الجزئية تقابلها سالبة كلية بمعنى وجودٍ ووجودٍ مضادّ، مع أنّ المناط الحقيقيّ هو في التنافي في الصدق لا في الوجود. إذن، المراد بالنقيضين عند المناطقة ليس الوجود والعدم، بل هما قضيتان لا تصدقان معاً في موردٍ واحدٍ بعينه، وإن كان يمكن أن تصدقا في موارد متعددة بلا تنافٍ، كما أوضح (دام ظلّه).
وللكلام تتمّة…
[ سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ]


