47/04/15
استصحاب الكلي/الاستصحاب /الأصول العملية
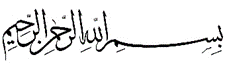
الموضوع: الأصول العملية/الاستصحاب /استصحاب الكلي
تقدّم الكلام في ما أفاده صاحب الكفاية (قدِّه)، فإنّه لم يَرتضِ التفصيلَ الذي ذكره الشيخُ الأعظم (قدِّه) بين الصورة الأوّلى والصورة الثانية من صور القسم الثالث من استصحاب الكلّي، بل ذهب إلى المنع من جريان الاستصحاب في كلا الصورتين معاً.
وقد تقدّمت البرهنةُ على ما أفاده (قدِّه)، وحاصلها: أنّ الكلّيّ في ضمن فردٍ يختلف وجودُه عن الكلّيّ في ضمن فردٍ آخر، بمعنى أنّ وجود الإنسان في زيدٍ غيرُ وجوده في عمرو، وإنْ كان العنوان الكلّي ـ من حيث المفهوم ـ مشتركاً بين الأفراد، إلّا أنّ تحصّص هذا الكلّيّ يختلف باختلاف الأفراد، لاختلاف مصاديق وجوده الخارجي. وهذا ما يُعبَّر عنه في كلماتهم بـ "الاختلاف الوجودي".
فالكليّ المتحقّق في ضمن زيدٍ مغايرٌ وجوداً للكلّيّ المتحقّق في ضمن عمرو، كما أنّه يغاير الكلّيّ في ضمن خالدٍ، على نحو علاقة الأباء المتعددين لأبناء متعددين وإن اشتركوا بعنوان الأبوة.
وعليه، فبعد العلم بارتفاع الكلّيّ المتحقّق في ضمن زيدٍ، وعدم العلم بأصل حدوث كلّيٍّ آخر في ضمن عمرو، ينتفي الركنُ الأوّل من أركان الاستصحاب ـ وهو اليقين بالحدوث ـ في كلا الصورتين الأوّلى والثانية من صور القسم الثالث من استصحاب الكلّي .
ثُمّ انتقل صاحب الكفاية (قدِّه) إلى بيان نكتةٍ دقيقةٍ تتعلّق بـ مراتب الوجود، وهي: أنّ اختلاف المراتب هل يُعدّ من قبيل اختلاف الوجودات المتعدّدة، أو من اختلاف الحالات الطارئة على وجودٍ واحد؟
وتقريب مراده (قدِّه): أنّه إذا فرضنا ـ مثلاً ـ أنّ زيداً كان مريضاً اليوم، ثم وُجد بعد أسبوعٍ صحيحاً، فإنّنا نقول: هذا زيدٌ، وقد عرضت عليه حالتان مختلفتان، هما المرض والصحّة. وفي باب الاستصحاب، لا بدّ من وحدة الموضوع بين زمان اليقين وزمان الشكّ. وهنا يُسأل: هل نلحظ هذه الوحدة بلحاظٍ دقّي فلسفيٍّ أم بلحاظٍ عرفيٍّ؟
فإن رجعنا إلى النظر الدقّي العقلي، فـ زيد الذي هو مريض اليوم مقيّدٌ بزمانٍ ومكانٍ مخصوصَين، وهما يغايران الزمان والمكان اللذين كان فيهما زيد قبل أسبوع، فيلزم من ذلك تعدّد الوجود بتعدّد القيود، فلا تكون وحدة الموضوع متحقّقة بالدقة.
إلّا أنّ العرف لا يرى هذا التغاير، بل ينظر إلى زيد بوصفه شخصاً واحداً مستمرّاً، سواء شغل هذا المكان أو ذاك، وسواء كان مريضاً أو صحيحاً، فيرى هذه الحالات بمنزلة الطوارئ العارضة على موضوعٍ واحدٍ بعينه.
ولذلك قال (قدِّه): إنّ اختلاف المراتب بالنظر العرفي لا يُعدّ من اختلاف الوجودات، بل من اختلاف الحالات على الواحد، فلا مانع حينئذٍ من جريان الاستصحاب.
وبيانه بمثالٍ: كما في الثوب الذي يكون شديد السواد ثم يضعف سواده، فالعرف لا يقول إنّ السواد الأوّل قد ارتفع، وجاء سوادٌ آخر مكانه، بل يرى أنّ السواد الواحد قد ضعف، فهي مرتبة من مراتب السواد، لا وجود مغاير له. وعليه، فالاستصحاب يجري في مثل ذلك، لأنّ الموضوع بنظر العرف باقٍ على وحدته، وإن اختلفت مراتبه شدّةً وضعفاً .
وأمّا إذا فُرض أنّ اختلاف المراتب من قبيل الوجوب والاستحباب، فقد تعرّض الأعلام لبحثهما من جهتين:
الجهة الأولى: من حيث الدقّة العقليّة.
فقد قرّروا أنّ الوجوب ليس إلّا مرتبةً شديدةً من الطلب، بحيث يمتنع ترك متعلّقه، فالعمل مطلوب طلباً أكيداً لا يسوغ الإخلال به، وأمّا الاستحباب فهو أيضاً طلبٌ، لكنّه طلبٌ ضعيفٌ لا يبلغ حدَّ الإلزام.
ومن أمثلة ذلك ما ورد في النصوص الشرعيّة:
فقوله (عليه السلام): "اغتسل للجمعة" هو طلبٌ للغُسل، إلا أنّه لم يبلغ مرتبة الإلزام والعقوبة على الترك، بخلاف قوله (عليه السلام): "اغتسل للجنابة"، فإنّه طلبٌ أكيدٌ لا يجوز تركه ولا تصحّ الصلاة بدونه.
وكذا ما ورد في النصوص من الأمر "صَلِّ" في الواجبات، و"صَلِّ" في المستحبّات، فكلاهما طلبٌ للصلاة، غير أنّ الأوّل طلبٌ إلزاميّ، والثاني طلبٌ ترغيبيّ. فبالنظر العقليّ الدقيق، يكون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الطلب، والوجوب مرتبة شديدة منه.
الجهة الثانية: من حيث النظر العرفيّ.
العرف لا يرى الوجوب والاستحباب على أنّهما مرتبتان من حقيقة واحدة، بل يراهما متباينين في الحقيقة والحكم؛ إذ يرى أنّ الوجوب عنوان مباين للاستحباب، ولذا عبّروا عن العلاقة بين الأحكام الشرعيّة بأنّها علاقة تضادٍّ لا تشكيكٍ، بمعنى أنّها ليست مراتب من حقيقة واحدة، بل أنواع متغايرة في مقام الإثبات.
فما يكون وجوباً لا يراه العرف ضعيفَ الوجوب، بل يرى أنّه نوع آخر، كما أنّ ما يكون استحباباً لا يراه العرف من مراتب الوجوب، بل حكماً آخر مغايراً له.
ومن الشواهد العرفيّة على ذلك:
أنّ كثير الشكّ يختلف عرفاً عن الشاكّ الطبيعيّ، لأنّ لكلٍّ منهما حكمه الخاص: فالأوّل لا يعتني بشكّه، والثاني يجب عليه الاعتناء به. والعرف لا يرى الثاني مرتبة ضعيفة من الأوّل، بل يراه نوعاً آخر مبايناً له.
وكذلك كثير القطع (القطاع) إذا خرج من حالته وصار قطعه كسائر العقلاء، فالعرف يرى أنّ حالته تبدّلت من نوعٍ إلى نوعٍ آخر، لا من مرتبةٍ إلى مرتبةٍ أضعف.
وبناءً على ذلك، ذهب صاحب الكفاية (قدِّه) إلى أنّ المناط في جريان الاستصحاب هو النظر العرفيّ لا الدقّي العقليّ؛ لأنّ الروايات الواردة في باب الاستصحاب ـ كقوله (عليه السلام): "لا تنقض اليقين بالشكّ"[1] ـ جعلت الملاك هو ما يعدّه العرف نقضاً لليقين.
فإذا رأى العرف أنّ الحالة الثانية نقضٌ للحالة الأولى، وجب إبقاء الحالة السابقة تعبّداً، أمّا إذا رآها حالةً
أخرى مباينة، فلا مورد لجريان الاستصحاب؛ لأنّه لا يرى حينئذٍ نقضاً لليقين بالشكّ.
فالنتيجة: أنّه بحسب نظر صاحب الكفاية (قدِّه) يجري الاستصحاب في المراتب التي يراها العرف اختلافَ شدّةٍ وضعفٍ في أمرٍ واحد، ولا يجري فيما يراها العرف حالتين متغايرتين أو نوعين متباينين. فالمناط في جريان الاستصحاب إنّما هو ما يحكم به العرف في باب المراتب من وحدة الموضوع أو تعدّده .
ولهذا أحال صاحب الكفاية (قدِّه) أمرَ اختلاف المراتب شدّةً وضعفاً إلى العرف، لأنّ العرف هو الملاك في تمييز كون الحالتين من سنخٍ واحد أو من نوعين متباينين. فمثلاً: الوجوبُ والاستحبابُ يراهما العرفُ فردين متباينين لا وصفين لحالةٍ واحدة اختلفت شدّةً وضعفاً عبر الزمان، فلا يرى أنّ الوجوب مرتبةٌ قويّة من الطلب، وأنّ الاستحباب مرتبةٌ ضعيفة منه، بل يراهما حكمين متغايرين في الحقيقة.
وبعبارة أخرى انه (قدِّه): يرى إنّ العرف إذا لاحظ أنّ الفرد واحدٌ وقد عرضت عليه صفتان مختلفتان في زمانين، فإنّه لامانع من جريان الاستصحاب، كما في مثال الماء المتغيّر، فإنّ الماء إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه في زمانٍ، ثم زال تغيّره في زمانٍ لاحق، يرى العرف أنّ هذا الماء هو هو بعينه، لم يتبدّل وجودُه، وإنّما طرأت عليه حالةٌ جديدة، فيُحكم بجريان الاستصحاب فيه.
أمّا في الموارد التي يرى العرف فيها أنّ التغيّر تبدّلٌ في حقيقة الموضوع، فلا يرى اتّحاداً بين الزمانين، كما في مثال الزوجة الحيّة والزوجة الميّتة، فإنّ العرف يراها حالتين متغايرتين لا حالةً واحدة تعدّدت أوصافها؛ فالزوجة في حال الحياة موضوع لجواز الاستمتاع، وأمّا بعد الموت فالعرف لا يرى أنّ الموضوع هو بعينه حتى يقال ببقاء الحكم، بل يرى أنّه قد تبدّل إلى موضوعٍ آخر مغايرٍ للأوّل.
ولهذا نجد أنّ بعض القائلين بعدم جواز تقليد الميّت استندوا ـ ضمناً ـ إلى هذا الفهم العرفي، باعتبار أنّ الحياة والموت حالتان متباينتان، فلا يجري استصحاب حجية قول المجتهد إلى ما بعد وفاته، لأنّ العرف لا يرى بقاء الموضوع.
وعليه، فخلاصة ما أفاده صاحب الكفاية (قدِّه):
إنّ اختلاف المراتب بالشدة والضعف يُرجع فيه إلى النظر العرفيّ، فمتى رأى العرف أنّ المرتبتين من سنخٍ واحدٍ اختلفتا شدةً وضعفاً، جرى الاستصحاب، إذ لا يُعدّ ذلك نقضاً لليقين بالشكّ، ومتى رآهما حالتين متباينتين في الحقيقة، فلا يجري الاستصحاب، لأنّ الشارع إنّما جعل الملاك في قوله: "لا تنقض اليقين بالشكّ" على ما يراه العرف نقضاً، لا على ما تدركه الدقّة العقليّة .
لذلك قال(قده) "لما مرت الإشارة إليه وتأتي، من أن قضية إطلاق أخبار الباب ، أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا ، وإن لم يكن بنقض بحسب الدقة"([2] ).
توضيح كلامه (قدِّه): بيانُه (قدِّه) يتّضح بالمثال الفقهي المعروف: وهو ما لو تنجّس ثوبٌ بالدم أو بنجاسةٍ أخرى، ثم غُسِل وأُزيلت عين النجاسة، إلّا أنّ اللون او اثر الدم بقي على الثوب.
فهنا العرف يرى أنّ النجاسة قد أُزيلت، وأنّ بقاء اللون لا يدلّ على بقاء عين الدم، فيحكم بطهارة الثوب، وقد دلّت النصوص على ذلك تعبّداً.
أمّا من جهة الدقّة العقليّة والفلسفيّة، فيُقال: إنّ الدم جوهر، والثوب جوهر آخر، فإذا أصاب الدمُ الثوبَ صار عرضاً عليه بلونه، فمقتضى التحليل الدقّي أنّ بقاء اللون بعد الغَسل دليلٌ على بقاء العرض، وبقاء العرض فرع بقاء جوهره، فمعناه أنّ الدم باقٍ حقيقة.
لكنّ الشارع المقدّس خالف هذا التحليل العقليّ، وحكم تعبّداً بأنّ بقاء اللون لا يضرّ، ولا يُعدّ بقاءً للنجاسة، لأنّ العرف لا يرى في هذا اللون دماً، بل يرى أنّ الدم قد أُزيل والباقي مجرّد أثرٍ لا حقيقة له.
ومن هنا يتبيّن أنّ الملاك في الأحكام الشرعيّة هو النظر العرفيّ لا الدقّي العقليّ، لأنّ الشارع كثيراً ما بنى أحكامه على ما يراه العرف، كما في هذا المثال.
وبهذا البيان نفسه يتّضح موقفه (قدِّه) في باب الاستصحاب، فإنّ قوله (عليه السلام): "لا تنقض اليقين بالشكّ"، ظاهرٌ في أنّ الملاك في النقض وعدمه هو ما يراه العرفُ نقضاً لا ما تُدركه الدقّة الفلسفيّة.
فإذا رأى العرف أنّ الحالة الثانية مناقضةٌ للأولى، فالنقض متحقّق عرفاً، ويجب إبقاء الحالة السابقة تعبّداً؛ وأمّا إذا رآها حالةً أخرى مباينةً لا اتصالَ بينها وبين الأولى، فليس هذا من موارد "النقض"، فلا يجري الاستصحاب.
ومن هذا الباب أيضاً ما ذكره (قدِّه) في الوجوب والاستحباب، فإنّ بعض الأعلام ـ بحسب الدقّة العقليّة ـ اعتبرهما من مراتب الطلب: أحدهما شديد والآخر ضعيف.
لكن العرف لا يراهما كذلك، بل يعدّهما حكمين متباينين، لا مرتبتين من حقيقة واحدة، فالوجوب عنده شيء والاستحباب شيء آخر، وكذلك سائر الأحكام الخمسة (الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة)، فإنّها متباينة عرفاً لا تشكيك بالشدّة والضعف .
فالنتيجة كما أفاد صاحب الكفاية (قدِّه):
إنّ العبرة في تشخيص وحدة الموضوع واختلاف المراتب إنّما هي بالعرف، لا بالدقّة العقليّة، لأنّ الشارع بنى خطابه وأدلّته على الارتكاز العرفيّ، فجعل قوله "لا تنقض اليقين بالشكّ" محكوماً بما يفهمه العرف من النقض والبقاء، لا بما تدركه العقول التحليلية .
ولذا قال(قده) "ولذا لو انعكس الامر ولم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هناك نقض عقلا"
وبذلك يتّضح أنّه قد حصلت لدينا من خلال البحث ثلاثة اقول أساسيّة في مسألة استصحاب الكلّي:
القول الأوّل:
وهو مختار الشيخ الأعظم الأنصاريّ (قدِّه)، حيث فصّل بين صورتين:
فإن علمنا بارتفاع الفرد الأوّل ـ كخروج زيدٍ من الدار ـ واحتملنا في آنٍ مقارنٍ لوجوده وجود فردٍ آخر من سنخ الكلّيّ، جرى الاستصحابُ عنده، لعدم العلم بانقطاع وجود الكلّيّ حقيقة.
وأمّا إذا علمنا بارتفاع الفرد الأوّل، واحتملنا حدوث فردٍ آخر بعد ارتفاعه مقارناً له، فـ الاستصحاب لا يجري، لانتفاء اليقين بالحدوث في الفرد الثاني.
نعم، استثنى (قدِّه) من ذلك صورةً خاصّة، وهي ما إذا تسامح العرف في اختلاف المراتب بالشّدّة والضّعف، كأن يرى المرتبتين من سنخٍ واحدٍ، ففي مثلها لا مانع من جريان الاستصحاب، كما تقدّم تفصيلُه سابقاً.
القول الثاني:
وهو ما أفاده السيّد اليزديّ (قدِّه) في حاشيته على الرسائل، حيث ذهب إلى جريان الاستصحاب مطلقاً في جميع صور القسم الثالث من استصحاب الكلي ، من غير تفصيلٍ بين صورتي المقارنة والتعاقب، بناءً على تماميّة أركانه عنده.
القول الثالث:
وهو الذي ذهب اليه صاحب الكفاية (قدِّه)، حيث ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب مطلقاً، سواء في الصورة الأوّلى أو الثانية، بدعوى أنّ الكلّيّ في ضمن فردٍ يغاير وجوداً الكلّيّ في ضمن فردٍ آخر، فلا يتحقّق اليقين بالحدوث في الفرد الثاني، ولا يُحرز اتّحاد الموضوع عرفاً.
وأمّا ما تعرّضنا له من مسألة اختلاف المراتب بالشّدّة والضّعف، فهي ـ وإن جعلها بعضُ الأعلام بحثاً مستقلاً ـ إلّا أنّ جماعةً منهم أدرجوها ضمن القسم الأوّل من استصحاب الكلّيّ، باعتبار أنّ الشكّ فيها يرجع إلى بقاء الفرد الواحد واختلاف أوصافه، لا إلى تعدّد الأفراد حقيقة، إذ المفروض أنّ الفرد واحدٌ، وإنّما اختلفت مراتبه. ولهذا سيأتي التعرّض لهذه الجهة لاحقاً إن شاء الله تعالى .
فهذه ثلاثةُ اقوال متباينةٌ في مبانيها ونتائجها، إذ يختلف كلّ واحدٍ منها عن الآخر في تصوير ركن اليقين بالحدوث، وفي تحديد مدى اتحاد الموضوع عرفاً، وفي ضابط جريان الاستصحاب وعدمه.
وأمّا الآن فننتقل إلى ما أفاده المحقّق النائينيّ (قدِّه)، فإنّه يوافق أستاذَه صاحبَ الكفاية (قدِّه) في النتيجة، ويُبدي تعَجَبه من موقف الشيخ الأعظم (قدِّه)، فيقول ـ بتعريضٍ لطيف ـ إنّا لم نكن نترقّب من الشيخ الأعظم مثل هذا القول، وكأنّ وضوحَ المطلب عنده يغنيه عن إقامة الردّ عليه، كما سيصرّح بذلك قريباً في كلامه.
وقد قرّب (قدِّه) وجهَ عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم بما أورده في فوائد الأصول،حيث قال:
"وأمّا عدم جريانه في الوجه الأوّل، فلأنّه لا منشأ لتوهّم جريان الاستصحاب فيه إلّا تخيّل أنّ العلم بوجود الفرد الخاص في الخارج ـ كزيدٍ ـ يُلازم العلم بحدوث الكلّيّ خارجاً"([3] ).
وبيان مقصوده (قدِّه): أنّه إذا علمنا بوجود زيدٍ في الدار، فذلك يستلزم أن يكون الكلّيّ (الإنسان) موجوداً في الدار، بدعوى الملازمة بين وجود الفرد ووجود الكلّيّ. غير أنّ هذا التعبير ـ أعني قولَه "يُلازم" ـ قد لا يرتضِه بعضُ المحقّقين، لأنّ الملازمة تقتضي الاثنينية، أي وجودَ شيئين بينهما ارتباط، في حين أنّ وجود الكلّيّ في الخارج ليس شيئاً وراء وجود الفرد، بل هو عينُه لا غير.
ولهذا أُشير إلى نظير ذلك في علم الكلام، حيث ذهب الإماميّة إلى أنّ صفاتَ الله تعالى عينُ ذاته، لا أنّها ملازمةٌ لها؛ لأنّ القول بالملازمة يقتضي المغايرة، والملازم يحتاج إلى ملزوم، بخلاف ما إذا قيل بالعينِيّة، فإنّ الصفات حينئذٍ ليست أمراً وراء الذات.
ثمّ عقّب المحقّق النائيني (قدِّه) على ما تقدّم بقوله:
"فبارتفاع الفرد الخاصّ يُشكّ في ارتفاع الكلّي، لاحتمال قيام الكلّي بفردٍ آخر مقارناً لوجود الفرد الذي عُلم بحدوثه وارتفاعه، فلم يختلّ ركنَا الاستصحاب من اليقين السابق والشكّ اللاحق بالنسبة إلى الكلّي".
وبيان مراده (قدِّه): أنّه بعد فرض العلم بارتفاع الفرد المعلوم ـ كـ زيدٍ مثلاً ـ يشكّ في ارتفاع الكلّي (الإنسان) لاحتمال أن يكون الكلّي قد قام في ضمن فردٍ آخر مقارنٍ لوجود الفرد الأوّل، لا متأخر حدث بعد ارتفاعه ، فلا يختلّ حينئذٍ ركنُا الاستصحاب اليقين السابق بوجود الكلّي، و الشكّ اللاحق في بقائه.
وعلى هذا الأساس، يكون هذا الوجه من وجوه التصوير مشابهاً للقسم الثاني من استصحاب الكلّي.
وتقريب المقصود: أنّ الصورة تشبه تماماً ما لو علمنا بوجود كليّ الحيوان في الخارج، ولكن لا ندري أنّ وجوده كان في ضمن حيوانٍ قصير العمر كـ البقّة أو حيوانٍ طويل العمر كـ الفيل؛ فبعد ارتفاع البقّة يشكّ في بقاء الكلّي من جهة احتمال بقاء الفيل، فيُقال إنّ الشكّ في بقاء الكلّي ناشئ من الشكّ في بقاء الفرد الآخر.
فكذلك هنا، بعد العلم بارتفاع الفرد الأوّل (زيدٍ)، يكون الشكّ في بقاء الكلّي (الإنسان) ناشئاً من احتمال وجود فردٍ آخر (عمر) مقارنٍ للفرد الذي علم ارتفاعه (زيد) .
ومن ثمّ يرى المحقّق النائيني (قدِّه) أنّ القول بجريان الاستصحاب في هذا الوجه من وجوه القسم الثالث من أقسام الكلي - والذي صُوّر على نحو يرجع إلى القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي- إنّما هو ـ على حدّ تعبيره (قدِّه) ـ تخيّلٌ وتوهّمٌ ناشئان من الخلط بين وجود الفرد الخاصّ ووجود الكلّي.
ولذلك قال المحقّق النائيني (قدِّه): "فبارتفاع الفرد الخاصّ - زيد - يُشكّ في ارتفاع الكلّي، لاحتمال قيام الكلّي في فردٍ آخر"
توضيح مراده (قدِّه) بعبارة أخرى:
إنّ الشكَّ ـ في نفسه ـ لا يُعتنى به ما لم يكن له منشأ عقلائيّ معتبر، إذ الطريقة العقلائيّة تقتضي البناء على الثبات وعدم الاعتناء بالشكوك غير المنضبطة. فالشخص كثير الشكّ مثلاً لا يُلتفت إلى شكّه، لأنّ منشأه غير عقلائي، وهذا أصلٌ عامّ في باب الاستصحاب أيضاً، إذ لا يُبنى على مجرّد الوهم أو التخيل، بل لا بدّ أن يكون للشكّ منشأ واقعيّ أو عقلائيّ يقرّه العقلاء.
ومن هنا يقرّر (قدِّه) أنّ الشكَّ في بقاء الكلّي إنّما يكون معقولاً إذا كان منشؤه احتمال قيام الكلّي بفردٍ آخر بعد ارتفاع الفرد المعلوم، لا مجرّد توهّمٍ ذهنيٍّ لا مستند له.
وبيان ذلك: أنّا نعلم بوجود زيدٍ في الخارج، وهذا الوجود للفرد ـ أي لزيدٍ ـ يُعبّر عنه بوجود الكلّيّ في ضمنه، فالعلم بزيدٍ يستتبع العلم بوجود الكلّيّ (الإنسان) في الخارج. وهذا ـ كما أشار إليه (قدِّه) ـ هو تصوير رأي الشيخ الأعظم (قدِّه)، القائل بأنّ الكلّيّ المتيقّن سابقاً يُستصحب عند الشكّ في بقائه، لاحتمال تحقّقه في فردٍ آخر.
ولهذا قال المحقّق النائيني (قدِّه): "لاحتمال قيام الكلّي في فردٍ آخر مقارناً لوجود الفرد الذي عُلم بحدوثه وارتفاعه".
تدقيق في مقصوده (قدِّه): هنا يُطرح سؤال أساس: هل يمكننا أن نمنع تحقّق الشكّ في مثل هذا الفرض؟
والجواب: كلاّ، لا يمكن ذلك، لأنّ الشكّ من الصفات الوجدانيّة التي لا تنفكّ عن النفس عند فقدان العلم. فإذا احتمل الإنسان شيئاً ممكناً في نفسه، فهو يشكّ وجداناً، ولا يمكن رفع هذا الشكّ بالمنع اللفظيّ أو الاعتباريّ.
فالكلام هنا مع الشيخ الأعظم (قدِّه): نحن نعلم بوجود الفرد المعيّن، أي زيدٍ، فالعلم بزيدٍ يستلزم العلم بتحقّق الكلّي (الإنسان) في الخارج، فإذا خرج زيد من الدار فقد ارتفع معه الكلّيّ الذي كان في ضمنه.
لكن الشيخ الأعظم (قدِّه) لم يقل إنّ الكلّيّ قد ارتفع حتماً، بل قال: نعم، خرج زيدٌ، ولكن أحتمل أن يكون في الدار عمرو، فحينئذٍ أشكّ في بقاء الكلّيّ لاحتمال وجود فردٍ آخر منه مقارناً لوجود زيد.
وهذا الشكّ ـ من حيث هو ـ شكّ وجيه ومقبول وجداناً، إذ لا يمكن أن يُقال للشيخ الأعظم: لا تحتمل وجود عمرو، كما لا يمكن أن يُقال للمحقّق النائيني: لا يصحّ منك هذا الاحتمال، لأنّ كلاًّ منهما يتكلّم في موردٍ قابلٍ للفرض عقلاً ووجداناً.
غير أنّ محلّ النزاع الجوهريّ بينهما ليس في أصل إمكان الشكّ، بل في حقيقة متعلَّقه: فبعد خروج زيد، لو سُئلنا: هل الكلّيّ الذي كان في ضمن زيد قد ارتفع أو لا؟
نقول: نعم، الكلّيّ في ضمن زيد قد ارتفع يقيناً؛ إذ بارتفاع الفرد ينعدم وجود الكلّيّ في ضمنه لا محالة.
ثمّ بعد ذلك نلتفت إلى احتمال وجود فردٍ آخر ـ كعمرو ـ في الدار، فنشكّ من هذه الجهة في وجود الكلّيّ من جديد، لا في بقائه.
فهذا الشكّ في الحقيقة شكّ في أصل الحدوث لا في البقاء، لأنّنا بعد أن قطعنا بارتفاع الكلّيّ الأوّل نحتمل حدوث كلّيٍّ آخر في ضمن فردٍ جديد.
ومن المعلوم أنّ الاستصحاب لا يجري في مورد الشكّ في أصل الحدوث، لأنّ أحد ركنيه ـ وهو اليقين السابق بالحدوث ـ غير متحقّق في ما نحن فيه، إذ اليقين الذي كان متعلّقاً بالكلّيّ في ضمن زيد قد ارتفع بارتفاعه، والشكّ اللاحق ليس في بقائه، بل في حدوث وجودٍ آخر له.
وعليه، فالشكّ هنا وإن كان وجدانياً، إلا أنّه ليس مورداً للاستصحاب، لعدم تحقّق موضوعه، إذ أركانه لا تكتمل إلا بوجود يقينٍ بالحدوث وشكٍّ في البقاء، والحال أنّ الموجود هنا هو شكّ في الحدوث، فيخرج المورد عن ضابطة الاستصحاب رأساً.
وهذا هو جوهر ما أفاده المحقّق النائيني (قدِّه) في جوابه على الشيخ الأعظم (قدِّه)، مبيّناً أنّ منشأ التوهّم في جريان الاستصحاب ناشئ من الخلط بين الشكّ في البقاء والشكّ في الحدوث.
وللكلام بقية ..


