47/04/14
استصحاب الكلي/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
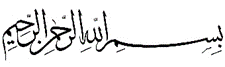
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب الكلي
لازال الكلام في القسم الثالث من استصحاب الكلي، وقد تقدم ان صورته: أن يُعلم بوجود الكلي في ضمن فردٍ معيّن، ثم يزول ذلك الفرد، فحينئذٍ يُحتمل أحد أمرين:
الأوّل: أن يكون هناك فرد آخر قد وُجد مقارناً للفرد الأول قبل ارتفاعه، بحيث يحتمل بقاء الكلي ببركة هذا الفرد الثاني.
الثاني: أن لا يكون هناك فردٌ مقارن، ولكن يُحتمل حدوث فردٍ جديد بعد ارتفاع الفرد الأول، فيُشك في بقاء الكلي من هذه الجهة.
وفي هذا المقام فصَّل الشيخ الأعظم (قده) بين الصورتين:
ففي الصورة الأولى: وهي احتمال وجود فرد آخر مقارن للفرد الأول ـ يرى جريان الاستصحاب، لأنّ المتيقَّن به سابقاً هو وجود الكلي في ضمن أحد الأفراد، والشك لاحقاً في بقائه، ومن ثَمَّ يتحقّق ركني الاستصحاب وهما اليقين بالحدوث والشك في البقاء، إذ يحتمل أن يكون الكلي مستعدّاً للبقاء ببركة وجود الفرد الثاني.
وأمّا الصورة الثانية: وهي احتمال حدوث فردٍ جديد بعد ارتفاع الأول ـ فقد أنكر (قده) جريان الاستصحاب فيها، لعدم إحراز أصل حدوث الكلي، إذ الكلي المحتمل حدوثه في ضمن الفرد الثاني الذي حدث بعد ارتفاع الفرد الأول غير الكلي المتيقن سابقا فلا يحرز حدوثه سابقا حتى يُستصحب بقاؤه، فالمورد خالٍ عن اليقين بالحدوث.
غير أنّ الشيخ الأعظم استثنى من هذه الصورة ما إذا كان العرف يرى الاتصال بين الحالتين للكلي بحيث يعدّهما العرف استمراراً لشيءٍ واحدٍ، كما في مثال السواد الشديد إذا انقلب إلى سوادٍ خفيف، فإنّ العرف لا يرى فيهما لونين مختلفين، بل يرى تخفيفاً في مرتبة الشدة، فيُحكم ببقاء الكلي عرفاً. ومن هنا يمكن عدّ هذه الحالة صورةً ثالثةً مستقلة بين الصورتين.
فالنتيجة: أنّ الشيخ الأعظم (قده) فصّل بين الصور، فحكم بالجريان في الأولى دون الثانية، مع استثناءٍ الاتحاد بين الكليين عرفا فيكون بمثابة صورة ثالثة.
بينما السيد اليزدي (قده) ـ كما تقدّم في حاشيته على الرسائل ـ ذهب إلى جريان الاستصحاب مطلقاً في جميع هذه الصور بدون تفصيل.
أمّا الآن فقد وصل بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب الكفاية (قده)، حيث ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب مطلقاً في هذا القسم من استصحاب الكلي.
وعليه، يتّضح مدى البُعد بين آراء الأعلام في هذه المسألة، فإنها قد تفرّعت على ثلاثة أقوال رئيسة:
الأول: القول بالجريان مطلقاً، كما هو رأي السيد اليزدي (قده)، حيث يرى تماميّة أركان الاستصحاب في جميع الصور.
الثاني: القول بعدم الجريان مطلقاً، وهو ما اختاره صاحب الكفاية (قده).
الثالث: القول بالتفصيل، وهو رأي الشيخ الأعظم (قده)، القائل بجريان الاستصحاب في صورة احتمال المقارنة دون صورة احتمال التعاقب، مع استثناءٍ عرفيٍّ يُلحق بها (صورة ثالثة كما تقدّم.)
وبهذا يتّضح أنّ المسألة قد دارت بين الإطلاقين والتفصيل، وهو ما يكشف عن عمق المباحث في استصحاب الكلي وتنوّع مناشئ الاختلاف بين الأعلام.
وسوف تأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ جملة من المناقشات في طيّ هذه الأقوال الثلاثة، وسنُسلّط الضوء على أهمّها وأدقّها بعد أن نُدرك أولًا أنّ هذه الأقوال في حدّ ذاتها ليست جديدة من حيث المضمون؛ إذ إنّ معظمها يرجع إلى ما قرّره الشيخ الأعظم (قده)، فبعض الأعلام وافقه في التفصيل، وبعضهم تبنّى جانب السيد اليزدي (قده) القائل بالجريان مطلقًا، وآخرون تبنّوا ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) من عدم الجريان مطلقًا.
وأمّا المناقشات التي سنتعرّض لها لاحقًا، فإنّما يكون التعرض لها إذا كانت ذات فائدة علمية تتجاوز مجرّد نقل الأقوال أو تكرارها، بحيث تُسهم في توضيح المبنى أو في رفع الإشكال عن أحد الاتجاهات.
فالغرض من البحث ليس استعراض الآراء فحسب، بل الوقوف على نكاتها التحقيقية وما يمكن أن يُبنى عليها في مقام الاستنباط.
قال صاحب الكفاية (قده) في مناقشته للقسم الثالث من استصحاب الكلي، "وأما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاصٍّ آخر في مقام ذاك الخاصّ الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه…"[1] .
بيان مراده (قده): لتتّضح الصورة، نقرّب المطلب: كما لو قطعنا بوجود زيد في الدار، فيكون عندنا يقين بوجود الكلي (الإنسان) في ضمن فرده وهو زيد. ثم خرج زيد من الدار، فصار عندنا يقين بارتفاع ذلك الفرد. لكن يُثار الشك الآن من جهة أخرى، وهي: هل قام فرد آخر مقامه، كعمرو مثلًا، بحيث يكون الكلي (الإنسان) باقياً بوجوده؟ فالمفروض أننا لا نشك في بقاء زيد، بل في قيام عمرو مقامه، أي في وجود فرد آخر للكلي بعد ارتفاع الأول. فحينئذٍ يكون الشك في بقاء الكلي ناشئاً من الشك في حدوث فرد جديد بعد ارتفاع الفرد المعلوم، لا من احتمال بقاء الفرد الأول.
ثم قال (قده) "ففي استصحابه إشكال، أظهره عدم جريانه، فإنّ وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده، إلا أنّ وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجودٍ واحدٍ له، بل متعدّدٌ حسب تعدّدها".
بيان مراده (قده): المقام في هذا القسم هو ما إذا قطعنا بوجود الكلي في ضمن فردٍ معيّن، كوجود الإنسان في ضمن زيد، ثم قطعنا بخروجه من الدار، فصار عندنا يقين بارتفاع الفرد المعلوم. لكن قد يُحتمل أنّ فردًا آخر ـ كعمرو ـ قد قام مقام زيد، لا لخصوصية عمرو، بل لكونه مصداقًا آخر لذلك الكلي.
فالشكّ حينئذٍ ليس في بقاء زيد، بل في حدوث فردٍ جديد، أي في أنّ الكلي قد وُجد الآن في ضمن عمرو أو لم يوجد. وهذا الشكّ من سنخ الشكّ في الحدوث لا في البقاء، ومن هنا قال (قده): "ففي استصحابه إشكال، أظهره عدم جريانه".
وجه استدلاله (قده):
استدلّ صاحب الكفاية على عدم الجريان بقوله: "فإنّ وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده، إلا أنّ وجوده في ضمن المتعدد من أفراده …إلى آخره"
تحليل الاستدلال:
إنّ الآخوند (قده) يُسلِّم بما اتّفق عليه أهل المعقول من أنّ الكلي الطبيعي لا وجود له منحازٌ عن الأفراد، بل وجوده بوجود فرده، وهذا مسلَّم لا نزاع فيه.
غير أنّ المقصود من وجود الكلي هنا ليس المفهوم الذهني، بل الوجود الخارجي الذي تترتّب عليه الآثار الشرعية، كقولنا: إذا أحدث الإنسان وجب عليه الوضوء، أو إذا تنجّس الثوب وجب غسله، فالموضوع هنا هو الكلي الخارجي لا الذهني.
وحين نُصوِّر هذا الوجود الخارجي، نرى أنّه يتعدّد بتعدّد الأفراد، فكلّ فردٍ من الأفراد يحقّق وجودًا خاصًّا للكلي على نحو الحقيقة لا المجاز. فالإشارة إلى زيد بقولنا: هذا إنسان، أو إلى عمرو بقولنا: هذا إنسان، كلتاهما صحيحتان على وجه الحقيقة، لكن لا يصحّ أن نشير إلى عمرو فنقول: هذا الإنسان الموجود في زيد؛ إذ لا يعقل أن يكون وجود الكلي في زيد هو نفسه وجوده في عمرو.
ولهذا شبَّه الأعلام علاقة الكلي بأفراده بـعلاقة الآباء بالأبناء، لا بالأب الواحد لأبناءٍ متعدّدين؛ أي إنّ الكلي ليس وجودًا واحدًا منبسطًا على الجميع كما يتوزّع أبٌ واحد على أولادٍ كثيرين، بل هو وجود يتكرّر ويتعدّد في كلّ فردٍ كما تتعدّد الآباء بتعدّد الأبناء.
فكلّ فردٍ يحقّق وجودًا خاصًّا للكلي، وعند ارتفاع ذلك الفرد يرتفع وجود الكلي المتقوّم به، ولا يبقى منه شيء في الخارج.
وعليه، إذا خرج زيد من الدار فقد ارتفع الكلي الموجود فيه قطعاً، وأمّا احتمال وجود عمرو فلا يلازمه بقاء الكلي، لأنّ الكلي في عمرو مغاير وجودًا للكلي في زيد. فمع الشك في أصل حدوثه ينتفي ركن اليقين بالحدوث، ولا يبقى ما يُستصحب.
وهذا بخلاف القسم الثاني من استصحاب الكلي، إذ الشك هناك كان في البقاء لا في الحدوث، لأنّ الكلي معلوم الوجود في ضمن فردٍ من الأفراد، والشك في أنه باقٍ في هذا الفرد أو انتقل إلى آخر.
الفارق بين الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية:
والفارق الجوهري بين الشيخ الأعظم (قده) وصاحب الكفاية (قده) هو أنّ الشيخ يرى أنّ للكلي استعدادًا للبقاء، ولكن لا يُعلم هل يرتفع بارتفاع الفرد الأول أو يبقى بفردٍ آخر، فملاك الشك عنده هو الشك في البقاء.
أمّا الآخوند (قده) فيرى أنّ الشك في هذه الصورة راجع إلى أصل الحدوث لا إلى البقاء، لأنّ الكلي في زيد قد ارتفع بخروجه، والكلي في عمرو لم يُحرز حدوثه، ففقدَ الاستصحاب ركنه الأول وهو اليقين بالحدوث.
ولهذا استغرب المحقق النائيني (قده) من تبنّي الشيخ الأعظم القول بالجريان، وعدّ المطلب واضحاً في جانب عدم الجريان، حتى قال بما معناه: ما كنا نترقّب مثل هذا من الشيخ الأعظم (قده)، لوضوح المانع عن جريان الاستصحاب في هذه الصورة.
فالنتيجة أنّ ما أفاده صاحب الكفاية (قده) من قوله: "فإنّ وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده…"
إنّما هو تسليم بالمقدّمة عند أهل المعقول لا استدلال بها على الجريان، وإنما أراد بيان أنّ وجود الكلي في الأفراد يتعدد بتعددها، فلا يحرز بقاء الكلي بعد ارتفاع الفرد الأول، وبذلك يمنع جريان الاستصحاب في هذا القسم مطلقاً.
وقد جاء بعده من الأعلام ونسجوا على منواله.
ثُمّ بعد ذلك قال (قده): "فلو قُطع بارتفاع ما عُلِم وجوده منها ـ أي من الأفراد ـ لَقُطع بارتفاع وجوده ـ أي الكلي ـ وإن شُكّ في وجود فردٍ آخر مقارنٍ لوجود ذاك الفرد، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه"
بيان المطلب:
الآخوند (قده) يُوضّح هنا نتيجة ما تقدّم من بيانه، وهي أنّه متى ما قُطع بارتفاع الفرد المعلوم الوجود، فإنّ هذا القطع يستلزم القطع بارتفاع الكلي الموجود في ضمنه، لأنّ الكلي الخارجي لا يتحقق إلا بوجود الفرد، وقد ارتفع الفرد بارتفاعه.
وأمّا احتمال وجود فردٍ آخر مقارنٍ للفرد الأول، أو حدوثه عند ارتفاعه ـ إمّا بنفسه أو بملاكه ـ، فهو احتمال في حدوث فردٍ جديد، لا في بقاء الفرد الأول ولا في بقاء الكلي المتقوّم به.
وعليه، يكون الشك هنا راجعًا إلى أصل الوجود لا إلى البقاء، ومن ثمّ ينتفي الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهو اليقين بالحدوث. فمع عدم إحراز حدوث الكلي في ضمن الفرد الثاني، لا يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات بقائه.
وبعبارة أخرى لبعض: إنّ الكلي في مقام التحقّق الخارجي منحصر في وجود الفرد، وهذا أمر واضح لا خلاف فيه. والمقصود هنا هو الكلي الطبيعي الموجود في الخارج الذي تترتّب عليه الآثار الشرعية، لا الكلي الذهني الذي هو في الحقيقة جزئيٌّ ذهني.
فالكلي الخارجي يتعدّد بتعدّد أفراده، وليس له وجود واحد منبسط على الجميع. وليس معنى ذلك أنّ الأفراد لوازم لذلك الوجود الواحد كما قد يُتوهّم، بحيث يكون هناك كليّ واحد في الخارج وتعدّد الأفراد من شؤونه أو لوازمه، فهذا غير صحيح، ولا يقول به أهل الدقة من أهل المعقول.
بل الحقّ أنّ الكلي في الخارج له تعيّنات متعددة بتعدّد تعيّنات أفراده، فكلّ فردٍ يحقّق للكلي وجودًا خاصًّا به، وليس هناك وجود واحد للكلي تتفرّع عنه الأفراد.
إلى هنا يتّضح أنّ مطلب الأعلام ـ كالشيخ الأعظم والسيد اليزدي (قدّس سرّهما) ـ يتمحور حول نقطة فارقة ومهمّة، وهي أنّ الكلي موجود بوجود أفراده، ويتعدّد بتعدّدها.
فالكلي ـ مثلًا ـ في ضمن زيد قد ارتفع بخروجه، لأنّ وجود الكلي متقوّم بوجود الفرد. فإن فُرض وجود كلي آخر، فلابدّ من وجود فردٍ آخر يكون في ضمنه. وأمّا في المقام، فوجود عمرو غير محرزٍ لدينا، وبانتفاء إحراز الفرد ينتفي إحراز الكلي.
وعليه، ينتفي الركن الأوّل من أركان الاستصحاب، وهو اليقين بالحدوث، فلا مجال لجريان الاستصحاب في هذا الفرص.
ثم أضاف صاحب الكفاية (قده) قوله: "أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه" وبهذا صار مورد الاحتمال على أربعة أنحاء:
الأول: أن يوجد فرد مقارن للفرد الأول في الوجود.
الثاني: أو يكون مقارنًا لوجوده في بعض أزمنته.
الثالث: أو يكون مقارنًا لارتفاعه عند زواله.
الرابع: أو يكون وجوده بنفسه أو بملاكه بعد ارتفاع الفرد الأول.
بيان معنى الملاك الذي ذكره صاحب الكفاية (قده):
المقصود من الملاك في كلامه (قده) هو الجهة التي من أجلها شُرِّع الحكم، أي المصلحة أو المقتضي الباعث على التشريع، وهو أمرٌ مغايرٌ لنفس الحكم الشرعي؛ لأنّ الحكم عبارة عن جعلٍ تشريعي، وأمّا الملاك فهو السبب الغائي أو العلّة الغائية لذلك الجعل.
هذا يشبه ما يُذكر في الأبحاث الأصولية من أنّ ملاك الأحكام غير نفس الأحكام، كما في قاعدة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فمن أين نعلم بالنهي عن الضد؟.
وكذلك في مسألة الترتّب بين الأهمّ والمهمّ، فإنّهم يقولون: إذا عصى علينا الأمر بالأهمّ، فهل يبقى الأمر بالمهمّ؟ بعض الأعلام قال: يكفي في ذلك بقاء المحبوبية وإن لم يوجد أمرٌ فعلي، فالمحبوبية هي عين الملاك، أي إنّ المصلحة باقية في الفعل.
وقد وقع البحث بين الأعلام في كيفيّة إحراز هذا الملاك؛ فقال المتأخرون: لا طريق لإحراز وجود الملاك إلاّ من خلال الأمر الشرعي نفسه، لأنّ الأمر كاشف عن وجود مصلحةٍ في متعلّقه. فمثلاً إذا أُمرنا بالصلاة، فملاكها هو ما اشتملت عليه من التوجه إلى الله تعالى، والطهارة، والذكر، والخضوع، وهذه الجهات هي المصلحة الواقعية التي من أجلها شُرّعت.
إلّا أنّ إدراك هذا الملاك على نحو التفصيل غير ممكن لنا عادة، إذ لم يُبيّنه الشارع، ولهذا قال المحققون من الأعلام: إنّ الملاك أمرٌ غير واضح لدينا تفصيلاً.
ومما يورده الأعلام مثالًا لتوضيح معنى الملاك: مسألة الصلاة لفاقد الطهورين، فإنّ وجوب الصلاة في حقّه يسقط لعدم القدرة على الشرط، ولكن يُقال: هل يبقى ملاك الصلاة ـ أي مصلحتها ومحبوبيتها الذاتية ـ بحيث يمكن الإتيان بها برجاء المطلوبية أو على وجه الاستحباب؟
فقد ذهب بعض الأعلام إلى أنّ الملاك باقٍ، فيجوز له الإتيان بالصلاة رجاءً أو استحبابًا، لأنّ المصلحة الكامنة فيها ـ وهي الخضوع والذكر والاتصال بالله تعالى ـ لا تزول بفقدان الطهارة. بينما رأى آخرون أنّه مع سقوط الأمر لا طريق لإحراز بقاء الملاك، إذ لا يُعلم إلا من خلال الأمر نفسه، ومع عدمه لا يُحرز وجود المصلحة الواقعية.
وعلى كلّ حال، فإنّ البحث في الملاك دقيق وعميق، إذ ليس من السهل إحرازه مع عدم وجود أمرٍ شرعي، لأنّ الأمر هو الكاشف الوحيد عن وجود المصلحة. فمتى انتفى الأمر، صار إثبات الملاك في غاية الصعوبة، ولهذا شدّد المحققون من الأعلام على أنّ الملاك لا يُدرك إلا بدليلٍ شرعي يدلّ عليه.


