47/04/05
الشبهة العبائية/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
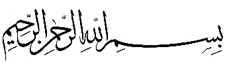
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الشبهة العبائية
ما زال الكلام في الشبهة التي طرحها السيّد إسماعيل الصدر (قده) وتناولتها أقلام بعض الأعلام. وقد ذكرنا في مقام البحث رأيين: الأوّل هو رأي المحقّق النائيني (قده)، وحاصله أنّ الاستصحاب لا يجري في طرفي العباءة إذا أُريد تطبيقه بلحاظ مفاد "كان الناقصة"، وذلك لعدم تحقّق الحالة السابقة المعلومة في كلٍّ من الطرف الأعلى والطرف الأسفل، فلا يصحّ أن نقول: "هذا الطرف الأعلى كان نجسًا" أو "هذا الطرف الأسفل كان نجسًا" لنستصحب نجاسته. أمّا إذا أُريد الاستصحاب على نحو مفاد "كان التامّة" فلا مانع من جريانه، ولذا فرّق المحقّق النائيني (قده) بين الصورتين، كما بيّنّا سابقًا.
أمّا الرأي الثاني فهو رأي السيّد الخوئي (قده) ومَن وافقه؛ إذ يرى عدم المانع من جريان الاستصحاب في الطرفين، وإن كنّا نحكم ــ في القاعدة ــ بطهارة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، إلا أنّه في خصوص المقام يعدّ الاستصحاب حاكمًا على أصل البراءة.
كما أنّ شيخَنا الأستاذ (سلّمه الله) بنى مبناه على نجاسة ملاقي أطراف الشبهة المحصورة من الأصل، فبناءً عليه تكون الشبهة في المقام محلولة ابتداءً. وأمّا إذا سلّمنا ــ تنزّلاً ــ بمقالة المشهور القائلين بالطهارة، فإنّه (سلّمه الله) أيضًا لا يرى جريان الأصل في الطرفين؛ لكونه من الأصول المثبتة، فيوافق بذلك المحقّق النائيني (قده) ويخالف أستاذه السيّد الخوئي (قده).
وقد وصل بنا البحث إلى ما أفاده السيّد الخميني (قده)؛ إذ اطّلع على رأي المحقّق النائيني (قده) فخالفه في طريق الاستدلال، مع موافقته إيّاه في النتيجة. فما هو رأيه (قده)؟
قال (قده) "فإنّه مع تطهير أحد طرفي الثوب لا يجري استصحاب الفرد المردَّد، ولكن جريان استصحاب النجاسة وإن كان ممّا لا مانع منه؛ لأنّ وجود النجاسة في الثوب كان متيقَّنًا ـ فركن الاستصحاب متحقّق ـ ومع تطهير أحد طرفيه يُشكّ في بقائه فيه فنستصحب البقاء. وعليه فبمقتضى الاستصحاب تكون العباءة نجسة، إلّا أنّه لا يترتّب على ملاقاة الثوب أثرُ ملاقاة النجس؛ فإنّ استصحاب بقاء الكلّي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الثوب ملاقاةً للنجس، أي إذا لاقى الإصبع أحد أطراف العباءة لا نقول إنّ هذا قد لاقى نجسًا، فإنّ استصحاب بقاء الكلّي أو الشخص الواقعي لا يثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاةً للنجس إلّا بالأصل المثبت"[1]
وحاصل كلامه (قده): أنّه يوافق على أصل جريان الاستصحاب في بقاء النجاسة الكلّيّة في الثوب بعد تطهير أحد الطرفين، لكنّه يمنع من ترتيب أثر ملاقاة النجس على ملاقي أحد الأطراف؛ لأنّ ذلك من اللوازم العقليّة لا من اللوازم الشرعيّة، فيكون من الأصول المثبتة غير الجارية.
وبهذا يتّضح أنّ كلامه (قده) منسجم ـ علميًّا ـ مع مَن سبقه في عدم الحكم بنجاسة ملاقي طرفي العباءة، وإن كان طريقه في الاستدلال مغايرًا لما سلكه المحقّق النائيني (قده). وهذا هو الوجه الأوّل في تقرير رأيه.
ثمّ قال (قده) في توضيح مقصوده من الأصل المثبت:
"ذلك لأنّ ملاقاة الأطراف ملاقاةٌ للنجس عقلًا -لا شرعًا-".
أي إنّ ترتّب عنوان "ملاقاة النجس" على ملاقاة أحد أطراف العباءة ليس أثرًا شرعيًا منصوصًا عليه حتّى يشمله دليل الاستصحاب، وإنّما هو لازم عقليّ ينتزع من بقاء النجاسة في أحد الأطراف، واللازم العقلي لا يثبت بالأصل الشرعي، فيكون من الأصول المثبتة غير الجارية.
ثمّ إنّ السيّد الخميني (قده) بعد ذلك اعترض على الجواب الأوّل للمحقّق النائيني (قده) المتعلّق بالفرد المردَّد؛ إذ إنّ المستصحَب في هذا الفرض حقيقته غير معلومة أصلًا، بخلاف ما في الفرض الثاني، فإنّ الجزئي معلوم ـ كزيد ـ لكنّ المجهول إنّما هو مكانه أو موضعه بالنسبة إلينا. فالأوّل غير الثاني.
وقد تقدّم منّا أنّ هذا التنظير في الجواب الأوّل الذي ذكره المحقّق النائيني (قده) يغاير ما ذكره في الجواب الثاني؛ حيث وجدنا له رأيين الأول في الفوائد والثاني ما ذكره في أجود التقريرات. فنظريًّا كان جوابه الأوّل غير جوابه الثاني؛ لأنّه في الجواب الآخر عالج المسألة في ضوء مفاد "كان التامّة" و"كان الناقصة".
وكما أشرنا سابقًا أيضاً إلى أنّ السيّد الخوئي (قده) ناقش كلا الجوابين معًا، بخلاف الشيخ الوحيد (دام ظلّه) الذي علّق بأنّ الجواب الثاني ـ القائم على الفرق بين مفاد "كان التامّة" و"كان الناقصة" ـ جوابٌ متينٌ على حدّ تعبيره (دام ظلّه).
قال السيّد الخميني (قده) في اعتراضه على المحقّق النائيني (قده):
"ففيه ما لا يخفى، وهو عبارة عن استصحابه على ما هو عليه من الترديد [2] وحاصل كلامه (قده): أنّ ما يُسمّى بـ "استصحاب الفرد المردَّد" لا موضوع له في الواقع؛ إذ لا يوجد شيء في الخارج يُدعى "الفرد المردَّد". فالترديد معناه "هذا أو غيره"، وهذا ـ بحسب الواقع ـ ممتنع، لأنّ كلّ فرد معيَّن له هويّته وفرديّته الخاصّة، فلا يُعقل أن نقول: "الطرف الأعلى إمّا الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل"؛ إذ الطرف الأعلى هو هو، والطرف الأسفل هو هو، ولا يمكن الترديد بينهما في نفس الحقيقة أو الفرديّة.
فالذين عبّروا عن ذلك بـ "الفرد المردَّد" إنّما أرادوا به إشارةً إلى جهلنا بالمصاب، أي إنّ النجاسة ـ مثلًا ـ أصابت هذا الطرف أو ذاك، لا أنّ في الخارج فردًا مردَّدًا واقعًا. فالترديد ناشئ من العلم الإجمالي لا من الواقع الخارجي.
وبعبارة أخرى: ينبغي التفريق بين "التنويع" و"الترديد". فالتنويع هو تقسيم الماهيّة إلى أصنافها كما في المنطق: نقول "الإنسان إمّا شاعر أو كاتب أو غير ذلك"، أو "الحيوان إمّا إنسان أو فرس أو غيرهما". هذا يُعبّر عن تنويع، لا عن ترديد، والمقسم فيه باقٍ مع جميع الأقسام. أمّا الترديد فليس كذلك، وإنّما هو تعبير عن جهلنا أو تردّدنا نحن، كأن نقول: "أنا متردّد هل أذهب إلى بغداد أم لا؟" أو "أنا متردّد هل النجاسة وقعت هنا أو هناك؟". ففي مقام العباءة نحن نعلم بكليّ النجاسة، لكننا متردّدون في محلّها، هل هو هذا الطرف أم ذاك؟ فهذا هو معنى الترديد عند الأصوليّين.
فجاء السيد الخميني(قده) وناقش المحقق النائيني، إذ قال أن الفرد المردد لا يمكن استصحابه؛ لأنه ليس له حالة سابقة وعليه أركان الاستصحاب غير متحققة. أمّا السيّد الخميني (قده) فقد قال: ليس المراد من "استصحاب الفرد المردَّد" ما فهمه المحقّق النائيني (قده) من المثال المطروح، بل المقصود هو استصحابه على ما فيه من الترديد نفسه. فهو يفرِّق بين هذا وبين المثال الذي ذكره النائيني من قبيل: "هل زيد موجود في هذا المكان أو في ذاك المكان؟"؛ لأنّ زيد ـ في هذا المثال ـ جزئي معيَّن لا مانع من استصحابه.
وبيان ذلك: أنّا نعلم بوجود زيد في الدار، فلو انهدمت الغرفة وبقينا نشكّ هل هو في الجانب الغربي منها أو في الجانب الشرقي، لا مانع من استصحاب وجود زيد؛ لأنّ زيد شخص معيَّن معلوم في الجملة، وإن جهلنا تفصيل مكانه. فالمثال الذي جاء به المحقّق النائيني وزعم أنّه من الفرد المردَّد ليس من هذا الباب، بل هو قابل لجريان الاستصحاب، ومن هنا عدَّه السيّد الخميني مثالًا خاطئًا.
وعليه، فإشكال السيّد الخميني (قده) مع النائيني (قده) إنّما هو في المثال والتطبيق، لا في أصل النتيجة؛ إذ النتيجة ـ في نهاية المطاف ـ ترجع إلى ما ذكره المحقّق النائيني من أنّ الاستصحاب في المقام إنّما هو بمفاد "كان الناقصة" لأنْ يلزم منه الأصل المثبت.
قال السيّد الخميني (قده): "وهو غير جارٍ في المقام، وليس المقام شبيهًا به، بل المراد بالاستصحاب في المقام ـ المثال الذي ذكره (قده) ـ هو استصحاب بقاء الحيوان في الدار من غير تعيين محلّه، وكذا استصحاب بقاء النجاسة في الثوب من غير تعيين كونها في هذا الطرف أو ذاك، ومن غير إرادة الجريان في الفرد المردَّد؛ ضرورة أنّه مع تطهير الطرف الأسفل من الثوب ينقطع الترديد ولا مجال لاستصحاب المردَّد، بل ما يُراد استصحابه هو بقاء الحيوان في الدار والنجاسة في العباءة، وهذا استصحاب الكلّي. وكون الحيوان الخاصّ فردًا جزئيًا حقيقيًا لا ينافي استصحاب الكلّي كما لا يخفى، كما أنّ استصحاب الشخص الخاصّ والجزئي الحقيقي كاستصحاب بقاء زيد في الدار وبقاء النجاسة المتحقّقة الخارجيّة الجزئيّة في الثوب ممّا لا إشكال فيه؛ فإنّه استصحاب الفرد المشكوك فيه ولا شَبَه له باستصحاب الفرد المردَّد".
وحاصل كلامه (قده): أنّ النزاع في الحقيقة ليس في الحكم، وإنّما في التسمية؛ فإطلاق عنوان "استصحاب الفرد المردَّد" على مثل المقام غير صحيح، إذ بعد تطهير الطرف الأسفل ينقطع الترديد رأسًا، وما يجري هنا ليس استصحاب الفرد المردَّد أصلًا، وإنّما هو استصحاب الكلّي أو استصحاب الفرد الجزئي المعلوم في الجملة، ولا يُلازم ذلك استصحاب طرفي العباءة إلا على نحو الأصل المثبت الذي لا نقول به.
وبهذا تنتهي هذه الجولة من الأقوال في "الشبهة العبائية"؛ فالمحصَّلة تنحصر في قولين:
القول الأوّل: ما تبنّاه المحقّق النائيني (قده) ومن وافقه.
القول الثاني: ما تبنّاه السيّد الخوئي (قده) ومن وافقه.
خلاصة الشبهة العبائية وتحليلها العلمي عند التدقيق في هذه الشبهة يتبيّن أنّ الاعتراض على "استصحاب الكلّي من القسم الثاني" بُني على إشكالين نظريَّين:
الإشكال الأوّل (الدوران بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء):
قيل: إنّ الأمر يدور بين موجود قد ارتفع ومعدومٍ لم يكن موجودًا أصلًا؛ فإذا استصحبناه لزم استصحاب المعدوم أو ما انقطع وجوده. والحال أنّ الاستصحاب إنما يجري في "الأمر الموجود" المتيقَّن حدوثه المشكوك بقاؤه، لا في المعدوم ابتداءً ولا في ما ارتفع يقينًا.
الإشكال الثاني (علاقة السبب بالمسبَّب):
قيل: إنّ الكلّي مسبب عن الفرد الطويل، ولا يُعقل بقاء المسبَّب مع انتفاء السبب، فإذا استصحبنا عدم السبب لزم استصحاب عدم المسبَّب. وهذا تصوير نظري قائم على قاعدة السببية والمسبَّبية.
إذن الشبهة في حقيقتها ذات صورة تنظيرية، لا تقوم على قاعدة عقليّة مانعة ولا على نصٍّ شرعي صريح، بل على تصوّر معيَّن لطبيعة الاستصحاب.
ركيزة الشبهة عند صاحبها بالتحليل يتضح:
أنّ صاحب الشبهة العبائية استند إلى ما بدا له من "تفكيك غير معقول" بين الأصول: كيف نحكم بطهارة ملاقي أحد الطرفين ثم نقول بجريان استصحاب النجاسة في العباءة؟! فالشبهة في جوهرها نقضٌ على الالتزام بهذين الأصلين معًا، لا إقامة برهان عقلي أو شرعي على بطلان أحدهما.
وبعبارة أخرى، الشبهة ليست أكثر من اعتراض على التفكيك بين الأصول في موردٍ خاصّ، وهو أمر كثير الحدوث في مباحث الفقه والأصول؛ إذ قد يحكم الشارع بأصلٍ في موضوع، وبأصلٍ آخر في أثرٍ مختلف، من غير أن يلزم منه محذور عقلي.
وقد شبّه بعضهم كالفاضل التوني هذه الشبهة بما يجري في باب التذكية والنجاسة:
عندنا حيوان مذكّى: حلالٌ أكله وطاهر.
وعندنا ميتة: حرامٌ أكلها ونجسة.
وعندنا غير مذكّى: حرامٌ أكلُه لكنّه طاهرٌ على رأيٍ مشهور.
فهذا تفكيك بين الحكمين (الطهارة والحليّة) مع أنّ المورد واحد. كذلك في السمك الميّت في الماء: طاهر لكن حرام أكله. فلا محذور في مثل هذا التفكيك، بل هو مألوف في الشريعة.
النتيجة النهائية في الشبهة العبائية:
القول الأوّل: ما تبنّاه المحقّق النائيني (قده) ومن وافقه، وهو عدم جريان الاستصحاب في أطراف العباءة بنحو مفاد "كان الناقصة".
القول الثاني: ما تبنّاه السيّد الخوئي (قده) ومن وافقه، وهو إمكان جريان الاستصحاب في الطرفين مع جعله حاكمًا على أصل البراءة.
وأمّا السيّد الخميني (قده) فقد خالف النائيني في المثال والتطبيق لا في النتيجة؛ فحاصل رأيه أنّ ما يجري في المقام هو "استصحاب الكلّي" أو "استصحاب الفرد الجزئي المعلوم في الجملة" لا "استصحاب الفرد المردَّد"، وأنّ تسمية المقام بالفرد المردَّد خطأ في التوصيف.
وعليه، فالمحصَّلة أنّ الشبهة العبائية ليست برهانًا عقليًّا أو نصًّا شرعيًّا مانعًا، بل هي مجرّد اعتراض على التفكيك بين الأصول، والتفكيك بين الأصول في نفسه لا محذور فيه ما دام كلّ أصل جارٍ في موضوعه وفي حدود دليله التعبّدي.
بهذه الخلاصة يظهر أنّ أصل الشبهة ـ كما وصفتَ ـ ليس إلا نقضًا وتمثيلًا، وأنّ المستند الحقيقي الذي يمكن أن يُقيم عليه صاحب الشبهة برهانًا غير موجود، ولذا رأى بعض الأعلام أنّها «شبهة تافهة» أو لم يتعرّضوا لها أصلًا.
وبعبارة أوضح: أن هذه الشبهة ينبغي أن تُعد إشكالاً على التفكيك بين الأصول فهي ليست شبهة نظرية، أي تختلف عن التوهم الأول الذي ذكره الشيخ، وهو توهم دوران الأمر بين مقطوع الارتفاع ومشكوك البقاء كذلك تختلف عن الوهم الثاني وهو أن الكلي مسبب عن الفرد الطويل فإذا استصحبنا عدمه ارتفع الكلي، فلا يوجد شيء لاستصحابه، وقد تقدم كلا التوهمين والإجابة عنهما، أما هذه الشبهة فليست فيها جهة نظرية، وإنما هي مسألة تطبيقية اعتقد صاحب الشبهة صعوبة التفكيك بين الأول.
بيان ذلك: أننا ذكرنا في هذا القسم من الاستصحاب ما قاله الأعلام في تصوير هذا الاستصحاب وقد مرّ ذلك، وذكروا له مثال الحدث، وهو لو علم بالحدث ولم يعلم أنّه الأصغر أو الأكبر، فلو توضأ فلا مانع من استصحاب كلي الحدث لكن لايثبت الكلي الذي في ضمن الفرد الطويل - أي الجنابة ومس الميت - بل يثبت الأثر المشترك وهو عدم مس كتابة القرآن وعدم جواز الصلاة، أمّا اللبث في المسجد فلامانع منه؛ لأنّه لا يثبت كلي حدث الجنابة ومعنى ذلك، أنّ مستصحب الحدث يجوز له اللبث في المسجد لكن لا يجوز له أن يصلي، وهي نتيجة غريبة؛ لأنّ أحدهما مرتبط بالآخر بحسب الواقع - حدث الجنابة - أي اذا جاز له اللبث في المسجد واقعاً فهو غير محدث بالأكبر - بحسب الواقع - ويجوز له الصلاة - لكن الأصول بحسب الظاهر - وأمّا التفكيك بينهما فهو غير معقول - يعني بحسب الواقع - لكن لمّا كان الأمر يتعلق بالاستصحاب فلا مانع من التفكيك بين جواز اللبث وعدم الصلاة، وإشكال صاحب الشبهة لا يعدو عن ذلك؛ إذ نقول لا مانع من الحكم بطهارة الملاقي وعدم جواز الصلاة - احدهما غير الآخر -؛، إذ لا يُفتي أحد بنجاسة ملاقي متيقن الطهارة مع مشكوك الطهارة، ولذلك سيدنا السيستاني يقول هذه مغالطة هو يتعلق بموضوع الاستصحاب.
والله العالم بحقائق الأمور.


