47/04/01
الشبهة العبائية/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
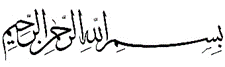
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الشبهة العبائية
قد انتهى بنا المقال إلى ما أفاده شيخُنا الأستاذ (سلّمه الله)، وتقدم إنّ نظره الشريف ـ وفق مبناه الخاص ـ مخالفٌ للمشهور في حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، حيث ذهب (دام ظلّه) إلى الحكم بنجاسة الملاقي، خلافًا لما عليه المشهور من الحكم بطهارته. ومن ثَمّ، فلو التزمنا بمقالته هذه، تنحلّ عقدة ما اشتهر بـ "الشبهة العبائيّة"، ولا يبقى بين استصحاب الكلّي من القسم الثاني وبين الحكم في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة أيّ منافاةٍ أو تزاحم. إذ الحكم بنجاسة الملاقي على مبناه (دام ظله) يرفع المعارضة المتوهَّمة.
غير أنّه قد يُلاحظ على ما أفاده (سلّمه الله) أنّ الجواب المبنائي لا يُغني عن معالجة أصل الإشكال، إذ غاية ما يفيده هو دفع الإشكال على طبق مبناه الخاص، وأمّا على تقدير التنزّل والالتزام بمقالة المشهور القائلين بالطهارة في ملاقي أحد الأطراف، فالسؤال الأساس يبقى قائمًا: هل يكون الحكم حينئذٍ بالطهارة أو بالنجاسة؟.
وبعبارة أخرى: هل يلتزم بما انتهى إليه المحقّق النائيني (قده)، أو بما قرّره السيد الخوئي (قده)؟ إذ هما رأيان على طرفي النقيض، فلا بُدّ من تحديد الموقف واختيار أحدهما.
إذن فلو سلّمنا ـ جدلاً ـ بما عليه المشهور من الحكم بطهارة الملاقي، كما سلّمنا بجريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فقد أفاد شيخنا الأستاذ (دام ظلّه) ما نصه:
"ومع الإغماض عن ذلك ـ أي عن مبناه في الحكم بنجاسة ملاقي أحد الأطراف ـ وتسليم ان الملاقي لاحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة محكوم بالطهارة لا بالنجاسة، إنّ الاستصحاب لا يجري في المسألة، لانه ان أُريد به استصحاب نجاسة واقع أحد الجانبين من العباءة، بأن نتّخذ عنوان أحدهما مشيراً ورمزا إلى واقعه المردّد بين هذا الجانب وذاك….. الى ان قال.. وإن أُريد به استصحاب بقاء نجاسة الجامع، وهو عنوان أحدهما بوصفه جامعا لا عنوانا مشيرا" [1] فهو أيضاً غير معقول.
وبيان مراده (دام ظلّه): أنّ أصل المسألة قد طُرحت في كلمات مدرسة المحقّق النائيني (قده) كثيراً، بل لعلّ جذورها ترجع إلى ما قبلها أيضاً. إلا أنّ محور الحديث الذي تداوله الأعلام يدور حول عبارة: (إذا تنجّس أحد الإنائين). فالمهم تحليل هذه العبارة: ما هو متعلّق النجاسة حقيقة؟ هل وقعت على الإناء الشرقي أو الغربي؟
في العلم التفصيلي: تكون النسبة واضحة، إذ نقول: الإناء الشرقي تنجّس أو الإناء الغربي تنجّس، فالموضوع معيَّن (الإناء) والمحمول هو النجاسة، وهذا لا إشكال فيه، إذ إنّ النجاسة حينئذٍ قد عُرضت على موضوع مشخص ومعيَّن.
أما في العلم الإجمالي: فنحن نعبّر عادة بقولنا: أحد الإنائين نجس. وهنا يحصل الإشكال، لأنّ موضوع القضية هو عنوان أحدهما، والمحمول هو نجس. ولكن في مقام التحقيق لا يوجد شيء اسمه أحدهما في الخارج، إذ الخارج ليس فيه إلا إناء شرقي وإناء غربي، ولكلّ منهما تشخّص وهويّة متعينة، ولا معنى للتردّد في الهوية أو التشخص بعد الوجود، إذ الترديد في الهوية والحقيقة غير معقول.
وإن أردنا تصحيح العبارة بمنطق القضايا المنفصلة: أمكننا القول: إمّا الإناء الشرقي نجس، وإمّا الإناء الغربي نجس. وهذا صحيح؛ لأنّ النجاسة عُرضت على الإناء الشرقي بخصوصه أو على الإناء الغربي بخصوصه. أمّا أن نقول رأساً: أحدهما نجس، فهذا يفضي إلى أن النجاسة عُرضت على عنوان أحدهما بما هو مفهوم ذهني، بينما النجاسة أمر خارجي، ولا يتّصف بها المفهوم الذهني.
فالنتيجة: أنّ عنوان أحدهما ليس معروضاً للنجاسة، ولا يتنجّس بعنوانه، لأنّه ليس إلا مفهوماً ذهنياً، بينما النجاسة محمول خارجي يحتاج إلى موضوع خارجي معيَّن.
ثم نقول: إنّ الجامع تارةً يكون جامعًا حقيقيًا، وأخرى يكون جامعًا اختراعيًا كما أفاد ذلك سيدنا السيستاني (دام ظله).
أمّا الجامع الحقيقي: فهو ما كان له نحو واقعيّة ماهويّة في الخارج، كما في الجامع بين زيد وعمرو، فإنّ بينهما جامعًا حقيقيًا وهو الإنسان، إذ هو الماهيّة المشتركة بين الأفراد. وفي مثله يكون الحمل عليه حملًا صحيحًا، كما لو قيل: الإنسان شاعر، وكان المراد حمل هذه الصفة على الكلّي بلحاظ انطباقه على فرد من أفراده (كزيد). فهذا الكلّي بما له من سعة وصدق على كثيرين، يصحّ أن يُحمل عليه المحمول الخارجي بلا إشكال.
وأمّا الجامع الاختراعي: فهو ما ليس له واقعيّة ماهويّة، بل يُنشئه العقل ويصطنعه لغرض الإشارة والتوصيف فقط، كعنوان أحدهما في محلّ الكلام. فهذا العنوان ليس له دور سوى الإشارة إلى فرد مردّد بين أمرين خارجيين، ولا يملك حيثيّة ذاتيّة مستقلّة بحيث يتّصف بالأوصاف الخارجيّة. ومن هنا، لا يصحّ أن يُحمل عليه محمول خارجي كعنوان النجاسة، إذ لا واقع موضوعي للجامع الاختراعي كي يُعْرَض عليه المحمول.
وعليه: فالحمل على الجامع الحقيقي صحيح، لكونه ماهيّة مشتركة متحقّقة في الأعيان، بخلاف الجامع الاختراعي، فإنّه لا يتجاوز كونه مفهومًا ذهنيًا يُستعمل أداةً للإشارة، ولا يُعقل أن يكون موضوعًا لأحكام خارجيّة.
فشيخُنا الأستاذ (دام ظله) يريد أن يُنبّه إلى أنّ عندنا طريقتين في مقام البرهان والتعبير. ففي مثال الشبهة العبائيّة، حيث إنّ العباءة ذات طرفين: علوي وسفلي، قد نعبّر عنهما بعنوان "أحدهما". وهذا العنوان يحتمل معنيين مختلفين:
الأول: العنوان المشير: وهو أن يُستعمل لفظ "أحدهما" على نحو الإشارة إلى واقع خارجي متعيّن مردّد عندنا بين الطرفين. فالعنوان هنا ليس مقصودًا بالذات، وإنّما أداة للإشارة إلى المصداق الخارجي الواقعي.
الثاني: العنوان الجامع: وهو أن يُراد من "أحدهما" جامعٌ بين الطرفين، لا بعنوان الإشارة إلى الخارج، بل باعتباره جامعًا موضوعًا للحكم. وهنا يظهر الفرق الجوهري، إذ الجامع بهذا اللحاظ لا واقعية له سوى كونه مفهومًا ذهنيًا اختراعيًا، لا يصلح للحمل عليه ولا لاتصافه بأوصاف خارجيّة.
إذن الفرق المهم بين اللحاظين هو أنّ العنوان المشير قد يُصحّح به الإسناد، لأنّ النجاسة تعرض حينئذٍ على موضوع خارجي متعيّن مشكوك عندنا، بينما العنوان الجامع بما هو جامع اختراعي لا يُعقَل أن يُعْرَض عليه المحمول الخارجي. والسؤال الأساس ماذا يترتّب على ذلك؟.
والنتيجة النهائية التي انتهى إليها شيخنا الأستاذ (دام ظلّه) هي أنّ الاستصحاب في هذه المسألة لا يجري.
وبيانه: قال (دام ظلّه) "لأنّه إن أُريد به استصحاب نجاسة واقع أحد الجانبين من العباءة، بأن يُتّخذ عنوان أحدهما مشيرًا ورمزًا إلى واقعه المردّد بين هذا الجانب أو ذاك ـ أي ليكون قنطرةً إلى الواقع ـ فيَرِدُ عليه أنّه من الاستصحاب في الفرد المردَّد، والاستصحاب فيه لا يجري، لعدم تمامية أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وإن أُريد به استصحاب بقاء نجاسة الجامع، وهو عنوان أحدهما بوصفه جامعًا لا بعنوانه المشير، فذلك أيضًا غير تام." توضيح مراده (دام ظلّه)
أولاً: أن يراد الجامع بنحو العنوان المشير
إذا قصدنا بـ "أحدهما" عنوانًا مشيراً إلى الواقع المردّد بين الطرف الأعلى والأسفل من العباءة، فالقضية تصير هكذا: إمّا الطرف الأعلى نجس، أو الطرف الأسفل نجس.
وهنا الإشكال: هل عندنا يقين سابق بنجاسة الطرف الأعلى كي نستصحبها؟ كلا. وهل عندنا يقين سابق بنجاسة الطرف الأسفل؟ كلا أيضًا. فبالتالي لا يوجد يقين سابق بخصوص أيٍّ من الطرفين، مع أنّ الاستصحاب متقوّم بركنين: اليقين السابق بالحدوث و الشك اللاحق في البقاء. وإذا انهدم أحد الركنين ـ وهو اليقين السابق هنا ـ بطل الاستصحاب رأسًا. وهذا هو وجه قوله (دام ظلّه): "لعدم تمامية أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء". وعليه فاستصحاب النجاسة على نحو الفرد المردّد لا معنى له.
ثانياً: وأما إذا أُريد من "أحدهما" الجامع، أي أن يُلحظ عنوانه بوصفه جامعًا لا بعنوانه المشير، فالمقام شبيه بقولنا: الإنسان شاعر أو الإنسان ناطق، حيث المحمول يُسند إلى الجامع. لكن هنا يرد إشكالان:
الإشكال الأول: أنّ الجامع ليس مصبًّا للنجاسة، بل النجاسة تعرض على الأعيان الخارجية (الإناء الشرقي أو الغربي)، لا على الجامع الذهني. فالحكم بأن "الجامع نجس" غير معقول في نفسه.
الإشكال الثاني: سلّمنا ـ جدلاً ـ بأن الجامع قد وُصف بالنجاسة، فكيف نثبت نجاسة الفرد الخارجي (الطرف الأعلى أو الأسفل)؟ هذا لا يثبت إلا بواسطة ملازمة عقلية، وهي لازم عقلي لا شرعي، فيكون من قبيل الأصل المثبت، وهو غير جارٍ عند التحقيق.
والخلاصة:
سواء فُسِّر "أحدهما" بمعناه المشير، أو بمعناه الجامع:
فعلى الأوّل: الاستصحاب لا يتم لعدم ركن اليقين السابق.
وعلى الثاني: الاستصحاب لا يتم كذلك إمّا للقول بعدم معروضية الجامع للنجاسة، وإمّا للانجرار إلى لزوم الأصل المثبت، وهذا لم يقل به أحد إلاّ شريف العلماء.
وبهذا تبيّن أنّ البناء على جريان الاستصحاب في المسألة غير تام، وهذا هو ما انتهى إليه شيخنا الأستاذ (دام ظلّه) من الفتوى بعدم جريان الاستصحاب في محل الكلام.
لذلك قال (دام ظله) "فالنتيجة، انه بعد غسل احد جانبي العباءة، فلا يجري الاستصحاب لا استصحاب الفرد ولا استصحاب الجامع الانتزاعي كما مر، ولهذا لا اصل هذه الشبهة."
وللكلام تتمة لبعض الأعلام سيأتي لاحقاً.


