47/03/30
الشبهة العبائية/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
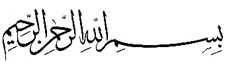
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الشبهة العبائية
تقدّم الكلام في ما أفاده السيد الخوئي (قده)، حيث التزم بجريان استصحاب النجاسة في محل الكلام، وهذا لا يعني تراجعه عن القول بطهارة ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة، بل يرى عدم التنافي بين القولين.
قال (قده) "وكيف كان، يكون الأصل الجاري – يعني الطهارة – في الملاقي في مثل مسألة العباء محكومًا باستصحاب النجاسة في العباء. فمن آثار هذا الاستصحاب – أعني استصحاب النجاسة – الحكم بنجاسة الملاقي"[1]
كما قال أيضًا:
"فبعد ملاقاة الماء مثلًا لجميع أطراف العباء نقول: إنّ الماء قد لاقى شيئًا كان نجسًا، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب، فيحكم بنجاسة الماء".
فمفاد عبارتيه أنّ الأصل في الملاقي (كالإصبع مثلًا) هو الطهارة، باستصحاب حالته السابقة، وأما في الملاقَى (أي العباءة) فيجري استصحاب النجاسة، فيحكم بنجاسة ما يلاقيها. وبهذا يفرّق بين موردين: استصحاب الطهارة في الملاقي، واستصحاب النجاسة في الملاقَى، من غير تنافٍ بينهما.
وبعبارة أوضح: لو فرضنا وجود إناءين، وكان أحدهما نجساً بالعلم الإجمالي، ثم لاقى الإصبع أحد الطرفين فقط، فنسأل: هل يحكم بنجاسة الإصبع أو بطهارته؟
جواب السيد الخوئي (قده): إنّ الإصبع قبل الملاقاة كان محكوماً بالطهارة، وبعد الملاقاة نشك في بقائه على الطهارة أو انتقاله إلى النجاسة، فنستصحب الحالة السابقة، وهي الطهارة، فيكون الملاقي (الإصبع) محكوماً بالطهارة، فهذه طريقة.
وهناك طريقة ثانية، وهي أن الإصبع قد لاقى ـ مثلًا ـ الطرف الأيمن، والملاقاة أمر وجداني، غير أنّ التنجّس إنما يترتب إذا كانت الملاقاة مع نجس محرز، والطرف الأيمن هنا مشتبَه النجاسة، فلا يصدق أنّه لاقى النجس، وعليه يكون الإصبع طاهرًا. فالنتيجة: أنّ ملاقي أحد أطراف الشبهة الموضوعية محكوم بالطهارة، وهذا هو مقصود السيد الخوئي (قده) هناك.
ولكن لو فُرض أنّا طهّرنا أحد أطراف العباءة ـ كالطرف الأعلى مثلًا ـ ثم إنّ الإصبع قد لاقى كلا الطرفين: الأعلى والأسفل، فالحكم هنا عند السيد الخوئي (قده) هو نجاسة الإصبع، مع أنّه في الصورة السابقة كان يحكم بطهارته. والوجه في هذا أنّه قبل التطهير كنّا نعلم بالعلم الإجمالي أنّ العباءة أو أحد طرفيها نجس، وهذا لا إشكال فيه. أمّا بعد أن وقع التطهير، فقد حصل لنا شك في أنّ النجاسة هل ارتفعت حقيقةً عن العباءة أو عن الطرفين أو أنّها باقية؟ وحيث إنّ الأصل يقتضي عدم ارتفاعها، فمقتضى استصحاب النجاسة هو الحكم ببقائها. ومن الآثار المترتبة على هذا الاستصحاب: نجاسة كلّ ما يلاقيها. ومن هنا قال (قده): "فمن آثار هذا الاستصحاب الحكم بنجاسة الملاقي".
قد يُثار هنا سؤال مهم، وهو: ما معنى قول السيد الخوئي (قده) إنّ من آثار هذا الاستصحاب الحكم بنجاسة الملاقي؟ وهل هذه الآثار المقصودة آثار شرعية أو آثار عقلية؟
فإن قلنا إنّها آثار عقلية، لزم أن يكون من قبيل الأصل المثبت، إذ الحكم بنجاسة الملاقي مترتب على النجاسة الواقعية ترتبًا عقليًا لا شرعيًا. وإن قلنا إنّها آثار شرعية، فهذا غير بيّن، لأنّا بعد أن طهرنا أحد الإناءين أو أحد طرفي العباءة خرج عن كونه طرفًا للعلم الإجمالي، وبقي الاحتمال في الطرف الآخر فقط. فحينئذٍ يكون عندنا طرف محكوم بالطهارة (كالشرقي مثلًا) وطرف آخر مشكوك النجاسة (كالطرف الغربي)، فإذا لاقى الإصبع الطرف الأول فهو معلوم الطهارة، وإذا لاقى الثاني فهو مشكوك النجاسة، فلا يثبت الحكم بنجاسته.
وبتعبير آخر: نجاسة العباءة أو نجاسة أحد أطرافها إنما هي أمر كلي، بينما الحكم بنجاسة ما يلاقي إنما هو أثر يترتب على نجاسة الفرد بعينه. فقول السيد الخوئي (قده): "من آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي" غير واضح في وجهه، لأنّ الحكم بنجاسة الملاقي هنا ليس أثرًا شرعيًا - وهو عدم الصلاة بالعباءة - للنجاسة المستصحبة، بل هو لازم عقلي لها، فيكون من قبيل الأصل المثبت، والسيد الخوئي (قده) ليس من القائلين بجريانه.
والبرهنة على هذا الوجه في غاية العُسر.
والحاصل أنّ في كلامه(قده) مواقع نظر:
أولاً: لم يتضح أنَّ من آثار استصحاب النجاسة في العباءة الحكمُ بنجاسة الملاقي؛ إذ يمكن أن يكون أثره شيئًا آخر، كالمنع من الصلاة فيها، لا الحكم بنجاسة الملاقي. نعم، للاستصحاب آثار، لكن لا يلزم أن يكون هذا الأثر منها، وذلك للزوم الأصل المثبت؛ لأنَّ الحكم بنجاسة الملاقي متفرع على نجاسة الملاقى بعنوانه الفردي، أي: "هذا نجس"، وهو عين محل الكلام في مفروض المسألة، أعني ما إذا غُسِل الطرف الأسفل وطُهّر، ثم لاقى الإصبع مع الرطوبة طرفي العباءة معاً. فدعوى أن الأثر هو نجاسة الملاقي مبنية على أصل مثبت.
ثانياً: ما ذكره(قده) من قوله: "إن الماء قد لاقى شيئًا كان نجسًا فيُحكَم ببقائه على النجاسة للاستصحاب، فيُحكَم بنجاسة الماء" محل تأمّل؛ أيضا فإن هذه العبارة تُعدّ كبرى قياسية: "كل ماء لاقى شيئاً كان نجساً فهو ينجس". غير أنّ الصغرى غير محرزة في محل الكلام.
فلو مثّلنا بالعباءة: نحن نعلم إجمالاً أنّها أصابتها نجاسة، ولكن لا نعلم هل هي في الطرف الأعلى أو الأسفل. فإذا طهّرنا الطرف الأسفل، ثم لاقى الإصبع مع الرطوبة الطرفين معاً، فهنا يقال: إنّ عبارته(قده) تقتضي أنّه لاقى شيئًا كان نجساً، فيصدق أنه لاقى نجساً. لكن التحقيق أن يقال: إنما كان نجساً قبل التطهير، وأما بعد التطهير فالملاقاة وقعت مع طرف طاهر ومع طرف آخر محتمل النجاسة أو مظنونها. فكيف تنطبق "لاقى شيئاً كان نجساً" على هذا المورد؟! هذا هو وجه الإشكال في تطبيق الكبرى على مثال العباءة، فلابد من التأمل في مطلبه(قده).
إذن قوله(قده) "أن الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً فيحكم ببقائه على النجاسة" كبرى لا صغرى لها في المقام إذ اليد أو الماء قد لاقى طاهراً فعلاً فالطهارة اليقينية قد قطعت الاحتمال والشك - وهو في الطرف المغسول - فما معنى قد لاقت ما كان نجساً فيحكم ببقائه على النجاسة.
وبالنتيجة فإن رأي السيد الخوئي(قده) النهائي يُخالِف رأي أستاذه المحقق النائيني(قده).
ثم إن مقتضى إطلاق كلام السيد الخوئي(قده) عدم الفرق بين أن تكون اليد الملاقية لطرفي العباءة قد لاقت الجانب المغسول اولا ثم لاقت الجانب غير المغسول منها ثانيا أو بالعكس.
وهذا بخلاف ما ذهب إليه الشهيد الصدر(قده) في المقام من التفصيل بين ما إذا لاقى الملاقي الطرف المغسول من العباءة اولا ثمّ لاقى الطرف الآخر منها وبالعكس. فحكم بأن جريان استصحاب النجاسة في الملاقى) (بالفتح) في الصورة الأولى معارض بجريان استصحاب الطهارة في الملاقي(بالكسر) فيسقطان معا و المرجع قاعدة الطهارة بخلاف الصورة الثانية فيجري فيها استصحاب النجاسة بلا معارضة.
وأمّا السيد عبد الله الشيرازي (قده) فقد ذكر كلاماً شبيهاً بعبارة السيد الخوئي، حيث قال: "وملاقاة أحد طرفي العباءة، وهو الطرف الأسفل مثلاً، وإن كان لا يؤثر في نجاسته للقطع بطهارته على الفرض، إلا أنه يوجب العلم بملاقاته لما كان نجساً"[2]
غير أنّ هذه العبارة أيضاً غير واضحة؛ لأنّا وإن علمنا بأن العباءة كانت نجسة سابقاً، ثم بعد التطهير نشك في بقاء النجاسة فنستصحبها، وهذا كلام في نفسه صحيح، إلا أنّ قوله: "الملاقاة لما كان نجساً" غير تام؛ إذ بعد التطهير لم تتحقق الملاقاة مع ما كان نجساً واقعاً، بل الملاقاة إنما وقعت مع طرف محكوم بالطهارة، ومع طرف آخر مشكوك النجاسة، فيرجع السؤال نفسه: أين هي الصغرى لهذه الكبرى؟.
وأمّا ما أفاده شيخُنا الأستاذُ الفيّاض (سلّمه الله) فقد تعرّض فيه إلى مطلبين:
المطلب الأوّل: في أصل المبنى، حيث قرّر (دام ظلّه) أنّ شبهةَ السيّد إسماعيل الصدر(قده) ناشئةٌ من القول برأي المشهور، وهو أنّ ملاقاةَ أحد الأطراف في الشبهة المحصورة لا يوجب الحكم بنجاسته، بل يبقى على الطهارة. وهذا المبنى لا يتبنّاه الشيخُ الفيّاض (سلّمه الله)، بل يرى أنّ ملاقاةَ أحد الأطراف كافٍ للحكم بالنجاسة، فكلّ ما لاقى طرفاً منها يتنجّس. وبناءً عليه، فالشبهةُ التي ذكرها السيّد الصدر(قده) لا أساس لها عنده من الأصل، إذ إنّ منشأها مبنيّ على مبنى لا يلتزم به. لذلك قال (سلّمه الله) "والخلاصة، أنّ هذه النتيجة الغريبة مبنيّة على القول بأنّ الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة محكوم بالطهارة. وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّه محكوم بالنجاسة ووجوب الاجتناب كالملاقي ـ بالفتح ـ والطرف الآخر، فعندئذٍ لا إشكال في المسألة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون اليد ملاقية للطرف غير المغسول أولاً ـ كما هو رأي صاحب الشبهة ـ ثمّ الطرف المغسول، أو بالعكس. وعلى كلا التقديرين فالملاقي محكوم بوجوب الاجتناب عنه كالملاقى بالفتح والطرف الآخر".
غير أنّه قد يُورد عليه بأنّ الجواب المبنائي لا يكفي وحده في دفع الإشكال، إذ لو سلّمنا ـ جدلاً ـ بالذهاب إلى ما ذهب إليه المشهور من القول بالطهارة في ملاقي أحد الأطراف، فهل يكون الحكم حينئذٍ هو الطهارة أو النجاسة؟ هذا هو السؤال الأساس الذي يبقى بحاجة إلى معالجة مستقلة.


