47/03/29
الشبهة العبائية/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
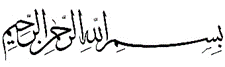
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الشبهة العبائية
ذكرنا فيما سبق ما أفاده المحقق النائيني(قده) في الجواب عن الشبهة العبائية في كتابيه، وذكرنا أيضًا ان السيد الخوئي (قد) قد ناقش كلا جوابي استاذه المحقق النائيني ولم يرتض بهما نعم الشيخ الوحيد (دام ظله) وصف الجواب الثاني والذي ذكره في أجود التقريرات بأنه جواب في غاية الدقة والمتانة.
أمّا الآن فننتقل إلى ما أفاده السيد الخوئي(قده)؛ في جواب الشبهة المذكورة. وقبل ذلك، نشير إلى أنّ صاحب منتقى الأصول السيد الروحاني(قده) قد أجاب عن الشبهة بما يرجع في المحصَّل إلى نفس ما أفاده المحقق النائيني في الاجود، أي أنه قَبِلَ أصل التفكيك بين أثر الكلّي وأثر الملاقاة الذي هو بعينه أثر الفرد.
وكيفما كان فيمكن فهرسة المطالب بما يلي:
أولا: منشأ الشبهة:
الشبهة العبائية إنما طرحها السيد إسماعيل الصدر(قده)، وصارت من أبرز موارد الإشكال على الأصوليين حيث التزموا بجريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني، وفي نفس الوقت التزموا بعدم نجاسة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة؛ وهذان الأمران لا يجتمعان في نظر المعترض. ومن هنا عُدّت هذه الشبهة في نظر بعضهم بمثابة نقض على مبنى الأصوليين.
ثانياً: ما أجاب به المحقق النائيني(قده) عن الشبهة:
وقد أجاب تارة بإرجاع الإشكال في الشبهة المذكورة إلى غير باب استصحاب الكلّي، واعتبر أنّ مفاد الشبهة شيء آخر غير مفاد الاستصحاب في الكلي. فمسألة استصحاب الكلّي عنده ترجع إلى أنّ حقيقة المستصحب وهويته مردّدة بين فرد قصير الأمد وفرد طويل الأمد. كما في مثال الحدث: نعلم بوجود حدث، لكن لا نعلم أنّه الأصغر أو الأكبر، بينما في مورد الشبهة العبائية، فإنّ النجاسة معلومة في نفسها، إلا أنّ مكانها مجهول، فهي مردّدة بين أطراف متعدّدة. ولهذا ساق المحقق النائيني(قده) هذه الصورة ضمن أمثلة متقاربة، كمثال: وجود زيد في الدار، ومثال الدرهم، ومثال النجاسة الواقعة في أحد أطراف العباءة. ثم عقّب قائلاً: إنّ جميع هذه الأمثلة ترجع إلى عنوان "الفرد المردّد"، ومن ثمّ لا يجري فيها الاستصحاب.
وأجاب تارة أخرى بعدم جريان الاستصحاب في نجاسة العباءة بمفاد كان الناقصة وجريانه فيها بمفاد كان التامة لا يترتب عليه نجاسة الملاقي.
غير أنّ الكلام لا ينتهي عند هذا الحدّ؛ إذ ان السيد الخوئي(قده) وغيره من الأعلام قد أفادوا في مقام الجواب عن الشبهة، وهو ما يقتضي مزيدًا من النظر والتأمل فيما أفادوا.
اما السيد الخوئي(قده) فبعد أن اعترض على كلا جوابي أستاذه المحقق النائيني، سواء ما أفاده في أجود التقريرات أو ما ذكره في الفوائد.
قال: "فالإنصاف في مثل مسألة العباء … إلى آخره"[1] .
وقد نبّه (قده) إلى أنّ العباءة ليست إلا مثالًا للتوضيح، فالملاك واحد في نظائرها. ومن جملة الأمثلة التي طرحها: أن يكون عندنا إناءان، أحدهما في الجانب الغربي والآخر في الجانب الشرقي، نعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما. ثم نفرض أنّ الإناء الشرقي قد طُهِّر، وبعد ذلك لاقى الإصبع الإناء الغربي، ثم لاقى الإناء الشرقي المطهَّر. والسؤال هنا: هل يجري الاستصحاب في مثل هذا المورد أم لا؟ هذا، وللسيد الخوئي(قده) في مقام الجواب بعض المباني والأُصول التي ابتنى عليها موقفه من الشبهة، وسوف نعرضها لاحقًا عند نقل نصّ كلامه وشرح دلالته. ثم قال(قده): "هو الحكم بنجاسة الملاقي"، وهذه هي فتواه الصريحة(قده). وأمّا المحقق النائيني(قده) فلا يحكم بنجاسة الملاقي، وكذلك الشيخ الوحيد وافقه في ذلك، واعتبر جواب المحقق النائيني في الاجود جوابًا دقيقًا ومتينًا.
وبيان ذلك: أنّ دليل المحقق النائيني في فتواه يقوم على التفصيل بين أثرين في فرض العباءة: أولاً: أثر الكلّي بمفاد كان التامة: وهو أنّنا نعلم بوجود نجاسة في العباءة على نحو القضية التامة، فيجري الاستصحاب في هذا المفاد.
ثانياً: أثر الجزئي بمفاد كان الناقصة: وهو أن نعلم بكون الطرف الأعلى مثلًا هو النجس، أو أن الطرف الأسفل هو النجس. وفي هذا الفرض لا يوجد يقين سابق بكون هذا الطرف أو ذاك متّصفًا بالنجاسة حتى يجري الاستصحاب؛ إذ لم تتحقّق حالة سابقة للنجاسة في كلّ طرف بخصوصه حتى نستصحبها.
وعليه، لا يثبت عند النائيني(قده) نجاسة الملاقي؛ لعدم تمامية أركان الاستصحاب في مفاد "كان الناقصة"
ثم قال السيد الخوئي(قده): "لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، على ما ذكره السيد الصدر(ره)، من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لابد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد اطراف الشبهة…".
بيان كلامه: قد مرّ معنا هذا المطلب سابقًا، إلا أنّه لا بأس ببيانه بوجه آخر:
كما لو فرضنا شبهة محصورة نعلم فيها بنجاسة أحد الإناءين، فإذا لاقى المكلف أحد الأطراف، فمشهور الأصوليين ـ ومنهم السيد الخوئي نفسه ـ ذهبوا إلى أنّه لا يُحكم بنجاسة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، بل يبقى على الطهارة.
غير أنّ السيد الخوئي في المقام حكم بنجاسة الملاقي، ولكن لا من جهة التخلي عن ذلك الأصل أو نقض ذلك المبنى، فإنّ المبدأ ما زال محفوظًا عنده، بل لخصوصية موجودة في محل الكلام ـ سيأتي التنبيه عليها لاحقًا ـ جعلته يستثني المورد من القاعدة العامة. وعليه فلا يلزم التعارض أو التنافي بين الموردين.
فإن قيل: كيف يقول السيد الخوئي هنا بنجاسة الملاقي، وهناك في مبحث الاشتغال يحكم بطهارة ملاقي أحد الأطراف؟ أليس في ذلك تناقض؟ قلنا: ليس تناقضًا، بل هما مسألتان متغايرتان موضوعًا، والاختلاف إنما جاء من جهة خصوصية المقام.
ثم عقّب السيد الخوئي(قده) قائلاً: "بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام…".
توضيح ذلك: إنّ القاعدة التي كنّا نعتمدها في موارد الشبهة المحصورة، وهي الحكم بطهارة ملاقي أحد الأطراف عند الملاقاة، لا تجري في هذا المورد بالخصوص. فالمسألة هنا خارجة عن مورد تلك القاعدة، لا أنّ القاعدة قد نُقضت أو رُفعت اليد عنها. ومن هنا يظهر أنّ حكمه بنجاسة الملاقي إنما كان لعدم شمول القاعدة للمقام، لا لتخلٍّ منه عن الأصل الكلي الذي قرّره في مبحث الشبهة المحصورة.
ثم قال(قده): "لأن الحكم بطهارة الملاقي إمّا أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، وإمّا أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي، وهو أصالة عدم ملاقاته النجس…".
بيان كلامه: إنّ البحث هنا يرجع إلى الموقف من العلم الإجمالي. فقد وقع الكلام عند الأعلام: هل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يقوم مقام العلم التفصيلي في تنجيز التكليف؟ فقالوا: لا، فالعلم التفصيلي منجّز على نحو العلّة التامّة؛ فإذا علم المكلّف بنجاسة إناء بعينه وجب الاجتناب عنه يقينًا. أمّا العلم الإجمالي فهو منجّز على نحو الاقتضاء لا على نحو العلّية التامة.
ولتقريب الفكرة: لو كان عندنا إناءان، أحدهما في الجانب الشرقي والآخر في الجانب الغربي، وعلمنا إجمالًا بنجاسة أحدهما. فلو أخذنا الإناء الشرقي مثلاً، فقد كان طاهرًا سابقًا، ونحن الآن ـ بعد العلم الإجمالي ـ نشك في عروض النجاسة عليه، فيستصحب طهارته السابقة. وكذلك الإناء الغربي كان طاهرًا قبل العلم، ويمكن أيضًا استصحاب طهارته السابقة. فإذا جرى الأصلان معًا، لزم أن يكون كلا الانائين محكومين بالطهارة.
غير أنّ هذا يلزم منه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، إذ نتيجته أنّ أحدهما قطعًا نجس، ومع ذلك يُحكم بطهارة كليهما. ولذا قال بعض الأعلام: إنّ الأصول لا تجري في مورد العلم الإجمالي، وقال آخرون: إنها تجري ولكنها تتساقط؛ لكون جريانها معًا يؤدي إلى مخالفة قطعية، وهي غير مقبولة عقلًا وشرعًا.
عندنا مقامان ينبغي التفكيك بينهما: الملاقي (بالكسر) و الملاقى (بالفتح).
ألف: الملاقي – بالكسر (كالإصبع):
الإصبع كان طاهرًا في السابق، وبعد وقوع الملاقاة نشك في أنّه هل تنجّس أم لا؟ ففي مثل هذا المورد يجري استصحاب الطهارة السابقة في الملاقي نفسه، أي أصالة عدم عروض النجاسة عليه.
باء: الملاقى – بالفتح (كأطراف العباءة أو الإناء): هنا نحتاج إلى أصل موضوعي مركّب من قضيتين:
الأولى وجدانية: وهي تحقّق نفس الملاقاة.
الثانية تعبدية: وهي ثبوت كون ما لُوقي نجسًا بالفعل.
وبعبارة أخرى: لا يكفي مجرّد تحقق الملاقاة، بل لابد من إحراز أنّ الملاقاة وقعت مع النجس، وهذا مركّب من وجود الملاقاة ومن ثبوت النجاسة في الطرف. وحيث إنّ النجاسة في الطرف الغربي ـ مثلاً ـ غير معلومة، بل يحتمل أن يكون طاهرًا، فلا يثبت بذلك أنّ الإصبع قد لاقى النجس حقيقة.
وعليه، فالملاقاة في حقيقتها عملية مركبة تحتاج إلى إحراز الملاقاة وإحراز النجس معًا، فإذا لم يثبت أحدهما سقط الأثر. ومن هنا كان مقتضى القاعدة: الحكم بطهارة الملاقي (الإصبع) عند ملاقاته لأحد الأطراف المشتبهة؛ إمّا باستصحاب الطهارة في نفسه، أو بلحاظ الأصل الموضوعي في الملاقى، حيث إنّ الملاقاة مع النجس لم تثبت.
إذن، فالمستفاد من مجموع كلمات الأعلام أنّ الفتوى الجارية عندهم هي الحكم بعدم تنجّس الملاقي بملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة، فيبقى على الطهارة. وهذه قاعدة عامة لم يتنازل عنها السيد الخوئي(قده) في مواردها المعتادة.
غير أنّنا نجده (قده) في الشبهة العبائية لم يلتزم بما التزم به في سائر الموارد، بل أفتى بنجاسة الملاقي، مع أنّ القاعدة السابقة تقتضي الحكم بطهارته، كما في الأمثلة الكثيرة الخارجة عن فرض العباءة. وهنا يثار التساؤل: ما عدا ممّا بدا؟ أي ما هو الموجب لذلك التغيير في هذا المورد بالخصوص عن تلك القاعدة المقرّرة.
قال السيد الخوئي(قده): "وكيف كان، يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكومًا باستصحاب النجاسة في العباء، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي".
مفاد كلامه: عندنا أصل شرعي، وهو استصحاب النجاسة في العباءة، وهذا الأصل يمنع من جريان ما ذكرناه سابقًا من أصالة الطهارة في الملاقي (الإصبع). فحيث نعلم بنجاسة أحد الطرفين، فإنّنا نشك بعد التطهير أو بعد الملاقاة، فنستصحب النجاسة في العباءة.
لكن الملاحظة المهمّة هنا هي عبارته: "فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي".
يعني أنّه إذا أجرينا استصحاب النجاسة في العباءة، فإنّ من لوازمه وآثاره الحكم بنجاسة ما يلاقيها، وهو الإصبع في المثال.
وبعبارة أخرى: أصل استصحاب النجاسة في العباءة لا خلاف في مشروعيته، بل هو على القاعدة ولا إشكال فيه عند الأعلام. إنّما وقع البحث في أنّ السيد الخوئي(قده) اعتبر أنّ من آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي، أي أنّ نجاسة الإصبع مترتبة على استصحاب نجاسة العباءة. وهنا يتعيّن الوقوف والتأمل في مراده(قده)، لفهم كيفية ترتّب هذا الأثر.
ثم بعد ذلك قال(قده) "ولا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات - في مبحث الاشتغال - والحكم بنجاسته في مثل المقام، للأصل - الاستصحاب وهو يتقدم على سائر الاصول كما سيأتي ذلك لاحقاً - الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي - وهو الطهارة - فان التفكيك في الأصول كثير جدا، فبعد ملاقاة الماء مثلا لجميع أطراف العباء نقول: إن الماء قد لاقى شيئا كان نجسا فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي". إذن في كلامه(قده) عبارتان مهمتان لابد من التأمل فيهما:
الأولى: "فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي".
الثانية: "إن الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً فيحكم ببقائه على النجاسة لاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء". والثانية متفرعة على الأولى، وبعبارة أوضح: ما معنى عبارته أنّ الماء لاقى شيئاً كان نجساً؟ فلابد من التفكير والتأمل.


