47/03/28
الشبهة العبائية/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
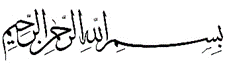
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الشبهة العبائية
تقدّم أنّ المحقق النائيني (قده) تصدّى لجواب الشبهة العبائية، وسعى لإعطاء ضابطة في باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني. غير أنّه أوضح أنّ هذه الشبهة خارجة عن حيّز هذا القسم، فلا تصلح أن تكون نقضاً أو إشكالاً عليه. ووجه ذلك أنّ استصحاب الكلّي من القسم الثاني إنما مورده ما إذا كان المستصحب متيقَّناً في هويته وحقيقته، إلا أنّه مردّد بين فرد قصير الأمد وفرد طويل الأمد، كما إذا تيقّنّا بوجود كلّي الحدث، لكن نشكّ هل هو حدث أصغر أو حدث أكبر، أو علمنا بوجود كلّي الحيوان ونجهل أنّه بقة أو فيل. فالمتيقَّن هو الكلّي بما هو كلّي، غير أنّ تردّدنا في كونه قائماً في ضمن الفرد القصير أو الفرد الطويل.
بينما في الشبهة العبائية ليس الحال كذلك، فإنّ المعلوم فيها ليس كلّياً مردّداً بين فردين، بل هو أمر جزئي معيَّن، كزيد مثلاً، غاية الأمر أنّنا لا نعلم بموضعه: هل هو في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي؟ فالترديد هنا إنما هو في المكان والموضوع لا في الحقيقة والهوية. فزيد معلوم بشخصه وهويته، إلا أنّ موضعه مردّد. ومن هنا اعتبر النائيني (قده) أنّ هذه الشبهة لا تنطبق على استصحاب الكلّي من القسم الثاني، كما صرّح بذلك في دورته الأولى من كتاب الفوائد. فالنتيجة المتفرّعة على ما تقدّم عند المحقّق النائيني (قده) أنّه لا يصح استصحاب الفرد المردَّد، وبذلك لا يمكن التمسّك باستصحاب بقاء النجاسة في مورد الشبهة العبائية. وإلى هذا الحدّ ينتهي ما أفاده (قده) في كتاب الفوائد.
ثم جاء بعد ذلك السيّد الخوئي (قده) فأورد إشكالًا على ما أفاده المحقق النائيني (قده)، حيث بيّن أنّ ما ذكره لا يدفع أصل النقض. فإنّ الإشكال الذي أورده صاحب الشبهة يبقى على حاله سواء اعتُبر المستصحب كلّيًا أم جزئيًا، فلا أثر للتفريق بينهما في هذا المقام. ووجه ذلك أنّ لازم الإشكال هو التنافي بين ما ذهب إليه الأعلام من أنّ ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة محكومة بالطهارة، وبين ما قرّروه من جريان استصحاب كلي النجاسة. فبناءً على استصحاب الكلي يثبت الحكم بالنجاسة، في حين أنّ القاعدة عندهم تقتضي الحكم بالطهارة. وهذا التنافي باقٍ على كلّ تقدير، سواء سُمّي المستصحب كليًّا أم جزيئًا. ومن هنا اعترض السيّد الخوئي (قده) على ما ذكره المحقق النائيني (قده).
وعليه فقد صرّح السيّد الخوئي (قده) في اعتراضه على المحقق النائيني بما نصّه:
"وهذا الجواب غير تام، فإنّ الإشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباء باستصحاب الكلّي، بل الإشكال إنّما هو في أنّ جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلّي أو الجزئي، فكما أنّه لا مانع من استصحاب حياة زيد في المثال الأوّل، كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباء" [1] .
وحاصل كلامه: أنّ السيّد الخوئي (قده) خالف شيخه المحقق النائيني (قده) في أصل المبنى؛ فإنّ المحقق النائيني يرى أنّ استصحاب النجاسة في العباءة لا يجري، لكونه الفرد المردَّد، ممّا يستلزم عدم تحقّق أركان الاستصحاب فيه. وأمّا السيّد الخوئي فقد ذهب إلى أنّ الاستصحاب في الفرد المردّد جارٍ، ولا مانع من إعماله، وعليه يبقى الإشكال على حاله ولم يُرفع، لأنّ نتيجة الاستصحاب هنا تنافي الحكم بطهارة الملاقي، وهذا هو لبّ اعتراضه (قده).
ثم قال(قده) "وأما المثال الثاني فالاستصحاب فيه معارض بمثله، فان أصالة عدم تلف درهم زيد معارض بأصالة عدم تلف درهم غيره، ولو فرض عدم الابتلاء بالمعارض لا مانع من جريان الاستصحاب فيه"
حاصل كلامه (قده): قد عبّر السيّد الخوئي (قده) هنا بـ تلف درهم زيد، بينما عبّر المحقّق النائيني (قده) في مقام آخر بقوله: "ثم أضاع أحد الدراهم واحتُمل أن يكون درهم زيد". والفرق بين التعبيرين واضح؛ فإنّ الضياع لا يمنع الحقّ، بخلاف التلف الذي يوجب سقوط الحقّ وانعدامه. لكن مع ذلك لا ينبغي جعل هذا التفاوت في المفردة اختلافًا جوهريًا، إذ المقصود في كلا الموردين واحد، ولا يغيّر اختلاف التعبير من أصل المطلب.
ثم قال (قده):
"كما إذا اشتبهت خشبة زيد ـ مثلاً ـ بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصليّة، فتلف أحدها، فتجري أصالة عدم تلف خشبة زيد بلا معارض"
والحاصل: إنّ الخشب الذي لا مالك له لا تترتّب على استصحاب بقائه ثمرة عمليّة، إذ لا يترتّب أثر شرعي على بقائه أو تلفه، لكونه مباحًا بالأصل، ويجوز لكلّ أحد التصرّف فيه بالوجدان من غير حاجة إلى الاستصحاب. ومن ثمّ لا يكون استصحاب عدم تلفه معارضًا لاستصحاب خشبة زيد، بخلاف ما لو كان المشتبه خشبةً لزيد، فإنّ له أثراً عملياً واضحاً، فتجري أصالة عدم تلف خشبة زيد من دون معارض. وعلى هذا الأساس تكون الأصول غير متعارضة، والجريان إنّما هو في مورد زيد فقط، وسيأتي تفصيل هذا المطلب في تنبيهات قاعدة الاشتغال.
ملخّص ما أفاده السيّد الخوئي (قده):
إنّ جواب المحقّق النائيني (قده) غير تام، ويتوجّه عليه أمران:
الأول: أنّ الإشكال ليس في مجرّد التسمية؛ فسواء سُمّي الاستصحاب الجاري في مسألة العباء استصحابًا كلّيًا أو جزئيًا، لا يندفع أصل النقض. إذ الإشكال قائم في عدم التوفيق بين أمرين: الحكم بطهارة ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة من جهة، وجريان استصحاب النجاسة من جهة أخرى. والجمع بينهما محال، لأنّ أحدهما ينفي الآخر، فلا يمكن الالتزام بهما معًا.
الثاني: أنّ استصحاب الفرد المردَّد جارٍ، خلافًا لما ذهب إليه المحقّق النائيني (قده) من امتناع جريانه لعدم تحقّق أركانه. بل يرى السيّد الخوئي (قده) أنّ أركان الاستصحاب متحقّقة فيه، فلا مانع من إجرائه. ثم أنّ المحقّق النائيني (قده) ذكر وجهاً آخر للجواب عن الشبهة ـ لعلّه أدقّ من الوجه الأوّل ـ في دورته الأولى من كتاب الفوائد. وقد نقله في أجود التقريرات، ووضّح مضمونه السيد الخوئي (قد) والشيخ الوحيد (دام ظلّه).
وقبل الدخول في بيان ما أفاده (قده) في هذا الوجه، لا بدّ من التعرّض إلى مطلب يتكرّر استعماله في كلماتهم، وهو الفرق بين مفاد "كان" التامّة ومفاد "كان" الناقصة:
مفاد "كان" التامّة: معناها في اللغة هو وُجِد، فهي فعل لازم لا يحتاج إلى خبر. فقولك: كان زيد، معناه: وُجِد زيد، ولا ينتظر السامع من المتكلّم شيئاً آخر يتمّ به المعنى.
وأما مفاد "كان" الناقصة: فهي تحتاج إلى خبر، إذ لا يكتمل معناها إلا به. فقولك: كان زيد عالماً، ليس معناه: وُجِد زيد عالماً، بل معناه ثبوت الوصف لزيد.
ثم بيّن المحقق النائيني (قده) عند التدقيق في الشبهة العبائية أنّ لها جهتين:
الجهة الأولى (مفاد كان التامّة):
نحن نعلم إجمالاً بوجود النجاسة في العباءة، وهذا من مفاد كان التامّة، أي: "وُجدت نجاسة". وهذا أمر متيقَّن ومتّفق عليه، لا إشكال فيه.
الجهة الثانية (مفاد كان الناقصة):
إذا جئنا إلى طرفي العباءة ـ الأعلى والأسفل ـ فإنّ الحكم بالنجاسة في كلّ طرف منهما يكون من مفاد كان الناقصة، كأن نقول: "كان الطرف الأعلى نجساً" أو "كان الطرف الأسفل نجساً". وهنا يرد الإشكال؛ إذ لا علم لنا ابتداءً بأنّ الطرف الأعلى كان نجساً لكي يُستصحب، وكذلك لا علم لنا بأنّ الطرف الأسفل كان نجساً حتى يصدق الاستصحاب. ومع عدم اليقين السابق في كلّ طرف بخصوصه، لا مجال لجريان الاستصحاب فيهما؛ لأنّ ركن اليقين مفقود.
وعليه: مفاد كان الناقصة لا يجري فيه الاستصحاب لعدم تحقّق اليقين السابق بالنجاسة في كلّ طرف بعينه، بخلاف مفاد كان التامّة، فإنّ النجاسة في أصل العباءة كانت معلومة الوجود، فإذا طُهّر أحد الطرفين وشككنا في بقاء تلك النجاسة التي تيقّنا بوجودها سابقاً، جرى الاستصحاب في هذا المفاد.
وهذا كلّه كما أوضحه وقرّره الشيخ الوحيد (دام ظلّه) في بيان مراد المحقق النائيني (قده).
وعليه يترتّب على ما أفاده المحقق النائيني (قده) أثران:
الأثر الأول (في نفس العباءة):
لا تصحّ الصلاة في العباءة، لأنّا نعلم إجمالًا بوجود النجاسة فيها سابقاً، فإذا طُهّر الطرف الأسفل بقي عندنا شك في ارتفاع النجاسة من أصلها أو بقائها. وحينئذٍ يجري استصحاب بقاء النجاسة، فيحكم بعدم جواز الصلاة فيها.
الأثر الثاني (في ملاقي الأطراف):
إذا لاقَت اليدُ أحد الطرفين بعد الغَسل، فنسأل: هل كان هناك يقين سابق بنجاسة هذا الطرف بعينه؟ الجواب: كلا. ومع عدم اليقين السابق لا مجال للاستصحاب في خصوص هذا الطرف، وعليه لا نحكم بنجاسة اليد الملاقيّة.
وبذلك يحصل التفكيك بين الحكمين: فبالنسبة إلى العباءة نفسها يحكم بعدم جواز الصلاة فيها لاستصحاب النجاسة فيها بمفاد كان التامّة، وأمّا بالنسبة إلى ملاقي الأطراف بعد الغسل فلا يحكم بالنجاسة، لعدم تحقّق اليقين السابق في مفاد كان الناقصة. وهذا هو الجواب الذي اختاره المحقق النائيني (قده) لحلّ الشبهة، وقد وصفه الشيخ الوحيد (دام ظلّه) بأنّه جواب متين، إلّا أنّ السيّد الخوئي (قده) لم يرتضِ هذا الجواب من المحقّق النائيني (قده)، ايضا كما سيأتي تفصيل اعتراضه لاحقاً.
قال الشيخ الوحيد (دام ظله) في مقام توضيح الجواب الثاني للمحقق النائيني " وأما الجواب الثاني فهو: إن لنجاسة الثوب أثرين: المانعية عن الصلاة، وانفعال الملاقي، وموضوع الأثر الأول هي نجاسة الثوب بمفاد كان التامة، بمجرد صدق تحقق النجاسة في الثوب تترتب المانعية عن الصلاة.
وأما الأثر الثاني فهو لا يترتب على وجود النجاسة بمفاد كان التامة، بل يترتب على وجودها بمفاد كان الناقصة، والسر في ذلك هو اعتبار الملاقاة للنجس للنجس، وهي لا تتحقق إلا مع ما يكون نجساً، وما كان نجساً هو مفاد كان الناقصة، وعليه ففي مورد الإشكال أن أحد طرفي العباءة نجس، وقد غسل أحد الطرفين، فيمكن هنا -بالنسبة للمانعية عن الصلاة - أن نستصحب بقاء النجاسة، لتمامية أركان الاستصحاب، - يقين وشك - فنحكم ببطلان الصلاة في هذا الثوب. وأما بالنسبة لنجاسة الملاقي فلا بدّ من استصحاب النجاسة في الملاقى بمفاد كان الناقصة، يعني أن يلاقي ما كان نجساً، ولا يمكن استصحاب ذلك؛ لكون الطرف المغسول مقطوع الطهارة فلا يجري فيه استصحاب النجاسة، والطرف الآخر يشك في حدوث النجاسة فيه من الأول، فلا يجري فيه الاستصحاب أيضاً، والنتيجة أن الاستصحاب لا يجري في كلا الطرفين، فلا يحكم بنجاسة ملاقيه" ([2] )
وعلى ذلك قال الشيخ الوحيد هذا جواب في غاية الدقة والمتانة.


