47/03/23
استصحاب الكلي/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
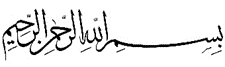
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب الكلي
وصل بنا الكلام إلى ما يعُرف بـ "الشبهة العبائية"، ويمكن ذكرها على نحوين:
الأول: أن تُجعل الشبهة بمثابة إشكالٍ واردٍ على القول باستصحاب الكلّي من القسم الثاني، فيكون موقعها موقع التوهمين اللذين سبق وذكرهما الشيخ الأعظم (قدّه)، أعني: توهم دوران الأمر بين ما هو مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث - وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل-.
وتوهم كون الشك في البقاء مسبب عن الشك في الحدوث وجريان الأصل في السبب حاكم على جريانه في المسبب.
وعلى هذا، فالشبهة العبائية تندرج في سياق تلك الاعتراضات التي تُطرح على أصل جريان الاستصحاب في هذا القسم.
الثاني: أن تذكر لا بعنوان الإشكال المباشر على أصل القول بجريان الاستصحاب في الكلي، من القسم الثاني بل على سبيل النقض عليه؛ أي باعتبارها مورداً يصلح أن يكون نقضاً، للقول بجريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثاني.
الفرق بين الإشكال والنقض يمكن توضيح الفرق بين الإشكال والنقض على النحو الآتي: أما الإشكال: فيكون في مقام المناقشة العلميّة لمبنى أو نظرية لم يُقطع بتماميّتها بعد. فالمناقش يورد عليها جملة من الإشكالات، والمبنى في نفسه ما زال في دائرة البحث، حيث يسعى صاحبه إلى تشييده والجواب عن تلك الاعتراضات المثارة حوله. فالإشكال إذن داخل في حريم المباحثة، ويُراد به هدم اصل المبنى أو إضعافه.
وأما النقض: فيختلف عن ذلك، إذ يُفرض فيه أنّ المسألة مفروغ عنها ومسلَّم بها عند الأعلام، ثم يأتي أحدٌ بمورد أو تطبيق على خلاف ما هو مسلَّم عندهم.
فالنقض إذن ليس اعتراضا في مقام تأسيس النظرية، بل هو ذكر مورد لا تنطبق عليه النظرية المسلمة والمفروض انها قاعدة في جميع الموارد فهو هدم للنظرية والقاعدة باعتبار تخلفها عن أحد موارد تطبيقها.
وقد صوّرنا هذه الشبهة ـ فيما سبق ـ على أنها إشكال، من جملة ما يُورد من الإشكالات على القول بجريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني.
وأمّا الآن، فالمناسب أن نعرض نفس هذه الشبهة لنرى: ما هو مرادُ صاحبها عند طرحها؟ وما الذي أراد الإشارة إليه من خلالها؟
كما أنّا قد أشرنا سابقًا إلى أنّ تسميتها بـ "الشبهة العبائية" إنما ورد من باب المثال، لا أنّ للعباءة بخصوصها مدخلية في أصل الشبهة او الإشكال فليس لها خصوصية في محل النزاع.
تصوير الشبهة العبائية ينقل أن السيد الجليل إسماعيل الصدر (قدس سره) زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخوند، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية. إلاّ أنّ المحقق الآخوند (قدّه) لم يتعرض لها، بل أوّل من تعرّض لها المحقق النائيني (قدّه)، ثم تبعه من جاء بعده من الأعلام.
وحاصل الشبهة: أنّه بعد الفراغ عن الحكم بجريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثاني والتسالم على عدم ما يمنع من جريانه يرد في المقام الإشكال او النقض بما حاصله: أن تكون عندنا عباءة، ونعلم إجمالاً بتنجّس أحد طرفيها، إمّا الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل. ثم نفرض أنّا قمنا بتطهير الطرف الأسفل، فصار معلوم الطهارة، وبقي الطرف الأعلى مشكوك النجاسة.
وصاحب الشبهة ـ وكأنّه يخاطب مشهور الأصوليين ـ فيقول: أنتم تلتزمون في باب الشبهة المحصورة بأن ملاقي أحد طرفي الشبهة لا ينجس، فلو كان عندنا إناءان، نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، فإذا لاقى شيء أحد الانائين برطوبة، فلا يُحكم بتنجّسه، نعم إذا لاقى الإناءين معاً حُكم بتنجّسه.
ولكن في فرض العباءة المذكورة، لو لاقينا الطرف الأعلى المشتبه، فبناءً على قولكم لا يحكم بنجاسة الملاقي، لأنه من قبيل ملاقاة أحد طرفي الشبهة المحصورة. وأما لو لاقينا الطرف الأسفل كذلك ـ مع أنه صار معلوم الطهارة بالتطهير ـ فبناءً على استصحاب النجاسة في مجموع العباءة، ستحكمون بنجاسة الملاقي، إذ لا زالت النجاسة مردّدة بين الأعلى والأسفل.
فتكون النتيجة: أن الإصبع الرطب مثلاً إذا لاقى الطرف الأعلى المشتبه فقط فلا يتنجس، وأما إذا لاقى كذلك الطرف الأسفل الذي هو معلوم الطهارة فسيحكم بنجاسته! وهذا غريب في النتيجة؛ إذ كيف يحكم بعدم نجاسة ملاقاة الطرف المشتبه لانها ملاقاة احد الطرفين ويحكم بالنجاسة لملاقاة الطرف الآخر الطاهر، قطعا بحسب الفرض؟ فالحاصل أنّا نُواجه أمرين لا ثالث لهما:
الأول: أن تقولوا إنّ الحكم بالنجاسة لم يكن بسبب ملاقاة الطرف المطهَّر (الأسفل)، بل إنّ الموجب للنجاسة هو ملاقاة الطرف الآخر (الأعلى). وهذا يستلزم التراجع عن المبنى الذي تبناه المشهور، وهو أنّ ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة لا يوجب الحكم بالنجاسة.
الثاني: أن تقولوا بعدم جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني، وحينئذٍ تكون العباءة محكومة بالطهارة.
وعلى هذا، فالجمع بين القولين مشكل، إذ ينتهي إلى نتيجة غير مرضيّة، لأنّ الالتزام بكلا المبنيين معاً يستلزم التناقض في التطبيقات: فكيف يحكم بعدم نجاسة الملاقي للطرف الأعلى المشتبه، باعتبار انها ملاقاة لأحد طرفي الشبهة فقط ثم يحكم بالنجاسة لمجرد ملاقاة الطرف الآخر - اي الطرف الأسفل- وهو مقطوع الطهارة، فهذا مما لا يمكن قبوله.
وبعبارة أخرى: عندنا مبنيان مشهوران بين الأصوليين:
المبنى الأول: في الشبهة المحصورة، أنّ ملاقي أحد الإناءين لا يُحكم بنجاسته؛ إذ لا يُحرز وقوعه في النجس، نعم لو لاقى الإناءين معًا يحكم بنجاسته.
المبنى الثاني: القول بجريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني، كما لو تيقنا في النجاسة المردّدة بين فرد قصير البقاء وفرد طويل البقاء.
فإذا جئنا إلى الشبهة العبائية، وصوّرناها بعباءة قد تنجّست قطعا إمّا في طرفها الأعلى أو طرفها الأسفل، ثم طهّرنا الطرف الأسفل، فصار معلوم الطهارة، بقي عندنا الطرفٌ الاعلى مشكوك النجاسة.
فالآن إذا لاقى أحدٌ طرف العباءة:
فإن لاقى الطرف الأعلى المشكوك، فبمقتضى المبنى الأول (الشبهة المحصورة) لا يحكم بنجاسة الملاقي.
ولكن إذا لاقى كذلك الطرف الأسفل المعلوم الطهارة فبمقتضى استصحاب الكلّي من القسم الثاني يُحكم بنجاسته، لأنّ العباءة ـ بلحاظ مجموعها ـ لا تزال محكومة بالنجاسة، إمّا في الأعلى أو في الأسفل.
وعليه، يكون لازم الجمع بين المبنيين أن يحكم بنجاسة الملاقي لأجل ملاقاته الطرف المقطوع الطهارة، فإن ملاقاة الطرف المشكوك ملاقاة لاحد طرفي الشبهة وهو لا يوجب التجنيس! وهذه نتيجة غريبة حقًّا، كما أشار إليها جمع من الأعلام، ومنهم سيدنا السيستاني (دام ظلّه) وشيخنا الأستاذ الفياض (سلّمه الله).
ولا فرق في ذلك بين أن يلاقي الملاقي الطرف الطاهر أولاً ثم المشتبه، أو بالعكس؛ إذ الحكم على كلا التقديرين واحد.
وبعبارة ثالثة: عندنا أصلان أو مبدآن مسلّمان عند المشهور من الأعلام:
المبدأ الأول: أنّ ملاقاة أحد أطراف الشبهة المحصورة لا توجب التنجيس، لعدم إحراز الملاقاة مع النجس الواقعي.
المبدأ الثاني: جريان استصحاب فالكلّي من القسم الثاني، بحيث يُحكم ببقاء النجاسة مردّدةً بين الطرفين.
ثم جاءت مشكلة الشبهة العبائية، وحاصلها: إذا علمنا إجمالا بنجاسة عباءة لا على التعيين وترددت النجاسة في احد طرفيها الأعلى أو الأسفل ثم طهّرنا طرفها الأسفل، فلو لاقينا الطرفين معاً، فبناءً على المبدأ الأول ملاقاة الطرف الأعلى لا توجب التنجيس لأنها ملاقاة لطرف واحد من اطراف الشبهة وملاقاة الطرف الأسفل لا يمكن أن تكون سببا للتنجيس لانه معلوم الطهارة فلا تتحقق الملاقاة مع النجس الواقعي، إذ ملاقاة الطرف الأعلى فقط لا توجب الحكم التنجيس وملاقاة الطرف الأسفل ملاقاة لما هو مقطوع الطهارة، فحينئذٍ لا يحكم بتنجيس الملاقي للطرفين .
ولكن بناء على المبدأ الثاني ـ وهو استصحاب كلي النجاسة- يحكم بوجود النجاسة في العباءة فيُفترض أن الملاقي للطرفين قد لاقى نجساً، والنجاسة بمقتضى جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني لا تزال باقية في العباءة.
والحاصل: أنّ ملاقاة الطرف المشكوك لا توجب التنجيس لأنها ملاقاة لطرف واحد فلابد أن يكون الحكم بالتنجيس بسبب ملاقاة الطرف الآخر والذي هو مقطوع الطهارة فتكون النتيجة ان ملاقاة ما هو مقطوع الطهارة توجب التنجيس! وهذه نتيجة غريبة لا نظير لها في أبواب الفقه، إذ المعروف أنّ ملاقي المقطوع الطهارة لا يتنجس بحال.
وقد أخذت هذه الشبهة حيّزًا واسعًا من النقاش، وطُرحت في المحافل العلميّة الأصوليّة، حتى دوِّنت في كلمات الأعلام واشتهرت بعنوان “الشبهة العبائيّة”. وهذا يكشف عن أنّها لم تكن مجرّد توهّمٍ ساذج، بل لشدّة دقّتها وما تثيره من إرباكٍ في الجمع بين المبنيين صارت مورداً للبحث والجدل.
وعليه، يمكن وصفها بأنّها شبهة ذات قوّة، إمّا في زمان طرحها الأوّل حيث شغلت بال الأعلام، أو حتى في عصرنا الحاضر لما تحمله من إلزامات على المباني المشهورة في الاستصحاب. فهي تستحق أن يُتصدى لها بالجواب والتحقيق.
والحاصل في تنبيهات مبحث الاشتغال تعرّض الأعلام لمسألة ملاقي أحد طرفي الشبهة، فقرّروا ـ ومنهم الشيخ الأعظم (قدّه) ومن تبعه ـ أنّ القاعدة تقتضي عدم الحكم بنجاسته، لأنّ الملاقاة في حدّ نفسها لم تُحرز وقوعها على النجس الواقعي، نعم لو حصلت الملاقاة مع الطرفين معًا لحكم بالنجاسة، لمصادفتها للعلم الإجمالي القاضي بوجود النجاسة في أحدهما. ومن هنا اشتهر هذا المبنى حتى صار من المسلَّمات.
غير أنّ المسألة في مورد الشبهة العبائيّة تختلف؛ وذلك لأنّ الملاقاة لم تقع قبل التطهير بحيث يحتمل إصابة النجس الواقعي، بل وقعت بعد تطهير أحد الطرفين (الأسفل) المقطوع طهارته. فالملاقي في هذه الصورة لا ينطبق عليه عنوان “ملاقاة النجس الواقعي”، لكونه قد لاقى طرفًا مقطوع الطهارة، وأمّا الطرف الآخر (الأعلى) فليس إلا مشكوك النجاسة.
وعليه، لا ينطبق على هذه الحالة ما عبّروا عنه بـ "المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة".
إنّ هذه الشبهة إنما طُرحت في سياق البحث عن استصحاب الكلّي من القسم الثاني. فإذا سلّمنا مع صاحب الشبهة بما ذكره، لزم أن يكون ما أورده نقضًا على القائلين بجريان الاستصحاب، لا مجرّد إشكالٍ. وحينئذٍ تكون النتيجة أنّ استصحاب النجاسة في مثل العباءة غير صحيح، فيُبنى على عدم جريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني رأسًا.
وعليه، ينتهي المآل إلى ما ذهب إليه بعض الأعلام، كالمحقق العراقي (قدّه)، أو ما أفاده السيد اليزدي (قدّه) في حاشيته على المكاسب، من عدم تمامية هذا القسم من الاستصحاب.
فلابد إذن من معالجة هذه المعضلة، ويمكن تصويرها في بعض الاحتمالات:
الاحتمال الأول: أن نرجع إلى مسألة ملاقاة أحد الأطراف، فمع أنّ المشهور حكموا بطهارته، إلا أنّه يمكن القول: إنّ هذا الإصبع لم يتنجّس من جهة ملاقاة الطاهر، فهذا لا يفتي به فقيه، وإنما تنجّس لملاقاته نفس الأطراف التي فيها النجاسة إجمالًا، فيكون حكم ملاقاة أحد الأطراف هو النجاسة. وهذا يعني التراجع عن مبنى المشهور، أو الميل إلى من يرى أنّ ملاقاة أحد الأطراف تنجّس، باعتبار أنّ العلم الإجمالي منجّز. وبهذا تنتهي المشكلة، غير أنّ هذا الحل لا ينسجم مع ما ذهب إليه المشهور، فتبقى الشبهة قائمة.
الاحتمال الثاني: أن نرجع إلى قاعدة استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فنلتزم بعدم جريانها. وبذلك تُحل الشبهة، لكن يلزم التراجع عمّا أسّسه المشهور من جريان هذا القسم. وهذا الاحتمال وإن كان مخرجًا، إلّا أنّ الأعلام بنوا على مقالة المشهور من جريان استصحاب الكلّي في القسم الثاني.
وعليه تبقى المشكلة، وهنا جاء المحقق النائيني (قدّه) بحلّه الخاص، فقال: نحن نلتزم برأي المشهور في ملاقاة أحد الأطراف، ونلتزم بجريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني، لكن بدقّة النظر يتّضح أنّ الشبهة العبائيّة ليست في حقيقتها مرتبطة باستصحاب الكلّي من القسم الثاني، بل هي أقرب إلى مسألة استصحاب الفرد المردّد.
بيان ذلك: أنّ الملاقى في الشبهة العبائيّة هو هوية شخصيّة معلومة الوجود، لكن مكانها مجهول، إمّا في الطرف الأعلى أو في الطرف الأسفل. وهذا شبيه بما لو علمنا بوجود زيد بعد هدم الدار، مردّدًا بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي، فهل يمكن استصحاب حياته أو لا؟ فالمحقق النائيني صرّح بعدم جريان استصحاب الفرد المردّد. نعم، هذا ليس رأيًا لجميع الأعلام، إذ إنّ بعضهم جوّز الاستصحاب في الفرد المردّد.
وفي الحقيقة ان المحقق النائيني (قدّه) ذكر في مقام الجواب عن الشبهة العبائية جوابين:
الجواب الأول: ما أفاده في فوائد الأصول وهو ما أشرنا إليه انفا، و الجواب الثاني: ما أفاده في أجود التقريرات.
قال(قده) "ثم لا يخفى عليك: أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته وحقيقته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدمة - كأمثلة الحدث وأمثلة البقة والفيل - وأما إذا كان الاجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلي بل يكون كاستصحاب الفرد المردد الذي تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه"[1]
وللكلام تتمة..


