47/03/15
الشبهة العبائية/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
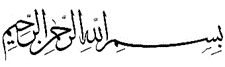
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الشبهة العبائية
قد تقدَّم الكلام على أنَّ صاحب الكفاية (قده) قد تصدّى للجواب عما ذكره المتوهِّم من عدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي لقضية السَّببيّة، بين الفرد والكلي وذكر في دفعه ثلاثة أوجهٍ، كنّا قد تكلمنا عنها.
ولا بأس في هذا الموضع أن نعرض هذه الوجوه ببيانٍ أوضح وأقرب للفهم، حتّى يتّضح المراد بشكلٍ جليّ، قبل الانتقال من كلامه.
بيان ذلك:
ان حاصل مراد المتوهم هو ان الفرد هو السبب للكلي فإذا استصحبنا عدمَه، فمعنى ذلك أنَّ المسبَّبَ أيضًا غير موجود، فلا يبقى عندنا ما نستصحبه؛ لأنَّ مقصودنا هو استصحاب الكلِّي.
فمَن يُنكر جريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلِّي يلجأ إلى هذا المسلك، باعتبار أنّ وجود الكلي مسبب اما عن الفرد القصير او الطويل والفرد القصير قد انتهى بحسب الفرض، كما لو كان الحدث الاصغر قد ارتفع بالوضوء، فلا يبقى حينئذ حدث أصلًا. لان وجود الكلِّي، قد انحصر على هذا في الفرد الطويل، وبما أنّ هذا الفرد قد استصحبنا عدمه ـ وهو السبب في تحقق الكلِّي ـ لزم أن يكون كلي الحدثُ الذي في ضمنه غير موجود أيضًا، وحينئذٍ لا يبقى عندنا شيء نستصحبه. هذا هو المناط في التوهّم.
وصاحب الكفاية (قده) قد أجاب عن هذا الإشكال بجملة من الأجوبة التي سنعرضها عند نقل كلامه في كتاب الكفاية.
أمّا الجواب الأوّل فهو ما أشار اليه بقوله لعدم كون بقائه . . . إلى آخره. [1]
توضيحه: انه لا يعقل ان يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر، لأن المفروض هو القطع بحدوث الكلّي المردّد وجوده بين كونه في ضمن الفرد القصير أو الطويل، وحيث كان حدوث الفرد الطويل مشكوكا من أول الأمر، فمع فرض الشك في حدوث السبب بحسب دعوى هذا المتوهّم كيف يمكن ان يحصل القطع بحدوث المسبب؟ فلا يعقل ان يكون الشك في بقاء الكلي - مثلا - مسبّباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل العمر، لان السبب في البقاء هو السبب في الحدوث، فكيف يعقل ان يكون الشك في الكلي بقاءاً مسبّباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل مع كون الكلي مقطوع الحدوث وسببه الذي هو الفرد الطويل مشكوك الحدوث؟ ."[2]
وبعبارة اخرى:
إنّ ما ذكره المتوهِّم من كون الكلّي لازمًا لحدوث الفرد الطويل، هو في نفسه غير صحيح؛ إذ الكلّي ليس من لوازم الفرد الطويل، ولا من لوازم الفرد القصير، بل المفروض في محلّ الكلام أنّ الكلّي قد تحقّق قطعًا، والشكّ إنّما هو في بقائه لا في أصل حدوثه.
وبيان ذلك: أنّا نقطع بحدوث الحدث الكلّي، غير أنّ ارتفاعه قد يفرض بمجرّد حصول الفرد القصير، كما قد يفرض بوجود الفرد الطويل وحده، بل ولو اجتمعا معًا لكان ارتفاع الكلّي متصوَّرًا، إلا أنّه قبل تحقّق هذه المحتملات يبقى عندنا يقين بحدوث الكلّي وشكّ في بقائه، فيجري الاستصحاب.
وعليه، فكيف يُعقل أن يكون الكلّي ـ وهو المسبَّب المقطوع به ـ موقوفًا على سببٍ لم يثبت حدوثه (أي الفرد الطويل)؟! فإنّ الفرد الطويل يُنفى بالأصل (استصحاب العدم)، والأصل عدم تحقّقه. فلو جعلنا الكلّي مسببًا عنه للزم البناء على عدم أصل الحدوث، مع أنّ المفروض القطع بالحدوث. ومن هنا، يرى صاحب الكفاية (قده) أنّ هذا المسلك في الاستدلال فاسد، لأنّ الكلّي ليس مسببًا عن خصوص الفرد الطويل، بل هو مردَّد بين تحقّقه في ضمن الفرد القصير أو في ضمن الفرد الطويل.
وبعبارة أخرى ان السبب للشك في بقاء الكلي فعلا هو كونه مردّداً وجوده بين ان يكون في ضمن الفرد الباقي أو في ضمن الفرد المرتفع، وليس الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل".
حاصل الكلام:
إنّ التوهم المذكور بالاعتماد على السببيّة ـ لو سلّمنا به ـ يتّضح من خلال تمثيل الشيخ الأعظم (قده) وغيره للقسم الثاني من استصحاب الكلي بمثال الموضوعات الخارجيّة، كما في البقّة التي لا يزيد عمرها على ثلاثة أيّام تقريبًا. فنحن بعد انقضاء هذه المدّة نحتمل أنّ الحيوان الكلّي قد ارتفع، ونحتمل بقاؤه. نعم، قد قطعنا بحدوث الكلّي (الحيوان) في ضمن أحد الأفراد، غير أنّا بعد الثلاثة أيّام نشك في بقائه. فإذن تحقّق عندنا ركنان: اليقين بالحدوث، و الشك في البقاء، فيجري استصحاب الكلّي، وهذا هو الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني.
ولكن المتوهِّم يقول: إنّ وجود الحيوان مسبب عن فرده. فلو تحقّق بسبب البقّة، فهي قد ماتت وارتفعت، فلا يبقى حيوان. ولو تحقّق بسبب الفيل، فالأصل عدم كون الحيوان فيلاً؛ إذ نستصحب عدم وجود الفرد الطويل. فإذا نفينا الفرد الطويل بالاستصحاب، و كان الفرد القصير (البقّة) قد ارتفع، فلا يبقى للحيوان الكلّي وجود. فبقاء الحيوان ـ على هذا المبنى ـ مسببًا عن وجود الفرد الطويل، فإذا رفضناه بالأصل، ترتّب أنّ الكلّي أيضًا غير موجود.
وصاحب الكفاية (قده) في كلامه يوضّح أنّا نقطع بوجود الحيوان الكلّي، فإذا ثبت وجوده فلابدّ له من سبب، غير أنّ هذا السبب مردَّد بين أن يكون هو الفرد القصير أو الفرد الطويل. فلا وجه لتعيين السبب في خصوص الفرد الطويل، كي يُستفاد من استصحاب عدمه (أي عدم الفيل) نفي وجود الحيوان الكلّي.
وعليه، فأصل الإشكال مبنيّ على خللٍ وتوهّمٍ؛ إذ كيف يُعقل أن يُجعل وجود الحيوان الكلّي المتيقَّن حدوثه متوقّفًا على سببٍ لم يثبت وجوده أصلًا؟! فبذلك يتّضح أنّ منشأ الإشكال غير صحيح، وأنّ الاستدلال على هذا النحو ساقط من أساسه.
وسيأتي قريبًا توضيح ما أفاده السيّد اليزدي (قده)، حيث ذهب إلى عدم جريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني.
وبهذا، نكون قد أنهينا الكلام في الجواب الأوّل لصاحب الكفاية (قده)، وخلاصته: أنّ الكلّي ليس مسببًا عن خصوص الفرد الطويل، بل هو مسبب عن مجموع الفردين: القصير والطويل معًا. فلا يصحّ حصر السبب في الفرد الطويل، ومن ثمّ نفي الكلّي باستصحاب عدمه.
واما الجواب الثاني عن هذا التوهّم فقد أشار اليه في الكفاية بقوله :(مع ان بقاء القدر المتيقن….) وحاصله: ان الكلّي وفرده ليس من قبيل السبب والمسبب، لوضوح ان لازم السببية والمسببية هو الاثنينيّة الخارجية، وكون السبب خارجا غير المسبب في الخارج، ومن الواضح ان الكلّي عين فرده في الخارج ولا سببيّة اصطلاحية بينهما ولا علّية ولا معلولية خارجيّة بينهما"[3]
ثم إنّ هذا الجواب من صاحب الكفاية (قده) ـ مع كونه قد خلّصنا من إشكال السببيّة ـ قد أوقعنا في مشكلةٍ أخرى، وهي العينيّة.
بيان ذلك:
إنّ المتوهِّم في اعتراضه الأول قال: لا يوجد عندنا كلّي لنستصحبه، وذلك بناءً على أنَّ الفرد سبب للكلّي؛ فإذا نفينا السبب بالاستصحاب، انتفى المسبَّب، أي: انتفى الكلّي. فعدم السبب مساوق لعدم المسبَّب. نعم، بهذا الجواب تخلّصنا من إشكال السببيّة، لكن بقيت مشكلة أخرى، وهي أنّ العلاقة بين الكلّي وفرده علاقة عينيّة لا سببيّة.
وعندئذٍ يَرِد السؤال: إذا كان الكلّي عين الفرد، فهل يوجد عندنا حدث أكبر؟ أو هل يوجد فيل؟ الجواب: لا جزم عندنا بوجود ذلك. إذن، وإن كُنّا قد فررنا من إشكال السببيّة، إلا أنّا وقعنا في إشكال العينيّة. ولهذا علّق السيّد الخوئي (قده) بأنّ الإشكال عاد إلينا من جديد. نعم، بعض الأعلام تصدّى للجواب عنه، غير أنّه في محلّ كلامنا يبقى الإشكال قائمًا.
خلاصة الإشكال:
إذا كان الكلّي عين الفرد، فنحن لا نعلم بوجود الفيل، فكيف نعلم بوجود الكلّي؟ فانتفى ما أردنا إثباته.
وإن كان لهذا الإشكال جوابٌ مذكور في كلمات بعض الأعلام، غير أنّا ذكرناه هنا لأجل تماميّة البحث وإبراز محلّ المناقشة، لا لأنّه خالٍ عن الجواب.
وأما الجواب الثالث فقد أشار اليه في الكفاية بقوله (على أنه لو سلم انه من لوازم….) وحاصله: ان لو سلّمنا كون الفرد سببا للكلي إلاّ ان هذه السببية عقلية لا شرعية، والاستصحاب الجاري في السبب انما يكون لازمه التعبّد بالمسبب، انما هو في السببية والمسببية الشرعية، بان يظهر في مقام من المقامات اعتبار الشارع لكون الفرد سببا للكلي، ولم يرد في مورد من الموارد من الشارع كون الفرد سببا للكلي حتى يكون التعبّد بالسبب الشرعي تعبدا بمسببه.
والحاصل أنا لو سلّمنا كون الكلي من لوازم الفرد وان الفرد سبب له إلاّ ان هذه السببية عقلية لا شرعية، ومن الواضح انه لا يترتب بالأصل الشرعي إلاّ اللوازم والآثار الشرعية لا العقليّة "[4]
ملخّص ما ذكره صاحب الكفاية (قده) في أجوبته الثلاثة:
الجواب الأوّل: إنّ الكلّي ليس مسببًا عن خصوص الفرد الطويل، بل هو مردّد بين الفرد الطويل والفرد القصير، فلا يصحّ حصر سببه في أحدهما دون الآخر.
الجواب الثاني: نمنع أصل القول بالسببيّة والمسبَّبيّة بين الكلّي وفرده، بل إذا وجد الفرد وُجد الكلّي بعين وجود فرده، ولا تغاير بينهما في هذا الاعتبار، خصوصًا على مبنى (الآباء والأبناء).
الجواب الثالث: لو سلّمنا بالسببيّة بين الفرد والكلّي، فإنّها ليست سببيّة شرعيّة حتّى يترتّب عليها أثر عملي في باب الاستصحاب، بل هي سببيّة عقليّة محضة، ولا تصلح لإبطال جريان الأصل.
فإذن، يتّضح أنّ صاحب الكفاية (قده) والشيخ الأعظم (قده) قد قبِلا بجريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني، بل إنّ أكثر الأعلام الذين جاؤوا بعدهما قد ساروا على هذا المبنى أيضًا، وقبلوا به.
أمّا السيّد اليزدي (قده)، فقد تعرّض الأصحاب لرأيه عند بحثهم في استصحاب الكلّي من القسم الثاني، إذ له فيه موقفان:
الأوّل: ما أورده في حاشيته على المكاسب للشيخ الأعظم (قده) في مبحث المعاطاة، وقد ناقشه الأعلام في كلماتهم.
ولا بأس أن نبيّن رأي السيّد اليزدي (قده) بصورةٍ مجملة، تمهيدًا لعرض تفاصيله:
بيانه:
إنّ عندنا مفهومًا يسمّى بـ البيع العقدي، وهو ما يتحقّق بالإنشاء اللفظي، كما لو قال البائع: بعتُ، وقال المشتري: قبلتُ. وهنا تثار جملة من المسائل المتعلّقة بـ شروط العقد (غير شروط المتعاقدين أو المبيع)، وقد دار البحث بين الأعلام حولها بشكل واسع.
ومن أبرز هذه المسائل:
هل يُشترط في البيع التلفّظ بألفاظٍ خاصّة، أم يكفي كلّ لفظٍ يدلّ على التمليك بعوض؟ فمثلاً: هل يكفي أن يقول البائع: ملّكتك هذا الكتاب بألف، أم لابدّ أن يصرّح بلفظ: بعتك الكتاب بألف؟
وكذلك في القبول: هل يشترط أن يقول المشتري: قبلتُ، أو يجزي أن يقول: رضيتُ؟
ومن جهة أخرى، هل يجوز أن يتقدّم القبول على الإيجاب، بحيث يقول المشتري: قبلتُ قبل أن يقول البائع: بعتُ، أم أنّ الترتيب معتبر بحيث يتقدّم الإيجاب على القبول؟
فهذه المسائل كلّها تُبحث تحت عنوان شروط العقد، وقد أطال الأعلام الكلام فيها عند المناقشة.
وعندما وصلوا إلى بعض شروط العقد، قالوا: قد لا تكون هناك ألفاظ خاصّة معتبرة في البيع؛ لأنّ البيع ليس من القضايا التوقيفيّة ـ بخلاف الصلاة مثلًا حيث حدّدها الشارع بركعات معيّنة ـ بل يكفي في البيع كلّ لفظٍ أو فعلٍ يدلّ على التمليك بعوض. بل قد لا يحتاج الأمر إلى تلفّظ أصلًا، كما هو الغالب في المعاملات العرفيّة الجارية بين الناس، إذ نادرًا ما يقول المشتري: بعتُ، ويجيبه الآخر: اشتريتُ، بل المتعارف أن يقول: بكم هذا؟ ثم يدفع الثمن ويأخذ المبيع.
وهذا هو ما يُسمّى بـ المعاطاة. وقد اختلف الأعلام في حقيقتها:
فمنهم من عبّر عنها بـ معاطاة إباحة، أي أنّ أثرها مجرّد إباحة التصرّف.
ومنهم من قال: إنّها معاطاة تمليك، وحقيقتها كحقيقة البيع تمامًا.
وعليه، دار البحث في ما لو حصل الفسخ بعد المعاطاة:
فإن قلنا إنّها إباحة، كان الفسخ موجبًا لانتهاء الإذن بالتصرف، كمن أعطى كتابًا للإعارة ثم طلب استرجاعه.
وأمّا إن قلنا إنّها بيع تمليكي، فحينئذٍ يكون بيعًا لازمًا لا ينفسخ بالفسخ إلّا في موارد الخيارات الشرعيّة كخيار المجلس مثلًا.
وبعبارة أخرى: إذا أعطيتك كتابًا في معاملة معاطاتيّة، فهل تملكه حقيقة أو لا؟
فإن قلنا بالإباحة، فمع الفسخ يرتفع الإذن في التصرّف.
وإن قلنا بالتمليك، فمجرد الفسخ لا يرفع الملكيّة، بل يبقى التمليك على حاله.
وهذا بعينه شبيهٌ بمحلّ كلامنا في الاستصحاب؛ إذ يمكن تشبيه التمليك بالـ حدث:
فإن كان فرده حدثًا أصغر وارتفع بالوضوء، فلا يبقى حدث.
وإن كان فرده حدثًا أكبر، فهو باقٍ لم يرتفع.
وكذلك في التمليك:
فإن كان على نحو الإباحة، ارتفع بالفسخ.
وإن كان بيعًا تمليكيًا، بقي البيع على حاله ولم يرتفع بالفسخ.
وهنا يقع الكلام: هل يمكننا أن نستصحب الجهة المشتركة بينهما ـ أي عنوان التمليك أو جواز التصرّف ـ بعد الفسخ؟ فقالوا: هذا من مصاديق استصحاب الكلّي من القسم الثاني.
ولهذا نجد أنّ الشيخ الأعظم (قده) ذكر هذا المطلب في المكاسب عند بحثه في المعاطاة، ثم جاء السيّد اليزدي (قده) وناقش هذا المبنى الأصولي بعينه، وعدّه من موارد استصحاب القسم الثاني. غير أنّ للسيّد اليزدي في هذه المسألة رأيًا خاصًا به، وقد حظي بالاهتمام لأنّ أكثر الأعلام ناقشوه في هذا الموضع، باعتبار أنّ حاشيته على المكاسب قد اشتهرت أكثر من كتابه الأصولي، فكان نظرهم متوجّهًا إليها بالخصوص.
وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ بيان ما أفاده صاحب الدرر (قده) في هذا المقام، حيث عبّر عنه بتعبيرٍ خاص، ثم نقل تعبير بعض أعاظم العصر (مدّ ظلّه) ممن ناقش هذه القضيّة، فبيّن كلامه، ثم تعرّض بعد ذلك لمناقشة رأي السيّد اليزدي (قده). وسنعرض هذه التفاصيل لاحقًا في محلّها إن شاء الله تعالى.
رأي السيّد اليزدي (قده) في المعاطاة:
فقال (قده) "قوله (كفاية تحقق القدر …)[5] أقول لا يخفى ان هذا داخل في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي التي ذكرها المصنف في الأصول وهو ما إذا كان الشك في تعيين الفرد الحادث أولا لكونه مترددا بين الباقي جزما - كما في مثال الحدث الأكبر - والمرتفع جزما - من قبيل الحدث الأصغر - نظير الشك في بقاء النجاسة بعد الغسل مرةً إذا كانت مرددة بين نجاسة البول والدم، والحق عدم الكفاية - أي لا نستصحب الكلي - وعدم الجريان - الاستصحاب - لأن الشك في بقاء القدر المشترك مسبب عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث والأصل عدمه ولعله إلى هذا
قوله (قده): "لأنّ الشكّ في بقاء القدر المشترك مسببٌ عن حدوث الفرد المشكوك الحدوث، والأصل عدمه"[6] .
وحاصل كلامه (قده): أنّه تبنّى ما ذهب إليه المتوهِّم في دعوى السببيّة، فجعل الشكّ في بقاء الجامع مسببًا عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل. فكأنّما اعتبر أنّ كلام المتوهِّم في أصل المبنى صحيح، لا مجرّد توهّم كما صرّح به صاحب الكفاية (قده).
ولأجل ذلك عقّب بقوله(قده): "ولعلّه أشار بقوله: فتأمّل"
إشارةً إلى ما في هذا المبنى من تأمّل وإشكال.
ثم قال (قده) "لكنه (قده) أجاب عن هذا في الأصول بان ارتفاع القدر المشترك من اثار كون الحادث ذلك المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدمه حدوث الامر الاخر قال نعم اللازم من عدم حدوثه عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني لا ارتفاع القدر المشترك بين الامرين وبينهما فرق واضح"
وللكلام بقية…


