47/03/14
الشبهة العبائية/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
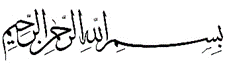
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الشبهة العبائية
كان كلامُنا حول ما يُعرف بـ الشبهة العبائية، وقد قلنا: إنَّ من المناسب أن تُعَدّ هذه الشبهة إشكالًا على جريان الاستصحاب في الكلى من القسم الثاني، لا نقضًا له. والغاية من ذلك أن نتتبّع كيفية محاولة الأعلام التخلّص منها، ضمن سياق الإشكالات الواردة على هذا القسم من استصحاب الكلي.
وعليه، نستطيع أن نُعيد فهرسة المطالب على النحو الآتي:
الإشكال الأول: وهو الذي ذكره الشيخ الأعظم (قده) وصاحب الكفاية (قده).
الإشكال الثاني: وقد تعرّض له أيضًا الشيخ الأعظم (قده) وصاحب الكفاية (قده).
الإشكال الثالث: وهو الشبهة العبائية التي لم يتعرّضا لها، وإنّما ذُكرت بعدهما.
أمّا بالنسبة إلى الإشكالين الأوّل والثاني، فقد تعرّض لهما الشيخ الأعظم (قده) وأجاب عنهما:
اما الاول: فقد مرّ منّا سابقًا أنّ مفاده دوران الأمر بين فردٍ مقطوع الارتفاع، كالفرد القصير، وبين فردٍ مشكوك الحدوث، وهو الفرد الطويل. والمشكوك الحدوث يُجرى فيه أصل العدم، وهذا ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) في جوابه.
والإشكال الثاني: وهو إشكال السببية والمسبَّبية، وحاصله: أنّ الفرد الطويل يكون سببًا لوجود الكلّي، فإذا لم يثبت وجود السبب لم يثبت المسبَّب.
وبتعبير آخر: نحن لا نقطع بوجود الفرد الطويل، كالفيل مثلًا، وإذا شككنا في وجوده فالأصل عدمه، ومع جريان هذا الأصل يثبت الارتفاع، وإذا ارتفع السبب ارتفع المسبَّب تبعًا له.
الإشكال الثالث: وهو ما يعرف بالشبهة العبائية.
وينبغي قبل بيان مضمون هذا الإشكال أن نذكر التفاتةً لصاحب الكفاية (قده) في جوابه عن إشكال السببية، وهو الإشكال الثاني.
بيان الالتفاتة:
إنّ الكلام تارةً يكون في شيءٍ لا نعلم بوجوده من الأساس، فهنا يجري فيه أصل العدم. وأخرى في شيءٍ نقطع بوجوده فعلاً، أي: وجودٌ بعد العدم. ففي هذه الصورة لا معنى للتمسّك بأصل العدم، لأننا قاطعون بوجوده، وإذا أردنا رفعه فلا بدّ من افتراض علّةٍ لارتفاعه. وهذا أمر بديهي، غير أنّه قد يُغفل عنه.
ووجه الإشكال كما صيغ:
ان المستشكل يقول: أنتم تقولون إذا كان الفرد قصيراً فقد ارتفع، والحال أنّ المكلّف لا يدري هل الحدث الذي أصابه حدثٌ أصغر أم حدثٌ أكبر. فإن كان حدثه أصغر فقد توضّأ وارتفع يقيناً، وإن كان حدثه أكبر فهو باقٍ. وبعبارة أخرى: الحدث إنّما هو مسبَّب، فما هو السبب الذي جعله محدثاً؟ نقول: السبب هو الحدث الأكبر (الجنابة). ولكنّ الجنابة غير مقطوع بها، بل هي مشكوكة، والأصل عدمها. فإذا لم يكن مجنباً، فمن أين جاءه الحدث؟ فحينئذٍ، إن كان حدثه أصغر فهو مقطوع الارتفاع بالوضوء، وإن احتمل أن يكون حدثه أكبر فهذا الاحتمال يرتفع بالأصل (وهو عدم الجنابة). فإذن النتيجة: الأصل يقتضي عدم الحدث من الأساس.
فهذا هو إشكال المستشكل الذي أورده وقد جعله اعتراضاً على ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) وصاحب الكفاية (قده) وبعده.
جواب صاحب الكفاية (قده):
يلتفت صاحب الكفاية (قده) إلى نكتة أساسية، وهي: أنّ الحدث ليس مسبباً عن الحدث الأكبر فقط، بل هو مسبب إمّا عن الحدث الأصغر، وإمّا عن الحدث الأكبر.
وبيان ذلك: إنّا نجزم بأصل وقوع الحدث، فلا شك عندنا في أصل وجوده، وإنما الشك في تعيين منشئه: هل هو من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر؟ فإذن، الحدث موجود فعلاً، وليس في عالم العدم، فلا وجه لأن يُقال: بما أنّ الحدث الأكبر مشكوك فنرجع إلى أصالة عدمه، فنحكم بأصالة عدم الحدث رأساً، فإنّ هذا مغالطة.
إذ الواقع أنّنا نعلم بوجود الحدث، لكن نشك: أهو من الأصغر أو من الأكبر؟ فإذا قيل: إنّ الحدث مسبب، فنسأل: ما هو سببه؟ نقول: إمّا الأصغر وإمّا الأكبر. فإذا رفعنا سبب الأصغر – كأن توضأ المكلّف – بقي الشك: هل ارتفع كليّ الحدث أو لا؟ إذ قد كان محرَز الوجود أولاً، ثم شككنا في بقائه بعد الوضوء. فحينئذٍ ينطبق عليه كبرى الاستصحاب: اليقين بالحدوث والشك في البقاء.
وعليه: فالحدث ليس مسبباً عن خصوص الحدث الأكبر حتى يقال: الأصل عدم الأكبر فالأصل عدم الحدث، بل هو مسبب عن أحدهما، الأصغر أو الأكبر.
هذا أولاً.
ثانياً: إنّ حديث السببية والمسبَّبية في المقام غير تام، بل هو مرفوض من أساسه. وذلك لأنّ معنى السبب والمسبَّب إنما يُلحظ في الأمور الخارجية، حيث نقول: هذا سبب لذاك. أما في محل الكلام، فالأمر مختلف؛ إذ الكلّي مع فرده ليسا من سنخ السبب والمسبَّب، بل هما شيء واحد بعينه.
وبيانه: إذا وُجد الفرد فقد وُجد الطبيعي، فوجود الفرد هو عين وجود الكلّي الطبيعي. فمثلاً: إذا وُجد الحدث الأصغر فقد وُجد كلي الحدث، وإذا وُجد الحدث الأكبر فقد وُجد كلي الحدث كذلك. فلا يصح أن يُقال إنّ الحدث الأصغر سبب لكلي الحدث، أو إنّ الحدث الأكبر سبب لكلي الحدث؛ فلا مجال للسببية هنا، لأنّ الكلّي الطبيعي لا يزيد على فرده شيئًا، بل هو متحقّق بعين تحقق الفرد.
وعليه، فالبحث عن السببية والمسبَّبية في هذا المجال ليس في محلّه، إذ ليس بين الكلّي وفرده إلا العينية، لا السببية.
فمثلاً: لو قيل إنّ زيداً سببٌ للإنسان، فما معنى ذلك؟ إنّ ظاهر العبارة يقتضي أن يكون وجود زيد سبباً لوجود شيء آخر مغاير، بينما الوجدان يشهد بخلافه؛ إذ لا نرى بين زيد والإنسان علاقة السببية، بل الإنسان موجود بعين وجود زيد. فالكلّي الطبيعي لا يتحقق إلا بوجود فرده، ووجود الفرد هو نفس وجود الكلّي، لا أنّه سبب له.
وعليه، فحديث السببية من أصله مرفوض في هذا الباب، ولا يصح توصيف العلاقة بين الفرد والطبيعي بعنوان السبب والمسبَّب، بل الصواب أن نصفها بعنوان العينيّة.
وسيأتي لاحقاً إيراد إشكالٍ على هذا المبنى سنتعرّض له في محلّه إن شاء الله.
ولكن لو سلَّمنا – تنزّلاً وتماشياً مع القائل – بثبوت علاقة السببية والمسبَّبية بين الفرد والكلّي، فإنّا نتساءل: هل هذه السببية والمسبَّبية قضية عقلية أو قضية شرعية؟
فإن كانت قضية عقلية، فكيف يمكن التمسك بالاستصحاب فيها؟! إذ مقتضى كلامهم أن يُستصحب عدم السبب، ويلزم من ذلك عدم المسبَّب. وهذا من قبيل الأصول المثبتة، حيث يثبت بالاستصحاب لازمٌ عقلي أو تكويني، لا حكم شرعي تعبّدي. ومن المعلوم أنّ الأصول المثبتة لا مجال لها في باب الاستصحاب، لأنّ مجرى الاستصحاب هو القضايا الشرعية، لا اللوازم العقلية. فتدبّر جيداً.
ومن هنا كان هذا الجواب – الذي أفاده (قده) – هو الجواب الرائج بعده، إذ تبنّاه أكثر من جاء من بعده من الأعلام، وجعلوه هو المخرج الأساس من هذا الإشكال.
إذن اشكال المستشكل في غير محله.
ولمزيدٍ بيان ما تقدّم نقول:
إنّ الإشكالات على استصحاب الكلّي من القسم الثاني ثلاثة:
1- أوّلها ذكره الشيخ الأعظم (قده) وتعرّض له صاحب الكفاية (قده).
2- الثاني كذلك أورده الشيخ الأعظم (قده) وتعرّض له صاحب الكفاية (قده).
3- واما الثالث، وهو ما عُرف بـ الشبهة العبائية، فقد أُثير بعدهما، وكان أوّل من طرحه السيد إسماعيل الصدر (قده) عند قدومه إلى النجف الأشرف في أيّام صاحب الكفاية (قده)، حيث أثاره وعدّه نقضاً على جريان الاستصحاب في القسم الثاني. وقد تقدّم شرحه مفصّلاً.
ولا بأس هنا أن نعيد ذكر جواب صاحب الكفاية (قده) عن الإشكال الثاني، وهو إشكال السبب والمسبَّب، وحاصله: أنّ الكلّي مسبب عن الفرد الطويل، والفرد الطويل غير مقطوع الوجود، فإذا جرى الأصل في السبب (أي: في الفرد الطويل)، فلا يبقى مجال لإثبات بقاء المسبَّب (أي: الكلّي).
وقد تقدّم جواب الشيخ الأعظم (قده) عن هذا الإشكال، كما نقلنا أيضاً عبارة تلميذيه الشيخ موسى (قده) في الأوثق، والآشتياني (قده) في بحر الفوائد.
والكلام الآن متوجّه إلى بيان ما أفاده صاحب الكفاية (قده) في جوابه عن هذا الإشكال.
فقال (قده) " لعدم كون بقائه - الكلي - وارتفاعه من لوازم حدوثه - الأكبر - وعدم حدوثه، بل من لوازم كون الحادث المتيقن إما ذلك المتيقن الارتفاع أو ذلك المتيقن البقاء"[1]
حاصل الإشكال:
أراد المستشكل أن يقول: بالنسبة إلى الفرد الطويل ـ كما في مثال غسل الجنابة أو مسّ الميت في الأحكام او الفيل في الموضوعات ـ نحن إذا توضّأنا فقد ارتفع كلّ ما يكون الوضوء رافعًا له من الأحداث. لكن أنتم تقولون: إنّ الكلّي، وهو مطلق الحدث، باقٍ. وهنا يُسأل: كيف يبقى الحدث؟ إنّما يبقى إذا كان له سبب، وسببُه في فرض المسألة إمّا الجنابة أو مسّ الميت. فنعود ونسأل: هل تحقّقت الجنابة أو مسّ الميت؟ الجواب: لا نعلم، بل الأصل عدمهما. فإذا استصحبنا عدم السبب (الجنابة أو مسّ الميت) لزم عدم المسبَّب (الحدث الكلّي)، فيرتفع الكلّي رأسًا. فبأيّ وجه يقال: إنّ الكلّي باقٍ؟!
وعليه: يكون ما عندنا في الواقع شيئان فقط:
حدث الوضوء، وقد ارتفع بالوضوء.
وأمّا حدث الجنابة، فالأصل عدم تحقّقه من البداية.
فإذا ارتفع الأوّل بالأثر الشرعي (الوضوء)، وانتفى الثاني بالأصل (عدم الجنابة)، فأيّ كلّيّ حدث يبقى حتى يُستصحب؟! هذا هو لبّ الإشكال. وقد جاء بهذا البيان أيضاً السيّد اليزدي (قده)، وإنْ كان المستشكل دقيقًا في تصويره، لكن الأجوبة عليه أدقّ وأمتن.
جواب صاحب الكفاية (قده):
وصاحب الكفاية التفت إلى أنّه ينبغي أوّلاً أن نُقرّر: هل نقول بوجود الحدث أو لا؟ فنقول: نعم، نحن نقطع بوجود الحدث في الجملة. فإذا جزمنا بوجود الحدث، فلابد أن نُرجع سببه إلى أحد أمرين: إمّا الجنابة وإمّا الحدث الأصغر. وعليه فالحدث ليس مسببًا عن خصوص الجنابة، بل هو مسبب إمّا عنها أو عن الأصغر.
فإذا ارتفع الحدث الأصغر بالوضوء، بقي احتمال الطرف الآخر، وهو الجنابة. وليس معنى ذلك أنّ أصل الحدث غير معلوم لنرجع إلى أصالة عدمه؛ بل أصل الحدث معلوم بالوجدان، والشك إنما هو في بقائه بعد الوضوء. وحينئذٍ ينطبق عليه ضابط الاستصحاب: اليقين بالحدوث والشك في البقاء.
إن قيل: ما معنى السببية والمسبَّبية؟
قلنا: إنّ هذا المفهوم إنما يتصوّر في مورد الاثنينيّة، أي فيما إذا كان هناك شيآن متغايران، فيُجعل أحدهما سببًا والآخر مسبَّبًا. وأمّا في محلّ الكلام، فلا اثنينيّة بين الكلّي الطبيعي وفرده؛ لأنّ وجود الكلّي ليس شيئًا وراء وجود الفرد حتى يُجعل أحدهما سببًا للآخر.
نعم، بالتحليل العقلي قد يُفترض التفكيك بين الكلّي وفرده، لكن هذا تفكيك ذهني، وأمّا في النظر العرفي ـ وهو الملاك في مثل هذه الموارد ـ فلا يُلحَظ هذا التحليل العقلي. بل لو سُئل العرف: أين الإنسان؟ لأشار إلى زيد، لكون وجود الكلّي الطبيعي عين وجود الفرد.
فأين مجال القول بالسببية والمسبَّبية هنا؟! بل الصحيح أن العلاقة بين الكلّي وفرده علاقة العينيّة والاتّحاد، لا علاقة السببية.
ثم قال (قده) في الجواب الثاني "مع أن بقاء القدر المشترك - الحدث - إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه - يعني من أسبابه ومسبباته -"[2] ثم قال(قده) في الجواب الثالث" على أنه لو سلم - وقبلنا بالسببية والمسببية - أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعا".
حاصل كلام صاحب الكفاية (قده):
ينبغي التمييز بين اللوازم الشرعية و اللوازم العقلية:
اللوازم الشرعية: وهي ما رتّبه الشارع بنفسه على موضوعٍ ما. فالاستصحاب حيث إنّه دليل شرعي مأخوذ من النصوص والروايات (وقد تقدّم أن أوّل من فتح هذا الباب هو والد الشيخ البهائي قدس سره)، فإنّ الشارع هو الذي يتكفّل بلوازمه الشرعية.
مثال ذلك: إذا قال الشارع: "الماء القليل إذا لاقته نجاسة يتنجّس"، فالحكم بالنجاسة لازم شرعي مترتّب على كون الموضوع ماءً قليلاً. فإذا أحرزنا أنّ هذا الماء قليل، ثم شككنا لاحقًا هل بقي قليلاً أو صار كثيراً، فنستصحب كونه قليلاً. وبناءً على هذا الاستصحاب، يترتب حكم الشارع: إذا لاقته النجاسة يحكم بنجاسته. فهنا اللازم الشرعي يثبت بالاستصحاب، ويكون الاستصحاب حجّة فيه.
اللوازم العقلية: وهي ما يثبته العقل من ملازمات خارجيّة لا علاقة لها بجعل الشارع. مثاله: إذا استقبل شخص الحائط (س) فإنّه عقلاً يكون مستدبراً للحائط (ص). فإذا استصحبنا بقاءه مستقبلاً الحائط (س)، فهل يثبت شرعاً أنّه مستدبر للحائط (ص)؟ الجواب: لا؛ لأنّ هذا لازم عقلي لا شرعي. فلو ورد دليل شرعي مثلاً: "اذا رأيته مستدبرا للحائط (ص) فتصدّق"، فلا يمكن إحراز ذلك بالاستصحاب، لأنّ الاستدبار للحائط (ص) لازم عقلي محض لا دخل للشارع فيه.
تطبيق ذلك على المقام:
صاحب الكفاية (قده) يقول: إنّ العلاقة بين السبب والمسبَّب علاقة عقلية، لا شرعية. فالسببية والمسبّبية أمران تكوينيان ليس للشارع دخلٌ في تحقّقهما. فإذا قيل: الأصل عدم السبب، وتفرّع عليه عدم المسبَّب، فهذا لازم عقلي محض. وإثباته بالاستصحاب لا يصح، لأنه من قبيل الأصل المثبت، وقد تقرّر أن الأصول المثبتة لا يُعتنى بها في باب الاستصحاب.
النتيجة:
بهذا يتبيّن أنّ الجواب الثاني والجواب الثالث على إشكال السببية والمسبّبية هما من مختصّات صاحب الكفاية (قده). والجواب الثالث على وجه الخصوص صار هو الجواب الرائج بين أكثر من جاء بعده من الأعلام، حيث جعلوه الأساس في مناقشة المستشكل.


