47/04/18
بسم الله الرحمن الرحیم
مرأي التفصیل بین ملکیّة العین و ملکیّة التصرّف/التكسب بالواجبات /المكاسب المحرمة
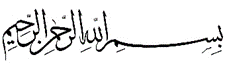
الموضوع: المكاسب المحرمة/التكسب بالواجبات /مرأي التفصیل بین ملکیّة العین و ملکیّة التصرّف
ملخص الجلسة الماضية:
إنَّ النقاش الفقهي حول أخذ الأجرة على الواجبات هو من المباحث الدقيقة في مجال فقه المعاملات و العبادات. السؤال الرئيسيّ المطروح هو: هل يجوز للمرء أن يحصل على أجر مقابل أداء عمل أوجبه الله تعالى؟ بعبارة أخرى، هل يصحّ الجمع بين الوجوب الإلهي و استلام الأجر لأداء العمل ذاته؟
في هذا الصدد، قُدِّمت أنظار متعدّدة من قِبَل الفقهاء. و كانت إحدى الإشكالات الأساسيّة التي طرحت منذ القدیم، التنافي بين مِلكيّة الله تعالى الناتجة عن وجوب الأمر، و بين المِلكيّة التي تنشأ عن استحقاق و تلقّي الأجرة.
الجواب الأول: نظرية الملكيّة الطوليّة
قيل ردّاً على الإشكال المذكور، إنَّ المُلکیّتین المبحوث عنهما هنا؛ أي الملكيّة الإلهية و ملكية المُستأجِر (الذي آجَرَ شخصاً آخر)، يقعان في طول بعضهما مع البعض، لا في عرضهما؛ و بناءً على ذلك، فلا يوجد أيّ تقابل أو تزاحم بينهما.
إنَّ ملكية المُستأجِر هي في الحقيقة تأكيدٌ لملكيّة الله تعالى. و المثال الواضح على هذا النوع من العلاقة هو النسبة بين المولى و العبد: فالمولى مالك لعبده، و لكن إذا قام العبد بعمل بإذن مولاه و تلقّى أجرًا مقابل ذلك، فإنه يصبح مالكًا لتلك الأجرة. إنَّ ملكية العبد هذه تقع في طول ملكية المولى و لا تتعارض معها. و على هذا القياس، فإنه في باب الوجوب و الإجارة أيضاً، تُعرَّف ملكية الله و ملكية المُستأجِر بشكل طولي و هما قابلتان للجمع.
رأي الإمام الخميني: التفريق بين ملكيّة العين و ملكيّة التصرُّف
ميَّز الإمام الخميني (رحمهالله) بين مفهومي «ملكيّة العين» و «ملكيّة التصرُّف». فملكيّة العين تعني المالكيّة الحقيقيّة على ذات الشيء و حقيقته، بينما ملكيّة التصرُّف تعني امتلاك اختیار اتخاذ القرار و إنفاذ الإرادة على شيءٍ ما دون تملّكه.
على سبيل المثال، قد يكون للوكيل أو الوصي اختیار بيع منزل، و لكنّه ليس مالكاً له. من وجهة نظره، فإنَّ الولاية التي تثبت لله تعالى، و للنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) و للأئمة (عليهم السلام)، هي من قبيل ملكية التصرُّف لا ملكيّة العين. و لذلك، فإنَّ التعبير بأنَّ الأولياء و الأوصياء المتعددين هم جميعاً مالكون، ليس تعبيراً صحیحاً؛ فهم في الحقيقة يمتلكون الأولويّة في التصرُّف.
على سبيل المثال، إذا عُيِّن عدة وكلاء لبيع عقار، فجميعهم يمتلكون حق التصرُّف، و لكن بما أنّ ملكيّة تصرُّفهم تقع في طول بعضها مع البعض، فلا يحدث أي تزاحم. بالطبع، إذا أتمَّ أحدهم المعاملة، ینتهي اختیار الآخرين.
«إنّ الطولية المدعاة في المقام عكس الطوليّة في المثالين، فإنّ فيهما يقال: إنّ الناس مملوكان للّه- تعالى- مع أملاكهم و العبد و ملكه لمولاه. و في المقام يقال: إنّ أمر اللّه- تعالى- أوجب ملكيّته- تعالى- للعمل و المستأجر ملك ما ملك اللّه، فاللّه- تعالى- ملك ذات العمل و المستأجر ملك المملوك له- تعالى- و هو بوصف مملوكيّته في طول الذات.
و أنت خبير بأنّ هذا النحو من الطوليّة لا يصحّح اعتبار الملكيّة بل ينافيه و يناقضه. فهل يصحّ القول بأنّ الثواب ملك لزيد و بما أنّه ملك لزيد ملك لعمرو و هل هذا إلّا التناقض في الاعتبار لدى العقلاء و العرف؟ و المسألة عرفية لا عقليّة لا بدّ في حلّها من المراجعة إلى الاعتبارات العقلائيّة، لا الدقائق العقليّة، مع أنّ مثل هذه الطوليّة لا يدفع به التنافي في العقليّات أيضاً، فهل يمكن تحريم شيء و إيجابه بوصف كونه محرّما عقلا؟
مضافا إلى أنّ الطوليّة في المثالين أيضاً ممّا لا أصل لها، فإنّ ملكيّته- تعالى- للأشياء بهذا المعنى الاعتباري المبحوث عنه في مثل المقام غير ثابتة، بل لا معنى لها. فهل ترى من نفسك أنّه- تعالى- ملك الأشياء بهذا المعنى المعروف؟ مع أنّ لازمه أنّه لو وهب بتوسط نبي من أنبيائه شيئاً من عبده سقطت ملكيّته و انتقلت إلى العبد، فلو كان سبيل ملكيّته للأشياء ما لدى العقلاء لا بدّ من الالتزام بآثارها و هو كما ترى.
و الظاهر أنّ أولويّة التصرّف و السلطان على التصرّفات الثابتة للّه- تعالى- عقلاً و للنبيّ (صلی الله علیه و آله) و الأئمّة (علیهم السلام) بجعله- تعالى-، أوجبت توهّم كونهم مالكين للأشياء تلك المالكيّة الاعتباريّة. و السلطنة على سلب الملكيّة و إقرارها غير الملكيّة.»[1]
نقد رأي الإمام الخميني: مسألة الملكية المشاعة
يُورَد على رأي الإمام القائل بأنَّه لا يمكن أن يكون لعين واحدة مالكان، إشكال الملكيّة المشاعة.
علی سبیل المثال: إذا ورث خمسة إخوة منزلاً، فإنَّ الإخوة الخمسة جميعهم يمتلكون عين ذلك المنزل. هذا النوع من الملكية هو «مشاع»؛ أي أنَّ كلّ جزء من المنزل، حتى و إن كان سنتيمتراً واحداً، هو ملك مشترك لجميع الإخوة الخمسة. و لا يمكن لأيّ منهم بيع جزء من المنزل دون إذن الباقین.
و بناءً على ذلك، فإنَّ وجود مالكين متعدّدين لمال واحد، ليس ممكناً فحسب، بل هو مقبول في الفقه أيضاً؛ و إن كان بيعه يستلزم موافقة جميع الشركاء. و لهذا، فإنَّ الجمع بين عدة أنواع من الملكية، سواء في طول بعضها أو في عرضها، أمرٌ متصوَّر في الواقع.
أمثلة فقهيّة للجمع بين الوجوب و الإجارة
لتوضیح عدم التنافي بين مفهومي الوجوب و الإجارة، يُورِد مثالاً کالآتي:
يأمر أبٌ ابنه بأداء عملٍ ما (وجوب الطاعة). و عندما يخرج الابن من المنزل لتنفيذ هذا الأمر، يقول له شخص آخر: «إذا قمتَ بالعمل ذاته، فسأدفع لك أجراً مقابل ذلك» فيقوم الابن بأداء العمل. في هذه الحالة، يكون الابن قد أطاع أمر والده (أي امتثل الوجوب الشرعي) و في الوقت نفسه قد حصل على الأجرة. من وجهة نظر الإمام الخميني، لا یتعارض هذان العناوان بعضهما مع البعض، بل يمكن الجمع بينهما في طول واحد.
إذا أمر الأب و الأم في آن واحد بأداء عمل واحد (مثل شراء الخبز)، فإنَّ إنجاز هذا العمل سيؤدّي إلى امتثال أمر كليهما. و يُستنتج من هذا القياس أنَّ اجتماع واجبين، أو اجتماع الوجوب مع الإجارة، في عمل واحد هو أمر ممكن.
«إنّ الوجوب الذي هو بمعنى مجرّد بعث الغير إلى إتيان العمل لا يوجب أن يكون ذلك العمل مملوكاً للباعث و مستحقّاً له بحيث ينافي مملوكية الغير؛ لأنّ مطلوبية الصدور و تحريك المأمور إلى الإصدار أمر و مملوكية الفعل الصادر و استحقاقه أمر آخر لا يرتبط أحدهما بالآخر و لو كان الوجوب مساوقاً للملكيّة لما صحّ أمر أحد الأبوين إلى شيء بعد أمر الآخر به؛ لأنّه إذا قال الأب: أكرم زيداً مثلاً، فمقتضى وجوب إطاعته الثابت بالشرع و كونه مساوقاً للملكية على ما هو المفروض هي صيرورة العمل و هو إكرام زيد مملوكاً للأب و مستحقّاً له و حينئذٍ فكيف يمكن أن يؤثّر أمر الأُمّ في الوجوب المساوق لها بعد عدم إمكان أن يصير المملوك المستحقّ مملوكاً ثانياً، فاللّازم هو القول بلغوية أمرها مع أنّ من الواضح خلافه و ليس ذلك إلّا لعدم كون الوجوب موجباً لمملوكية الواجب للموجب، كيف و أنّ متعلّق الأحكام إنّما هي نفس الطبائع و العناوين لا الأفراد و الوجودات؛ لأنّها قبل التحقّق ليست بفرد و بعده يحصل الغرض المطلوب منها فيسقط الأمر و الطبيعة لا معنى لكونها مملوكة أصلًا.»[2]
حفظ قصد القربة و الإخلاص
في سياق أخذ الأجرة على الواجبات العبادية (كالصلاة)، یکون الشرط الأساسي هو حفظ قصد القربة.
إذا أدّى شخص الصلاة بهدف الحصول على الأجر فقط، و بدون نية خالصة لله، فإنَّ عبادته باطلة؛ لأنّه لم يمتثل الوجوب الإلهي، و لم یحقِّق شرط الإجارة و بالتالي لا يستحقّ الأجر.
أما إذا أدّى الشخص الصلاة بنيّة إلهيّة و في الوقت نفسه كان قد أستأجِر على القيام بها، فإنَّ كلا العنوانين- الوجوب الشرعيّ و عقد الإجارة- يتحقّقان بشكل صحيح.
قد ذهب أکثر الفقهاء المتأخرين و منهم: المحقّق الخوئي و آیةالله الفاضل اللنكراني و آیةالله السبحاني، و آیةالله المكارم الشيرازي و الإمام الخميني، إلى جواز أخذ الأجرة على الواجبات، و لا يرون في ذلك منافاةً لقصد القربة.
استدلال المحقق الخوئي: الملكية الطولية الإلهية
قال المحقّق الخوئي (رحمهالله) تأييداً لنظريّة الملكيّة الطوليّة: «إنّا لو سلمنا استحالة توارد الملكين على مملوك واحد فإنما هي في الملكيتين العرضيتين بأن يكون شيء واحد مملوكاً لاثنين في زمان واحد على نحو الاستقلال. و لا تجري هذه الاستحالة في الملكيتين الطوليتين: بأن تكون سلطنة أحد الشخصين في طول سلطنة الآخر، فإنّ هذا لا محذور فيه، بل هو واقع في الشريعة المقدسة، كسلطنة الأولياء و الأوصياء و الوكلاء على التصرّف في مال المولى عليهم و الصغار و الموكّلين، فإن ملكيّة هؤلاء في طول ملكيّة الملاك و من هذا القبيل مالكيّة العبيد على أموالهم بناء على جواز تملك العبد فان مالكيّتهم في طول مالكية مواليهم. و كذلك في المقام، فإنّ مالكيّة المستأجر للعمل المستأجَر عليه في طول مالكيّته- تعالى- لها، بل مالكيّة الملّاك لأموالهم في طول مالكيّته- تعالى- لها، فإنّه- تعالى- مالك لجميع الموجودات ملكيّةً تكوينيّةً إيجاديّةً و هي المعبَّر عنها في اصطلاح الفلاسفة بالإضافة الإشراقيّة و قد سلّط الإنسانَ على سائر الموجودات و جعله مالكاً لها، إمّا مالكيّة ذاتية كملك الشخص لأعماله و ذمّته و إمّا مالكية اعتبارية، كمالكيّته لأمواله.»[3]
إذا سلّمنا استحالة اجتماع ملكيّتين عرضيّتين على مملوك واحد، فإنَّ هذا الاستحالة لا تسري على الملكيّات الطوليّة. و المقصود بالملكيّة الطوليّة هو أن تكون سُلطة شخصٍ ما تابعةً لسُلطة شخص آخر. و هذا النوع من العلاقة موجودٌ بالفعل في الشريعة، و مثاله سُلطة الأوصياء و الوكلاء في تصرُّف الأموال.
من ناحية أخرى، ملكيّة كلّ شيءٍ هي لله- تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾[4] و مع ذلك، يمتلك البشر أيضاً ممتلكاتهم في حدود معيّنة و يتصرّفون فيها. هذه العلاقة تُسمى «الإضافة الإشراقيّة»، حيث يقع تصرّف الإنسان في طول تصرّف الله- تعالى؛ ذلك لأنّ الله قد أذن له بهذا التصرّف: «الناس مسلَّطون على أموالهم».
و قد أشار آيةالله السبزواري (رحمهالله) إلى النقطة ذاتها في كتابه «مهذّب الأحكام» حيث يكتب: «إنّ مالكيّة اللّه- تعالى- للعمل و لذات العامل حقيقيّة واقعيّة و استحقاق العامل لعمله اعتباريّ ظاهريّ و لا منافاة بينهما و هذا الإشكال جارٍ في جميع أموال العباد و أعمالهم و لا اختصاص له بالواجبات ﴿فإنّ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ﴾[5] و لا محذور فيه، لأنّه تعالى مالك العباد و أموالهم و أعمالهم و جميع شؤونهم و أعطى العامل استحقاق عمله و ملكه على أمواله، فالاستحقاق موهبة منه تعالى لعباده و لا محذور فيه من عقل أو نقل، بل هو المناسب لفضله غير المتناهي، فلا المالكية المطلقة تزيده- تعالى- فضلاً و لا العطيّات غير المتناهية تنقصه شيئاً.»[6]
مع أنَّ العبد و أمواله ملكٌ لله-تعالى، إلا أنَّ الله أذن له بالتصرف. بناءً على ذلك، فإنَّ الحصول على الأجرة مقابل أداء الواجبات، في حال الحفاظ على قصد القربة، لا يتعارض مع نظام الملكيّة الإلهيّة.
الاستنتاج
القضية التي كانت محلّ النقاش هي إمكان و جواز أخذ الأجرة على الواجبات، و ليس وجوب ذلك. و كما أنَّ أخذ الأجرة جائز على الأعمال المستحبة، مثل الزيارة أو قراءة الأدعية، فإنّه يجوز كذلك أخذ الأجرة على أداء العمل الواجب نفسه، بشرط الحفاظ على النيّة الإلهيّة و قصد القربة.
و عليه، يمكن للوجوب الإلهي و عقد الإجارة أن يقع بعضهما في طول البعض و يتحقّقا في آن واحد، بشرط مراعاة الشروط الشرعية.


