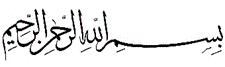التنبیه الثاني عشر و التنبیه الثالث عشر/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
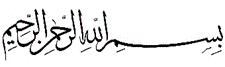
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الثاني عشر و التنبیه الثالث عشر
التنبیه الثاني عشر: جریان الاستصحاب في الأمور الاعتقادیة
يدور البحث هنا حول جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية، ثم يتناول استدلال بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيهم وبقاء أحكام شريعته باستخدام الاستصحاب. تنقسم الأمور الاعتقادية إلى قسمين:
القسم الأول: الأمور التي يلزم الالتزام بها، حتى بدون حصول اليقين
تشمل هذه الأمور مسائل يجب الاعتقاد بها والالتزام بها وعقد القلب عليها، حتى لو لم يحصل اليقين بها أو لم تُعرف تفاصيلها بدقة، مثل بعض خصائص الرجعة والمعاد. يُقال هنا إن الاستصحاب الموضوعي والحكمي يجريان.
الاستصحاب الموضوعي: على سبيل المثال، الاعتقاد بما نُقل عن المعصومين حول عذاب القبر وضغطته. الآن، إذا دُفن شخص في قبر وبعد فترة قصيرة (سنة أو أقل أو أكثر)، هُدم ذلك القبر، فإننا في هذه الحالة نشك في بقاء الموضوع (أي عذاب القبر بعد هدم القبر) ونجري الاستصحاب.
الاستصحاب الحكمي: مثل وجوب الاعتقاد بما نُقل عن المعصومين حول الرجعة. في حال وصلت إليه روايات مختلفة حول كيفية الرجعة ولم يستطع تمييز الروايات الصحيحة من غير الصحيحة أو لم يستطع الجمع بين الروايات الصحيحة، فقد يشك في وجوب الاعتقاد بالرجعة أو عدم وجوبه. هنا يقتضي الاستصحاب بقاء وجوب الاعتقاد بالرجعة. ومع ذلك، فإن المكلف يعتقد بأصل الرجعة والخصائص الصحيحة المنقولة عنها فقط، ولا يلزمه الاعتقاد بالتفاصيل غير المعروفة.
أشار صاحب الكفاية(قدسسره) أيضًا إلى هذا القسم فقال:
«أمّا الأمور الاعتقادية التي كان المهمّ فيها شرعاً هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكماً و كذا موضوعاً فيما كان هناك يقين سابق و شك لاحق».[1]
استدل المرحوم الآخوند(قدسسره) على هذا القول بأنه من الناحية الإثباتية، يجري الاستصحاب في هذه الحالات وهو ممكن؛ لأنه يمكن اعتبار المشكوك هنا بمنزلة المتيقن. وكذلك من الناحية العملية، يجري الاستصحاب استنادًا إلى قاعدة «لا تنقض اليقين بالشك».
يوجد هنا توهم مفاده أن الاستصحاب كأصل عملي لا يجري إلا في مورد الأعمال الجوارحية (الأعمال البدنية) ولا يشمل الأمور الاعتقادية والقلبية (الأعمال الباطنية).
يجيب صاحب الكفاية(قدسسره) على هذا التوهم:
«و كونه أصلاً عملیاً إنّما هو بمعنی أنّه وظیفة الشاك تعبّداً قبالاً للأمارات الحاكیة عن الواقعیات، فیعمّ العمل بالجوانح كالجوارح»[2]
.
القسم الثاني: المسائل التي يجب أن يكون الاعتقاد بها عن يقين وجزم
تشمل هذه الأمور مسائل يجب الاعتقاد بها عن يقين ومعرفة تامة، مثل الاعتقاد بأصول الدين كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. في هذه الحالات، يجب على المكلف أن يعتقد بأصول دينه عن معرفة وعلم، والتعبد هنا غير كافٍ. فصّل صاحب الكفاية(قدسسره) بين الاستصحاب الموضوعي والحكمي. ويعتقد أن:
• الاستصحاب الموضوعي لا يجري في هذه الحالات.
• الاستصحاب الحكمي يجري في هذه الحالات.
يقول المرحوم الآخوند(قدسسره):
«أمّا التي كان المهمّ فیها شرعاً و عقلاً هو القطع بها و معرفتها، فلا مجال له موضوعاً و یجري حكماً، فلو كان متیقّناً بوجوب تحصیل القطع بشيء كتفاصیل القیامة في زمان، و شك في بقاء وجوبه یستصحب و أمّا لو شك في حیاة إمام زمانٍ(علیه السلام) مثلاً فلایستصحب، لأجل ترتیب لزوم معرفة إمام زمانه، بل یجب تحصیل الیقین بموته أو حیاته مع إمكانه».[3]
ثم يستثني صاحب الكفاية(قدسسره) من عدم جريان الاستصحاب الموضوعي الحالات التي اكتفى فيها الشارع بالظن أو الاعتقاد الراجح: «في هذه الحالات، يجري الاستصحاب، بشرط أن يكون الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن؛ مثل معرفة بعض الكرامات الصادرة عن المعصومين أو المصائب التي حلت بهم».[4]
يبدو أن جريان الاستصحاب في هذه الحالات يرجع فقط إلى حجيته من باب إفادة الظن. لأنه إذا قلنا إن حجية الاستصحاب من باب الأخبار (وهو الرأي المختار أيضًا)، فلا فائدة من جريان الاستصحاب في هذه الحالات؛ لأنه في هذه الحالة، لا يمكن للاستصحاب أن يحل محل المعرفة الظنية؛ كما أنه لا يمكن أن يحل محل القطع الموضوعي.[5]
إشارة: استدلال بعض أهل الكتاب بالاستصحاب لإثبات دينهم[6]
الاستدلال بالاستصحاب إما بهدف تبرير البقاء على دينهم[7]
أو بهدف إلزام المسلمين بطريقتهم ودعوتهم إلى دينهم. إذا كان لتبرير البقاء على دينه، فإما أنه على يقين ببقاء لزوم الالتزام بنبوة نبيه، أو أنه شاك: في كلتا الحالتين لا يجري الاستصحاب؛ لأن هذه المسألة من الاعتقادات التي يلزم فيها العلم والمعرفة. وكذلك مع الشك في بقاء أحكام شريعته، إذا كان على يقين بها، لا يجري الاستصحاب، وإذا شك، لا يجري إلا إذا كان الاستصحاب حجة في كلتا الشريعتين، أما إذا لم يكن الاستصحاب حجة في شريعته، فلا يجري. كان هذا المطلب حول الكافر الكتابي. أما بالنسبة لنا، فقد بُيّن سابقًا جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة وكمال أركان استصحاب عدم النسخ. وإذا كان لإلزام المسلمين بطريقته ودعوتهم إلى دينه، فلا يجري الاستصحاب، لأن المسلمين يعتقدون اعتقادًا جازمًا ويقينيًا بنبوة الأنبياء المقدسين مثل موسى وعيسى ولا يشكون حتى نقول إنه يجري الاستصحاب لإثبات نبوتهم. وأما بخصوص استصحاب شريعتهم، فقد قيل سابقًا إن شريعتهم منسوخة، والمسلمون يعلمون بنسخ كثير من أحكام الشرائع السابقة، فلا يجري الاستصحاب فيما عُلم نسخه. أما جريان الاستصحاب فيما يُحتمل بقاؤه، فلا إشكال فيه، كما أُشير سابقًا.
هذا تمام الكلام في هذا التنبیه.[8]
التنبیه الثالث عشر: المراد من الشك في دلیل الاستصحاب
يقوم الاستصحاب على أساس اليقين والشك. كما بيّنا سابقًا، فإن المراد باليقين أعم من اليقين الوجداني واليقين التعبدي. البحث هنا يدور حول مفهوم الشك: هل المراد بالشك هو حالة تساوي الطرفين فقط أم أن للشك معنى أوسع ويشمل حتى الظن غير المعتبر؟ وبعبارة أخرى، هل يقع الشك في مقابل عنوان اليقين ويشمل كل ما ليس بيقين، سواء كان وهمًا أو شكًا أو ظنًا غير معتبر؟ يبدو أن المراد بالشك هو ما يقع في مقابل اليقين؛ وعليه، فإنه يشمل الظن غير المعتبر أيضًا.
الاستدلال على شمول الشك للظن غير المعتبر
توجد ثلاثة أدلة على هذا الموضوع تفيد بأن الشك يشمل الظن غير المعتبر أيضًا:
الدليل الأول: الفهم العرفي
من وجهة نظر العرف، يُقال الشك لما يقع في مقابل اليقين. وفقًا للمفهوم العرفي، يشمل الشك كل ما هو ظن غير معتبر.[9]
الدليل الثاني: دلالة صحيحة زرارة على حكم من يعتريه الشك وعدم العلم
يُستفاد من صحيحة زرارة أن الشك يشمل الظن غير المعتبر أيضًا، لأنه في هذه الرواية، انطبق الشك على عبارة «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ». فأجاب الإمام(علیهالسلام): «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَام».[10]
[11]
توضيح: إذا تحرك شيء بجانب الشخص ولم يعلم به، تنشأ للمكلف حالتان: إما حالة تساوي الطرفين (الشك) أو الظن بالنوم. وقد عبّر الإمام(علیهالسلام) عن كلتا الحالتين بتعبير واحد وهو «الشك». وعليه، نفهم من هذه الرواية أن الشك قد استُخدم بمعنى أعم من حالة تساوي الطرفين وحالة الظن.
الدليل الثالث: الاستفادة من روايات الاستصحاب من باب تنزيل الشك منزلة اليقين في حالة تساوي الطرفين والظن
في هذه الروايات، طرح الإمام(علیهالسلام) ثلاث حالات: اليقين بالوضوء، والشك في بقاء الوضوء، واليقين بالنوم. حكم الإمام(علیهالسلام) في حالة الشك بأن على المكلف أن يضع نفسه في موضع من هو على يقين بالوضوء، حتى يصل إلى يقين بالنوم. من هنا يتضح أن على المكلف أن يفترض نفسه في حالة يقين بالوضوء، إلا إذا حصل له يقين بالنوم. هذا التنزيل يشمل كلتا حالتي تساوي الطرفين والظن بالنوم. وعليه، فإن تعبير الشك أعم من الشك الاصطلاحي (تساوي الطرفين) والظن بالنوم.
توجد أدلة أخرى[12]
قدمها الشيخ الأنصاري(قدسسره) لتعميم الشك ليشمل الظن، مثل الإجماع، ولكننا نمتنع عن ذكرها لكي لا يطول البحث.[13]
من مجموع هذه المباحث، يتضح بطلان رأي من فصّل بين الشك في زوال الأمر المتيقن السابق والظن بزواله.[14]
التنبیه الرابع عشر: التمسك بعموم العامّ أو استصحاب حكم المخصّص
يدور البحث هنا حول حالة يخرج فيها أحد أفراد العام من العموم لفترة زمنية خاصة، وبعد انقضاء هذه الفترة، نشك في شمول العام لذلك الفرد. في مثل هذه الظروف، يوجد اختلاف في الرأي بين العلماء حول هل يجب الرجوع إلى عموم العام أم استصحاب الحكم الخاص.
منشأ هذا الاختلاف هو هل يؤدي التخصيص إلى سقوط حجية العام كليًا، بحيث لا يعود التمسك بعموم العام ممكنًا، أم أن للتخصيص ليس مثل هذا الأثر ويمكن الرجوع إلى عموم العام بعد انقضاء زمن التخصيص.
أحد الأمثلة المشهورة في هذا الصدد هو خيار الغبن، الذي يوجد اختلاف في الرأي حول كونه فوريًا[15]
أو غير فوري. هنا، نرى أن لزوم العقد يثبت بالتمسك بعموم الآية الشريفة ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[16]
. ولكن زمن العلم بوجود الغبن هو فترة زمنية محددة خرجت فيها المعاملة يقينًا من عموم الآية؛ لأن فسخ العقد في هذا الزمان جائز بخيار الغبن. الآن، بعد انقضاء هذا الزمان:
• إذا لم يفسخ المغبون العقد، فهل لا يزال بإمكانه إعمال خيار الغبن وفسخ العقد؟ (وفي هذه الحالة لن يكون خيار الغبن فوريًا)
• أم أنه لم يعد بإمكانه إعمال الخيار؟ (وفي هذه الحالة يجب القول بفورية خيار الغبن)
بيان الأقوال في هذه المسألة
القول الأول: التمسك بعموم العام بصورة مطلقة
في هذا القول، يُتمسك بعموم العام بشكل مطلق، أي أنه بعد انقضاء زمن التخصيص، يجري الحكم العام. وعليه، في مثال خيار الغبن، سنقول بفورية خيار الغبن ونستند إلى عموم آية ﴿﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾.
هذا رأي المحقق الثاني، والمحقق الخوئي، والسيد محمد باقر الصدر(قدسسرهم)، وبعض الأساطين(دامظله)، والسيد السيستاني(دامظله).[17]
القول الثاني: استصحاب الحكم الخاص بصورة مطلقة
في هذا القول، يُستصحب الحكم الخاص بشكل مطلق. أي أنه بعد انقضاء زمن التخصيص، يبقى الحكم الخاص قائمًا. في مثال خيار الغبن، يُقال إن الخيار كان ثابتًا يقينًا في الزمان الأول (زمن العلم بالغبن) وفي الأزمنة التالية له نشك في بقائه. وعليه، بناءً على الاستصحاب، يبقى خيار الغبن قائمًا.([18]
)
نُسب هذا الرأي إلى السيد بحر العلوم(قدسسره).
القول الثالث: التفصيل بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي
في هذا الرأي، يُفرق بين المخصص اللبي (العقلي أو الإجماعي) والمخصص اللفظي:
• إذا كان المخصص لبيًا، يُتمسك بعموم العام.
• أما إذا كان المخصص لفظيًا، يُستصحب الحكم الخاص. نُسب هذا الرأي إلى صاحب الرياض(قدسسره)[19]
. ولكن العبارات الواردة في كتاب الرياض، وكذلك ما نقله الشيخ الأنصاري(قدسسره) في هذا الصدد، لا تتوافق مع هذه النسبة.[20]
القول الرابع: التفصيل بين كون الزمان مفردًا للعام وكونه ظرفًا له
في هذا القول، يُطرح الفرق في دور الزمان بالنسبة للعام:
• إذا كان الزمان قيدًا مستقلاً للعام، يُتمسك بعموم العام.
• أما إذا كان الزمان مجرد ظرف لتحقق العام، يُستصحب الحكم الخاص.
هذا رأي الشيخ الأنصاري(قدسسره).[21]
القول الخامس: التفصيل بين كون الزمان قيدًا للعام والمخصص وكونه ظرفًا لكليهما
في هذا القول، يُدرس الزمان بأربع صور:
١. أن يكون الزمان قيدًا للعام والمخصص.
٢. أن يكون الزمان ظرفًا للعام والمخصص.
٣. أن يكون الزمان قيدًا للعام وظرفًا للمخصص.
٤. أن يكون الزمان قيدًا للمخصص وظرفًا للعام. هذا تفصيل صاحب الكفاية(قدسسره).[22]
الفرق بين هذا التفصيل والتفصيل الرابع
في التفصيل الرابع، يُدرس كون الزمان قيدًا وظرفًا في ارتباطه بالعام فقط. أما في التفصيل الخامس، فيُؤخذ كون الزمان قيدًا وظرفًا في الاعتبار لكل من العام والمخصص.
[4] كفاية الأصول، ص422: «إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن و كان المورد مما يكتفى به أيضاً فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لابد في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه كان ذاك متعلقاً بعمل الجوارح أو الجوانح».
[5] وافق المحقق الإصفهاني صاحب الكفایة بأن الاستصحاب الحكمي جارٍ في كلا القسمین لكن بسط الكلام في الموضوعي و قال في نهاية الدراية، ج5 و 6، ص213: «و أما الثاني [الاستصحاب الموضوعي]، فما هو قابل لدعوى اليقين به سابقاً، و الشك في بقائه لاحقاً هي الإمامة و النبوة ليتعبد بآثارها.فنقول: أما الإمامة، فإن كانت بمعنى الرئاسة المعنوية الكبرى في الدين و الدنيا، المنبعثة عن كمال نفسه المقدسة الّتي من شؤونها الروحانية وساطتها للفيض، ... فحينئذٍ لا شك في زوالها لا بالموت و لا بمجيء إمام لاحق، كما سيجيء في النبي صلى الله عليه و آله.و إن كانت بمعنى الرئاسة المجعولة تشريعاً من الله تعالى في أمور الدنيا و الدين، فهي حينئذٍ من المناصب المجعولة، و تزول بالموت، إذ لا معنى لاعتبارها له
بعد موته، ... فإذا شك في موته فلامحالة يشك في إمامته فعلاً.و حينئذٍ إذا كان الواجب هو عقد القلب على إمامته، فالأثر المترتب على التعبد بحياته وجوب عقد القلب على إمامته، و إذا كان الواجب معرفته بالإمامة، فظاهر المتن أنه لايترتب عليه هذا الأثر، لأن الشك في حياته مع اليقين بإمامته فعلاً متنافيان.و يمكن أن يقال: إن التعبد بالأمور الاعتبارية الشرعية- الّتي منها المناصب المجعولة- محقق لها في ثاني الحال، فمقتضى استصحاب الملكية أو ما يترتب عليه الملكية إيجاد اعتبار مماثل للاعتبار الواقعي فعلاً لا إيجاب ترتيب آثار ذلك الاعتبار فقط، و مع وجوده فعلاً يكون وجوده فعلاً ملزوماً لليقين به فعلاً، و لا منافاة بين اليقين بوجود الاعتبار المماثل فعلاً مع الشك في بقاء الاعتبار الواقعي، للشك في حياته واقعاً.و أما إيجاب تحصيل معرفته بمقدماته الّتي منها تحصيل اليقين بحياته واقعاً، ليكون التعبد بحياته تعبداً بتحصيل معرفته بالإمامة واقعاً الممكنة بمقدماتها، فغير معقول، إذا كان إيجاب تحصيل معرفته مطلقاً، لأن تحصيل اليقين بحياته يوجب انتفاء التعبد الاستصحابي، فيلزم من وجود التعبد الاستصحابي- الموجب لتحصيل اليقين بالحياة- عدم التعبد الاستصحابي و هو محال.و هكذا الأمر إذا كان وجوب تحصيل اليقين بالإمامة مشروطاً باليقين بالحياة و على تقدير حصوله، لأن هذا التقدير ضدّ التعبد الاستصحابي، و لايعقل أن يقتضي التعبد ما يتوقف على ما يضاده فتدبر.و أما النبوة فإن كانت من الصفات الواقعية، و مرتبة عالية من الكمالات النفسانيّة، و هو تلقي المعارف الإلهية، و الأحكام الدينية من المبادئ العالية بلا توسط بشر، فيكون النبوة من النبأ، و النبي فعيل بمعنى المفعول، فصيرورة نفسه المقدسة مجلى المعارف و الأحكام معنى بلوغها درجة النبوة. فالشك في بقائها حينئذٍ، لأحد أمور:أما انحطاط نفسه المقدسة عن هذه الدرجة، أو زوالها بالموت، أو بمجيء نبي لاحق.و الكل غير معقول، لأن هذه الملكة ليست كسائر الملكات الّتي لها درجة التخلق، بل لها درجة التحقق.و المعرفة الشهودية، و ما ينبعث عنها، لا زوال لها خصوصاً بالموت، فإنه لايزيل سائر الملكات الراسخة فضلًا عن هذه الملكة الشامخة، ... .و أما زوالها بمجيء نبي لاحق- و لو كان أكمل- فبديهي الفساد، إذ كمال شخص أو زيادته لايوجب زوال كمال شخص آخر أو نقضه، و عليه فلا شك في بقاء النبوة بهذا المعنى حتّى يستصحب.... و إن كانت النبوة من المناصب المجعولة، بمعنى أنّ موضوع الاعتقاد هذا المعنى، لا كونه ذا صفة كذائية، و إن كان كذلك، و كان هو المخصص لاعتبار هذا المنصب له من بين سائر العباد.... ثم من الواضح أنّ النبوة المجعولة تزول بالموت، إذ لا معنى لاعتبار المبلغية و السفارة للميت بحسب العادة، إلّا أنّ حالها حال النبوة غير المجعولة في أن التعبد بنبوته فعلًا- للشك في زوالها بالموت- لايترتب عليه إلّا وجوب الاعتقاد بنبوته، و أما التصديق فيما أتى به، فيجتمع مع القطع بزوالها فعلًا، كما أنّ بقاء شريعته يجامع القطع بموته، بل القطع بمجيء نبي لاحق».استظهر بعض الأساطین
. في المغني في الأصول، ج2، ص255 من كلام صاحب الكفایة هذا الاستدلال و استشكل علیهما فقال: «المناقشة في ما أفاده العلمان ...»
[6] قال المحقق القمي
. في القوانين، ج3، ص164 بأنه قد وقعت مناظرة لبعض الأعلام مع كتابي و ذكر هذه الشبهة
[7] قسّم بعض الأساطین
. هذا القسم بالاعتقاد بالنبوة و الاعتقاد بالشریعة و استشكل على الاعتقاد بالنبوّة بما هو قریب من المتن و على الاعتقاد بالشریعة بلزوم الدور. راجع المغني في الأصول، ج2، ص261 - 262
[8] تكملة الـ «إشارة»:قال المحقق الإصفهاني
بأن المستصحب على هذا الفرض هو المسلم و لایجري الاستصحاب في حقه؛ ففي نهایة الدرایة، ج5 - 6، ص216: «فالمستصحب هو المسلم على الأول [إلزام المسلم] و لا مجال للأول [إلزام المسلم]، فإن فرض كون الخصم مسلماً ينافي فرض كون ما يرويه الكتابي مسلّماً عنده، و إلّا إلزام جدلاً إلّا في المسلمات، و لو عند الخصم بالخصوص.و عليه فلا شك في انقطاع نبوة موسى
و نسخ شريعته، و لا استصحاب إلّا مع اليقين، و الشك من المستصحب».و أجاب بعض الأساطین
من هذا الكلام بعدم وجود أركان الاستصحاب. راجع المغني في الأصول، ج2، ص264.مصباح الأصول (ط.ج): ج3، ص254: «إن استدلال الكتابي لايخلو من وجهين: فإما أن يكون استدلالاً له لمعذوريته في البقاء على اليهودية، و إما أن يكون لإلزام المسلمين و دعوتهم إلى اليهودية فإن كان مراده الأول، فنقول له: ... و أما استصحاب بقاء أحكام الشريعة السابقة، فغير جارٍ أيضاً إذ نقول له: إن كنت متيقناً على بقاء أحكام الشريعة السابقة، فلا معنى للاستصحاب و هو واضح ... و إن كان مراده الثاني- أي كان استدلاله لإلزام المسلمين و دعوتهم إلى اليهودية- فنقول له: جريان الاستصحاب متوقف على اليقين بالحدوث و الشك في البقاء، و ليس لنا يقين بنبوة موسى
إلا من طريق شريعتنا ...».و قد وقعت مناظرة لبعض الأعلام مع كتابي و ذكر هذه الشبهة؛ قال المحقق القمي
في القوانين، ج3، ص164: «و هاهنا لطيفة يعجبني أن أذكرها من باب التّفريع على هذا الأصل ممّا ألهمني الله تعالى به ببركة دين الإسلام و الصّادعين به عليهم الصلاة و السلام. و هو أنّ بعض السّادة الفضلاء الأزكياء من أصحابنا، ذاكرني حكاية ما جرى بينه و بين أحد من أهل الكتاب من اليهود و النصارى من أنّه تمسّك بأنّ المسلمين قائلون بنبوّة نبيّنا عليه السّلام فنحن و هم متّفقون على حقيّته و نبوّته في أوّل الأمر، فعلى المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه.ثمّ ذكر أنّه أجابه بما هو المشهور: من أنّا لانمنع نبوّة نبيّ لايقول بنبوّة محمّد
، فموسى أو عيسى عليهما السّلام الذي يقول بنبوّته اليهود أو النصارى، نحن لانعتقده، بل نعتقد بموسى أو عيسى عليهما السّلام الذي أخبر عن نبوّة محمّد صلّى الله عليه و آله و سلم و صدّقه، و هذا مضمون ما ذكره الرضا عليه الصلاة و السلام في جواب الجاثليق، فإنّه قال له عليه السّلام: ما تقول في نبوّة عيسى
و كتابه، هل تنكر منهما شيئاً؟ قال الرضا صلوات الله و سلامه عليه: «أنا مقرّ بنبوّة عيسى و كتابه و [ما] بشّر به أمّته، و ما أقرّت به الحواريّون، و كافر بنبوّة كلّ عيسى لميقرّ بنبوّة محمّد
و [بـ] كتابه و لميبشّر به أمّته».قال الفاضل: فأجابني بأنّ عيسى بن مريم المعهود الذي لايخفى على أحد حاله و شخصه، أو موسى بن عمران المعلوم الذي لايشتبه على أحد من المسلمين و لا أهل الكتاب، جاء بدين و أرسله الله نبيّاً، و هذا القدر مسلّم الطّرفين، و لايتفاوت ثبوت رسالة هذا الشّخص و إتيانه بدين بين أن يقول: بنبوّة محمّد صلّى الله عليه و آله و سلم أم لا. فنحن نقول: دين هذا الرّجل المعهود رسالته باقٍ بحكم الاستصحاب، فعليكم بإبطاله. و بذلك أفحم [أقحم] الفاضل المذكور في الجواب».حكاها الشيخ الأنصاري
في الفرائد، ج2، ص672 و من ثمّ وقع البحث حولها من بعد الشيخ الأنصاري مبسوطاً و أمّا المناظر ذكره الشيخ الأنصاري بعنوان بعض الفضلاء السادة.و قال في بحر الفوائد، ط.ج، ج7، ص385: «الفاضل المذكور هو السيّد السّند المتبحّر في كثير من العلوم السّيد باقر القزويني طيّب الله رمسه قد وقعت المناظرة بينه و بين عالم يهوديّ على ما حكاه الأستاذ العلّامة في قرية تسمّى بذي الكفل في قرب المشهد الغرويّ على من شرّفه ألف تحيّة و سلام و السيّد المذكور و إن ألزمه و أفحمه ببراهين واضحة إلّا أنّ الكتابي لميرض بما أجاب به عن الاستصحاب ...».و قال في الأوثق، ج5، ص473: «قد ذكر بعض مشايخنا أنّه السيّد حسين القزويني. و قيل: إنّه السيّد محسن الكاظمي. و لكنّي قد رأيت رسالة من بعض تلامذة السيّد السّند العلّامة الطباطبائي الملقّب ببحر العلوم
قد نسب هذه المناظرة فيها إليه، و قد وقعت حين سافر من النجف الأشرف إلى زيارة جدّه أبي عبد الله الحسين
. في البلدة المعروفة الآن بذي الكفل، و هي مجمع اليهود. و قد كانت الرسالة عندي مدّة، ثمّ أخذها بعض الطلبة مع عدّة من الرسائل فذهب بها منذ خمس سنين أو أزيد. و لكن ببالي أنّ الموجود فيها أنّ اليهودي الذي ناظره قد عجز في الجواب، و كَلَّ لسانه في الخطاب، على عكس ما نقله المحقّق القمّي رحمه الله من إفحام الفاضل. و ينبغي أن يكون الأمر كما وصفناه، إذ كيف يمكن أن ينسب إليه العجز في مناظرة اليهود، و هو مفتاح كنوز الدلائل، و كشّاف رموز المسائل؟ لمتسمح الأيّام بمثله، و لمتلد الأعوام بشكله، و هو ذو مفاخر و كرامات، و مآثر و علامات، قدس الله روحه، و طيّب رمسه، و جزاه الله عنّا خير الجزاء. و يحتمل في المقام تعدّد الواقعة».و السيد صاحب العروة في حاشيته على الفرائد: «قيل: أنّ المناظر هو بحر العلوم السيد مهدي الطباطبائي و هو بعيد، لأنه أجلّ شأناً من مثل هذه المناظرة و إفحامه كما حكاه في القوانين. و قيل: إنه السيد حسين أو السيد محسن القزويني ...»
[9] و في مصباح الأصول، (ط.ج): ج3، ص268 و (ط.ق): ج3، ص225: «أمّا الشك فالظاهر أنّ المراد منه خلاف اليقين الشامل للظن، فإنّه هو المتعارف في لغة العرب، و جعل الظن مقابلًا للشك و اليقين اصطلاح مستحدث، فالشك بمفهومه العرفي شامل للظن».و یعاضد هذا الدلیل ما في كتب اللغة من تفسیر الشك بما هو غیر الیقین:العین، ج5، ص270: «الشَّكُّ: نقيض اليقين».المحیط في اللغة، ج6، ص121: «الشك: نقيض اليقين».الصحاح، ج4، ص1594: «الشك: خِلاف اليقين».مصباح المنیر، ج6، ص126: «قال أئمّة اللغة: الشَّكُّ خلاف اليقين، و هو التردّد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجّح أحدهما على الآخر».و في المفردات، ج1، ص461عرّف الشك بالتعريف المنطقي و قال: «الشَّكُّ: اعتدال النّقيضين عند الإنسان و تساويهما ...».و حمله بعض الأعلام على بیان المستعمل فیه. قال بحر الفوائد، ج7، ص442: «و إن كان ربما يظهر من بعض كتب اللّغة تفسيره بخصوص التّسوية، لكن من المعلوم أنّ المقصود بيان المستعمل فيه لا المعنى الحقيقي، أو المعنى الحقيقي بحسب اصطلاح أهل المعقول فتأمل».
[10] الوسائل، ج1، ص245، كتاب الطهارة، الباب1 من أبواب نواقض الوضوء، ح1.و راجع عيون الأنظار ج10، ص143.
[12] استدل الشیخ الأنصاري
عليه بوجوه:منها: الإجماع؛ قال في فرائد الأصول، ج2، ص687: الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.منها: شاهد آخر من روایة أخری من زرارة في فرائد الأصول، ج2، ص687: «و منها: قوله
في صحيحة زرارة الثانية: «فلعلّه شيء أوقع عليك، و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ»؛ فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال، خصوصاً مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام، فيكون الحكم متفرّعاً عليه».و منها: شاهد من روایة أخرى و هو: «و منها: تفريع قوله عليه السّلام: «صم للرّؤية و أفطر للرّؤية» على قوله عليه السّلام: «اليقين لايدخله الشّكّ».و منها: و استدلّ الشیخ أیضاً بدلیل آخر و هو قوله: «الثالث: أنّ الظنّ الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أنّ وجوده كعدمه عند الشارع، و أنّ كلّ ما يترتّب شرعاً على تقدير عدمه فهو المترتّب على تقدير وجوده. و إن كان ممّا شكّ في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعليّ السابق بسببه، إلى نقض اليقين بالشكّ، فتأمّل جداً».و ناقش فیه المحقق الخراساني
في كفایة الأصول، ص426: «و فيه: أن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لايكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبداً ليترتب عليه آثاره شرعاً لا ترتيب آثار الشك مع عدمه بل لابد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أي أصل من الأصول العملية من الدليل، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلابد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة و لا ارتياب، و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل، فتأمل
جيداً». أجاب عنه في المغني في الأصول، ج2، 300 فراجع.
[13] و استدلّ المحقق النائيني
بدليل آخر:ففي أجود التقریرات، ج4، ص179: «أما الظن الغير المعتبر فهو ملحق بالشك حكماً لو لميكن منه حقيقة و ذلك لما عرفت في بحث حجية الطرق من أن الشك إنما يؤخذ في موضوع الأصول بما أنه موجب للحيرة لا بما أنه صفة خاصة كما أخذ كذلك في باب الصلاة، فكلما فرض عدم كونه موجباً لإحراز الواقع و وصوله يكون مورد الجريان الأصل لامحالة».و في فوائد الأصول، ج4، ص563: «مضافاً إلى ما تقدّم في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي: من أنّ الشكّ إنّما أخذ موضوعاً في الأصول العمليّة من جهة كونه موجباً للحيرة و عدم كونه محرزاً و موصلاً للواقع، لا من جهة كونه صفة قائمة في النفس في مقابل الظنّ و العلم، فكلّ ما لايكون موصلاً و محرزاً للواقع ملحق بالشكّ حكماً و إن لميكن ملحقاً به موضوعاً، كما أنّ كلّ ما يكون موصلاً للواقع و محرزاً له ملحق بالعلم حكماً و إن لميكن ملحقاً به موضوعاً».و ناقش في هذا الاستدلال بعض المحققین:ففي زبدة الأصول، ج5، ص555: «و فيه: أولاً: إن هذا خلاف ظاهر لفظي اليقين و الشك، و ثانياً: إن لازم ذلك الالتزام بالورود في المسألة الآتية، و هي تعارض الأمارات و الاستصحاب كما هو واضح مع أنه
. ملتزم بالحكومة».في أصول الفقه، الشيخ حسين الحلي، ج10، ص487: «إنّ الغرض من اليقين ناقضاً و منقوضاً هو اليقين الوجداني، و الغرض من الشكّ هو خصوص تساوي الطرفين، و لكن لمّا كان اليقين في هذا الباب معتبراً من باب الطريقية قامت مقامه الأمارات، و كان محصّل ذلك أنّ الشكّ الذي هو عبارة عن تساوي الطرفين معتبر من حيث عدم الطريق، فيقوم مقامه الظنّ غير المعتبر»
[14] و يستظهر من صاحب العروة في حاشيته على الفرائد، ج3، ص329: «لا ريب أنّ المراد باليقين السابق هو اليقين بالواقع، و كذا المراد بالشك هو الشك في الواقع، و الظن المشكوك الحجية لايدخل في الشك بالواقع موضوعاً جزماً، و إنما الشك في الاعتماد عليه و العمل به، و معنى قوله
: «لاتنقض اليقين بالشك» حرمة نقض اليقين بالواقع بالشك فيه، فلايشمل ما إذا ظنّ خلاف الحالة السابقة المتيقنة، و إن كان هذا الظن مشكوك الحجية، كيف و لو كان المراد من الشك هو الشك في حكم العمل كان المراد من اليقين في قوله
: «بل تنقضه بيقين آخر» أيضاً هو اليقين بحكم العمل، فيشمل ما إذا استفيد الحكم من الأدلة الاجتهادية، فيكون العمل على الدليل الاجتهادي على خلاف الاستصحاب من باب حصول الغاية لكونه نقضاً باليقين، نظير قوله
: «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» فإذا علم بالقذارة فقد حصلت الغاية و ارتفع الحكم بالطهارة لارتفاع موضوعه، فيلزم أن تكون الأدلة الاجتهادية واردة على الاستصحاب مع أنها على التحقيق، و المختار عند المصنف حاكمة على الأصول و مخصصة لها حكماً دون الإخراج الموضوعي، و الحاصل أنّ نقض اليقين بالظن المشكوك الحجية ليس نقضاً بالشك، و لعلّه إلى ذلك أشار بقوله: فتأمل جدّاً».و قال ذیل قوله: «فظاهر كلماتهم أنه لايقدح فيه وجود الأمارة غير المعتبرة»: «فيه: أنّا و إن لميحصل لنا التتبّع التامّ في كلماتهم إلّا أنّ ما تمسكوا به لحجية الاستصحاب من باب الظن من بناء العقلاء يشهد بأنهم لايقولون بهذا الإطلاق المدّعى، فإنّ بناء العقلاء على الاعتماد على الظن النوعي ما لميحصل الظن الفعلي على خلافه كما هو كذلك في بنائهم في ظواهر الألفاظ، و عدم اعتبار الشارع لهذا الظن على الخلاف أو المنع عن العمل به لايثبت حجية ذلك الظن النوعي أو بناء العقلاء على اعتباره. نعم لو كان الظن الشخصي على الخلاف حاصلاً ممّا لايرتضيه العقلاء من مثل الرؤيا و الاستخارة فالظاهر أنهم لايعبئون به و يأخذون بذلك الظن النوعي، و السرّ في ذلك كلّه أنّ العقلاء لايرون ما سوى الوصول إلى الواقع، و ليس في طريقتهم أن يتعبّدوا بشيء مطلقاً، و لذا يتحرّون أوّلاً في بلوغ مقاصدهم العلم فإن لميحصل فالظن الشخصي القوي ثم الضعيف فإن لميحصل فالظن النوعي و هكذا».یمكن أن یستظهر من كلمات الأعلام أن هذا التفصیل و الخلاف بینهم مبنائي لأن بعض الأعلام بنی تفسیر الشك بالمعنی الأخص على حجیة الاستصحاب من باب العقل:ففي فرائد الأصول، ج3، ص287: «هذا كلّه على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار. أمّا على تقدير اعتباره من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب في السابق، فظاهر كلماتهم أنّه لايقدح فيه أيضاً وجود الأمارة الغير المعتبرة، فيكون العبرة فيه عندهم بالظنّ النوعي و إن كان الظنّ الشخصي على خلافه؛ و لذا تمسّكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه الكلّي، من غير التفات إلى وجود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيّات الموارد».فیظهر منه أنه على مبنی حجیة الاستصحاب من باب الظن -إن كان مرادهم الظن الشخصي- فإنه حینئذٍ لایجري الاستصحاب في حالة الظن.درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد، ص379: «لايخفى أنّه لا منشأ لدعوى القطع بالإجماع هاهنا، إلا انحصار وجه اعتباره من باب التعبّد بالأخبار مع استظهار ذلك منها، و إلا كان ذهاب الجلّ أو الكلّ إلى اختصاص الاعتبار بما إذا تساوى طرفا الاحتمال بمكانٍ من الإمكان؛ و أنت خبير بأنّ ذلك لايوجب هذه الدعوى، و لو سلّم ظهور الأخبار بمثابة لايقبل الإنكار، بل لايوجب إلا دعوى دلالة الرّوايات عليه، فلا وجه لجعلهما وجهين. و أما دعوى القطع بطريق الحدس من غير هذا الطريق فعهدتها على مدّعيها، حيث لا طريق إلى تصديقها، كما لايخفى».المغني في أصول الفقه، ج2، ص304: «و نتیجة البحث أنه إن كان المبنی في حجیة الاستصحاب هي الأخبار ... فالمراد من الشك خلاف الیقین و إن كان المستند من باب حصول الظن بالبقاء ... أو من باب الظن النوعي بالبقاء فیقتصر فیهما على حصول الشك الاصطلاحي أي تساوي الحالین».فیظهر من هذا الكلام عدم الفرق بین الظن النوعي و الشخصي في عدم جریان الاستصحاب على مبنی حجیته من باب الظن لا الأخبار.و قد ناقش في هذا التفصیل بين المباني الشيخ حسين الحلي
. في أصول الفقه، ج10، ص487: «إنّ هذا الذي تقدّم من جريان الاستصحاب في مورد الظنّ غير المعتبر على خلافه لايفرق فيه بين كون الاستصحاب معتبراً من باب التعبّد أو أنّه من باب الظنّ، أمّا الأوّل فواضح كما تقدّم، و أمّا الثاني فلأنّ الغرض من كونه معتبراً من باب الظنّ ليس هو الظنّ الفعلي، و إلّا فلا ريب في كون مجرد الحدوث فيما تقدّم قد لايكون موجباً للظنّ الفعلي بالبقاء، بل الغرض منه الظنّ النوعي كسائر الأمارات التي يقال إنّها معتبرة من باب الظنّ النوعي، و حينئذٍ فلا مانع من قيام الظنّ الفعلي على خلافها»
[15] المشهور هو القول بالفوریة: شرح اللمعة، ج3، ص298: «(و لا خيار للبائع والمشتري إلا مع الغبن) فيتخير المغبون على الفور في الأقوى».جواهر الكلام، ج22، ص475: «إنما الكلام فیه أن الخیار فیه على الفور ... أو على التراخي قولان؛ فعن جماعة من المتقدمین و المتأخرین الأول بما ربما كان مشهوراً».المكاسب، ج5، ص206: «اختلف أصحابنا في كون هذا الخیار على الفور أو على التراخي على قولین: و استند للقول الأول و هو المشهور ظاهراً».كتاب المكاسب، ج5، ص212 – 213: «إنه قد علم من تضاعيف ما أوردناه على كلمات الجماعة: أن الأقوى كون الخيار هنا على الفور، لأنه لما لميجز التمسك في الزمان الثاني بالعموم - لما عرفت سابقاً من أن مرجع العموم الزماني في هذا المقام إلى استمرار الحكم في الأفراد فإذا انقطع الاستمرار فلا دليل على العود إليه، كما في جميع الأحكام المستمرة إذا طرأ عليها الانقطاع – و لا باستصحاب الخيار - لما عرفت من أن الموضوع غير محرز، لاحتمال كون موضوع الحكم عند الشارع هو من لميتمكن من تدارك ضرره بالفسخ، فلايشمل الشخص المتمكن منه التارك له، بل قد يستظهر ذلك من حديث نفي الضرر - تعين الرجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون وعدم ترتب الأثر عليه وبقاء آثار العقد، فيثبت اللزوم من هذه الجهة و هذا ليس كاستصحاب الخيار لأن الشك هنا في الرافع فالموضوع محرز كما في استصحاب الطهارة بعد خروج المذي فافهم و اغتنم و الحمد لله».و ذهب بعض الأعلام إلى التراخي:مفتاح الكرامة، ج12، ص345: «و في الشرائع و التحریر و الإیضاح أنه على التراخي و قواه في التنقیح و في إیضاح النافع أنه أحوط و لمیذكر الفور في الإرشاد و مجمع البرهان و شرح فخر الإسلام و كأنهم موافقون للشرائع».السيد الخوئي
في منهاج الصالحين، ج2، ص35 و السيد محمد الروحاني
في ج2، ص38 و السيد محمد صادق الروحاني
في ج2، ص40 و بعض الأساطين
في ج3، ص45 و الشيخ محمد إسحاق الفياض
في ج2، ص155: «الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور».و قال السيد محمد سعيد الحكيم
. في ج2، ص64: «الظاهر أن خيار الغبن ليس فورياً»
[17] قال في جامع المقاصد، ج4، ص38 عند قول صاحب القواعد «خاتمة تشتمل على أحكام: الأول: تلقي الركبان مكروه على رأي ... و مع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي...»: «قوله: (على الفور على رأي) اقتصاراً على مقدار الضرورة في مخالفة لزوم البيع، و الاستصحاب يقتضي عدم الفورية، و الأول أولى، لأن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، و إلا لمينتفع بعمومه».مصباح الأصول (ط.ج): ج2، ص260-266: «... تحصل مما ذكرناه: جواز الرجوع إلى العام بلا فرق بين كون الاستمرار راجعاً إلى الحكم أو راجعاً إلى المتعلق، و أن ما ذكره المحقق النائيني
من الفرق بينهما غير تامّ في نفسه».الحاشية على كفاية الأصول (المحقق البروجردي
) ج2، ص439: «التحقيق على ما أفاده السيد الأستاذ مدّ ظله هو أنه في المقام لابد من التمسك بعموم العام و لا مجال للتمسك باستصحاب حكم الخاص مطلقاً...».بحوث في علم الأصول، ج6، ص337: «هكذا يتّضح أنه لايبقى تفسير معقول للتفصيل في الرجوع إلى العموم الأزماني أو استصحاب حكم المخصص إذا فرض تمامية أركانه في نفسه. نعم لو فرض عدم تمامية العموم و لا مقدمات الإطلاق في العموم الأزماني وصلت النوبة إلى الأصول العملية و التي منها الاستصحاب و ليس في ذلك نكتة جديدة». المغني في الأصول، الاستصحاب، ج2، ص294 و 295: «الحقّ هو التمسك بالعام بعد التخصیص حتی في الواحد الشخصي و النتیجة إلى هنا ... إذا تعلق الحكم بمجموع الأزمنة ثم خرج بعضها بالتخصیص فیتمسك في باقي الأزمنة بالعموم أو الإطلاق ... قد اتّضح مما تقدم أن التخصیص في الأزمان كالتخصیص في الأفراد لایستلزم سقوط العام عن البقیة».الاستصحاب (السید المحقق السیستاني
.)، ص688-690: «المختار في المقام هو ما ذهب إلیه المحقق الثاني و جماعة من المحققین توضیح ما ذهب إلیه المحقق هو أن ...»
[18] بحر الفوائد (ط.ج): ج7، ص420: «و أما دليل القول بالرجوع إلى استصحاب حكم الخاص مطلقاً الذي ذكرنا أنه يستظهر من كلام بعض السادة الفحول فهو الذي تعرض له في طي كلامه الذي لخّصه بعض أفاضل من تأخر و هو الذي حكاه الأستاذ العلامة في الكتاب و المستفاد منه في ظاهر النظر صلاحية الاستصحاب لتخصيص العام ابتداء فضلاً عن صلاحيته لإبقاء حكم الخاص في زمان الشك و إن لزم منه التخصيص بالنسبة إلى العام. و حاصل ما ذكره من الاستدلال هو كون الاستصحاب الجزئي أخص من العام الذي في مقابله، فتعين الخروج منه به على ما هو المقرر في محله من وجوب حمل العام على الخاص مؤيداً ذلك باستشهاد الفقهاء في الموارد التي ذكرها في مقابل العمومات».
[19] نسبه إليه في منتهى الوصول إلى غوامض كفاية الأصول، ص180: «الثالث عشر: أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب إلخ إذا ورد عام .. ثم ورد مخصص له بالنسبة إلى فرد منه فى زمان .. و شك فيما بعد ذلك الزمان المقطوع خروجه عن تحت العام .. في أنه مندرج تحت حكم العام أو يشمله حكم المخصص، فهل يتمسك لإثبات حكم العام فيه بالعموم مطلقاً كما هو مختار المحقق الثاني، أو يرجع إلى استصحاب حكم المخصص كذلك كما هو مختار السيد السند السيد مهدي الطباطبائي
. أو يفصل بين ما كان التخصيص ثابتاً بدليل لبّي فيقال بالأول و بين ما كان ثبوته بدليل لفظى فيقال بالثاني كما هو مختار صاحب الرياض»
[20] هذا القول -و إن كان منسوباً إلى صاحب الریاض
في منتهی الوصول- یأباه كلام صاحب الریاض
فإنه تمسك في المخصص الثابت بدلیل الإجماع بالاستصحاب و في المخصص الثابت بدلیل لا ضرر بالعموم.قال الشيخ الأنصاري
في كتاب المكاسب، ج5، ص206: «و ذكر في الرياض ما حاصله: أن المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتّجه التمسك بالاستصحاب، و إن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول، إذ به يندفع الضرر».و الإجماع هو دليل لبّي و المقصود من نفي الضرر أدلة لا ضرر من الأخبار فيكون الدليل لفظياً.و قال صاحب الريّاض
. في رياض المسائل، ج8، ص191: «و في سقوط الخيار ببذل الغابن التفاوت قولان: للأول الاقتصار فيما خالف الأصل الدال على لزوم العقد على المتيقن المجمع عليه و المتحقق به الضرر و ليس منهما محل الفرض؛ أما الأول فللخلاف و أما الثاني فلاندفاع الضرر بالبذل و للثاني و هو الأشهر الاستصحاب لما ثبت، و هو الأظهر إن كان الإجماع في إثبات أصل هذا الخيار هو المستند. و لاينافيه وقوع الخلاف في محل الفرض، لأنه غير محل الإجماع. و ثبوت الحكم فيه به يقتضي انسحابه في محل الخلاف بالاستصحاب، و لا كذلك لو كان المستند للإثبات أدلة نفي الضرر خاصة، لدوران الحكم معه حيث دار، فيندفع بالبذل وحيث إن الاعتماد فيه على الأول أيضاً كان القول الثاني متجهاً»
[21] بحر الفوائد (ط.ج): ج7، ص414 - 415: «إذا كان للعام شمول بالنسبة إلى الزمان دون الخاص فهل يرجع إلى عموم العام بالنسبة إلى زمان الشك مطلقاً، أو إلى استصحاب حكم الخاص مطلقاً، أو يفصل بين ما إذا كان شموله للزمان على الوجه الأول من العموم أو على الوجه الثاني منه فيحكم في الأول بالرجوع إلى عموم العام و في الثاني إلى استصحاب حكم الخاص وجوه، بل أقوال، ظاهر المحقق الثاني في جامع المقاصد هو الأول، و ظاهر كلام بعض السادة الفحول حسب ما ستقف عليه هو الثاني و صريح الأستاذ العلامة في الكتاب هو الثالث، و ربما يستفاد من كلام ثاني الشهيدين أيضاً، بل نسبه الأستاذ العلامة في مجلس البحث إلى الأكثرين، بل المشهور».
[22] اختار قول المحقق الخراساني
، بعض الأعلام:المحاضرات (مباحث أصول الفقه) ج3، ص133: «[إذا أخذ الزمان ظرفاً في كل من العام و الخاص] ... إن الملازمة المدعاة [الملازمة بين كون المقام مورداً للتمسك بالعموم و بين عدم جريان الاستصحاب و كذلك بين كونه مورداً للتمسك بالاستصحاب و بين عدم جريان العموم] إنما كانت ثابتة في هذا الفرض إذا كان القطع من الوسط، إذ حينئذ يجري الاستصحاب و لا مجال للتمسك بالعموم بل و لو لميكن هناك استصحاب. و إن أخذ الزمان في كل واحد من العام و الخاص مكثراً و مفرداً فيكون المقام من التمسك بالعموم دون الاستصحاب، بل لو لميكن عموم أيضاً كان المرجع سائر الأصول العملية فالملازمة ثابتة في هذا الفرض أيضاً، و إن أخذ قيداً مفرداً في العام و ظرفاً في الخاص جرى كل واحد من العموم و الاستصحاب، إلا أنه مع وجود الأول لايرجع إلى الثاني فالملازمة منتفية هاهنا و إن أخذ بالعكس فلايجري واحد من العموم و الاستصحاب، أما الأول فلما عرفت في الفرض الأول، و أما الثاني فلأن المفروض أن زمان الخاص مكثر لأفراد الزمان فيتعدد الموضوع، هذا و للمحقق اليزدي
في مبحث خيار الغبن إيرادات على ما أفاده الشيخ
. يظهر ضعفها بعد التأمل فيما تقدم عند بيان مراده، فراجع و تدبّر».نهج الفقاهة، ص77: «التحقيق أن دلالة العام على ثبوت الحكم في الزمان الثاني إن كان بعناية ثبوته في الزمان الأول بحيث كان مفاد العام ثبوت الحكم لكل فرد في كل زمان بعنوان الاستمرار و الدوام فإذا خصص العام في زمان بنحوٍ ينتقض الاستمرار و ينفصم لا مجال للرجوع إلى العام بعد ذلك الزمان، و إن كانت دلالة العام على ثبوت الحكم في الزمان الثاني ليست بتلك العناية فلا مانع من الرجوع إلى العام في الزمان الثاني. و من ذلك يظهر أنه لو كان التخصيص من أول الأمر لا مانع من الرجوع إلى العام و إن كان مفاده على النحو الأول لأن التخصيص المذكور لايوجب انفصام الاستمرار و لا انتقاضه، و إنما يختلف المفادان عملاً لو كان التخصيص في الأثناء، و قد تعرّضنا لذلك في حاشية الكفاية».و راجع منتهى الأصول، ج2، ص669 و 670: «عدم جواز الرجوع إلى العموم الأزماني إذا لميكن انحلالياً ...»