46/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه العاشر؛ المطلب الثاني؛ التتمة/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
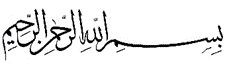
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه العاشر؛ المطلب الثاني؛ التتمة
تتمة: الاستصحاب في المقام قد یكون شخصیاً و قد یكون كلیاً
اقترب بحثنا في التنبيه العاشر من نهايته وقلنا في النهاية إن جريان الاستصحاب ممكن في جميع أقسام الاستصحاب، سواء في مجهول التاريخ أو في معلوم التاريخ. بالطبع، في بعض الحالات، يسقط الاستصحاب بسبب التعارض، وقد درسنا هذا البحث سابقًا وبيّنا أنه في مثل هذه الحالات، يعود الوجوب إلى الأصل العملي.
ولكن بقيت تتمة، وهي أن الاستصحاب هنا يكون أحيانًا شخصيًا وأحيانًا كليًا. نفس أقسام الاستصحاب الكلي التي بحثناها بالتفصيل سابقًا في المباحث الماضية وفي المجلد الحادي عشر، تُطرح هنا أيضًا. أحيانًا يجري الاستصحاب الكلي؛ كيف؟ أحيانًا يصبح الاستصحاب شخصيًا، كما نرى في مورد الاستصحاب الجاري في معلوم التاريخ. بمعنى أنه في معلوم التاريخ، يكون زمن وقوع الحادثة محددًا، مثلاً نعلم أن الحادثة وقعت في زمن معين ومعلوم وليست مترددة بين عدة أزمنة. هذا النوع من الاستصحاب شخصي. ولكن أحيانًا يصبح الاستصحاب كليًا، مثل الاستصحاب الجاري في مجهول التاريخ. هنا لدينا أمر كلي، ولكننا لا نعلم في أي زمن وقع هذا الأمر أو أنه متردد بين عدة حالات. وبعبارة أخرى، هذا الأمر الكلي قابل للانطباق على حالات مختلفة. السؤال الآن هو هل يجري الاستصحاب الكلي في مثل هذه الحالات أم لا؟ الجواب هو أن الاستصحاب الكلي يكون أحيانًا من القسم الثاني وأحيانًا من القسم الرابع.
أ) الكلي من القسم الثاني:
بيّن المحقق الخوئي(قدسسره) مثالاً لهذا القسم[1] . لنفترض أن شخصًا استيقظ من النوم في الساعة الأولى وصدر منه حدث أصغر في الساعة الثالثة. ولكنه لا يعلم هل توضأ في الساعة الثانية أم الساعة الرابعة. هنا:
• استصحاب الحدث: بما أن زمن وقوع الحدث (الساعة الثالثة) محدد، فهذا الاستصحاب شخصي.
• استصحاب الطهارة: بما أن زمن الوضوء مجهول (متردد بين الساعة الثانية والرابعة)، سيكون هذا الاستصحاب من نوع الكلي من القسم الثاني. لأنه إذا كان قد توضأ في الساعة الثانية، فقد ارتفع قطعًا (لأن الحدث الأصغر وقع في الساعة الثالثة). أما إذا كان قد توضأ في الساعة الرابعة، فهو مقطوع البقاء. إذن هنا، الطهارة مترددة بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، وهذا أحد مصاديق الاستصحاب الكلي من القسم الثاني.
ب) الكلي من القسم الرابع:
في الكلي من القسم الثاني قلنا إن الاستصحاب يجري، ولكن في الكلي من القسم الرابع أيضًا يمكن جريان الاستصحاب. بيّن المحقق الخوئي(قدسسره) مثالاً لهذا القسم أيضًا[2] . لنفترض أن شخصًا توضأ وعلم أن وضوءه تحقق في الساعة الثالثة. ولكنه يتردد بشأن الحدث الأصغر، هل وقع هذا الحدث في الساعة الثانية أم في الساعة الرابعة. هنا:
• استصحاب الطهارة: بما أن زمن الوضوء معلوم (الساعة الثالثة)، فهذا الاستصحاب شخصي.
• استصحاب الحدث الأصغر: هو من الكلي من القسم الرابع. لأن حدث النوم قد ارتفع بالوضوء قطعًا. أما بخصوص الحدث الأصغر، فإذا كان هذا الحدث قد وقع في الساعة الثانية، فلم يعد حدثًا جديدًا (لأنه ارتفع بوضوء الساعة الثالثة). أما إذا كان قد وقع في الساعة الرابعة، فهو حدث جديد. هنا، الحدث متردد بين ما ارتفع قطعًا وما هو مشكوك الحدوث. وعليه، يجري الاستصحاب الكلي من القسم الرابع هنا. هذه كانت تتمة البحث في التنبيه العاشر، وبهذه التوضيحات، انتهى بحثنا في هذا القسم.
و هذا تمام الكلام في التنبیه العاشر.
التنبیه الحادي عشر: جریان الاستصحاب عند الشك في المانع و القاطع
جریان الاستصحاب عند الشك في المانع و القاطع
في التنبيه الحادي عشر؛ يدور البحث حول جريان الاستصحاب عند الشك في المانع والقاطع. لنرَ ما يجب فعله هنا.
في بحثنا، النقطة التي يجب أن نطرحها هي أن الحديث الآن يدور حول استصحاب صحة العمل، وذلك في حالة الشك في وجود المانع. أي جريان الاستصحاب في حالة الشك هل كان هناك مانع أم لا.
وكذلك في حالة الشك في القاطع. قال البعض إن استصحاب صحة العمل يجري في مثل هذه الحالات. ولكن قبل الدخول في البحث، يجب الانتباه إلى عدة نقاط:
• ما الفرق بين المانع والقاطع؟
• وماذا نقصد أساسًا بصحة العمل؟
تبيين الشك في صحة العمل
الشك في صحة العمل يكون أحيانًا من جهة الشبهة الموضوعية وأحيانًا من جهة الشبهة الحكمية. كما أن صحة العمل يمكن أن يكون لها معنيان:
١. صحة الأجزاء السابقة: والمقصود بها الصحة التأهلية؛ حتى تنضم إليها بقية الأجزاء.
٢. صحة كل مجموعة العمل: المقصود بها صحة العبادة كلها، كمجموعة كاملة. إذن، يجب أولاً تحديد ما نقصده بصحة العمل. هل المقصود صحة الأجزاء السابقة (على سبيل المثال، عندما نكون في منتصف العبادة) أم المقصود صحة العمل كله (الذي يُدرس بعد الانتهاء من العبادة)؟ إذا كنا في أثناء العمل، فالمقصود بالصحة هو صحة الأجزاء السابقة. بمعنى أننا نشك هل الأجزاء التي أديناها حتى الآن كانت صحيحة أم لا. على سبيل المثال:
• إذا شككت في منتصف الصلاة هل اختلت الموالاة (ارتباط وتتابع أجزاء الصلاة) أم لا، فهذا الشك يتعلق بالهيئة الاتصالية للصلاة.
• أو إذا شككت في منتصف الطواف أو السعي هل الأشواط التي أديتها حتى الآن كانت صحيحة أم لا، فهذا الشك يتعلق بالأجزاء السابقة.
أما إذا كان الشك بعد الانتهاء من العبادة، فلا يُطرح بعد ذلك بحث عن الأجزاء السابقة، بل السؤال هو هل العبادة كلها صحيحة أم لا. على سبيل المثال:
• صليت الصلاة كلها والآن تشك هل كان هناك مانع في هذه العبادة أم لا.
• أديت الطواف كله وتشك هل تسبب شيء في بطلان العمل كله أم لا. في هذه الحالة، يُطرح الشك في صحة العمل كله، لا في أجزائه. والآن يجب أن ندخل في البحث ونرى كيف يجري الاستصحاب في هذه الحالات وكيف يمكننا إثبات صحة العمل.
الشبهة الموضوعية
قيل في الشبهة الموضوعية إنه لا يوجد أي مانع لجريان الاستصحاب؛ سواء في الحالات التي يوجد فيها شك في تحقق المانع أو القاطع، أو في الحالات التي يُطرح فيها الشك في مانعية أو قاطعية الموجود. في هذه الحالات، تُستخدم طريقة “ضم الوجدان إلى الأصل”. وفيما يلي، سندرس هذا الموضوع بدقة أكبر. تنقسم أجزاء العمل العبادي إلى فئتين رئيسيتين:
١. الأجزاء الوجودية: الأجزاء التي يكون وجودها وتحققها شرطًا لصحة العمل العبادي.
٢. الأجزاء العدمية: الأجزاء التي يُعتبر عدم تحققها شرطًا لصحة العمل العبادي. تُطرح هذه الأجزاء عادة بصورة شروط عدمية في العبادات، مثل عدم وجود مانع أو قاطع.
نُحرز الأجزاء الوجودية عن طريق الوجدان. وهذا يعني أن وجود وتحقق هذه الأجزاء يثبت بشكل مباشر وبالعلم والمشاهدة. وتتم الأجزاء العدمية عن طريق الاستصحاب. في هذه الحالات، إذا كنا في الماضي على يقين من عدم وجود مانع، فإننا الآن أيضًا بالاستصحاب نقول إن المانع لا يزال غير موجود. وبالمثل، إذا لم يكن هناك قاطع في الماضي، نستصحب أن القاطع غير موجود الآن أيضًا.
الشبهة الحكمية
في الشبهة الحكمية، ينقسم البحث إلى موضعين:
١. صحة الأجزاء السابقة: يتعلق بالوقت الذي نكون فيه في منتصف العبادة وندرس صحة الأجزاء الماضية.
٢. صحة مجموع الأعمال: يتعلق بالوقت الذي انتهت فيه العبادة وتُقيّم صحة العمل العبادي كله. نبدأ هنا بالموضع الأول، أي صحة الأجزاء السابقة.
الموضع الأول: صحة الأجزاء السابقة
لنفترض أنك في منتصف الصلاة وتشعر بالشك فيما إذا كان هناك مانع أو قاطع يؤثر على صحة الأجزاء الماضية أم لا. السؤال هو: هل يمكننا إحراز صحة الأجزاء الماضية بالاستصحاب وإكمال بقية العبادة أم لا؟ حول جريان استصحاب صحة الأجزاء السابقة، توجد ثلاث وجهات نظر رئيسية:
القول الأول: القول بجريان استصحاب الصحة
ترى مجموعة من الفقهاء جريان استصحاب الصحة في هذه الحالات. طُرح هذا الرأي من قبل أعلام مثل الشيخ الطوسي، وابن إدريس الحلي، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي(قدسسرهم). تعتقد هذه الفئة أن استصحاب الصحة يمكن أن يكون كافيًا لإثبات صحة الأجزاء الماضية، وأن إكمال العبادة بالاعتماد عليه ممكن.[3]
القول الثاني: القول بعدم جريان استصحاب الصحة
ترى مجموعة أخرى من الأصوليين عدم جريان استصحاب الصحة في هذه الحالات. من بين هؤلاء الأعلام يمكن الإشارة إلى صاحب الفصول، والمرحوم النائيني[4] ، والمرحوم الأصفهاني، والمرحوم الخوئي(قدسسرهم)[5] . تعتقد هذه المجموعة أن استصحاب الصحة لا يجري في مثل هذه الحالات ولا يمكن استخدامه لإحراز صحة الأجزاء الماضية.
القول الثالث: القول بالتفصيل
فصّل بعض الفقهاء الآخرين بين حالات الشك في القاطعية والشك في المانعية. من بين هؤلاء الأعلام يمكن الإشارة إلى الشيخ الأنصاري(قدسسره)[6] . بناءً على وجهة النظر هذه:
• في حالات الشك في القاطعية (أي الشك فيما إذا كان شيء ما قاطعًا للعبادة أم لا)، يجري استصحاب الصحة.
• أما في حالات الشك في المانعية (أي الشك فيما إذا كان شيء ما مانعًا لصحة العبادة أم لا)، فلا يجري استصحاب الصحة. وجهة النظر هذه، التي طرحها الشيخ الأنصاري(قدسسره)، قد عززها العديد من المحققين، وهي في رأينا أيضًا أقوى الأقوال في هذه المسألة.
تقرير الشيخ الأنصاري(قدسسره) لقول عدم جريان استصحاب صحة الأجزاء السابقة
في شرح وجهة نظر القائلين بعدم جريان استصحاب الصحة، يتناول المرحوم الشيخ الأنصاري(قدسسره)، في تقرير هذا القول، المسألة بتحليل دقيق ويبيّن أن الإشكال الرئيسي يكمن في عدم ارتباط المشكلة بصحة الأجزاء السابقة. يبدأ بحثه بتبيين معنى “الصحة” ثم يصل إلى نتيجة مفادها أن استصحاب صحة الأجزاء السابقة، لعدم ارتباطه بمنشأ المشكلة، لا تأثير له في حل المسألة.
يقول سماحته:
«أمّا صحّة الأجزاء السابقة فالمراد بها إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها و إمّا ترتیب الأثر علیها.
أمّا موافقتها للأمر([7] ) المتعلّق بها فالمفروض أنّها متیقّنة، سواء فسد العمل أم لا، لأنّ فساد العمل لایوجب خروج الأجزاء المأتي بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك؛ ضرورة عدم انقلاب الشيء عمّا وجد علیه.
و أمّا ترتیب الأثر([8] )، فلیس الثابت منه للجزء من حیث إنّه جزء إلا كونه بحیث لو ضمّ إلیه الأجزاء الباقیة مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ في مقابل الجزء الفاسد و هو الذي لایلزم من ضمّ باقي الأجزاء و الشرائط إلیه وجود الكلّ.
و من المعلوم أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائماً، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقیة أم قطع بعدمه، أم شك في ذلك فإذا شك في حصول الفساد من غیر جهة تلك الأجزاء فالقطع ببقاء صحّة تلك الأجزاء لاینفع في تحقّق الكلّ مع وصف هذا الشك فضلاً عن استصحاب الصحّة.
مع ما عرفت من أنّه لیس الشك في بقاء صحّة تلك الأجزاء بأي معنی اعتبر من معاني الصحّة»[9] .
يشير المرحوم الشيخ الأنصاري(قدسسره) إلى أن الصحة يمكن تفسيرها بأحد المعنيين التاليين:
١. الموافقة لأمر الشارع: العمل الصحيح يعني أنه أُدي وفقًا لأمر الشارع.
٢. ترتب الأثر الشرعي: العمل الصحيح يترتب عليه أثر شرعي؛ بمعنى أنه في حال انضمام بقية الأجزاء والشروط، يكتمل العمل العبادي ويترتب عليه الأثر.
يدرس الشيخ(قدسسره) في تقرير قول القائلين بعدم جريان استصحاب الصحة، المسألة في حالتين:
١. إذا كانت الصحة بمعنى الموافقة لأمر الشارع: في هذه الحالة، تكون الأجزاء السابقة التي أُديت حتى الآن موافقة لأمر الشارع وهذه الموافقة قطعية. بتعبير المرحوم الشيخ الأنصاري(قدسسره): «ضرورة عدم انقلاب الشیء عمّا وُجد علیه» أي أن الشيء لا يتغير عما تحقق عليه.
وعليه، فإن الأجزاء السابقة التي أُديت وفقًا لأمر الشارع تبقى موافقة للأمر. الشبهة الموجودة هنا تتعلق باحتمال وجود مانع أو قاطع، لا بصحة الأجزاء السابقة. لذا، في هذه الحالة، يوجد يقين بصحة الأجزاء السابقة وينتفي استصحاب الصحة موضوعًا، لأن الاستصحاب يجري حيث يوجد شك في البقاء، بينما هنا لدينا يقين بصحة الأجزاء السابقة.
٢. إذا كانت الصحة بمعنى ترتب الأثر: في هذه الحالة أيضًا، تتمتع الأجزاء السابقة، كأجزاء صحيحة، بالقدرة على إكمال العمل العبادي إذا انضمت إليها بقية الأجزاء والشروط. وعليه، فإن ترتب الأثر على الأجزاء السابقة محفوظ ولا توجد مشكلة من هذه الناحية. بتعبير الشيخ(قدسسره): «إذا انضمت إليها بقية الأجزاء والشروط، يتشكل الكل». وعليه، فإن شكنا ليس في صحة الأجزاء السابقة، بل في وجود مانع أو قاطع قد يمنع من تحقق العمل العبادي الصحيح بشكل كلي.
سبب عدم جريان استصحاب الصحة
يقول الشيخ الأنصاري(قدسسره) في شرح سبب عدم جريان استصحاب الصحة: «فالقطع ببقاء صحة تلك الاجزاء لاینفع في تحقق الکل، مع وصف هذا الشك.» بمعنى أنه حتى لو كان لدينا قطع بصحة الأجزاء السابقة، فإن هذا القطع لا تأثير له في تحقق العمل العبادي كله، لأن المشكلة الرئيسية ليست من ناحية الأجزاء السابقة، بل من ناحية الشك في وجود مانع أو قاطع. وعليه، فلن يكون لاستصحاب الصحة فائدة أيضًا، لأن حتى اليقين بصحة الأجزاء السابقة لا يمكنه حل المشكلة. يقول سماحته: «الشك في وجود مانع أو قاطع لا يضر بصحة الأجزاء السابقة، لأن صحة الأجزاء السابقة باقية كصحة تأهلية وهذه الصحة قطعية.» وبعبارة أخرى، أُديت الأجزاء السابقة بشكل صحيح وصحتها التأهلية محفوظة، ولكن شكنا يكمن في هل يوجد مانع يمنع من تحقق العمل كله أم لا.
تقرير المرحوم الخوئي(قدسسره)
على الرغم من أن المرحوم الخوئي(قدسسره) يرى عدم جريان استصحاب صحة الأجزاء السابقة، إلا أنه قدم تقريرًا جميلاً ودقيقًا للاستصحاب يسمى الاستصحاب التعليقي. ورغم أنه هو نفسه لا يقبل هذا النوع من الاستصحاب، إلا أن تقريره جدير بالاهتمام. الاستصحاب التعليقي يعني أن «كان الأمر سابقًا بحيث لو انضمت بقية الأجزاء لكان ذا أثر؛ والآن أيضًا نقول لو انضمت بقية الأجزاء فسيكون ذا أثر».
يقول سماحته:
١. الأجزاء السابقة (مثلاً الأجزاء الخمسة الأولى من الصلاة) التي أديتها حتى الآن، لا شك في صحتها ولها تأهل للتأثير.
٢. لو انضمت في الماضي بقية الأجزاء (الأجزاء الخمسة المتبقية) إلى هذه الأجزاء ولم يكن هناك مانع أو قاطع، لحصل امتثال أمر الشارع.
٣. الآن نستصحب ذلك نفسه: أي نقول لو انضمت بقية الأجزاء ولم يتحقق مانع، فالعمل صحيح ويتحقق الامتثال. حتى قبل الشك في المانع وظهور المانع كان هذا الوضع موجودًا؛ أي قبل حدوث المانع، لو انضمت بقية الأجزاء، لكان العمل ذا أثر. والآن نقول أيضًا لو انضمت الأجزاء ولم يتحقق المانع، فسيظل العمل ذا أثر.
على الرغم من هذا التقرير، لا يقبل المرحوم الخوئي(قدسسره) الاستصحاب التعليقي ويقول: إن الاستصحاب يجري حيث يكون الحكم أو الموضوع موجودًا في الماضي بشكل فعلي ومتحقق. أما في الاستصحاب التعليقي، فالموضوع (انضمام بقية الأجزاء) كان موجودًا في الماضي بشكل فرضي فقط، لا فعلي. وعليه، فإن الاستصحاب لا يجري أساسًا في مثل هذه الحالات.[10]
تفصيل الشيخ الأنصاري(قدسسره)[11]
فصّل المرحوم الشيخ الأنصاري(قدسسره) في بحث الشك في المانع والشك في القاطع.
يقول سماحته:
• «إنّه قد یكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع و هذا هو الذي لایعتنی في نفیه باستصحاب الصحّة؛ لما عرفت من أنّ فقد بعض ما یعتبر من الأمور اللاحقة لایقدح في صحّة الأجزاء السابقة.
• و قد یكون من جهة عروض ما ینقطع معه الهیأة الاتصالیة المعتبرة في الصلاة، فإنّا استكشفنا من تعبیر الشارع عن بعض ما یعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع أنّ للصلاة هیأة اتصالیة ینافیها توسّط بعض الأشیاء في خلال أجزائها الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابلیة الانضمام و الأجزاء السابقة عن قابلیة الانضمام إلیها فإذا شك في شيء من ذلك وجوداً أو صفةً جری استصحاب صحّة الأجزاء بمعنی بقائها على القابلیة المذكورة فیتفرّع على ذلك عدم وجوب استینافها أو استصحاب الاتّصال الملحوظ بین الأجزاء السابقة و ما یلحقها من الأجزاء الباقیة فیتفرّع علیه بقاء الأمر بالإتمام.
• و هذا الكلام و إن كان قابلاً للنقض و الإبرام إلا أنّ الأظهر بحسب المسامحة العرفیة في كثیر من الاستصحابات جریان الاستصحاب في المقام»[12] .
• في الشك في المانع: لا يجري الاستصحاب.
• في الشك في القاطع: يجري الاستصحاب.
لتوضيح هذا التفصيل، يجب أولاً شرح الفرق بين المانع والقاطع.
الفرق بين المانع والقاطع
• المانع: المانع هو شيء اعتبر الشارع عدمه كشرط أو قيد في العبادة؛ بمعنى أن وجوده يُسقط العبادة من الاعتبار. على سبيل المثال، إذا قال الشارع إن «الشيء الفلاني لا يجب أن يكون أثناء الصلاة»، فإن وجود ذلك الشيء يوجب بطلان العبادة. هنا، شكنا يتعلق بما إذا كان الشارع قد جعل شيئًا مانعًا أم لا.
• القاطع: القاطع هو شيء يخل بالهيئة الاتصالية بين أجزاء العبادة؛ بمعنى أن الأجزاء السابقة واللاحقة لم تعد تستطيع تشكيل عمل واحد. على سبيل المثال، في الطواف أو الصلاة، إذا حدث فاصل طويل (مثلاً تأمل لمدة عشر دقائق في منتصف الطواف أو الصلاة)، فقد يقطع هذا الفاصل الهيئة الاتصالية ويوجب بطلان العبادة.
يقول الشيخ الأنصاري(قدسسره): إذا كان شكنا في وجود مانع شرعي أم لا، فلا فائدة من استصحاب صحة الأجزاء السابقة. والسبب هو أن احتمال وجود المانع يتعلق بأمر اعتبره الشارع كشرط أو قيد في العبادة، وحتى لو كان لدينا يقين بصحة الأجزاء السابقة، فإن هذا اليقين لا يمكنه نفي المانع الشرعي. بتعبيره: «فقدان ما هو معتبر من الأمور اللاحقة لا يضر بصحة الأجزاء السابقة، ولكن العبادة لن تكون صحيحة مع ذلك بسبب احتمال وجود المانع.» وعليه، لا يجري استصحاب صحة الأجزاء السابقة هنا؛ لأنه حتى لو استصحبنا صحة الأجزاء السابقة، تبقى مشكلة الشك في وجود المانع قائمة.
يرى الشيخ الأنصاري(قدسسره) رأيًا مختلفًا بشأن الشك في القاطع. يقول سماحته: القاطع هو شيء يخل بالهيئة الاتصالية بين الأجزاء السابقة واللاحقة؛ مثل التوقف الطويل أو الفاصل الكبير بين الأجزاء. إذا كان شكنا في وقوع القاطعية أم لا، يجري الاستصحاب. هناك طريقتان لحل هذه المشكلة:
الطريقة الأولى: استصحاب صحة الأجزاء السابقة
في هذه الحالة، يعني الاستصحاب أن الأجزاء السابقة لا تزال لديها قابلية الانضمام مع الأجزاء اللاحقة. بتعبير الشيخ(قدسسره): «نجري استصحاب صحة الأجزاء السابقة ونقول إن هذه الأجزاء لا تزال لديها قابلية الانضمام مع الأجزاء اللاحقة، فلا يلزم إعادة العبادة من البداية». مثال: في الطواف، إذا توقفت بعد أداء ثلاثة أشواط لفترة طويلة (مثلاً ١٥ دقيقة) وشككت هل أخل هذا التوقف بالهيئة الاتصالية أم لا، يقول الاستصحاب إن الأجزاء السابقة (الأشواط المنجزة) لا تزال صحيحة ولها قابلية الانضمام. بمعنى أنه يمكنك إكمال الأشواط المتبقية ولا حاجة لبدء الطواف من جديد.
الطريقة الثانية: استصحاب الاتصال أو الموالاة
في هذه الحالة، نستصحب الاتصال أو الموالاة نفسها بدلاً من استصحاب صحة الأجزاء. أي: «كان الاتصال والموالاة بين الأجزاء موجودين سابقًا؛ والآن نشك هل زال هذا الاتصال أم لا، فنستصحب أن الاتصال لا يزال قائمًا». مثال: في الصلاة، إذا توقفت بعد ركعتين لفترة طويلة (مثلاً ١٠ دقائق) وشككت هل أوجب هذا التوقف قطع الاتصال أم لا، يقول الاستصحاب إن الاتصال قائم والصلاة صحيحة.
ثلاث مناقشات على هذا التفصيل
المناقشة الأولى: رأي المرحوم النائيني والمرحوم الخوئي(قدسسرهما)
المرحوم النائيني والخوئي(قدسسرهما) من بين الذين ناقشوا قول الشيخ الأنصاري(قدسسره). يمكن تلخيص هذه المناقشة في عدة نقاط أساسية:
١. عدم وجود فرق بين المانع والقاطع
يقول المرحوم النائيني(قدسسره):
«إنّه لمیظهر لنا بَعدُ أنّ اعتبار المانعیة یغایر اعتبار القاطعیة، بل الظاهر من الأدلّة هو اعتبار نفس الأعدام في الصلاة مطلقاً من جهة مانعیة الوجودات. غایة الأمر أنّ بعض الأعدام معتبر في خصوص الأفعال و الأذكار، و بعضها معتبر فیها مطلقاً و لو في حال السكنات و عدم الاشتغال بشيء منها. و مجرّد تسمیة القسم الثاني بالقاطع لایكشف عن اعتبار الهیأة الاتصالیة حتّی لایكون العدم معتبراً إلا من جهة الإخلال بها»[13] .
يعتقد سماحته أن الشارع اعتبر نفس الأعدام (عدم وجود بعض الأمور) في العبادات. تظهر هذه الأعدام أحيانًا في صورة مانعية (أي لا يجب وجود شيء ما)، وأحيانًا في صورة قاطعية (أي لا يجب أن تختل الهيئة الاتصالية). ولكن حسب رأيه، لا يوجد أي فرق جوهري بين المانع والقاطع؛ لأن كلاهما يعود بطريقة ما إلى الإخلال بالعبادة.
٢. تقسيم الأعدام إلى فئتين
يقسم المرحوم النائيني(قدسسره) الأعدام إلى فئتين:
• أعدام تتعلق بالأفعال والأذكار: مثل أنه لا يجوز أثناء الصلاة القيام بعمل مثل الأكل أو التحدث.
• أعدام مطلقة: أي حالة يجب مراعاتها حتى في السكون وعدم الانشغال بشيء؛ مثل الموالاة في الصلاة أو الطواف.
ويؤكد أن القسم الثاني (الأعدام المطلقة المتعلقة بالهيئة الاتصالية) نسميه «قاطعًا»، ولكن هذه التسمية لا تبرر فصله جوهريًا عن المانع. وبعبارة أخرى، القاطعية مجرد اسم، واعتبار الهيئة الاتصالية هو أيضًا بحيث لو اختلت هذه الهيئة، فإنها تؤدي نفس دور المانع.
٣. عدم الكشف عن فرق من الأدلة الشرعية
يقول المرحوم النائيني(قدسسره) إنه لا يمكن الكشف عن مثل هذا الفرق من الأدلة الشرعية بحيث يكون المانع والقاطع شيئين منفصلين لهما آثار مختلفة. حسب رأيه، اعتبر الشارع الأعدام بشكل عام، سواء كانت في صورة مانعية أو قاطعية، وهذان لا يختلفان اختلافًا أساسيًا.
باختصار، يعتقد المرحوم النائيني(قدسسره) أن:
• المانع والقاطع لا يختلفان: كلاهما يعتبر عدم وجود شيء ما في العبادة.
• تسمية القاطع لا تخلق فرقًا جوهريًا: مجرد ارتباط القاطع بالهيئة الاتصالية لا يجعله منفصلاً عن المانع.
• الهيئة الاتصالية هي أيضًا جزء من اعتبار الشارع: وعليه، فإن أي إخلال بالهيئة الاتصالية يضر باعتبار العبادة تمامًا مثل وجود المانع.
للمرحوم الخوئي(قدسسره) أيضًا توضيحات في هذه المناقشة سيتم تناولها في الجلسة التالية نظرًا لتفصيلها وأهميتها.


