46/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات الاستصحاب؛ التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
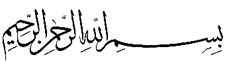
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تنبیهات الاستصحاب؛ التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره
المطلب الأوّل: في تقدّم أحد الحادثين على الآخر إذا كان الموضوع مركّباً
وصل بحثنا إلى المطلب الأول من التنبيه المتعلق بالشك في تقدم وتأخر الحادث. بينا سابقًا أن هذا البحث يشمل قسمين:
١. حيث يكون كلا الموضوعين مجهولي التاريخ.
٢. حيث يكون أحد الموضوعين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ. سنتناول القسم الثاني إن شاء الله. حاليًا، يدور بحثنا حول الحالة الأولى، أي عندما يكون كلا الموضوعين مجهولي التاريخ.
ينقسم بحثنا إلى قسمين رئيسيين، ينقسم كل منهما إلى أربعة أقسام. توضيحه التمهيدي كالتالي:
إذا كان الموضوع مجهول التاريخ:
• الأثر المترتب على الوجود:
◦ بمفاد “كان التامة”.
◦ بمفاد “كان الناقصة”.
• الأثر المترتب على العدم:
◦ بمفاد “ليس التامة”.
◦ بمفاد “ليس الناقصة”.
هذا التقسيم يصدق أيضًا في كلتا حالتي “معلوم التاريخ” و"مجهول التاريخ". وعليه، عندما يكون أحد الموضوعين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، قد يكون الأثر على إحدى الصور التالية:
إذا كان أحد الموضوعين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ:
• الأثر المترتب على الوجود:
◦ بمفاد “كان التامة”.
◦ بمفاد “كان الناقصة”.
• الأثر المترتب على العدم:
◦ بمفاد “ليس التامة”.
◦ بمفاد “ليس الناقصة”.
ونتيجة لذلك، لدينا في المجموع ثمانية أقسام رئيسية. أقسام هذا البحث أكثر بكثير مما تبدو عليه في البداية. فإذا أردنا طرح التقسيمات بشكل أدق، ستنشأ أقسام كثيرة جدًا، وإذا أردنا ترقيم جميع الأقسام بالكامل، فقد نصل حتى إلى القسم الرابع والعشرين، مما يسبب الارتباك. لهذا السبب، نتقدم بهذا الترتيب وبشكل طبيعي وقد قسمناه إلى قسمين، لكل منهما أربع صور.
لذا يجب أن ننتبه إلى أنه على الرغم من وجود أقسام كثيرة، فإن جميع هذه الأقسام تنقسم إلى أربع فئات عامة:
• أربعة أقسام في حالة “مجهولي التاريخ”.
• أربعة أقسام في حالة كون أحد الطرفين “معلوم التاريخ” والآخر “مجهول التاريخ”.
يجب أن نلاحظ أن هذا البحث ليس معقدًا إلى هذا الحد، والتركيز الأكبر هو على الفروق بين مفاد كان التامة وكان الناقصة، وكذلك الفروق بين ليس التامة وليس الناقصة. يجب الاهتمام بهذه المسائل بدقة.
من وجهة نظر المرحوم الأصفهاني(قدسسره)، يجب الانتباه بشكل خاص إلى أن مفاد استصحاب ليس التامة لا يمكنه إثبات ليس الناقصة. وكذلك في الحالات التي يدور فيها الحديث عن استصحاب العدم الأزلي، يجب أن ننتبه إلى أن هذا الاستصحاب لا يثبت ليس الناقصة بأي حال من الأحوال. ففي معظم الحالات، كان استصحابنا إما ذا مفاد كان التامة، أو ذا مفاد ليس التامة.
إذن يجب الانتباه إلى عدم الخلط بين هذه المفاهيم، لأن لكل منها تأثيراته الخاصة ولا ينبغي استخدامها بدلاً من بعضها البعض بشكل غير صحيح في بحث الاستصحاب.
ولكن طُرح استصحاب آخر يعارضه البعض، وهو استصحاب العدم الأزلي. بعض الأعلام مثل المحقق الخوئي وصاحب الكفاية(قدسسرهما) يقبلون هذا النوع من الاستصحاب، ونحن أيضًا نؤمن بصحته. استصحاب العدم الأزلي يثبت ليس الناقصة نفسها.
الآن، عندما تثبت ليس الناقصة، فإذا كان موضوع الدليل هو ليس الناقصة، ففي هذه الحالة تتحقق النتيجة المرجوة، فبها ونعمت. أما إذا كان المفاد كان الناقصة، فستنعكس الحالة هنا، ونقول إن الأمر يسير بشكل عكسي. والآن يجب أن نرى ما هي النتيجة التي ستتحقق من هذا البحث لاحقًا.
البحث الأول: مجهولا التاريخ
بحثنا الأول يدور حول مجهولي التاريخ، وهو يشمل أربعة أقسام.
القسم الأول: الأثر المترتب على الوجود بمفاد كان التامة
القسم الأول هو عندما يكون الأثر مترتبًا على الوجود ويتعلق هذا الأثر بمفاد كان التامة؛ مثلاً في مسألة الإرث الذي يترتب على تقدم موت المورث على موت الوارث. بمعنى أنه لكي يتمكن الوارث من الإرث، يجب أن يموت المورث (مثل الأب، العم، الجد، أو أي شخص آخر) قبل الوارث؛ لأن تقدم أحدهما على الآخر شرط لتحقق الأثر.
في حال لم يتحقق تقدم المورث على الوارث ولم يمت المورث قبل الوارث، فلن يتعلق الإرث بالوارث. هذا المثال يوضح الأثر المترتب على الوجود الذي يتعلق بمفاد كان التامة.
بحث تقدم وتأخر الحادثات
في القسم الأول نفسه، تُتصور أربع صور:
أن يترتب الأثر على تقدم الحادث الأول بالنسبة للحادث الثاني، ولا يترتب أي أثر على تقدم الحادث الثاني على الأول، ولا يكون لتأخر الحادث الأول عن الثاني أثر أيضًا.
على سبيل المثال، يترتب الأثر على تقدم الحادث الأول بالنسبة للحادث الثاني؛ هنا، يمكن أن يكون الحادث الأول موت الأب والأثر مترتب على تقدمه على موت الابن. يجب أن يتوفى الأب ثم الابن، حتى يتحقق الإرث للابن. أما إذا وقع تقدم الحادث الثاني (أي موت الابن) على الحادث الأول (موت الأب)، ففي فرض أن الابن لا يملك مالاً، لا يكون هناك أثر. وبعبارة أخرى، إذا مات الابن قبل الأب، فلن ينشأ أي أثر حقوقي مثل الإرث للابن؛ في هذه الحالة، لا يرث الابن.
أن يترتب الأثر على تقدم الحادث الأول على الثاني، ويترتب أثر على تأخره أيضًا، ولكن لا يكون لتقدم أو تأخر الحادث الثاني على الأول أي أثر.
في هذه الصورة، قد يكون لتأخر الحادث الأول عن الثاني أثر أيضًا. وبعبارة أخرى، إذا لم يكن الحادث الأول متأخرًا عن الثاني أو كان متأخرًا، ففي كلتا الحالتين سيترتب الأثر. من المهم أن الأثر يترتب في كلتا الحالتين، أي سواء عندما يكون الحادث الأول متأخرًا أو عندما لا يكون متأخرًا. أؤكد على هذا المطلب مرة أخرى ليرسخ في أذهانكم تمامًا.
أن يترتب الأثر على تقدم كل من الحادث الأول والثاني دون وجود علم إجمالي بتقدم أحدهما على الآخر.
أن يترتب الأثر على تقدم كل من الحادثين على الآخر مع وجود علم إجمالي بتقدم أحدهما على الآخر.
دراسة آثار تأخر الحادث الأول بالنسبة للحادث الثاني
قيل إنه في بعض الأحيان قد يكون لتأخر الحادث الأول بالنسبة للحادث الثاني أثر، وفي أحيان أخرى لا يكون له أثر. بحيث إذا مات الأب بعد الابن، ففي بعض الأحيان سيترتب الأثر وفي أحيان أخرى لا. على سبيل المثال، إذا كان للابن مال ومات بعده الأب، فإن الأب يرث. ولكن في حالات أخرى، حتى في هذا الفرض، لن يكون هناك أثر. هنا، يتم أخذ هذين الفرضين في الاعتبار. من المهم ملاحظة أنه في بحثنا، لتقدم الحادث الأول على الحادث الثاني أثر بمفرده، أما تقدم الحادث الثاني على الحادث الأول فلن يكون له أثر.
الفرض التالي: الأثر المترتب على تقدم كلا الحادثين
أما الفرض التالي فهو أن يترتب الأثر على تقدم كلا الحادثين، أي سواء مات الأب أولاً أو مات الابن أولاً، ففي كلتا الحالتين سيكون هناك أثر. على سبيل المثال، إذا مات الابن أولاً، يرث الأب، وإذا مات الأب أولاً، يرث الابن. هذه الحالة تظهر أنه في كلتا الصورتين، سيترتب الأثر، أي أن كلا الحادثين له أثره الخاص.
دراسة العلم الإجمالي في تقدم الحوادث
الآن بعد أن قلنا إن لتقدم كلا الحادثين أثر، يجب أن نشير إلى أننا في بعض الأحيان لدينا علم إجمالي بأن أحدهما متقدم على الآخر. في هذه الحالة، يوجد علم إجمالي بأن إحدى الحوادث متقدمة على الأخرى. ولكن في بعض الحالات، ليس لدينا علم إجمالي ولا يمكننا تحديد أي الحادثين متقدم؛ قد تكون الحادثتان متقارنتين. هذه الحالة أيضًا تجلب معها مسألة جديدة ومحفوفة بالتحديات.
إذن في النهاية، لدينا أحيانًا علم إجمالي بأن إحدى الحوادث متقدمة، وأحيانًا لا نملك مثل هذا العلم ويوجد احتمال تقارن الحوادث. والآن يجب أن ندخل في الصور المختلفة وندرس حكم هذه الصور الأربع.[1]
الصورة الأولى: الأثر المترتب على تقدم الحادث الأول على الحادث الثاني
يترتب الأثر فقط على تقدم الحادث الأول، وهو موت الأب. إذا حدث موت الأب قبل موت الابن، يصل الإرث إلى الابن. أما إذا كان موت الابن قبل موت الأب - بسبب أن الابن مفلس - فلا أثر ولا فائدة له.
لهذا المطلب، ضُرب مثال: لتقدم موت المورث على موت الوارث أثر دائمًا. بينما إذا مات الوارث قبل المورث، فلن يكون هناك أي أثر. افترض أن وارثك ابن لا يملك مالاً. إذا مات قبل المورث (الأب)، لا يتحقق الإرث. هنا، لا أثر لتأخر موت الوارث.
إذا شككنا في تقدم أو تأخر موت المورث والوارث، فالأصل عدم التقدم. أي إذا لم يكن تقدم موت المورث على موت الوارث محرزًا سابقًا، فيجب أن نقول الآن أيضًا إنه لا يوجد مثل هذا التقدم، ونتيجة لذلك، لا ينتقل الإرث. هذا الأصل مبني على “استصحاب العدم”.
لماذا التقدم هو موضوع البحث ولم يُطرح فرض التأخر؟
هنا حيث قيل إن التقدم لا أثر له، ذُكر هذا المطلب بهدف منع التعارض بين الأصول المختلفة. بحيث إن تقدم موت المورث على موت الوارث هو موضوع الإرث، وبالتالي فإن تقدم المورث على الوارث فقط له أثر شرعي، وليس العكس. في هذه الحالة، يجري أصل عدم تقدم موت المورث على موت الوارث وينتفي موضوع الإرث.
إذا كان للتأخر أثر شرعي، يجري الاستصحاب فيه. لهذا السبب، لم يُقل إن للتأخر أثرًا شرعيًا ولم يُطرح هذا الفرض بشكل مباشر. لأنه لو كان للتأخر أثر شرعي، لكان من الممكن أن يجري أصل عدم التأخر أيضًا إلى جانب أصل عدم التقدم، ونتيجة لذلك، يقع التعارض. ولكن بما أنه قيل إن للتأخر أثرًا شرعيًا، فإن الاستصحاب في هذه الحالة سيكون أصلاً مثبتًا.
وعليه، لمنع هذا التعارض والتعقيد، قيل إن لتأخر موت المورث على موت الوارث لا أثر شرعيًا، وفقط تقدم موت المورث على موت الوارث هو الذي له أثر، وبهذه الطريقة تُحل المسألة ببساطة.
الصورة الثانية: الأثر المترتب على تقدم وتأخر الحادث الأول بالنسبة للحادث الثاني
في الصورة الثانية، يترتب الأثر على كل من تقدم الحادث الأول على الحادث الثاني وتأخره عنه، ولكن لا يوجد أي أثر على تقدم أو تأخر الحادث الثاني بالنسبة للحادث الأول. وبعبارة أخرى، الحادث الثاني، سواء كان متقدمًا أم متأخرًا، لا تأثير له. فقط تقدم وتأخر الحادث الأول هو المؤثر.
هنا، يُطرح استصحابان:
١. استصحاب عدم تقدم الحادث الأول على الحادث الثاني.
٢. استصحاب عدم تأخر الحادث الأول بالنسبة للحادث الثاني.
بما أن تأخر الحادث الأول هو أيضًا موضوع للأثر ولم يكن موجودًا سابقًا، يجري استصحاب عدم التأخر أيضًا. في هذه الحالة، يتعارض الاستصحابان (عدم التقدم وعدم التأخر) معًا. هذا التعارض يسبب تساقط (إبطال متقابل) الاستصحابين، وفي النهاية، يعود المرجع لحل المسألة إلى «البراءة» (أصل عدم المسؤولية أو عدم الإثبات). هذه وجهة النظر المشار إليها في النص.
الجواب على تعارض الاستصحابين في الصورة الثانية[2]
النقطة التي يجب الانتباه إليها هي أنه لا يوجد تعارض بين الاستصحابين. وسبب ذلك هو أننا نحتمل أن صحة التعبد بكليهما موجودة بحسب الواقع؛ فلا تقدم لدينا ولا تأخر. لأنه من الممكن أن تكون الحوادث متقارنة وليس من الضروري أن يكون هناك دائمًا تقدم وتأخر، بل من الممكن أن تقع كلتا الحادثتين في وقت واحد.
إذا كان هناك تقارن بينهما، تتعقد هذه المسألة. أما إذا لم يُحتمل التقارن، كما قلنا في موضع حيث لدينا علم إجمالي بأن إحدى الحوادث متقدمة على الأخرى والأخرى متأخرة، فهناك يحدث التعارض والتساقط ويكون مرجعنا إلى الأصل العملي غير الاستصحاب، لأن الاستصحابين قد تعارضا وفي هذه الحالة نلجأ إلى البراءة.
أما إذا لم يكن لدينا علم إجمالي بأن إحدى الحوادث متقدمة على الأخرى، ففي هذه الحالة يجري كل من أصل عدم التقدم وأصل عدم التأخر في وقت واحد. ونتيجة ذلك هي أننا نأخذ احتمال التقارن في الاعتبار، ولكن هذا لا يعني إثبات التقارن، لأن هذه الحالة تصبح أصلاً مثبتًا. هنا لا يثبت التقدم ولا التأخر؛ ونتيجة لذلك لا يجري حكم أي منهما.
الصورة الثالثة: الأثر المترتب على تقدم أحدهما على الآخر
في الصورة الثالثة، يترتب الأثر على تقدم إحدى الحادثتين على الأخرى([3] )، مثل ابن غني. إذا مات الابن، يرث الأب. في هذه الحالة، ليس لدينا علم إجمالي بتقدم الحادث الأول أو الحادث الثاني. في هذه الصورة، يجري استصحاب عدم تقدم الحادث الأول على الحادث الثاني واستصحاب عدم تقدم الحادث الثاني على الحادث الأول.
النتيجة التي نصل إليها هي أن كلا الاستصحابين يجريان، ولكن لا يحدث تعارض هنا. لأن احتمال المقارنة بين الحادثتين موجود، وفي هذه الحالة لا يجري حكم التقدم أو التأخر لأي منهما. وعليه، بناءً على الاستصحاب، لا يرث أي من الحادثين من الآخر.
الصورة الرابعة: الأثر المترتب على تقدم كل من الحادثين مع علم إجمالي بتقدم أحدهما
في الصورة الرابعة، يترتب الأثر على تقدم كل من الحادثين، ولكن هنا لدينا علم إجمالي بوقوع تقدم إحدى الحادثتين. بمعنى أننا نعلم أن إحدى الحادثتين متقدمة، ولكن لا نعلم أيتهما بالضبط.
في هذه الصورة، لا يمكننا أن نتعبد بكلا الاستصحابين، لأن لدينا علم إجمالي بأن أحد الاستصحابين غير صحيح. وعليه، لا يمكننا أن نجري استصحاب عدم تقدم الحادث الأول واستصحاب عدم تقدم الحادث الثاني معًا. ونتيجة لذلك، لا يترتب أثر أي من هذين الاستصحابين على تقدم أي من الحادثين.
في هذا الوضع، لا الابن يرث من الأب ولا الأب من الابن، لأن كل منهما يريد التقدم. بينما كلاهما غني وهذه الأموال تبقى، ولكن لا يرث أحدهما من الآخر ولا الآخر يرث منه.
في هذه الصورة، لدينا علم إجمالي بأن إحدى الحادثتين متقدمة، ولكن لا نعلم أيتهما. وعليه، لا يوجد احتمال تقارن، لأننا نعلم أن إحدى الحادثتين قد سبقت. في هذا الفرض، لا يمكننا التعبد بكلا الاستصحابين.
إذا كان في الصورة السابقة، استصحاب عدم تقدم كل من الحادثين ممكنًا وكنا نحتمل التقارن، فهنا مع العلم الإجمالي الذي لدينا بتقدم إحدى الحادثتين، يتعارض الاستصحاب في كلا الطرفين. بمعنى أنه لا يمكننا أن نجري استصحاب عدم تقدم الحادث الأول على الحادث الثاني واستصحاب عدم تقدم الحادث الثاني على الحادث الأول معًا، لأن التعارض بين هذين الاستصحابين يؤدي إلى مخالفة قطعية. ونتيجة لذلك، لا يمكننا القول بأن الأب لا يرث من الابن والابن لا يرث من الأب معًا.
هنا بما أن لدينا علمًا إجماليًا بأن أحد الاستصحابين خطأ، فإن جريان الاستصحاب في كلا الطرفين ممنوع. هذا يعني أنه لا يمكننا إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين.
في هذه الصورة، رأي الأصحاب هو أن جريان الأصل في أحد هذين الطرفين ممنوع، لأن الترجيح بلا مرجح غير جائز. وعليه، يكون المرجع إلى أصل عملي آخر غير الاستصحاب. وبعبارة أخرى، في هذه الحالة لا يجري الاستصحاب وننتقل إلى أصل عملي آخر.
في النهاية، الصورتان الثالثة والرابعة متشابهتان، والفرق الوحيد بينهما هو وجود العلم الإجمالي. في الصورة الثالثة، لم يكن لدينا علم إجمالي وكنا نحتمل التقارن، بينما في الصورة الرابعة مع العلم الإجمالي، لا نحتمل التقارن وأحد الاستصحابين خطأ. ونتيجة لذلك، لا يمكننا الالتزام بكلا الاستصحابين.
بحث العلم الإجمالي وإمكانية جريان الاستصحاب في أحد الطرفين
في المجلد السادس[4] من بحث العلم الإجمالي، طرحنا نقطة مهمة نشير إليها هنا أيضًا. قلنا في ذلك البحث إن المخالفة القطعية غير جائزة، لكن الموافقة القطعية ليست ضرورية في بعض الحالات. حيثما لدينا علم إجمالي بأن أحد الاحتمالين صحيح، لا يمكننا القول بأن كليهما خطأ وننتقل إلى أصل عملي آخر. بل يجب أن نقبل إحدى هاتين الحجتين ونقوم بالموافقة الاحتمالية.
طُرحت هذه النقطة في بحوث مختلفة، بما في ذلك في مباحث النجاسات والطهارات. هناك أيضًا قلنا إن الموافقة القطعية ليست ضرورية في بعض الحالات ولا ينبغي أن نكلف أنفسنا عناءً. هنا أيضًا عندما يكون لدينا علم إجمالي بأن أحد الاستصحابين صحيح، لا يمكننا أن نضعهما جانبًا وننتقل إلى أصل عملي آخر. لأن إحدى هاتين الحجتين قد تكون صحيحة، وبقبول إحداهما باحتمال 50% يمكننا الوصول إلى نتيجة.
وعليه، في هذه الحالات يجب الاعتماد على أحد الاستصحابين بدلاً من ترك الاستصحاب والرجوع إلى أصل عملي آخر. في الواقع، المخالفة القطعية غير مقبولة، لكن الموافقة الاحتمالية يمكن أن تكون مناسبة في هذه الحالات.[5]
القسم الثاني: الأثر المترتب على الوجود بمفاد كان الناقصة
ننتقل هنا إلى القسم الثاني حيث يكون الأثر مترتبًا على الوجود بمفاد كان الناقصة. لمفاد كان الناقصة هذا أهمية كبيرة. ومثاله في موضوع الإرث حيث يُنظر إلى موضوع الإرث في ارتباط موت المورث بموت الوارث، لا كأمرين مستقلين. مفاد كان الناقصة هو أن “الوارث يرث من المورث في حالة كون موت المورث قبل موت الوارث”، حيث يُعتبر هنا وجود رابطي بين الحادثين.
يوجد هنا اختلاف في الرأي بين العلماء. فقد أكد صاحب الكفاية(قدسسره) على عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم. وفي المقابل، يرى بعض المحققين مثل المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما) جريان الاستصحاب في هذه الحالة. وفيما يلي، يجب أن ندرس ما إذا كنا سنقبل رأي السيد صاحب الكفاية(قدسسره) أم رأي المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما).


