46/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه التاسع: اعتبار المستصحب حكماً شرعیاً أو موضوعاً له بقاءً/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
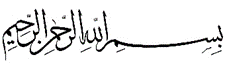
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه التاسع: اعتبار المستصحب حكماً شرعیاً أو موضوعاً له بقاءً
التنبیه التاسع: اعتبار المستصحب حكماً شرعیاً أو موضوعاً له بقاءً
تمهيد وعرض البحث
بحمد الله ومنّه، بعد أن طوينا المراحل الأساسية والجذرية في بحث الاستصحاب، نصل الآن إلى تنبيهات هذا الباب. والتنبيهات، كما يدلّ عليه اسمها، تتناول دقائق ونكات وحالات خاصة، يتوقف عليها الفهم الأعمق للاستصحاب وكيفية تطبيقه. ويبدأ بحثنا بالتنبيه التاسع الذي خُصّص لأحد الشروط الأساسية في «المستصحَب».
إن القاعدة المشهورة والمسلّمة بين الأصوليين هي أن «المستصحَب» (أي ذلك الأمر الذي كان متيقناً سابقاً وصار مشكوك البقاء الآن) لا بد أن يكون إما حكماً مجعولاً شرعياً بنفسه، أو موضوعاً لحكم شرعي. وبعبارة أخرى، لا بد أن يكون المستصحَب إما «أثراً شرعياً» بنفسه، أو «ذا أثرٍ شرعي»، ليكون جريان الاستصحاب فيه معقولاً ومفيداً ومجدياً.[1]
والسؤال المحوري ومحل النزاع في هذا التنبيه هو: في أي مرحلة زمنية يجب أن يتوفر شرط «كونه ذا أثر شرعي»؟ هل يلزم أن يكون المستصحَب في زمان اليقين السابق، أي مرحلة الحدوث، ذا أثر شرعي، أم يكفي أن يكون متصفاً بهذا الأثر في زمان الشك اللاحق، أي مرحلة البقاء، لصحة جريان الاستصحاب؟
وبعد هذا التنبيه، سنتناول إن شاء الله تعالى مباحث هامة أخرى، قائمتها كالتالي:
• التنبيه العاشر: الشك في تقدّم الحادث وتأخّره.
• التنبيه الحادي عشر: جريان الاستصحاب في الشك في وجود المانع أو القاطع.
• التنبيه الثاني عشر: جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية.
• التنبيه الثالث عشر: المراد من «الشك» في دليل الاستصحاب.
• التنبيه الرابع عشر: مسألة التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصِّص، وهو من المباحث الدقيقة والتطبيقية جداً.
وفي الختام، ستكون هناك خاتمة في بيان شروط جريان الاستصحاب.
تبيين الأقوال: توهّم لزوم الأثر حدوثاً وبقاءً في مقابل نظرية صاحب الكفاية(قدسسره)
في معرض الإجابة عن السؤال الرئيس في هذا التنبيه، يمكن تصور قولين أساسيين:
١. القول المتوهَّم (الرأي البدوي): لقد توهّم البعض[2] لزوم الشرط المذكور في كلتا مرحلتي الحدوث والبقاء [3] [4] ؛ أي إن المستصحَب يجب أن يكون ذا أثر شرعي في زمان اليقين السابق وفي زمان الشك الفعلي معاً، حتى يمكن استصحابه. وهذا القول، كما سيأتي، يفتقر إلى الدليل المتين.
٢. القول المحقَّق (رأي صاحب الكفاية(قدسسره)[5] ): لقد ردّ المرحوم الآخوند الخراساني(قدسسره) هذا القول، معتقداً أن وجود الأثر الشرعي إنما يلزم ويكفي في مرحلة البقاء (أي زمان الشك) فقط، ولا حاجة لوجوده في مرحلة الحدوث (زمان اليقين). والقول الحق هو هذا، وسنقوم في ما يأتي بتبيين صحته وإتقانه بذكر الأمثلة والاستدلال.
نكتة تكميلية ومبنائية: إعادة النظر في أصل القاعدة المشهورة (رأي المحقق الخوئي(قدسسره))
قبل الخوض في أدلة صاحب الكفاية(قدسسره)، يجدر بنا الإشارة إلى نكتة مبنائية بالغة الأهمية، تتحدى أصل القاعدة المشهورة (لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي). فالمرحوم آية الله الخوئي(قدسسره) لا يقبل هذه القاعدة على إطلاقها، ويرى أن الشرط الأساسي لجريان الاستصحاب هو «قابلية المستصحَب للتعبّد به»، لا لزوم كونه ذا أثر شرعي بالمعنى المصطلح.
وقد بيّن(قدسسره) هذا المبنى الدقيق في بحث «مقام الامتثال»، مستنداً إلى قواعد من قبيل «قاعدة الفراغ والتجاوز». وتوضيح ذلك: أنه في قاعدة الفراغ، عندما يشك المكلف بعد إتمام الصلاة في كونه كان على وضوء أم لا، فإن الشارع يتعبّده بصحة صلاته. ويرى سماحته أن هذا «الاكتفاء بالفرد المأتي به في مقام الامتثال» ليس هو بنفسه حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي بالمعنى المتداول، ومع ذلك، يجري فيه التعبّد الشرعي.
ويستنتج سماحته من هذا التحليل أن الاستصحاب يمكن أن يؤدي دوراً كهذا. فعندما نستصحب شرطاً (كالطهارة للصلاة)، فإن الشارع في الحقيقة يتعبّدنا بأن نفترض أن العمل قد أُتي به مع شرطه، وأن نقبل هذا الامتثال. وهذا الرأي يقدّم رؤية جديدة لتطبيقات الاستصحاب، ويوسّع نطاقه ليتجاوز الأحكام والموضوعات الشرعية المصطلحة إلى «مقام الامتثال» أيضاً.
وبطبيعة الحال، يمكن المناقشة في رأيه الدقيق هذا وإرجاع الموارد المذكورة إلى القاعدة المشهورة نفسها. ذلك لأن نفس هذا التعبّد من الشارع في مقام الامتثال، له أثر شرعي مباشر وبالغ الأهمية، وهو «رفع وجوب الإعادة». فلولا تعبّد الشارع عن طريق الاستصحاب أو قاعدة الفراغ، لوجب على المكلف عقلاً أو شرعاً أن يعيد العمل ليحصل له اليقين بفراغ الذمة. فإذاً، عندما يجري الاستصحاب أو قاعدة الفراغ، فإن أثره الشرعي هو إسقاط وجوب الإعادة. وبما أن «عدم الوجوب» هو بنفسه أثر شرعي (كما أن «الوجوب» أثر شرعي)، فإن المستصحَب (صحة العمل) يكون ذا أثر شرعي (عدم وجوب الإعادة)، ولا يخرج بذلك عن دائرة القاعدة المشهورة.
والآن، بالعودة إلى البحث الأصلي، نتناول تبيين نظرية صاحب الكفاية(قدسسره)، أي كفاية كون المستصحب ذا أثر شرعي في مرحلة البقاء. وقد استند سماحته لإيضاح مدّعاه وتثبيته إلى خمسة أمثلة هامة وتطبيقية، سنتناولها بالتفصيل في ما يأتي، ليتضح لماذا يقتصر اعتبار المستصحَب على مرحلة البقاء.
تبيين نظرية صاحب الكفاية(قدسسره) بخمسة أمثلة توضيحية
استند المرحوم الآخوند الخراساني(قدسسره) لإثبات مدّعاه المتقن، أي كفاية كون المستصحَب ذا أثر شرعي في مرحلة البقاء، إلى خمسة أمثلة واضحة وتطبيقية من مختلف أبواب الفقه. وإن التحليل الدقيق لهذه الأمثلة ليُظهر بوضوح لماذا لا يكون اشتراط وجود الأثر الشرعي في مرحلة الحدوث (زمان اليقين) لازماً ولا وجهاً له.
المثال الأول: استصحاب حياة الولد إلى زمان موت الأب
صورة المسألة: توفي أبٌ، وله ولد كان حياً يقيناً في الماضي، ولكن ثار الشك في بقاء حياته عند وفاة أبيه. والمسألة هي: هل يرث هذا الولد من أبيه أم لا؟
التحليل الدقيق: في هذا الفرض، تكون «حياة الولد» هي المستصحَب. فلدينا يقين سابق بحياته وشك لاحق في بقائها. فإذا أُحرزت حياة الولد لحظة موت أبيه، يترتب عليها أثر شرعي بالغ الأهمية وهو «استحقاق الإرث». وعليه، فإن «حياة الولد» موضوع لحكم شرعي وضعي (الإرث). ولكن النقطة المفتاحية تكمن في التمييز بين المرحلتين الزمنيتين:
في مرحلة الحدوث (زمان اليقين السابق): لنفرض أننا قبل عامين كنا على يقين قاطع بأن هذا الولد حي. في تلك الفترة الزمنية، هل كان كونه حياً يستتبع أثراً شرعياً يسمى «الإرث من الأب»؟ الجواب بالنفي قطعاً. لماذا؟ لأن الشرط الأساسي لتحقق الإرث، وهو «موت المورِّث (الأب)»، لم يكن قد تحقق بعد. فكانت حياة الولد آنذاك مجرد حقيقة تكوينية، لكنها فاقدة للأثر الشرعي المتمثل في الإرث، لانتفاء موضوع الإرث أساساً.
في مرحلة البقاء (زمان الشك اللاحق): الآن وقد توفي الأب وتحقق الشرط الأساسي للإرث، نشك في حياة الولد (الذي هو شرط آخر من شروط الإرث). وهنا يأتي دور الاستصحاب. فبإجراء «استصحاب حياة الولد»، نُحرز تعبّداً بقاء حياته إلى زمان وفاة الأب. وهذا الإحراز التعبّدي له أثر شرعي مباشر؛ أي يُحكم بأن هذا الولد يُعدّ في زمرة الورثة ويرث من أبيه.
الاستنتاج من المثال: يُظهر هذا المثال بوضوح تام أن موضوعية حياة الولد لحكم الإرث، إنما هي باعتبار مرحلة البقاء فقط (أي زمان موت الأب الذي هو ظرف شكّنا). ففي مرحلة الحدوث، كان المستصحَب (حياة الولد) فاقداً لهذا الأثر الشرعي، وهذا الأمر لا يُخلّ بجريان الاستصحاب في مرحلة البقاء. والثمرة العملية لهذا الاستصحاب هي أنه لو كان لهذا الولد الغائب أولاد (أي أحفاد للمتوفى)، فبهذا الاستصحاب، تعود حصة الإرث إلى أبيهم، ثم تنتقل عبره إلى هؤلاء الأحفاد.
المثال الثاني: استصحاب الاستطاعة المالية لوجوب الحج
صورة المسألة: شخص كان في فترة طفولته وصباه ذا ثروة معتبرة عن طريق الإرث أو الهبة، وكان مستطيعاً يقيناً. والآن وقد بلغ هذا الشخص سن الرشد، نشك في ما إذا كانت تلك الاستطاعة المالية لا تزال باقية له أم أنها زالت بفعل حوادث طارئة.
التحليل الدقيق: في هذا الفرض، تكون «الاستطاعة المالية» هي المستصحَب.
في مرحلة الحدوث (زمان الطفولة): عندما كان هذا الشخص في السابعة أو الثامنة من عمره مستطيعاً مالياً يقيناً، هل كانت استطاعته هذه تستتبع الأثر الشرعي المتمثل في «وجوب حجة الإسلام» عليه؟ من الواضح أن الجواب هو النفي. لأن وجوب الحج مشروط بأمرين: الاستطاعة والبلوغ. وفي ذلك الزمان، كان شرط البلوغ مفقوداً، وعليه لم تكن لاستطاعته أي أثر شرعي إلزامي، وكان مجرد وصف الثراء يصدق عليه.
في مرحلة البقاء (زمان البلوغ): الآن وقد بلغ هذا الفرد سن التكليف (الخامسة عشرة مثلاً) وتحقق شرط البلوغ، نشك في الشرط الآخر وهو «الاستطاعة المالية». في هذه المرحلة، إذا أحرزنا بقاء استطاعته المالية السابقة عن طريق إجراء الاستصحاب، فإن هذا الاستصحاب سيكون له أثر شرعي مباشر، وهو الحكم بـ«وجوب الحج الفوري» عليه.
الاستنتاج من المثال: نرى بوضوح في هذا المثال أيضاً أن الأثر الشرعي (وجوب الحج) إنما يترتب على المستصحَب في مرحلة البقاء؛ أي عندما تهيأت الأرضية لترتب الأثر بانضمام شرط البلوغ. أما في مرحلة الحدوث، فقد كان المستصحَب فاقداً لمثل هذا الأثر، وهذا لا يمنع من جريان الاستصحاب.
المثال الثالث: استصحاب الأعدام الأزلية (عدم التزكية وعدم القرشية)
يتناول هذا المثال استصحاب الأمور العدمية الثابتة منذ الأزل، ويبيّن كيف أن أمراً عدمياً لا أثر له في الماضي، يصبح ذا أثر شرعي في ظل ظروف جديدة.
• أ) استصحاب عدم التزكية:
في مرحلة الحدوث (قبل الذبح): الأصل أن كل حيوان قبل أن يُذبح، متصف بـ«عدم التزكية». وهذا العدم هو عدم أزلي يلازم الحيوان منذ بداية خلقه. فعندما يكون الخروف حياً ويرعى، فإن «عدم التزكية» هذا لا أثر شرعياً خاصاً له كحرمة الأكل أو النجاسة.
في مرحلة البقاء (بعد الذبح المشكوك): ولكن عندما يُذبح ذلك الحيوان ونشك في تحقق شروط التزكية الشرعية (كالاستقبال والتسمية وغيرها)، فهنا يجري «استصحاب عدم التزكية الأزلي». وهذا الاستصحاب في هذا الظرف الجديد، تترتب عليه آثار شرعية بالغة الأهمية: الحكم بـ«حرمة أكل» لحم ذلك الحيوان و«نجاسة» ميتته.
• ب) استصحاب عدم كون المرأة قرشية:
◦ في مرحلة الحدوث (قبل سن الخمسين): إن عدم انتساب امرأة إلى قبيلة قريش أمر ثابت منذ ولادتها. وهذا «العدم للقرشية» في فترة طفولتها أو شبابها، لا أثر شرعياً خاصاً له يتعلق بأحكام اليأس.
◦ في مرحلة البقاء (بعد سن الخمسين): ولكن عندما تبلغ هذه المرأة سن الخمسين (وهو سن اليأس في النساء غير القرشيات) وترى دماً مشتبهاً، فإذا شُكّ في كونها قرشية، يجري «استصحاب عدم كونها قرشية». وهذا الاستصحاب في هذه المرحلة الجديدة، له أثر شرعي، وهو الحكم بكونها «يائسة» وترتيب أحكام ذلك عليها (كعدم وجوب عدة الطلاق وصحة الصلاة والصوم).
الاستنتاج من المثال: في كلتا الحالتين، يترتب الأثر الشرعي على ذلك العدم الأزلي في مرحلة البقاء فقط وبعد تهيؤ الظروف الجديدة (الذبح أو بلوغ سن معينة)، وكونه بلا أثر في مرحلة الحدوث أمر طبيعي تماماً ولا يضر بجريان الاستصحاب.
المثال الرابع: استصحاب عدم رضا المالك في التصرف
صورة المسألة: شخص تصرّف في مال غيره. ونعلم أن المالك في الماضي لم يكن راضياً بهذا التصرف، ولكن نشك في ما إذا كان قد رضي لاحقاً أم لا.
التحليل الدقيق: هنا يكون «عدم رضا المالك وعدم إذنه» هو المستصحَب.
في مرحلة الحدوث (قبل التصرف): عندما لم يكن قد وقع أي تصرف في مال ذلك الشخص، كان عدم رضا المالك بتصرف مفترض أمراً مسلّماً، لكن لم يترتب عليه أي أثر شرعي عملي باسم «الضمان» أو «الحرمة»، لأن موضوع هذه الأحكام وهو «التصرف» لم يكن قد تحقق بعد.
في مرحلة البقاء (زمان التصرف): ولكن الآن وقد وقع التصرف ونشك في حصول الرضا اللاحق من المالك، فإن «استصحاب عدم الرضا» له أثران شرعيان مهمان ومباشران: الحرمة التكليفية لمواصلة التصرف، والضمان الوضعي للمال في حال التلف أو النقص.
الاستنتاج من المثال: يُظهر هذا المثال أيضاً بوضوح أن الأثر الشرعي وليد مرحلة البقاء ومقارنة المستصحَب بفعل خارجي (التصرف)، وأنه لم يكن له أثر في مرحلة الحدوث.
المثال الخامس: استصحاب عدم التكليف (البراءة الأصلية)
صورة المسألة ([6] ): واجه المكلف موضوعاً مستحدثاً أو حالة جديدة، وشك في ما إذا كان الشارع المقدس قد جعل له حكماً إلزامياً (وجوباً أو حرمة) أم لا.
التحليل الدقيق: هنا يكون «عدم جعل التكليف» هو المستصحَب.
• في مرحلة الحدوث (في الأزل وقبل الابتلاء): لدينا يقين بأن الشارع في الأزل وقبل نزول الشريعة، لم يجعل تكليفاً في هذا المورد الخاص. وكان «عدم التكليف» هذا أمراً مسلّماً ويقينياً، لكن لم يكن له أثر عملي لمكلف لم يواجهه بعد.
• في مرحلة البقاء (زمان الشك والابتلاء): الآن وقد واجه المكلف هذا الموضوع وشك في وجود التكليف، فإنه بإجراء «استصحاب عدم جعل التكليف الأزلي»، يحكم ببراءة ذمته. وهذا الحكم بالبراءة أثر شرعي بالغ الأهمية يحدد الوظيفة العملية للمكلف في مقام الامتثال. وتجدر الإشارة إلى أنه كما أن «ثبوت الحكم» أثر شرعي، فإن «نفي الحكم» وإثبات عدمه يُعدّ أثراً شرعياً أيضاً، لأن كليهما بيد الشارع، وكلاهما مرشد للمكلف ومحدّد لوظيفته في مقام العمل.
جمع وتلخيص نتائج الأمثلة
إن التحليل الدقيق لهذه الأمثلة الخمسة من مختلف أبواب الفقه (الإرث، الحج، الطهارة، المعاملات، والأصول العملية) ليرشدنا إلى نتيجة واحدة لا تقبل الخدش:
في جميع هذه الموارد، كان المستصحَب في مرحلة الحدوث وزمان اليقين فاقداً للأثر الشرعي المنشود، لأن الشروط اللازمة لترتب ذلك الأثر لم تكن قد تهيأت بعد. ولكن هذا المستصحَب نفسه، في مرحلة البقاء وزمان الشك، وبسبب نشوء ظروف جديدة (كموت الأب، أو البلوغ، أو الذبح، أو التصرف، أو الابتلاء بالمسألة)، أصبح ذا أثر شرعي مباشر ومهم. وعليه، فإن رأي المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) القائل بأنه في صحة جريان الاستصحاب، يُعتبر وجود الأثر الشرعي في مرحلة البقاء فقط، هو رأي صحيح تماماً ومنطبق على التحليل الدقيق للموارد والمصاديق. وإن اشتراط وجود الأثر في مرحلة الحدوث هو شرط إضافي لا دليل عليه، ومن شأنه أن يواجه الكثير من الاستصحابات الصحيحة والجارية في الفقه بالتحدي.
الاستدلال المتين لصاحب الكفاية(قدسسره) والجمع النهائي للتنبيه التاسع
بعد أن أثبت المرحوم الآخوند الخراساني(قدسسره) مدّعاه بالاستقراء من خلال إقامة خمسة أمثلة واضحة لا يمكن إنكارها، حان الآن أوان تقديم البرهان والاستدلال العقلي-الأصولي على هذه النظرية. وهو يشرح في عبارة موجزة لكنها غنية بالمعنى، الأساس الاستدلالي لرأيه.
متن الكفاية:
«و ذلك لصدق نقض الیقین بالشك على رفع الید عنه [بمعنى أنّ رفع الید عن الیقین هنا ینطبق علیه نقض الیقین بالشك و هو المنهي عنه بقوله(علیهالسلام): «لَاتَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّك»] و العمل كما إذا قطع بارتفاعه یقیناً [أي یصدق نقض الیقین بالشك على العمل كما إذا كان قاطعاً بارتفاع الیقین] و وضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فیه و في تنزیلها بقاءً [یعني أنّ التعبّد ببقاء الحالة السابقة، لا دخل فیه لثبوت أثر شرعي في زمان الیقین و حالة الحدوث]»[7] [8] [9] .
تحليل وتبيين دقيق للاستدلال:
يرتكز استدلال المرحوم الآخوند(قدسسره) على ركيزتين متينتين، تبدو كل واحدة منهما كافية لإثبات المطلوب:
١. محورية «مرحلة البقاء» في صدق عنوان «نقض اليقين بالشك»:
إن روح وجوهر أدلة حجية الاستصحاب، لا سيما الرواية المشهورة «لا تنقض اليقين بالشك»، هو النهي عن فعل معين، وهو «نقض» الحالة اليقينية السابقة بواسطة «الشك» اللاحق. والآن يجب أن نسأل: في أي زمان وفي أي ظرف يكتسب فعل «النقض» هذا معناه؟
الجواب واضح تماماً. فطالما أن المكلف في حالة اليقين (مرحلة الحدوث)، فلا وجود لـ«شك» أساساً حتى يقع «نقض». إن فعل «النقض» لا يمكن تصوره إلا عندما يخرج المكلف من حالة اليقين ويدخل وادي الشك والتردد. وهنا يأمره الشارع المقدس: «أيها المكلف الشاك! لا ترفع يدك عن يقينك السابق ولا تُبطله بهذا الشك الجديد».
وعليه، فإن تمام موضوعية ومحورية دليل الاستصحاب، إنما هي مرحلة البقاء وظرف الشك. ففي زمان الشك يكون المكلف متحيراً ويحتاج إلى وظيفة عملية. والشارع أيضاً يعيّن له هذه الوظيفة من خلال التعبّد ببقاء اليقين السابق. فعندما يكون كل قوام الاستصحاب ودليل حجيته ناظراً إلى مرحلة البقاء، كيف يمكن أن نلزم بشرط (وهو كون المستصحب ذا أثر شرعي) في مرحلة الحدوث، التي هي خارجة أساساً عن دائرة خطاب دليل الاستصحاب؟
٢. عدم دخل أثر الحالة السابقة في ماهية التعبّد بالبقاء:
الركيزة الثانية للاستدلال هي تحليل دقيق لماهية «التعبّد» في الاستصحاب. فالتعبّد في الاستصحاب يعني «البناء العملي على بقاء الحالة السابقة» و«تنزيل مشكوك البقاء منزلة متيقن البقاء». والهدف من هذا التعبّد هو تعيين الوظيفة الفعلية للمكلف وإخراجه من حيرته.
والسؤال الآن هو: لكي يتمكن الشارع من أن يتعبّدنا ببقاء أمر ما، هل يلزم أن يكون ذلك الأمر ذا أثر في الماضي أيضاً؟ الجواب بالنفي. فلا توجد أي ملازمة عقلية أو شرعية بين الأمرين. المهم هو أن يكون لهذا التعبّد، الآن وفي زمان الشك، فائدة وأثر عملي. فلو كان البناء على بقاء الحالة السابقة لا ثمرة له في زمان الشك، لكان هذا التعبّد لغواً. أما إذا كان ذا أثر في زمان الشك، فإن التعبّد به يكون عقلائياً ومفيداً تماماً، سواء كان له أثر في الماضي أم لم يكن.
وبعبارة أخرى، إن وجود أو عدم وجود أثر شرعي في مرحلة الحدوث لا دخل له إطلاقاً في إمكان وصحة تعبّد الشارع ببقاء تلك الحالة في مرحلة الشك. إن ما يجعل التعبّد معقولاً وغير لغوٍ هو وجود الأثر في ظرف التعبّد نفسه، وظرف التعبّد هو مرحلة البقاء وزمان الشك.
الجمع النهائي وخلاصة التنبيه التاسع
من مجموع ما قيل، بدءاً من تحليل الأمثلة المتعددة وصولاً إلى دراسة برهان صاحب الكفاية(قدسسره)، نصل إلى هذه النتيجة القطعية والواضحة:
في باب الاستصحاب، إن ما هو معتبر ولازم لصحة جريانه، هو وجود أثر شرعي للمستصحَب في مرحلة البقاء (زمان الشك)، ولا حاجة لوجود مثل هذا الأثر في مرحلة الحدوث (زمان اليقين).
والسبب في ذلك هو:
• أولاً، إن ظرف التعبّد في الاستصحاب هو مرحلة البقاء. فنحن في هذا الزمان مأمورون من قبل الشارع بالبناء العملي على الحالة السابقة لنخرج من الحيرة والتردد. فمن الطبيعي إذن أن يُقاس شرط «كونه ذا أثر» في ظرف التعبّد هذا نفسه.
• ثانياً، في مرحلة الحدوث، بما أن المكلف في حالة يقين، فإنه لا يحتاج أساساً إلى تعبّد وجعل وظيفة ظاهرية حتى يُبحث عن فائدة ذلك وأثره.
• ثالثاً، كما أظهرت الأمثلة، في كثير من الاستصحابات الصحيحة والجارية في الفقه، يكون المستصحَب في مرحلة الحدوث فاقداً للأثر الشرعي، لأن الشروط اللازمة لترتب ذلك الأثر (كموت المورِّث، أو البلوغ، أو وقوع التصرف، وغيرها) لم تكن قد تهيأت بعد.
وعليه، فإن الكلام المتين للمرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) في هذا التنبيه تام تماماً ولا نقص فيه، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كقاعدة هامة في تطبيق الاستصحاب. إذ يجب أن يكون المستصحَب بلحاظ مرحلة البقاء (زمان الشك) إما حكماً شرعياً بنفسه أو موضوعاً لحكم شرعي، لأن هذا الزمان هو ظرف تعبّد المكلف، والأثر الشرعي إنما يتحقق في هذه المرحلة لرفع حيرته.
التنبیه العاشر: الشك في تقدّم الحادث و تأخّره
(فیة مقدمة و مطلبان و تتمة)
المطلب الأوّل: في تقدّم أحد الحادثين على الآخر إذا كان الموضوع مركّباً
المطلب الثاني: في تقدّم أحد الحادثین علی الآخر إذا كان الموضوع بسیطاً
تتمة: الاستصحاب في المقام قد یكون شخصیاً و قد یكون كلیاً
الشك في تقدّم الحادث و تأخّره
مقدمة وطرح البحث
نصل الآن إلى التنبيه العاشر من سلسلة تنبيهات باب الاستصحاب. ويتناول هذا التنبيه إحدى المسائل الدقيقة جداً وذات الثمرة الكبيرة في الأصول العملية، والتي اشتهرت في كلمات الفقهاء والأصوليين بـ «أصالة تأخّر الحادث». وموضوع هذا البحث هو دراسة الوظيفة العملية للمكلف في الحالة التي يعلم فيها إجمالاً بوجود حادثين، ولكنه يشك ويتردد في التقدم والتأخر الزمني لأحدهما على الآخر، أو في التاريخ الدقيق لوقوع حادثة ما.
ولتبيين هذا البحث بشكل دقيق ومنهجي، سنتابع المطالب ضمن مقدمة ومقامين رئيسيين، وفي الختام، سنشير إلى نكتة تكميلية بعنوان «تتمة».
• المقدمة: تبيين جريان الاستصحاب في الوجود والعدم بصورة مطلقة.
• المقام الأول: الشك في تقدم الحادث وتأخره بالنسبة إلى أجزاء الزمان.
• المقام الثاني: الشك في تقدم حادثين وتأخرهما بالنسبة إلى بعضهما البعض.
مقدمة: جريان الاستصحاب في الوجود والعدم
قبل الدخول في البحث الأصلي، يشير المرحوم الآخوند(قدسسره) إلى نكتة جوهرية[10] ، وهي شمولية واتساع نطاق جريان الاستصحاب ليشمل الأمور الوجودية والعدمية. فكما مرّ تفصيلاً في المباحث السابقة، إن أركان الاستصحاب هي اليقين السابق والشك اللاحق. فمتى ما تحقق هذان الركنان، جرى الاستصحاب، سواء كان متعلق اليقين السابق أمراً وجودياً أم أمراً عدمياً.
• الاستصحاب الوجودي: إذا تيقنا في الماضي بوجود شيء (كعدالة زيد) وشككنا الآن في بقائه، أجرينا استصحاب وجوده.
• الاستصحاب العدمي: وإذا تيقنا في الماضي من عدم شيء (كعدم التكليف) وشككنا الآن في حدوثه، أجرينا استصحاب عدمه.
وتكمن أهمية هذه المقدمة في أن الأساس الذي يقوم عليه بحث «أصل تأخر الحادث» هو هذا «الاستصحاب العدمي» نفسه. أي أننا من خلال إجراء استصحاب عدمِ حادثةٍ في الزمان السابق، نحاول أن نحصر تاريخ وقوعها في الزمان المتأخر.
المقام الأول: الشك في تقدم الحادث وتأخره بالنسبة إلى أجزاء الزمان
الفرض في هذا المقام هو أننا نعلم بوقوع حادثة (حكم أو موضوع خارجي) في فترة زمنية معينة، ولكننا نشك في نقطة بدايتها الدقيقة ضمن هذه الفترة.
صورة المسألة: لدينا يقين بأن أمراً معيناً قد وقع يوم الجمعة. ولكننا نشك في ما إذا كانت هذه الحادثة موجودة يوم الخميس أيضاً واستمرت إلى يوم الجمعة، أم أن نقطة بدايتها وحدوثها كانت يوم الجمعة نفسه؟ وبعبارة أخرى، نعلم بوجود الحادثة يوم الجمعة، ولكننا نشك في وجودها يوم الخميس.
تحليل المسألة وتبيين «أصل تأخّر الحادث»:
هنا، لتحديد التكليف بالنسبة ليوم الخميس، يمكننا التمسك بـ «استصحاب العدم». فحالتنا السابقة اليقينية بالنسبة ليوم الخميس هي عدم هذه الحادثة (لأن الفرض هو أن الحادثة لم تكن موجودة قطعاً قبل هذه الفترة الزمنية). وعليه، فإننا نستصحب «عدم حدوث هذه الواقعة في يوم الخميس».
ونتيجة هذا الاستصحاب هي أنه يثبت تعبّداً أن هذه الحادثة لم تقع يوم الخميس. فعندما نعلم بوجودها يوم الجمعة بالوجدان، وننفي وجودها يوم الخميس بالاستصحاب، فإن اللازم العقلي لهاتين المقدمتين هو أن «الحدوث» ونقطة بداية هذه الواقعة كان يوم الجمعة. وتُعرف هذه العملية الاستنباطية بـ «أصل تأخّر الحادث». أي أنه في حالة الشك بين زمانين، يكون الأصل هو وقوع الحادثة في الزمان المتأخر (الجمعة) لا في الزمان المتقدم (الخميس).
المناقشة في حجية «أصل تأخّر الحادث» (مبحث الأصل المُثبِت):
وهنا يبرز أحد أدق المباحث الأصولية، وهو مسألة «حجية الأصل المُثبِت». إذ يجب أن نرى هل يمكن أن نستنتج من خلال أصل عملي (استصحاب العدم يوم الخميس) لازماً عقلياً (الحدوث يوم الجمعة) ونرتّب عليه أثراً شرعياً؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتوقف على المباني المختلفة في ماهية الاستصحاب:
١. مبنى المشهور (الاستصحاب بصفته أمارة): إذا اعتبرنا الاستصحاب من باب الظن النوعي ومن سنخ الأمارات (كما هو رأي مشهور القدماء)، وقلنا بحجية مثبتات الأمارات ولوازمها العقلية، فحينئذ يكون «أصل تأخّر الحادث» حجة بالكامل. ذلك لأن استصحاب العدم يوم الخميس (بصفته أمارة) يثبت أن الواقعة لم تكن في ذلك اليوم، ولازمه العقلي (وهو الحدوث يوم الجمعة) يكون حجة أيضاً.
٢. مبنى المرحوم آية الله الخوئي(قدسسره) (الاستصحاب أمارة ولكن مثبتاته ليست بحجة): سماحته، مع قبوله بكون الاستصحاب أمارة، يرى أنه بسبب خصوصية دليل حجيته، فإن مثبتاته ولوازمه العقلية ليست بحجة. وبناءً على ذلك، ورغم جريان استصحاب العدم يوم الخميس، لا يمكن استنتاج لازمه العقلي أي «الحدوث يوم الجمعة» وترتيب الأثر عليه. وعليه، وطبقاً لهذا المبنى، لا يكون «أصل تأخّر الحادث» حجة.
٣. المبنى المختار (الاستصحاب بصفته أصلاً عملياً): إذا اعتبرنا الاستصحاب (كما هو الحق) مجرد أصل عملي لرفع حيرة المكلف، لا أمارة كاشفة عن الواقع، فحينئذ تكون لوازمه العقلية غير حجة قطعاً. فاستصحاب العدم يوم الخميس إنما يفيد لنفي الآثار في يوم الخميس نفسه، ولكنه لا يستطيع أن يعيّن لنا بنحو إثباتي تاريخ الحدوث يوم الجمعة. فإثبات الحدوث يوم الجمعة بواسطة استصحاب العدم يوم الخميس هو «أصل مُثبِت»، والأصول المثبتة ليست بحجة.
الحل البديل: تحليل الموضوع على نحو التركيب
حاول البعض، فراراً من إشكال الأصل المثبت، أن يحللوا «الحدوث يوم الجمعة» كموضوع مركّب. فوفقاً لهذا الرأي، معنى «حدوث الشيء يوم الجمعة» هو: [الجزء الأول: وجود الشيء يوم الجمعة] + [الجزء الثاني: عدم الشيء يوم الخميس].
فإذا قبلنا هذا التحليل، لن نواجه مشكلة الأصل المثبت. لأننا لإثبات هذا الموضوع المركب، نُحرز الجزء الأول (الوجود يوم الجمعة) بالوجدان، ونُحرز الجزء الثاني (العدم يوم الخميس) بالاستصحاب (وهو أصل تعبّدي). وبضم الوجدان إلى الأصل، يثبت الموضوع المركب بالكامل ويمكن ترتيب الآثار الشرعية عليه.
نقد الحل: هذا التحليل أيضاً تعرض لنقد جاد. فالمرحوم السيد الخوئي(قدسسره) وغيره من المحققين يرون أن «الحدوث» معنى بسيط عرفي وعقلي، وهو عبارة عن «كون الوجود مسبوقاً بالعدم». واعتباره مركباً هو تكلّف وخلاف للفهم العرفي. وعليه، فإن حل تحليل الموضوع على نحو التركيب ليس طريقاً صحيحاً للفرار من إشكال الأصل المثبت.
نتيجة المقام الأول: إن حجية «أصل تأخّر الحادث» حيث يكون تاريخ وقوع حادثة ما مشكوكاً فيه، هي مسألة مبنائية تماماً. فلا يمكن الالتزام بهذا الأصل إلا على مبنى كون الاستصحاب أمارة وحجية مثبتاته. أما على المبنى المختار القائل بأن الاستصحاب أصل عملي، فإن هذا الأصل لن يكون حجة.


