46/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ ثلاثة موارد لا تكون من الأصل المثبت؛ الكلام في المورد الثالث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
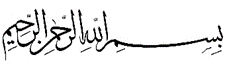
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ ثلاثة موارد لا تكون من الأصل المثبت؛ الكلام في المورد الثالث
الجواب الثاني: من المحقّق الخوئي(قدسسره)
الجواب الثاني، الذي طرحه المرحوم المحقّق الخوئي(قدسسره)، ليس مجرّد جواب بجانب الجواب الأوّل، بل هو ثورة وتحوّل بنيويّ في النظرة إلى نفس الاستصحاب. فهو بدلاً من قبول الفرضيّات المسبقة للإشكال ومحاولة حلّها، يتحدّى أساساً الفرضيّة المسبقة للمستشكِل ويعيد تعريف شرط جريان الاستصحاب. يقول(قدسسره):
«إنّ الإشكال المذكور إنّما نشأ ممّا هو المعروف بینهم من أنّه یعتبر في الاستصحاب أن یكون المستصحب بنفسه مجعولاً شرعیاً أو موضوعاً لمجعول شرعي، فیتوجّه حینئذٍ الإشكال في جریان الاستصحاب في الشرط؛ لعدم كونه مجعولاً بالجعل التشریعي و لیس له أثر جعلي.
و التحقیق في الجواب أنّه لا ملزم لاعتبار ذلك، فإنّه لمیدلّ علیه دلیل من آیة أو روایة، و إنّما المعتبر في جریان الاستصحاب كون المستصحب قابلاً للتعبّد.
و من الظاهر أنّ الحكم بوجود الشرط قابل للتعبّد، و معنی التعبّد به هو الاكتفاء بوجوده التعبّدي و حصول الامتثال، فإنّ لزوم إحراز الامتثال و إن كان من الأحكام العقلیة إلا أنّه معلّق على عدم تصرّف الشارع بالحكم بحصوله، كما في قاعدتي الفراغ و التجاوز؛ فإنّه لولا حكم الشارع بجواز الاكتفاء بما أتی به المكلّف فیما إذا كان الشك بعد الفراغ أو بعد التجاوز لحكم العقل بوجوب الإعادة لإحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، لكنّه بعد تصرف الشارع و حكمه بجواز الاكتفاء بما أتی به ارتفع موضوع حكم العقل، لكونه مبنیاً على دفع الضرر المحتمل و لایكون هناك احتمال الضرر، فكذا الحال في المقام، فإنّ معنی جریان الاستصحاب في الشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبّد الشرعي، فلا محذور فیه أصلاً، و تكون حال الاستصحاب حال قاعدة الفراغ و التجاوز في كون كل منهما تصرّفاً من الشارع، غایة الأمر أنّ الاستصحاب لایختصّ بمقام الامتثال، فیجري في ثبوت التكلیف تارة و في نفیه أخری و في مقام الامتثال ثالثة، بخلاف قاعدة الفراغ و التجاوز فإنّها مختصّة بمقام الامتثال».[1]
نقد المبنى المشهور في شرط المستصحَب
يرى المرحوم المحقّق الخوئي(قدسسره) أنّ جذر الإشكال يكمن في مبنى مشهور بين الأصوليّين. وذلك المبنى هو: «المستصحَب» (أي الأمر الذي نستصحب بقاءه) يجب أن يكون إمّا هو نفسه مجعولاً شرعيّاً (كالملكيّة والزوجيّة) وإمّا موضوعاً لمجعول شرعيّ (كالخمر الذي هو موضوع للحرمة).
فلو قبلنا بهذا المبنى، لكان الإشكال على جريان الاستصحاب في الشرط التكويني (كالاستقبال) صحيحاً تماماً؛ لأنّ الاستقبال ليس بمجعول شرعيّ وليس له بذاته أثر شرعيّ مباشر.
ولكنّ تحقيق المرحوم الخوئي(قدسسره) هو أنّ هذا المبنى المشهور ليس له أيّ دليل أو مستند من الكتاب والسنّة. فلم تقيّد أيّ آية أو رواية جريان الاستصحاب بمثل هذا الشرط.
طرح مبنى جديد: «قابليّة التعبّد» بدلاً من «كونه مجعولاً شرعيّاً»
إذن، لو لم يكن ذلك الشرط لازماً، فما هو الشرط الحقيقي لجريان الاستصحاب؟ يقول(قدسسره): إنّ الشرط الوحيد اللازم لجريان الاستصحاب هو «قابليّة التعبّد» للمستصحَب.
والمقصود بقابليّة التعبّد هو: أن يكون ذلك الأمر المشكوك شيئاً يمكن للشارع المقدّس أن يلزمنا ببقائه على نحو تعبّديّ. أي هل يُعقل أن يقول الشارع: «أيّها المكلّف، عند الشكّ، ابنِ على بقاء هذا الأمر وافرضه موجوداً»؟
الجواب إيجابيّ. فأمر كـ«وجود الشرط» (الاستقبال) له قابليّة تامّة لأن يعبّدنا الشارع به. ومعنى هذا التعبّد أيضاً هو أن نكتفي بنفس ذلك الوجود التعبّدي ونعتبر تكليفنا ممتثلاً.
الاستدلال على المبنى الجديد: قياس الاستصحاب بقاعدتي الفراغ والتجاوز
لإثبات هذا المبنى، يتناول تحليلاً دقيقاً للعلاقة بين حكم العقل وتصرّف الشارع ويقارن الاستصحاب بقواعد كـ«الفراغ والتجاوز»:
الحكم الأوّلي للعقل: يحكم العقل بشكل مستقلّ بأنّ «الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني». أي لو كُلِّفت بتكليف، لوجب أن تتيقّن بأنّك قد أدّيته بشكل صحيح. وهذا الحكم العقلي هو من باب «دفع الضرر المحتمل» (تجنّب العقوبة المحتملة). فلو لم تكن القواعد الشرعيّة، لأوجب الشكّ في صحّة الصلاة بعد إتمامها عقلاً لزوم الإعادة.
تصرّف الشارع: ولكنّ هذا الحكم العقلي يبقى ما لم يتصرّف الشارع في هذا المجال. فالشارع المقدّس، بجعل قواعد كـ«الفراغ والتجاوز»، قد تصرّف في هذا الحكم العقلي فيقول: «في صورة الشكّ بعد تجاوز المحلّ، ابنِ على الصحّة واكتفِ بما أدّيته».
نتيجة تصرّف الشارع: بهذا الأمر الشرعي، لم يعد هناك «احتمال ضرر» حتى يكون موضوعاً لحكم العقل. فالشارع، بالتعبّد بالصحّة، قد رفع موضوع حكم العقل واعتبر الامتثال حاصلاً.
الاستنتاج: استصحاب الشرط تصرّف من الشارع في مقام الامتثال
يستنتج المرحوم الخوئي(قدسسره) أنّ الاستصحاب يؤدّي تماماً هذا الدور نفسه: فجريان الاستصحاب في الشرط (كالاستقبال) يعني أنّ الشارع يسمح لنا بالاكتفاء بالوجود الاحتمالي لذلك الشرط في مقام الامتثال، بواسطة التعبّد الشرعي.
وبعبارة أخرى، فالاستصحاب هو تصرّف من قبل الشارع يرفع الحكم العقلي لـ«لزوم الإحراز اليقيني للشرط» ويقول لنا: «لا حاجة إلى اليقين، ابنِ على بقاء الشرط وأدِّ عملك؛ نحن نقبل منك هذا الامتثال».
بناءً عليه، فالإشكال منتفٍ من الأساس؛ لأنّه ليس من اللازم أن يكون لنفس الشرط أثر شرعيّ. بل إنّ التعبّد ببقاء الشرط، الذي هو أمر شرعيّ تماماً، يستتبع الأثر الشرعي (أي جواز الدخول في العمل وصحّته). وبهذا البيان، لم تعد هناك حاجة إلى بحث «الشرطيّة» والانتزاع والأصل المثبت، ويرتفع الإشكال بالكلّيّة.
الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتجاوز
مع وجود التشابه البنيوي بين الاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتجاوز في دور «تعبّد الشارع» والتصرّف في حكم العقل، يوجد فرق مهمّ بينهما يجعل نطاق شمول الاستصحاب أوسع بكثير:
اختصاص قاعدتي الفراغ والتجاوز بمقام الامتثال: تجري هاتان القاعدتان فقط في «مقام الامتثال». أي عندما يشكّ المكلّف أثناء أداء التكليف أو بعد إتمامه في صحّة العمل المؤدّى، تُستخدم هاتان القاعدتان لتصحيح ذلك العمل تعبّديّاً. ومن المثير للاهتمام أنّ نفس «مقام الامتثال» هو أمر عقليّ وليس بمجعول شرعيّ، ولكنّ الشارع قد تصرّف فيه بجعل هاتين القاعدتين.
عموميّة واتّساع الاستصحاب: في المقابل، ليس للاستصحاب مثل هذا التقييد وهو أصل عامّ وشامل. فنطاق تطبيقه أوسع بكثير ويجري في ثلاثة مجالات رئيسيّة:
١. في مقام ثبوت التكليف: أحياناً يُستخدم لإثبات بقاء تكليف. فمثلاً، عند الشكّ في نسخ وجوب ما، نحكم باستصحاب بقاء ذلك الوجوب.
٢. في مقام نفي التكليف: أحياناً يجري لنفي تكليف. فمثلاً، باستصحاب البراءة الأصليّة، نحكم بعدم التكليف في الموارد المشكوكة.
٣. في مقام الامتثال: وأحياناً أيضاً، كبحثنا الحالي في الشرط، يجري في مقام الامتثال ويساعد المكلّف في اتّجاه إحراز صحّة العمل.
بناءً عليه، فعلى الرغم من أنّ كليهما من جنس واحد (تصرّف الشارع في حكم العقل)، إلّا أنّ الاستصحاب أصل أمّ وأشمل.
الجمع النهائي لجواب المحقّق الخوئي(قدسسره)
محصَّل كلام المحقّق الخوئي(قدسسره) هو أنّ الإشكال الأساسي على استصحاب الشرط قد نشأ من فرضيّة مسبقة غير مدلَّلة وخاطئة (أي لزوم كون المستصحَب مجعولاً شرعيّاً).
وبترك هذه الفرضيّة المسبقة جانباً، يتّضح أنّ الشرط الوحيد المعتبر لجريان الاستصحاب هو «قابليّة التعبّد». وبما أنّ «وجود الشرط» (حتّى لو كان أمراً تكوينيّاً) قابل تماماً للتعبّد من قبل الشارع، فإنّ الاستصحاب يجري فيه بسهولة.
ونتيجة هذا الجريان هي تصرّف شرعيّ في الحكم العقلي لـ«لزوم إحراز الامتثال». فالشارع، بجعل الحجّيّة للاستصحاب، يسمح للمكلّف بالاكتفاء بالوجود الاحتمالي للشرط واعتبار عمله صحيحاً. وهذه العمليّة تشبه تماماً آليّة قاعدتي الفراغ والتجاوز، مع فارق أنّ للاستصحاب دائرة شمول أوسع بكثير.
وهذا الرأي لا يحلّ الإشكال في باب الشرط بشكل جذريّ فحسب، بل يمهّد الطريق أيضاً لجريان الاستصحاب في كثير من الأمور التكوينيّة التي كانت تواجه تحدّياً سابقاً بسبب ذلك الإشكال نفسه، ويفتح أفقاً جديداً في تطبيق هذا الأصل العملي المهمّ.
ملاحظات تكميليّة: توجيه جريان الاستصحاب على مبانٍ مختلفة
بعد تبيين الجواب الدقيق والمبنائي للمرحوم المحقّق الخوئي(قدسسره) (الذي يرتكز على محور «قابليّة التعبّد»)، ننتقل الآن إلى ملاحظات تكميليّة. والغرض من هذه الملاحظات هو أن نبيّن أنّه حتّى لو لم نقبل بالمبنى التوسعي للمحقّق الخوئي(قدسسره) وظللنا على المباني المشهورة والتي تبدو أكثر تضييقاً في باب شرط المستصحَب، فلا يزال بالإمكان تصحيح جريان الاستصحاب في «الشرط» ورفع الإشكال الأساسي.
وفي ما يلي، نبحث ثلاثة تعابير مشهورة في باب المستصحَب ونبيّن حلّ جريان استصحاب الشرط بناءً على كلّ منها.
التعبير الأوّل: المستصحَب هو «الحكم الشرعي» أو «موضوع الحكم الشرعي»
هذا التعبير هو الرأي الأكثر شيوعاً بين الأصوليّين. وبناءً على هذا المبنى، كان الإشكال هو أنّ «الشرط» (كالاستقبال) ليس هو نفسه حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً يترتّب عليه أثر شرعيّ مباشرةً.
الحلّ: يكمن الحلّ في توسعة مفهوم «الموضوع». فكما قال بعض الأعلام: «كلّ شرطٍ موضوعٌ». وهذه الجملة تعني أنّه على الرغم من أنّ الشرط ليس موضوعاً مستقلاً لحكم، إلّا أنّه يعمل كـ«قيد للموضوع». فحكم الوجوب قد تعلّق بـ«الصلاة المقيَّدة بالاستقبال». وقيد الموضوع يُعدّ نوعاً ما جزءاً من الموضوع المركّب. وعليه، فإنّ استصحاب الشرط هو في الواقع استصحاب لقيد موضوع الحكم الشرعي، وهو من هذه الجهة ذو أثر شرعيّ وجريانه لا إشكال فيه.
التعبير الثاني: المستصحَب هو «المجعول الشرعي» أو «موضوع المجعول الشرعي»
يؤكّد هذا التعبير على مفهوم «الجعل». وكان الإشكال هو أنّ الشرط (كالقيام) أمر تكوينيّ وليس بمجعول للشارع.
الحلّ: يوجد هنا أيضاً جواب دقيق وفنّيّ: فعلى الرغم من أنّ ذات «القيد» (العمل الخارجي) تكوينيّة، إلّا أنّ «التقييد» (تقييد العمل بذلك القيد) هو أمر تشريعيّ واعتباريّ تماماً. فالشارع هو الذي يحكم بجعله واعتباره بأنّ الصلاة يجب أن تكون «مقيَّدة» بالاستقبال. وهذا «التقييد» هو نفسه مجعول شرعيّ، والشرط هو أداة تحقيقه.
بناءً عليه، يمكن إلحاق الشرط، من حيث إنّه يتوقّف على أمر مجعول شرعيّ (أي التقييد)، بموضوع المجعول الشرعي. فيجري الاستصحاب في نفس الشرط، لأنّه في ارتباط وثيق مع مجعول شرعيّ، وهذا كافٍ لجريان الاستصحاب.
التعبير الثالث: المستصحَب هو «الأثر الشرعي» أو «ذو الأثر الشرعي»
يركّز هذا التعبير على «الأثر». وكان الإشكال هو أنّ الشرط (كالاستقبال) ليس هو نفسه أثراً شرعيّاً.
الحلّ: الجواب هو أنّ الشرط «ذو أثرٍ شرعيّ»؛ أي له أثر شرعيّ. وهذا هو نفس البيان الذي أشار إليه المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) في جوابه الأوّل.
وتوضيحه: أنّ «الشرطيّة» هي موضوع الأثر الشرعي (كجواز الدخول في الصلاة مثلاً). وبما أنّ «الشرطيّة» تُنتزَع من نفس «الشرط» ولهذين علاقة تحليليّة وغير قابلة للانفصام (كالفوق والفوقيّة)، فإنّ التعبّد بأحدهما هو التعبّد بالآخر. وعليه، يُعدّ «الشرط»، بواسطة انتزاع «الشرطيّة» منه، «ذا أثر شرعيّ». وجريان الاستصحاب في الشرط لإثبات الشرطيّة ليس بأصل مثبت، لأنّ هذه الواسطة (الشرطيّة) هي من اللوازم العقليّة غير المنفكّة والتحليليّة للمستصحَب، لا أمراً خارجيّاً مغايراً.
الجمع النهائي للأستاذ
يذكّر الأستاذ، بطرح هذه التعابير الثلاثة، أنّه حتّى مع قبول المباني الشائعة والأكثر تضييقاً من مبنى المرحوم الخوئي(قدسسره)، فلا يزال بالإمكان تصحيح جريان الاستصحاب في الشرط. وهذا الأمر يبيّن أنّ الإشكال المطروح قابل للجواب بتحليلات دقيقة ومن طرق مختلفة، وأنّ صحّة جريان الاستصحاب في الشرط أمر متين وقابل للدفاع.
وبهذا البيان، ينتهي بحثنا في المطلب الأوّل من التنبيه الثامن الذي تناول موارد الخروج عن الأصل المثبت. وخلاصته أنّه في موردين، تكون الواسطة متّحدة مع المستصحَب ويجري الاستصحاب:
١. اتّحاد الفرد والكلّيّ: كاستصحاب الفرد لترتيب حكم الكلّيّ.
٢. اتّحاد الأمر الانتزاعيّ مع منشأ انتزاعه: كاستصحاب الشرط لإثبات الشرطيّة.
وإنّ الفهم الدقيق لهذه الموارد، التي كانت محلّ تضارب آراء أعلام كالمحقّق الأصفهاني وصاحب الكفاية والمحقّق الخوئي(قدسسرهم)، يُعدّ من أكثر مباحث علم الأصول محوريّة.[2] [3]
المطلب الثاني: تعمیم المستصحب وجوداً و عدماً
في تتمّة المباحث المتعلّقة بالاستصحاب وخصائص المستصحَب، نصل إلى مطلب مهمّ وهو هل يجري الاستصحاب فقط في الأمور الوجوديّة (كبقاء حياة زيد) أم يجري في الأمور العدميّة أيضاً (كعدم وجود حياة زيد أو عدم وجود التكليف)؟ وهذا البحث، وإن بدا قليل الأهمّيّة في النظرة الأولى، إلّا أنّه يؤدّي دوراً محوريّاً في كثير من الاستدلالات الفقهيّة والأصوليّة، لا سيّما في بحث البراءة.
رأي صاحب الكفاية(قدسسره) في تعميم الاستصحاب:
للمرحوم صاحب كفاية الأصول، الآخوند الخراساني(قدسسره)، موقف واضح وقاطع في هذا الشأن. فهو يقول:
«لا تفاوت في المستصحب أو المترتّب بین أن یكون ثبوت الأثر و وجوده، أو نفیه و عدمه، ضرورة أنّ أمر نفیه بید الشارع كثبوته»[4] .
وبعبارة أخرى، فالاستصحاب يجري في إثبات وجود شيء كما يجري في إثبات عدمه. ودليله على هذا التعميم بسيط وبنيويّ جدّاً: «ضرورة أنّ أمر نفيه بيد الشارع كثبوته». أي كما أنّ أمر ثبوت ووجود حكم أو موضوع هو في اختيار ويد الشارع المقدّس (فالشارع يمكنه أن يوجب شيئاً أو يضع ملكيّة)، فإنّ أمر نفيه وعدمه هو بالكامل في اختيار الشارع أيضاً (فالشارع يمكنه أن يحرّم شيئاً أو يرفع تكليفاً). بناءً عليه، فلو كان ملاك جريان الاستصحاب هو أن يكون المستصحَب أمراً يتصرّف فيه الشارع، سواء كان ذلك التصرّف بالإيجاد أم بالإزالة، لوجب إذن أن يجري الاستصحاب في كلّ من الوجود والعدم.
ملاك جريان الاستصحاب في العدم:
ثم يشرح صاحب الكفاية(قدسسره) ملاك جريان الاستصحاب في الأمور العدميّة. فيقول: إنّ الملاك الرئيسي والأساسي لجريان الاستصحاب في العدم هو نفس «صدق نقض اليقين بالشكّ». وهذه العبارة هي جوهر دليل حجّيّة الاستصحاب التي تبيّن: كلّما تيقّنّا بشيء ثم شككنا في بقائه، فقد أمرنا الشارع بألّا ننقض يقيننا السابق وأن نبقى على نفس تلك الحالة السابقة (سواء كانت وجوداً أم عدماً).
إذن، حتّى لو كنت على يقين بعدم شيء (كيقينك بعدم حكم أو عدم وجود موضوع) ثم شككت في بقاء ذلك العدم، لكان «نقض اليقين بالشكّ» صادقاً أيضاً ولكان دليل الاستصحاب شاملاً له. وقد يُشكل بأنّ «العدم» نفسه ليس أثراً شرعيّاً، بل هو مجرّد لا شيء. فكيف يمكن إجراء الاستصحاب فيه؟ يجيب صاحب الكفاية(قدسسره) بأنّ هذا لا إشكال فيه[5] ؛ لأنّ «ملاك جريان الاستصحاب في العدم هو نفس صدق نقض اليقين بالشكّ… والأمر المستصحَب يجب أن يكون وضعاً ورفعاً بيد الشارع، والعدم هنا أيضاً وضعاً ورفعاً بيد الشارع». أي إنّ صدق نقض اليقين بالشكّ موجود في الأمر العدمي، ووضعه ورفعه (أي إنّ الشارع يمكنه إيجاده أو إزالته) هو بيد الشارع.
بناءً عليه، «فعدم إطلاق حكم عليه استصحاب عدم لا إشكال فيه، لأنّه ليس لدينا دليل على أنّه يجب حتماً أن يكون المستصحَب حكماً». وبعبارة أخرى، لا يلزم أن يكون المستصحَب حتماً حكماً شرعيّاً حتى يجري فيه الاستصحاب. فيكفي لجريان الاستصحاب أن يكون «العدم» أمراً قابلاً لتصرّف الشارع وأن نكون على يقين سابق به وأن نشكّ الآن في بقائه.
إشكال الشیخ(قدسسره) علی استصحاب البراءة
ينجرّ البحث في هذا القسم إلى أحد أهمّ تطبيقات الاستصحاب في الأمور العدميّة، أي استصحاب «البراءة» (رفع التكليف). فقد أورد المرحوم الشيخ الأنصاري(قدسسره) إشكالاً على استدلال استخدمه بعض الفقهاء لإثبات حجّيّة «أصالة البراءة» (أصل براءة الذمّة من التكليف). وهذا الاستدلال هو التمسّك باستصحاب البراءة المتيقَّنة في حال الصغر أو الجنون. أي إنّنا على يقين بأنّ الشخص في فترة طفولته أو جنونه لم يكن عليه تكليف وكانت ذمّته بريئة. والآن بعد أن بلغ وعقل، نشكّ فيما إذا كان قد وجب عليه تكليف أم لا؟ فيقول المستصحِبون: الحالة السابقة كانت عدم التكليف والبراءة، فنحكم الآن أيضاً بالبراءة بالاستصحاب.
وقد أورد المرحوم الشيخ الأنصاري(قدسسره) إشكالاً على هذا الاستدلال وبحثه من عدّة جهات:
«قد یستدلّ على البراءة بوجوه غیر ناهضة:
منها استصحاب البراءة المتیقّنة حال الصِغَر و الجنون.
و فیه: إنّ الاستدلال به مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ فیدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالّة على الحكم الواقعي دون الأصول المثبتة للأحكام الظاهریة، و سيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء الله[6] .
و أمّا لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهیة عن نقض الیقین بالشك، فلاینفع في المقام، لأنّ الثابت بها ترتّب اللوازم المجعولة الشرعیة على المستصحب، و المستصحب هنا لیس إلا براءة الذمّة من التكلیف و عدم المنع من الفعل و عدم استحقاق العقاب علیه [و في هذا التعبیر تسامح أو سقط].
و المطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل أو ما یستلزم ذلك [و ما یستلزم عدم ترتّب العقاب هو الجواز، فإنّ الجواز مستلزم لعدم ترتّب العقاب] إذ لو لمیقطع بالعدم [أي عدم العقاب] و احتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غیر بیان إلیه، حتّی یأمن العقل عن العقاب، و معه [أي مع انضمام قاعدة قبح العقاب بلا بیان] لا حاجة إلى الاستصحاب و ملاحظة الحالة السابقة.
و من المعلوم أنّ المطلوب المذكور [و هو الجواز و عدم العقاب على فعله] لایترتّب على المستصحبات المذكورة؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة لیس من اللوازم المجعولة حتّی یحكم به الشارع في الظاهر [بل عدم استحقاق العقاب هو من الأحكام العقلیة، لأنّ العقل یحكم بأنّ من خالف المولى مستحق للعقوبة و من لمیخالف فغیر مستحق لها، و الاستصحاب یجري في الأحكام الشرعیة لا في الأحكام العقلیة]» .[7] [8] [9]
الإشكال على مبنى كون الاستصحاب ظنّيّاً:
يقول الشيخ(قدسسره): لو كان الاستدلال باستصحاب البراءة مبنيّاً على أنّ الاستصحاب معتبر من باب «الظنّ» أو «الأمارة» (الدليل الكاشف عن الواقع)، لكان أصل البراءة المستفاد من هذا الطريق يقع في زمرة الأمارات التي تدلّ على الحكم الواقعي (أي إنّه لا يوجد تكليف واقعاً). ولكنّ الشيخ يثبت في المباحث التالية من أصوله (الواردة في كتاب «الرسائل») أنّ الاستصحاب من باب الظنّ ليس بحجّة ولا معتبر. فالاستصحاب هو «أصل عمليّ» يحدّد فقط الوظيفة الظاهريّة للمكلّف في مقام الشكّ، لا أنّه كاشف عن الواقع. بناءً عليه، فلو اعتبر أحد الاستصحاب ظنّيّاً، لكان هذا الاستدلال باطلاً.
الإشكال على مبنى كون الاستصحاب إخباريّاً (مبنى الشيخ(قدسسره) المختار):
ثم يشير الشيخ الأنصاري(قدسسره) إلى رأيه المختار في حجّيّة الاستصحاب. فهو يعتقد أنّ الاستصحاب معتبر من باب «الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ» (كرواية «لا تنقض اليقين بالشكّ»). ولكن يقول الشيخ(قدسسره): حتّى لو كان الاستصحاب معتبراً بناءً على هذا المبنى، فإنّه لا ينفعنا في هذا المورد (البراءة).
لأنّ ما يثبت بهذا النوع من الاستصحاب هو فقط «اللوازم المجعولة الشرعيّة» (اللوازم والآثار الشرعيّة التي جعلها واعتبرها الشارع نفسه) للمستصحَب. والمستصحَب هنا هو «براءة الذمّة من التكليف» (أي إنّ ذمّة الشخص خالية من التكليف)، ولازمها هو «عدم المنع من الفعل» (جواز أداء الفعل) و«عدم استحقاق العقاب» (عدم استحقاق العقوبة).
يقول الشيخ(قدسسره): لنفرض أنّك قد أجريت استصحاب براءة الذمّة من التكليف وتريد أن تثبت به «جواز الفعل» و«عدم استحقاق العقاب». فمطلوبك النهائي في الزمن اللاحق (الآن) هو «القطع بعدم ترتّب العقاب على الفعل»، ولازمه هو «الجواز». ولكنّ المشكلة هنا هي:
• لو كنت بعد الاستصحاب لا تزال تحتمل العقاب: ففي هذه الصورة، لكي تأمن من العقاب، يجب أن ترجع إلى قاعدة «قبح العقاب بلا بيان». وهذه القاعدة هي حكم عقليّ يقول إنّ العقل يرى من القبيح أن يعاقب الله عبده من دون إبلاغ التكليف. ولكن لو كان من المقرّر أن ترجع إلى هذه القاعدة العقليّة لرفع احتمال العقاب، فما الحاجة إذن إلى الاستصحاب؟ لكان الاستصحاب هنا لغواً وبلا فائدة، لأنّ العمل الرئيسي تقوم به القاعدة العقليّة.
• لو قطعت بعد الاستصحاب بعدم العقاب (وهو ما لا يصحّحه الشيخ(قدسسره)): يقول الشيخ(قدسسره) إنّ هذا ليس بصحيح؛ لأنّ «عدم استحقاق العقاب» ليس من الأحكام «المجعولة الشرعيّة» حتى يمكن ترتيبه مباشرةً على الاستصحاب. فعدم استحقاق العقاب هو «حكم عقليّ». فالعقل هو الذي يحكم بأنّ كلّ من يخالف المولى (الشارع) يستحقّ العقاب وكلّ من لا يخالف لا يستحقّ العقاب. والاستصحاب، الذي هو أصل عمليّ شرعيّ، يجري فقط في الأحكام الشرعيّة ولا يمكنه إثبات أو نفي الأحكام العقليّة مباشرةً.
وبعبارة أخرى، فإشكال الشيخ(قدسسره) هو أنّك تريد أن تثبت باستصحاب (وهو دليل شرعيّ) لازماً عقليّاً (عدم استحقاق العقاب)، والحال أنّ الاستصحاب لا يمكنه إثبات الأحكام العقليّة.
جوابان عن إشكال الشیخ الأعظم الأنصاري(قدسسره)
الجواب الأول: من صاحب الكفایة(قدسسره)
ننتقل الآن إلى بحث الأجوبة التي قُدِّمت على هذا الإشكال المهمّ للشيخ الأنصاري(قدسسره).
الجواب الأوّل: من صاحب الكفاية(قدسسره)
يقول المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) في جوابه على إشكال الشيخ الأنصاري(قدسسره):
«إنّ عدم استحقاق العقوبة و إن كان غیر مجعول إلا أنّه لا حاجة إلى ترتیب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع»[10] .
نعم، عدم استحقاق العقاب ليس مجعولاً شرعيّاً (أي إنّ الشارع لم يضعه)، ولكنّنا لا نحتاج إلى ترتيب أثر مجعول شرعيّ على استصحاب عدم المنع (أي استصحاب عدم التكليف).
يقول صاحب الكفاية(قدسسره): إنّ «عدم المنع من الفعل» (وهو نفس براءة الذمّة من التكليف وجواز الفعل)، وإن كان «استصحاباً عدميّاً» ولا نسمّيه مباشرةً «حكماً شرعيّاً»، إلّا أنّه لا يوجد مانع من جريان استصحابه.
لأنّ «وضعه ورفعه بيد الشارع». أي إنّ عدم المنع من الفعل هو من الأمور التي يمكن للشارع وضعها أو رفعها (فيمكنه مثلاً وضع منع أو رفعه).
بناءً عليه، فعلى الرغم من أنّ عدم المنع بذاته ليس حكماً شرعيّاً، إلّا أنّ استصحابه جائز، لأنّ الشارع يسيطر عليه وله السلطة عليه. فبعد جريان استصحاب «عدم المنع من الفعل» (وهو أمر ظاهريّ)، يترتّب عليه «عدم استحقاق العقاب».
ويقبل صاحب الكفاية(قدسسره) بأنّ عدم استحقاق العقاب هو «حكم عقليّ». ولكنّ النكتة المفصليّة هنا هي: «عدم استحقاق العقاب من الأحكام العقليّة التي تترتّب على مطلق عدم المنع، سواء كان ذلك عدم المنع واقعيّاً أم ظاهريّاً».
توضيح هذه النكتة المهمّة جدّاً: هذا يعني أنّ العقل لا يصدر حكمه بعدم استحقاق العقاب فقط في الحالة التي لا يوجد فيها تكليف «واقعاً»، بل يصدر نفس هذا الحكم أيضاً في الحالة التي يثبت فيها عدم التكليف «ظاهراً» (أي بسبب أمارة أو أصل عمليّ شرعيّ كلاستصحاب).
ولتوضيح أكثر، يمكن مقارنة هذا الموضوع بقاعدة «الفراغ والتجاوز»: ففي قاعدتي الفراغ والتجاوز، لو شكّ المكلّف في صحّة عمله، لحكم العقل من باب «وجوب دفع الضرر المحتمل» بلزوم الإعادة أو القضاء (أي يقول إنّه يجب عليك أن تؤدّيه مرّة أخرى لتطمئن). ولكن عندما يعلن الشارع المقدّس على نحو «تعبّديّ» (أي من باب القبول واللطف منه) أنّه «قد قبلتُ منكم هذا الامتثال» (كقاعدة الفراغ والتجاوز التي تقول إنّ صلاتك صحيحة)، ففي هذه الصورة، يزول موضوع الحكم العقلي لـ«وجوب دفع الضرر المحتمل». فلم يعد العقل يحكم بالإعادة، لأنّ الشارع نفسه قد رفع خطر العقاب وقال: «لا ضرر يلحقكم». وهذا يبيّن أنّ الأحكام العقليّة لا تلتفت فقط إلى الأمور الواقعيّة، بل تلتفت أيضاً إلى الأمور الظاهريّة (التي جعلها الشارع حجّة على نحو تعبّديّ) وتتأثّر بها.
إذن، فنتيجة كلام صاحب الكفاية(قدسسره) هي: أنّ استصحاب «البراءة المتيقَّنة في حال الصغر والجنون» يمكن استخدامه كدليل لـ«أصالة البراءة». لأنّ استصحاب عدم المنع من الفعل هو من الأمور التي يكون وضعها ورفعها في اختيار الشارع ويمكن أن يجري. ثم يترتّب عدم استحقاق العقاب (وهو حكم عقليّ) على عدم المنع هذا (سواء كان واقعيّاً أم ظاهريّاً).
مناقشة المحقّق الخوئي(قدسسره) في جواب صاحب الكفایة(قدسسره)
يورد المرحوم السيّد الخوئي إشكالاً على جواب صاحب الكفاية(قدسسرهما) فيقول:
«ما ذكره من الإشكال على الشیخ(قدسسره) فغیر وارد، لأنّ منع الشیخ(قدسسره) عن الاستدلال بالاستصحاب للبراءة لیس مبنیاً على عدم جریان الاستصحاب في العدمي، كیف؟ و قد ذكر في أوائل الاستصحاب في جملة الأقوال القول بالتفصیل بین الوجودي و العدمي، و ردّه بعدم الفرق بینهما من حیث شمول أدلّة الاستصحاب لهما.
بل منعه(قدسسره) عن استصحاب البراءة مبني على ما ذكره هناك من أنّه بعد جریان الاستصحاب إمّا أن یحتمل العقاب و إمّا أن لایحتمل، لكون الاستصحاب موجباً للقطع بعدم استحقاقه.
و على الأوّل فلابدّ في الحكم بالبراءة من الرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بیان، فلتكن هي المرجع من أوّل الأمر بلا حاجة إلى جریان الاستصحاب فإنّ الرجوع إلیه حینئذٍ لغو محض.
و الثاني غیر صحیح؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب لیس من الأحكام المجعولة الشرعیة حتّی یصحّ ترتّبه على الاستصحاب، بل هو من الأحكام العقلیة فلایترتّب على الاستصحاب المزبور»[11] .
يورد المحقّق الخوئي(قدسسره) هنا إشكالاً على صاحب الكفاية بأنّه قد ظنّ أنّ إشكال الشيخ الأنصاري(قدسسره) هو أنّ الاستصحاب لا يجري في الأمور العدميّة. والحال أنّ هذا التصوّر خاطئ! فالشيخ الأنصاري(قدسسره) نفسه هو من الذين ردّوا، في أوائل بحث الاستصحاب (في كتاب الرسائل)، القول بالتفصيل بين الاستصحاب الوجودي والعدمي (الذي قال به البعض)، وبيّنوا أنّه لا فرق بين الاستصحاب الوجودي والعدمي وأنّ كليهما يجري، لأنّ أدلّة الاستصحاب تشملهما معاً. بناءً عليه، فإنّ الشيخ الأنصاري(قدسسره) نفسه قائل بجريان الاستصحاب في كلّ من الأمور الوجوديّة والعدميّة. إذن، فإشكال الشيخ(قدسسره) يكمن في مكان آخر، وصاحب الكفاية(قدسسره) قد رأى إشكال الشيخ(قدسسره) خطأً في هذه النقطة.
ثم يبيّن المحقّق الخوئي(قدسسره) أنّ المنع الرئيسي للشيخ الأنصاري(قدسسره) من استصحاب البراءة يرتكز على مبنى آخر ذكره الشيخ(قدسسره) نفسه هناك (في الرسائل):
يقول الشيخ(قدسسره): بعد جريان الاستصحاب (للبراءة)، نواجه حالتين:
أ) إمّا أن يبقى احتمال العقاب موجوداً: وفي هذه الصورة، للحكم بالبراءة ورفع التكليف، يجب الرجوع إلى قاعدة «قبح العقاب بلا بيان». ولو كان الأمر كذلك، لكان الاستصحاب من البداية لغواً وبلا فائدة، لأنّ رفع احتمال العقاب تقوم به القاعدة العقليّة ولا حاجة إلى الاستصحاب.
ب) وإمّا أن لا يكون هناك احتمال للعقاب، بل يحصل الجزم والقطع بعدم استحقاق العقاب: فيقول الشيخ(قدسسره): هذه الحالة الثانية ليست صحيحة.
لأنّ «عدم استحقاق العقاب» ليس من الأحكام «المجعولة الشرعيّة» حتى يمكن ترتيبه مباشرةً على الاستصحاب (أي أن يثبته الاستصحاب كأثر شرعيّ). بل إنّ عدم استحقاق العقاب هو «حكم عقليّ»، والأحكام العقليّة لا تترتّب على الاستصحاب (الذي هو أصل عمليّ شرعيّ).
وبعبارة أخرى، يقول المحقّق الخوئي(قدسسره): إنّ صاحب الكفاية(قدسسره) لم يفهم إشكال الشيخ(قدسسره) الرئيسي بشكل صحيح. فإشكال الشيخ(قدسسره) ليس هو أنّ الاستصحاب لا يجري في العدمي، بل إشكاله هو أنّه عندما تجري استصحاب براءة الذمّة، كيف يمكنك أن ترتّب عليه «عدم استحقاق العقاب» الذي هو حكم عقليّ؟ وهذه هي النقطة التي يجب حلّها.
الجواب الثاني: من المحقّق الخوئي(قدسسره)[12]
يقدّم المرحوم المحقّق الخوئي(قدسسره)، في تتمّة كلامه، الجواب النهائي والصحيح على إشكال الشيخ الأنصاري(قدسسره). فيقول: إنّ ما ذكره صاحب الكفاية(قدسسره) في «التنبيه التاسع» من كتاب «كفاية الأصول»[13] هو نفس الجواب الصحيح على إشكال الشيخ الأنصاري(قدسسره) (وإن كان صاحب الكفاية(قدسسره) ربّما لم يطرحه كجواب على هذا الإشكال الخاصّ، ولكنّ المحقّق الخوئي(قدسسره) يوضّحه ويقرّره).
تقرير الجواب الصحيح: قال المرحوم الشيخ الأعظم(قدسسره) إنّه بعد جريان الاستصحاب، إمّا أن يبقى احتمال العقاب وإمّا أن يحصل الجزم بعدم العقاب. فيقول المحقّق الخوئي(قدسسره): نحن نختار الشقّ الثاني ونقول: نعم، لدينا جزم بعدم العقاب.
والآن السؤال هو: من أين يحصل هذا الجزم بعدم العقاب؟ وهل هو عن طريق الاستصحاب كَلازم شرعيّ؟ كلّا. يوضّح المحقّق الخوئي(قدسسره): «بعد إحراز البراءة من التكليف ظاهراً، بجريان استصحاب البراءة، يحكم العقل على نحو وجدانيّ بعدم استحقاق العقاب». والنكتة الدقيقة والمفصليّة جدّاً هنا هي: «عدم استحقاق العقاب» ليس من لوازم الاستصحاب المباشرة، بل هو حكم عقليّ يصدره العقل بشكل مستقلّ، بسبب تحقّق موضوعه.
توضيح أكثر وتبيين موضوع الحكم العقلي: إنّ موضوع حكم العقل بـ«عدم استحقاق العقاب» هو إحراز عدم التكليف، سواء تحقّق عدم التكليف هذا «واقعاً» أم «ظاهراً». فعندما يجري استصحاب البراءة ويقول لنا إنّه «لا تكليف» (على نحو ظاهريّ وتعبّديّ)، فإنّ موضوع الحكم العقلي (إحراز عدم التكليف) يكون قد تحقّق في الواقع. فالعقل عندما يرى أنّ الشارع قد أعلن على نحو تعبّديّ أنّه لا تكليف، لم يعد يرى نفسه ملزماً بالحكم باستحقاق العقاب.
مثال قاعدة الفراغ والتجاوز (توضيح مجدّد لتثبيت الفهم): هذا يشبه تماماً نفس البحث الذي كان لدينا في قاعدة الفراغ والتجاوز. فهناك، كان العقل من باب «دفع الضرر المحتمل» يحكم بأنّه لو شككت في صحّة صلاتك، لوجب عليك أن تعيدها لتطمئن. ولكن عندما يعلن الشارع بقاعدة الفراغ والتجاوز على نحو تعبّديّ أنّه «قد قبلتُ منكم هذا الامتثال»، لم يعد العقل يرى موضوعاً للحكم بـ«دفع الضرر المحتمل». فيقول العقل: «إنّ موضوعي (احتمال الضرر وعدم إحراز الامتثال) لم يعد متحقّقاً، لأنّ الشارع نفسه قد قال على نحو تعبّديّ إنّه لا ضرر وإنّ الامتثال قد حصل».
الاستنتاج النهائي للمحقّق الخوئي(قدسسره): إذن، نحن لا نقول إنّنا نجري استصحاب عدم التكليف ويكون «عدم استحقاق العقاب» لازمه العقلي الذي يُرتَّب عليه. (وهذا هو نفس الخطأ الذي تصوّر الشيخ الأنصاري أنّنا نرتكبه). بل نحن نجري استصحاب «عدم التكليف» (وهو أمر ظاهريّ وتعبّديّ)، والعقل، بشكل مستقلّ، عندما يرى أنّ التكليف قد نُفي على نحو ظاهريّ، لم يعد يرى موضوعاً للحكم بـ«استحقاق العقاب». فموضوع استحقاق العقاب هو حيث يكون هناك احتمال للتكليف ولم يُنفَ التكليف، لا واقعاً ولا ظاهراً. أمّا هنا، فقد نُفي التكليف على نحو ظاهريّ وقد عبّدنا الشارع بـ«عدم التكليف». بناءً عليه، فإنّ الإشكال الذي قاله الشيخ الأنصاري(قدسسره) (بناءً على أنّ عدم استحقاق العقاب هو حكم عقليّ ولا يُرتَّب على الاستصحاب) يُحلّ؛ لأنّنا لا نرتّبه كَلازم للاستصحاب، بل إنّ العقل يحكم بعدم استحقاق العقاب بشكل مستقلّ وبتحقّق موضوعه.
وبهذا الجواب الدقيق والقويّ جدّاً من المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره)، ينتهي بحثنا في هذا التنبيه أيضاً بالكامل. وقد انتهى هذا المجلّد (المجلّد الحادي عشر) الذي شمل حتّى هذا التنبيه الثامن. وسنتابع إن شاء الله في الجلسات القادمة تتمّة مباحث الاستصحاب من المجلّد الثاني عشر من الأصول.


