46/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ ثلاثة موارد لا تكون من الأصل المثبت؛ الكلام في المورد الثالث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
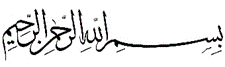
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ ثلاثة موارد لا تكون من الأصل المثبت؛ الكلام في المورد الثالث
بيان المحقّق الأصفهاني(قدسسره) في القسم الأوّل من الوضعيّات (الشرطيّة للتكليف)
نصل الآن إلى قلب استدلال وذروة تحليل المحقّق الأصفهاني(قدسسره) في هذا البحث. فهو بعد التمييز بين المباني المختلفة في باب جعليّة الأحكام الوضعيّة، يتوجّه إلى القسم الأوّل من تقسيم صاحب الكفاية(قدسسره) الثلاثي؛ أي حيث نتعامل مع عناوين كالـ«سببيّة» و«الشرطيّة» و«المانعيّة» لنفس «التكليف». وفي هذا القسم، كما نتذكّر، لم يكن نفس صاحب الكفاية(قدسسره) يرى جريان الاستصحاب. ويقدّم المحقّق الأصفهاني(قدسسره) هنا، بنظرته الدقيقة والموشّحة، استدلالاً مختلفاً وأعمق لعدم فائدة الاستصحاب في هذا القسم. يقول(قدسسره):
و قال المحقّق الإصفهاني(قدسسره) بالنسبة إلى القسم الأوّل:
«و أمّا بناء على مجعولیتهما [أي مجعولیة الشرطیة و المانعیة للتكلیف كما هو مختار المحقّق الإصفهاني(قدسسره) حیث اختار الجعل بالعرض] فإن كان المهم إثبات نفسهما [أي نفس السببیة أو الشرطیة أو المانعیة للتكلیف] فلا كلام [في جریان الاستصحاب] فإنّ المستصحب حكم شرعي جعلي [بالجعل بالعرض] على الفرض و لا حاجة إلى أثر آخر و إن كان المهمّ إثبات التكلیف، فهو کما عرفت مرتّب على ذات الشرط و المانع لا على الشرطیة و المانعیة حتّی بناء على المجعولیة، كیف؟ و هما مجعولتان بتبع جعل التكلیف و مترتّبتان على ترتّبه [أي ترتّب التكلیف] على ذات الشرط و المانع، فكیف یعقل أن یكون التعبّد بهما [أي بالشرطیة و المانعیة و استصحابهما] تعبّداً بما [أي بالتكلیف الذي] یترتّبان [أي الشرطیة و المانعیة] علیه».[1]
يبدأ أوّلاً بالبحث بناءً على رأيه المختار، أي «المجعوليّة بالعرض» لهذه العناوين، فيقول إنّه يجب أن نرى ما هو هدفنا وغرضنا النهائي من إجراء الاستصحاب هنا. ويميّز بين هدفين متصوَّرين:
الهدف الأوّل (إثبات نفس الشرطيّة): استصحاب لا إشكال فيه ولكنّه غالباً عديم الفائدة
يقول المحقّق الأصفهاني(قدسسره) إنّه لو كان هدفنا من إجراء الاستصحاب هو مجرّد إثبات بقاء نفس عنوان «الشرطيّة» أو «المانعيّة»، ولو افترضنا أنّ هذا العنوان نفسه له أثر شرعيّ آخر بشكل مستقلّ، ففي هذه الصورة، لا مانع من إجراء الاستصحاب؛ لأنّ مستصحبنا (أي الشرطيّة) هو بناءً على الفرض حكم شرعيّ جعليّ (وإن كان بالجعل بالعرض) وأركان الاستصحاب تامّة فيه. وفي هذه الحالة، نحن نستصحب مجرّد حكم وضعيّ لنرتّب عليه الأثر الشرعي لنفس ذلك الحكم الوضعي، ولا حاجة إلى توسيط أمر آخر.
ولكنّ الحقيقة هي أنّه في المباحث الأصوليّة، نادراً ما يحدث أن نكون بصدد إثبات «الشرطيّة» لـ«الشرطيّة» نفسها؛ فمثل هذا البحث له جانب فرضيّ ونادر. فالهدف الرئيسي ومحلّ ابتلائنا في مقام البحث هو أمور أخرى.
الهدف الثاني (إثبات التكليف): استصحاب غير معقول ومستحيل منطقيّاً
وهنا يتجلّى الإشكال الرئيسي والتحليل الدقيق للمحقّق الأصفهاني(قدسسره). فالهدف الواقعي والنهائي لنا في هذا القسم عادةً هو أن نثبت وجود نفس «التكليف» باستصحاب «الشرطيّة». فمثلاً، شككنا في بقاء بلوغ شخص؛ فنريد استصحاب «شرطيّة البلوغ للتكليف» لنستنتج أنّ «التكليف» لا يزال باقياً على عهدته. أو شككنا في وجود مانع للتكليف؛ فنستصحب «المانعيّة» لنستنتج أنّ «التكليف» لا يزال غير موجود.
يعتبر المحقّق الأصفهاني(قدسسره) هذا المسار، باستدلال منطقيّ قويّ وجميل جدّاً، ليس عديم الفائدة فحسب، بل «غير معقول». فهو يستدلّ على هذا النحو بأنّ هذه المحاولة مبنيّة على خطأ فادح في فهم العلاقة العلّيّة والمعلوليّة بين هذه المفاهيم.
بحث استدلال المحقّق الأصفهاني(قدسسره):
لفهم عمق كلامه، يجب أن نتتبّع هذه السلسلة من المراتب المنطقيّة خطوة بخطوة:
الخطوة الأولى: التكليف معلول ماذا؟ أوّل وأهمّ سؤال هو: ما الذي يسبّب وجود «التكليف»؟ الجواب واضح: التكليف يترتّب على وجود «ذات الشرط» وعدم «ذات المانع». أي إنّ الوجود الخارجي والواقعي للبلوغ هو الذي يفعِّل التكليف، لا العنوان الذهني والانتزاعي لـ«شرطيّة البلوغ». فالتكليف يترتّب على أمر عينيّ وواقعيّ في الخارج.
الخطوة الثانية: الشرطيّة معلول ماذا؟ والآن يجب أن نسأل: من أين يأتي نفس عنوان «الشرطيّة»؟ الشرطيّة ليست وجوداً خارجيّاً مستقلاً. بل هي عنوان تحليليّ وانتزاعيّ يخلقه ذهننا بعد مشاهدة العلاقة بين «ذات الشرط» و«التكليف». وبعبارة أخرى، يجب أوّلاً أن يكون هناك «تكليف» قد ترتّب على «شرط»، حتى نتمكّن من انتزاع وفهم عنوان «الشرطيّة» من هذه العلاقة. إذن، «الشرطيّة» هي معلول ومنتج لوجود «التكليف المترتّب على الشرط».
الخطوة الثالثة: كشف الدور الباطل وعدم المعقوليّة: بوضع هاتين الخطوتين جنباً إلى جنب، يتشكّل دور منطقيّ واضح وغير قابل للإنكار:
١. وجود «ذات الشرط» ← هو علّة وجود «التكليف».
٢. وجود «التكليف» ← هو علّة انتزاع عنوان «الشرطيّة».
والآن، كيف يمكن باستصحاب «الشرطيّة» (التي هي معلول المعلول) إثبات «التكليف» (الذي هو علّتها)؟ فهذا العمل يشبه محاولة إثبات وجود النار باستصحاب وجود الدخان؛ والحال أنّ الدخان نفسه فرع على وجود النار. فهذه المحاولة لإثبات العلّة من خلال المعلول هي استدلال معكوس وباطل منطقيّاً.
الاستنتاج النهائي من كلام المحقّق الأصفهاني(قدسسره):
بناءً عليه، يبيّن المحقّق الأصفهاني(قدسسره) بهذا التحليل الدقيق أنّ محاولة إثبات التكليف عن طريق استصحاب الشرطيّة هي محاولة عقيمة وغير مثمرة. وهذا الاستصحاب لا فائدة فيه، ليس لأنّ أركانه غير تامّة، بل لأنّه لا ينتج النتيجة التي نرجوها من الناحية المنطقيّة. فعندما يكون هدفك إثبات التكليف، يجب أن تتوجّه إلى استصحاب «الموضوع» أو «ذات الشرط». والتوسّل باستصحاب «الشرطيّة» للوصول إلى «التكليف» هو طريق تحليليّ مختصر يصل إلى طريق منطقيّ مسدود، ولهذا السبب يصفه المحقّق الأصفهاني(قدسسره) بأنّه أمر «غير معقول».
إيراد الأستاذ على المحقّق الأصفهاني(قدسسره)
بعد أن بحثنا الاستدلال الدقيق والمعقّد في الوقت نفسه للمحقّق الأصفهاني(قدسسره) القائم على عدم فائدة وعدم معقوليّة استصحاب الشرطيّة لإثبات التكليف، تصل النوبة الآن إلى تقديم نقد ومناقشة أساسيّة لهذا الرأي ورأي صاحب الكفاية(قدسسره). ويسعى هذا النقد، بالعودة إلى الأصول البنيويّة للبحث وبالاستعانة بقاعدة مفصليّة من المحقّق النائيني(قدسسره)، إلى فتح الطريق المسدود الذي يبدو أنّه قد نشأ في كلام هذين العلمين، وتقديم مسار واضح للوصول إلى النتيجة المطلوبة، أي إثبات التكليف.
إعادة قراءة الهدف الأصلي
لفهم هذه المناقشة بدقّة، يجب أن نعود إلى نقطة انطلاق البحث في المورد الثالث. فما هو أصل مدّعى صاحب الكفاية(قدسسره)؟ كان يريد أن يقول: «جريان الاستصحاب في الشرط لإثبات الشرطيّة ليس أصلاً مثبتاً». ودليل عدم المثبتيّة هذا كان نكتة مفصليّة: فمن وجهة نظر العرف، «الشرط» و«الشرطيّة» ليسا وجودين مستقلّين ومنفصلين حتى يكون أحدهما لازماً والآخر ملزوماً. بل إنّ «الشرطيّة» وصف انتزاعيّ وغير منفصل عن نفس «الشرط»؛ فهذان مرتبطان ومتشابكان إلى درجة أنّ التعبّد بأحدهما يُعتبر عيناً وعرفاً تعبّداً بالآخر.
وهذا مقبول إلى هنا، وهذا المبنى نفسه هو الذي فتح الطريق للاستصحاب. ولكنّ المشكلة بدأت من حيث إنّ صاحب الكفاية(قدسسره) وتبعه المحقّق الأصفهاني(قدسسره)، بعد عبور هذه المرحلة والوصول إلى «الشرطيّة»، قد أغلقا الطريق فجأة. فقالا: «لقد وصلت باستصحاب الشرط إلى التعبّد بالشرطيّة؛ ولكن لم يعد بإمكانك إثبات التكليف بهذه الشرطيّة!».
وكان استدلالهما: أنّ التكليف هو الأثر الشرعي لـ«ذات الشرط»، لا الأثر الشرعي لعنوان «الشرطيّة» الانتزاعيّ. وبما أنّ ترتّب التكليف على الشرطيّة ليس ترتّباً شرعيّاً مباشراً، فلا يمكن ترتيب هذا الأثر بالاستصحاب.
القاعدة المفيدة للمحقّق النائيني(قدسسره)
وهنا تبدأ مناقشة الأستاذ بطرح قاعدة مفصليّة، قصيرة ولكنّها غنيّة بالمعاني، من المرحوم الميرزا النائيني(قدسسره). وتلك القاعدة هي: «كلّ شرطٍ موضوعٌ».
تتضمّن هذه العبارة القصيرة أصلاً أصوليّاً عميقاً. ومعناها هو أنّ كلّ «شرط» يُعتبر لحكم ما ليس أمراً خارجيّاً وأجنبيّاً عن الموضوع، بل هو نفسه «جزء الموضوع» لذلك الحكم. فـ«موضوع» حكم ما هو مجموعة من القيود والشروط التي يتفعّل الحكم بتحقّقها الكامل. بناءً عليه، فـ«الشرط» هو جزء من هويّة ومقوِّمات نفس الموضوع، لا أمر هامشيّ.
والآن، بوجود هذا المفتاح (كون الشرط موضوعاً) وبالنظر إلى أصل البحث الأوّلي (وحدة الشرط والشرطيّة)، يمكننا أن نتحدّى استدلال صاحب الكفاية والمحقّق الأصفهاني بالكامل. ويمكن القيام بهذا العمل من خلال مسارين منطقيّين وواضحين:
المسار الأوّل: البدء من استصحاب «الشرط» (المسار المباشر)
١. نستصحب «الشرط» طبقاً لأصل البحث (كاستصحاب بقاء الطهارة أو بقاء البلوغ).
٢. وقد قبل نفس المحقّق الأصفهاني(قدسسره) أيضاً صراحةً بأنّ التكليف مترتّب على «ذات الشرط».
٣. وبالاستناد إلى القاعدة المذكورة، فإنّ هذا «الشرط» هو نفس «جزء الموضوع» للتكليف.
٤. والعلاقة بين «الموضوع» و«حكمه» هي علاقة مباشرة وبلا واسطة وشرعيّة. وهذا من أوضح أصول الفقه والأصول.
٥. النتيجة: إذن، فعندما نثبت بالاستصحاب «الشرط» الذي هو نفس «جزء الموضوع»، يجب ترتيب أثره الشرعي المباشر، أي «التكليف»، من دون أيّ واسطة أو بحث إضافيّ. وفي هذا المسار، لا نحتاج أصلاً إلى جرّ البحث نحو «الشرطيّة» وإدخال أنفسنا في استدلالات معقّدة ودور باطل للعلّة والمعلول.
المسار الثاني: البدء من استصحاب «الشرطيّة»
والآن لنفرض أنّنا نريد أن نسلك تماماً نفس المسار الذي سلكه السادة وأن نركّز البحث على «الشرطيّة».
١. نستصحب «الشرطيّة».
٢. وكما قلنا في البداية، فإنّ دليل عدم المثبتيّة هنا هو الوحدة العرفيّة لـ«الشرط» و«الشرطيّة». وهذه طريق ذات اتّجاهين؛ فلو كان التعبّد بالشرط هو التعبّد بالشرطيّة، لوجب إذن أن يكون التعبّد بالشرطيّة هو عين التعبّد بالشرط أيضاً. فهذان كالروح والجسد لبعضهما البعض ولا ينفصلان. فلا يمكن قبول أحدهما وإنكار الآخر.
٣. إذن، فعندما نتعبّد بـ«الشرطيّة»، فإنّنا في الحقيقة قد تعبّدنا بـ«ذات الشرط» أيضاً.
٤. وطبقاً للقاعدة المذكورة، فإنّ «ذات الشرط» هذه هي نفس «جزء الموضوع» للتكليف.
٥. النتيجة: وصلنا مرّة أخرى إلى نفس النقطة. فبالتعبّد بالشرطيّة، وصلنا إلى موضوع التكليف، وعندما يثبت الموضوع، يجب ترتيب أثره الشرعي أي «التكليف».
وحاصل القول إنّ الإشكال الوارد على كلام صاحب الكفاية والمحقّق الأصفهاني هو نوع من الاضطراب في المبنى وعدم الانسجام في التحليل. فهما لدفع محذور «الأصل المثبت» في المرحلة الأولى - أي من الشرط إلى الشرطيّة - قد تمسّكا بالوحدة العرفيّة لهما وقبلا بها؛ ولكنّهما في المرحلة الثانية - أي من الشرطيّة إلى التكليف - قد تجاهَلا هذه الوحدة نفسها وفصلا بينهما بفصل تحليليّ عقليّ وقالا إنّ التكليف هو أثر لـ«الشرط» لا أثر لـ«الشرطيّة».
ويرى الأستاذ هذا الفصل غير تامّ ويبيّن: أنّ نفس الملاك الذي أوجب جواز جريان الاستصحاب في المرحلة الأولى (أي وحدة الشرط والشرطيّة) هو بعينه جارٍ في المرحلة الثانية أيضاً، ولهذا السبب نفسه يجب قبول أثره النهائي، أي ترتّب التكليف؛ لأنّ هذا «الشرط» الواحد هو نفس «موضوع» التكليف، والنسبة بين الموضوع والحكم هي نسبة مباشرة وشرعيّة وغير قابلة للفصل. بناءً على هذا، فإنّ التفصيل بين القسم الأوّل والثاني من الوضعيّات وادّعاء عدم فائدة الاستصحاب في القسم الأوّل لا سند محكم وتامّ له، ومقتضى الصناعة هو أنّ الاستصحاب قابل للجريان ومثبت للتكليف في كلا القسمين.


