46/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه السابع؛ المطلب الرابع؛ الفرع الرابع: استصحاب عدم السرایة و استصحاب الحیاة/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
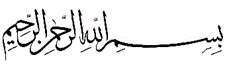
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه السابع؛ المطلب الرابع؛ الفرع الرابع: استصحاب عدم السرایة و استصحاب الحیاة
تحليل أقوال الفقهاء في الفرع الرابع (مسألة القتل والنزاع في سببه)
بعد أن بيّنا في الجلسة السابقة مثالين مهمّين من تمسّك القدماء بالأصل المثبت في باب الجنايات (أحدهما النزاع حول سراية الجراحة والآخر النزاع حول حياة المقتول)، ننتقل الآن إلى البحث الدقيق لأقوال وآراء الفقهاء العظام المختلفة في هذه المسألة. فهذه المسألة، التي يدّعي فيها الجاني الموت السابق للمجنيّ عليه ويدّعي أولياء الدم حياته، كانت منذ القدم محلّ اختلاف في الرأي وطُرحت حولها ثلاثة آراء رئيسيّة.
مقدّمة: الإطار العامّ للاختلاف بناءً على نقل الشيخ الأنصاري(قدسسره)
قبل أن نبحث كلّ قول من الأقوال بالتفصيل، من الضروري أن نلتفت إلى نكتة مفصليّة تُستفاد من عبارة المرحوم الشيخ الأنصاري(قدسسره). فالظاهر من عبارة الشيخ الأنصاري(قدسسره) هو أنّ جميع الفقهاء متّفقون على أنّ هناك استصحابين يتعارضان. أي إنّ أصل النزاع والنقطة المحوريّة للبحث هو وجود تعارض بين «استصحاب حياة المجنيّ عليه» (الذي نتيجته الضمان) و«استصحاب عدم الضمان». فكأنّ جميع الفقهاء قد قبلوا هذا الإطار، ولكنّ اختلافهم قد برز في المرحلة التالية، أي في كيفيّة حلّ هذا التعارض. وبناءً على ذلك، يمكن تفسير الأقوال الثلاثة بثلاث طرق مختلفة لحلّ هذا التعارض:
• الطريقة الأولى: ترجيح استصحاب عدم الضمان.
• الطريقة الثانية: ترجيح استصحاب الحياة.
• الطريقة الثالثة: عدم الترجيح والحكم بالتكافؤ والتوقّف. والآن، بهذه المقدّمة، نتناول بالتفصيل كلّ حلّ من هذه الحلول الثلاثة وكلّ قول.
القول الأوّل: عدم الضمان (ترجيح استصحاب عدم الضمان)
يُنسب هذا الرأي إلى فقهاء كبار كالمحقّق الحلّي(قدسسره) في كتاب الشرائع[1] والشهيد الثاني(قدسسره) في المسالك[2] .
ومبنى هذا القول بسيط وواضح جدّاً ومبنيّ على القواعد الكلّيّة للأصول. فهم في مقام تعارض أصلين، قد أخذوا جانب الاستصحاب الحكمي، أي «أصالة عدم الضمان» أو نفس أصل براءة الذمّة، وقدّموه على الاستصحاب الموضوعي. واستدلالهم هو أنّ استصحاب الحياة لإثبات وقوع القتل هو أصل مثبت واضح، والأصول المثبتة ليست بحجّة. وعندما يسقط الاستصحاب الموضوعي (استصحاب الحياة) عن الحجّيّة لكونه مثبتاً، تصل النوبة إلى الأصل الحكمي. فنحن هنا نشكّ في اشتغال ذمّة الجاني بالديّة أو القصاص، ومقتضى الأصل هو براءة ذمّته. ونتيجة لذلك، يحكمون بعدم الضمان.
القول الثاني: ثبوت الضمان (ترجيح استصحاب الحياة)
تُنسب هذه النظريّة، التي تقع تماماً في مقابل القول الأوّل ولها نتيجة مختلفة تماماً، إلى الفقيه الكبير العلّامة الحلّي(قدسسره)[3] [4] .. فهو قائل بضمان الجاني.
فالعلّامة الحلّي(قدسسره)، خلافاً للقول الأوّل، يرى استصحاب الحياة جارياً ومعتبراً ومقدَّماً. ويعتقد أنّ «استصحاب بقاء الحياة إلى زمان تحقّق القدّ [ضربة السيف]» يوجب ثبوت موضوع القتل بشكل معتبر، ونتيجة لذلك، يثبت الضمان على عهدة الجاني.
واستدلاله، الذي يشبه كثيراً مبنى صاحب الكفاية(قدسسره) في موارد الاستثناء، يمكن صياغته على هذا النحو: القتل معلول ويحتاج إلى علّة تامّة. وفي مسألتنا مورد البحث:
• مقتضي القتل: هو نفس العمل الخارجي أي ضربة السيف والقدّ نصفين، ووجوده مُحرَز لنا بالعلم الوجداني والقطعي.
• شرط تأثير المقتضي: هو حياة المجنيّ عليه لحظة وقوع الجناية.
وهذا الشرط الحيويّ، وإن كان مشكوكاً لنا، إلّا أنّه يُحرَز بـ«أصل استصحاب الحياة» على نحو تعبّديّ. وبضمّ المقتضي المُحرَز بالوجدان إلى الشرط المُحرَز بالأصل، تتشكّل العلّة التامّة على نحو تعبّديّ ويثبت معلولها (أي وقوع القتل) أيضاً. «هذا المثال من الموارد التي قيل فيها بحجّيّة الأصل المثبت تبعاً لصاحب الكفاية».
القول الثالث: التردّد والتوقّف (الحكم بتكافؤ الأصلين)
يُنسب هذا الرأي، الذي لا يأخذ بجانب القول الأوّل ولا القول الثاني وينتهي في النهاية إلى التوقّف في المسألة، إلى شيخ الطائفة، المرحوم الشيخ الطوسي(قدسسره) في كتابه القيّم المبسوط([5] ).
فالشيخ الطوسي(قدسسره) يرى أنّ كلا الاستصحابين، أي «استصحاب حياة المجنيّ عليه» من جهة، و«استصحاب عدم الضمان» من جهة أخرى، لهما نفس القدرة والاعتبار ولا يوجد أيّ دليل أو مرجِّح لتفوّق أحدهما على الآخر.
والاستدلال هو أنّك من جهة تريد أن تثبت الضمان باستصحاب الحياة. ومن جهة أخرى، فإنّ الأصل العملي المسلَّم هو البراءة من الضمان. فهذان الأصلان يقعان في مقابل بعضهما البعض، وبما أنّه لا تفوّق لأيّ منهما على الآخر، فإنّهما يتعارضان ويتساقطان. ونتيجة هذا التعارض والتساقط هو «التردّد» والتوقّف في الفتوى، ولا يمكن للقاضي أن يحكم بشكل قطعيّ بالضمان أو عدم الضمان.[6]
بناءً عليه، فكما يتّضح من تحليل الشيخ الأنصاري(قدسسره)، فإنّ نقطة اشتراك الفقهاء هي إدراك وجود تعارض، ولكنّ نقطة افتراقهم هي في كيفيّة مواجهة هذا التعارض، ممّا أدّى إلى ثلاثة أحكام مختلفة تماماً هي عدم الضمان، والضمان القطعي، والتوقّف في المسألة.[7]
إیراد المحقّق الخوئي(قدسسره) علی القول بالتردّد [8]
بعد أن بيّنا في الجلسة السابقة الأقوال الثلاثة الرئيسيّة في مسألة تعارض «استصحاب الحياة» و«استصحاب عدم الضمان»، ننتقل الآن إلى البحث والنقد الدقيق للقول الثالث، أي القول بالتردّد المنسوب إلى الشيخ الطوسي(قدسسره). فقد أورد المرحوم المحقّق الخوئي(قدسسره) إيراداً قويّاً وأساسيّاً جدّاً على هذا الرأي سنبيّنه بالتفصيل ثم نناقشه.
مقدّمة: أهمّيّة المسألة والمصاديق المعاصرة لها
قبل الدخول في الإيراد الفنّيّ للمرحوم السيّد الخوئي(قدسسره)، من المناسب الإشارة إلى الأهمّيّة التطبيقيّة لهذا البحث. فهذه المسألة ليست مجرّد نزاع تاريخيّ في كتب القدماء، بل «تكثر الموارد الشبيهة بهذه في عصرنا هذا». فمثلاً، يصطدم سائق بشخص يعاني من نوبة قلبيّة حادّة ويتوفّى ذلك الشخص. فيدّعي السائق أنّ الموت كان ناتجاً عن السكتة القلبيّة ولا علاقة له بالاصطدام. وفي المقابل، ينسب أولياء الدم الموت إلى الاصطدام. فهنا أيضاً نواجه تماماً نفس النزاع: هل يجب إجراء استصحاب الحياة واعتبار السائق ضامناً أم التمسّك بأصل عدم الضمان وتبرئته؟ أو هل يجب، كالشيخ الطوسي(قدسسره)، التوقّف والتردّد في المسألة؟ وهذه المصاديق تضاعف أهمّيّة التحليل الدقيق لهذه الأقوال.
عدم وجود وجه للتردّد يرفض المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره) بقطعيّة تامّة القول بالتردّد ويقول:
«أمّا التردّد المنسوب إلى الشیخ(قدسسره) فلا وجه له أصلاً فإنّه على تقدیر القول بالأصل المثبت لا إشكال في الحكم بالضمان كما علیه العلامة(قدسسره).
و على تقدیر القول بعدم حجّیته [أي حجیة الأصل المثبت] لا إشكال في عدمه [أي عدم الضمان] كما علیه المحقّق(قدسسره) [و الشهید الثاني(قدسسره)].
فالتردّد في غیر محلّه على كلّ تقدیر، إلا أن یكون تردّده لأجل تردّده في حجّیة الأصل المثبت؛ لكنّه خلاف التعلیل المذكور في كلامه(قدسسره)، فإنّه علّل التردّد بتساوي الاحتمالین، أي احتمال كون القتل بالسرایة و احتمال كونه بسبب آخر، فلایكون منشأ تردّده في الحكم بالضمان هو التردّد في حجّیة الأصل المثبت».
أي إنّ التردّد المنسوب إلى الشيخ الطوسي(قدسسره) لا أساس له ولا مبنى بأيّ وجه. ويرتكز استدلاله على تقسيم حاصر ومنطقيّ يغلق الباب أمام أيّ تردّد. فيقول:
أنت كفقيه، عند مواجهة هذه المسألة، مضطرّ لتحديد موقفك تجاه مسألة أصوليّة بنيويّة، أي «حجّيّة الأصل المثبت». والأمر لا يخرج عن حالين:
التقدير الأوّل: أن تكون قائلاً بحجّيّة الأصل المثبت
لو كنت (كالعلّامة الحلّي(قدسسره)) ترى الأصل المثبت حجّة في مثل هذه الموارد، ففي هذه الصورة، يجري استصحاب الحياة ويثبت وقوع القتل، وتبعاً له، يثبت الضمان على عهدة الجاني. إذن، في هذا الفرض، «لا إشكال في الحكم بالضمان كما عليه العلّامة(قدسسره)». فلم يعد هناك مجال للتردّد ويجب أن تحكم بالضمان بقطعيّة.
التقدير الثاني: أن تكون قائلاً بعدم حجّيّة الأصل المثبت.
ولو كنت (كالمحقّق الحلّي والشهيد الثاني(قدسسرهما)) لا ترى الأصل المثبت حجّة، ففي هذه الصورة، لن يكون لاستصحاب الحياة القدرة على إثبات القتل وسيسقط عن الاعتبار. والأصل الوحيد الذي يبقى في الميدان هو أصل عدم الضمان. إذن، في هذا الفرض أيضاً، «لا إشكال في عدمه [أي عدم الضمان] كما عليه المحقّق(قدسسره)». ومرّة أخرى لا مجال للتردّد ويجب أن تحكم بعدم الضمان بقطعيّة.
نتيجة استدلال السيّد الخوئي(قدسسره): بناءً عليه، «فالتردّد في غير محلّه على كلّ تقدير». فسواء اعتبرت الأصل المثبت حجّة أم لا، ستصل في كلتا الحالتين إلى نتيجة قطعيّة (الضمان أو عدم الضمان)، والتردّد في البين لا معنى له وغير منطقيّ.
الجواب على احتمال وردّه
المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره) نفسه يطرح توجيهاً محتملاً لتردّد الشيخ(قدسسره) ويردّه على الفور. فيقول: «إلا أن يكون تردّده لأجل تردّده في حجّيّة الأصل المثبت»؛ إلّا أن نقول إنّ الشيخ الطوسي(قدسسره) نفسه كان متردّداً في مبنى حجّيّة الأصل المثبت، وقد سرى هذا التردّد في المبنى إلى التردّد في الفتوى. ولكنّ هذا الاحتمال مردود أيضاً. ولماذا؟ «لكنّه خلاف التعليل المذكور في كلامه(قدسسره)». لأنّ الشيخ(قدسسره) نفسه لم يبيّن أنّ علّة تردّده هي التردّد في المبنى الأصولي، بل نسبها إلى «تساوي الاحتمالين»؛ أي إنّه قال إنّه لأنّ احتمال الموت بالسراية واحتمال الموت بسبب آخر متساويان، والأصلان (استصحاب الحياة واستصحاب عدم الضمان) يتعارضان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، لذا يتردّد. إذن، «فلا يكون منشأ تردّده في الحكم بالضمان هو التردّد في حجّيّة الأصل المثبت».
مناقشة الأستاذ على إيراد المحقّق الخوئي(قدسسره)
مع كلّ القوّة الموجودة في استدلال المرحوم الخوئي(قدسسره)، يبدو أنّ هذا الإيراد لم يأخذ جميع جوانب المسألة في الاعتبار وهو قابل للمناقشة. وإيرادنا الرئيسي عليه هو أنّه «قد نظر إلى جانب واحد فقط من القضيّة». ويرتكز نقدنا على هذا الفرض وهو أن نقول: «لعلّ الشيخ الطوسي(قدسسره) كان قائلاً بالأصل المثبت ولكنّه تردّد بسبب التعارض مع أصل عدم الضمان».
وبعبارة أخرى، نقول للمرحوم الخوئي(قدسسره): قلتم إنّه لو كان أحد قائلاً بحجّيّة الأصل المثبت، لوجب عليه أن يحكم بالضمان «بلا إشكال». ونسأل: لماذا بلا إشكال؟ فأنتم لم تحدّدوا تكليف الأصل المعارض، أي «استصحاب عدم الضمان». فحتّى لو كان فقيه كالشيخ الطوسي(قدسسره) يرى الأصل المثبت حجّة، فإنّه يواجه مع ذلك أصلاً معتبراً آخر (أصل عدم الضمان). وفي هذه الصورة، يواجه تعارض أصلين حجّة:
• استصحاب الحياة (الذي هو معتبر بسبب حجّيّة الأصل المثبت) ونتيجته الضمان.
• استصحاب عدم الضمان (الذي هو بذاته أصل معتبر) ونتيجته عدم الضمان.
فعندما يتعارض أصلان حجّة ولا يوجد أيّ مرجِّح لتقديم أحدهما على الآخر، تكون النتيجة الطبيعيّة والمنطقيّة هي التساقط وفي النهاية التوقّف والتردّد في الفتوى. بناءً عليه، «فكلام الشيخ الطوسي(قدسسره) ليس بعيداً عن الصواب كثيراً». فمن المحتمل أنّه كان يرى الأصل المثبت حجّة، ولكن بسبب وجود معارض قويّ اسمه أصل عدم الضمان، لم يجد سبيلاً إلّا التوقّف والتردّد. وهذا تماماً هو ما عبّر عنه بـ«التكافؤ» و«عدم الترجيح».
تحقیق المحقّق الخوئي(قدسسره) في المقام [9]
بعد أن رفض المرحوم المحقّق الخوئي(قدسسره) القول بالتردّد المنسوب إلى الشيخ الطوسي(قدسسره) بشكل قاطع، ينتقل الآن إلى بيان رأيه المختار وتحقيقه النهائي في هذه المسألة. فهو في النهاية يصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها المحقّق الحلّي والشهيد الثاني(قدسسرهما)، أي القول بعدم الضمان. ولكنّه للوصول إلى هذه النتيجة، يقدّم تحليلاً دقيقاً ومبنيّاً على «تحليل موضوع الحكم» هو مفيد جدّاً. ويرتكز أساس تحليله على هذا السؤال المفصلي: ما هو موضوع حكم الضمان (أعمّ من القصاص والديّة) في الأدلّة الشرعيّة؟
فرضان في تحليل موضوع الضمان
يطرح المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره) البحث بتقديم فرضين وتحليل نتائج كلّ منهما:
«التحقیق أن یقال: إنّه إن قلنا بأنّ موضوع الضمان هو تحقّق القتل كما هو الظاهر لترتّب القصاص و الدیة في الآیات و الروایات علیه، فلابدّ من الالتزام بعدم الضمان في المقام؛ لأصالة عدمه و لایمكن إثباته [أي الضمان] بأصالة عدم سبب آخر و لا باستصحاب الحیاة إلا على القول بالأصل المثبت، فإنّ القتل لازم عادي لعدم تحقق سبب آخر و لبقاء حیاته.
و إن قلنا بأنّ الموضوع له أمر مركب من الجنایة و عدم سبب آخر في المثال الأوّل و [مركّب] من الجنایة و الحیاة فلا إشكال في جریان الاستصحاب و إثبات الضمان؛ فإنّ أحد جزءي الموضوع محرز بالوجدان و [الجزء] الآخر [محرز] بالأصل، لكن هذا خلاف الواقع لعدم کون الموضوع مركباً من الجنایة و عدم سبب آخر و لا من الجنایة و الحیاة بل الموضوع شيء بسیط و هو القتل [كما هو الظاهر من الأدلّة]».
الفرض الأوّل: موضوع الضمان هو عنوان بسيط هو «القتل».
يقول(قدسسره): «التحقيق أن يقال: إنّه إن قلنا بأنّ موضوع الضمان هو تحقّق القتل كما هو الظاهر»؛ أي إنّ ظاهر الآيات والروايات هو أنّ ما يوجب القصاص والديّة هو العنوان البسيط والواحد «القتل». وهذا هو الفرض الأوّل والفرض الصحيح من وجهة نظره. فلو كان الموضوع هو العنوان البسيط «القتل»، «فلا بدّ من الالتزام بعدم الضمان في المقام». ولماذا؟ لأنّنا في ما نحن فيه نشكّ في تحقّق عنوان «القتل». ولإثباته ليس لدينا إلّا طريقان:
استصحاب عدم سبب آخر للموت: أي أن نقول إنّ الأصل هو عدم وجود سبب آخر للموت (كالسمّ)، إذن فسبب الموت هو هذه الجناية.
استصحاب حياة المجنيّ عليه: أي أن نستصحب حياته إلى زمن الجناية لنثبت أنّ الجناية قد وقعت على شخص حيّ وأنّ القتل قد وقع.
إشكال كلا الطريقين: كلا هذين الاستصحابين هو مصداق بارز للأصل المثبت. لأنّ «القتل» ليس لازماً عقليّاً لاستصحاب عدم سبب آخر ولا لازماً عقليّاً لاستصحاب الحياة. بل هو لازمهما العادي. وبما أنّنا (المرحوم الخوئي(قدسسره)) لا نرى الأصل المثبت حجّة، فلا يمكن لأيّ من هذين الاستصحابين أن يثبت لنا موضوع «القتل».
النتيجة النهائيّة للفرض الأوّل: عندما يُسدّ طريق إثبات الموضوع (القتل) بالأصل المثبت، فالشيء الوحيد الذي يبقى هو الشكّ في تحقّق الموضوع، وعند الشكّ، يجب الرجوع إلى الأصل الحكمي أي «أصالة عدم الضمان».
الفرض الثاني: موضوع الضمان هو «أمر مركّب»
الفرض الثاني، وهو فرض لمجرّد تحليل البحث، هو أن نقول إنّ موضوع الضمان ليس هو العنوان البسيط “القتل”، بل هو أمر مركّب:
• في المثال الأوّل (السمّ): مركّب من «الجناية + عدم سبب آخر».
• في المثال الثاني (القدّ نصفين): مركّب من «الجناية + الحياة حين الجناية».
الاستنتاج في هذا الفرض: لو اعتبرنا الموضوع مركّباً على هذا النحو، «فلا إشكال في جريان الاستصحاب وإثبات الضمان». ولماذا؟ لأنّنا هنا لم نعد نتعامل مع أصل مثبت. فموضوع الحكم له جزءان:
الجزء الأوّل (الجناية): هذا الجزء مُحرَز بالعلم الوجداني. فالجاني نفسه يقرّ بأنّه قد ضرب.
الجزء الثاني (عدم سبب آخر أو الحياة): هذا الجزء يُحرَز أيضاً بالأصل (استصحاب عدم سبب آخر أو استصحاب الحياة). وهنا، يثبت الاستصحاب مباشرةً أحد جزأي الموضوع وهذا ليس مصداقاً للأصل المثبت. فعندما يثبت كلا جزأي الموضوع (أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل)، يتحقّق الموضوع المركّب للضمان بالكامل ويترتّب عليه حكم الضمان.
النظريّة النهائيّة والمختارة للمحقّق الخوئي(قدسسره)
بعد تحليل هذين الفرضين، يرفض المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره) بصراحة الفرض الثاني ويقول: «لكنّ هذا خلاف الواقع»؛ فهذا الفرض القائل بأنّ الموضوع أمر مركّب هو خلاف ظاهر وواقع الأدلّة الشرعيّة. فموضوع الضمان ليس مركّباً من الجناية وعدم سبب آخر أو الحياة، «بل الموضوع شيء بسيط وهو القتل». بناءً عليه، فبما أنّ موضوع الحكم هو العنوان البسيط «القتل»، وأنّ الاستصحابات الجارية في المسألة لإثبات هذا العنوان هي جميعها من نوع الأصل المثبت، وبما أنّه قد أنكر بقطعيّة (سواء في ردّ كلام الشيخ الأنصاري أم في ردّ كلام الآخوند الخراساني(قدسسره)) حجّيّة الأصل المثبت في جميع هذه الموارد الاستثنائيّة، فلا تبقى نتيجة إلّا عدم الضمان. ويبيّن هذا التحقيق بجمال كيف يمكن لتحليل دقيق لـ«موضوع الحكم» أن يكون مفتاح حلّ لمسألة فقهيّة وأصوليّة معقّدة.
الفرع الخامس: استصحاب عدم رضا المالك
نصل الآن إلى آخر فرع من الفروع الخمسة مورد البحث، والذي يُخصَّص لـ«استصحاب عدم رضا المالك». وهذا الفرع، الذي طرحه أعلام كالمحقّق النائيني(قدسسره)، يتناول تحليل مثالين مهمّين وتطبيقيّين جدّاً في أبواب الضمانات: ضمان اليد وضمان المعاوضة. وتكمن أهمّيّة هذا الفرع في أنّه يرتبط مباشرةً بالدعاوى الماليّة الشائعة والاختلافات حول ماهيّة التصرّفات والمعاملات.
تبيين المثالين الرئيسيين في الفرع الخامس
للدخول في البحث، يجب أوّلاً تصوير السيناريوهين مورد النزاع بدقّة.
المثال الأوّل: ضمان اليد
صورة المسألة: يقع نزاع بين مالك مال ما وشخص كان ذلك المال في يده (المتصرِّف) وتلف. وقد قُرّر هذا المثال في كلمات الأعلام بصورتين:
تقرير المحقّق النائيني(قدسسره): يدّعي المالك: «لقد أجّرتك هذا المال». وفي المقابل، يدّعي المتصرِّف: «كلّا، لقد أودعتني إيّاه أمانة».[10]
تقرير المحقّق الخوئي(قدسسره): يدّعي المالك: «لقد أخذت هذا المال وتصرّفت فيه من دون إذني (غصب)». وفي المقابل، يدّعي المتصرِّف: «كلّا، لقد أعرتني إيّاه بنفسك».[11]
التحليل الحقوقي: في كلا التقريرين، النتيجة واضحة. فلو قُبل قول المالك، لكانت يد المتصرِّف «يداً ضمانيّة» (سواء بسبب الإجارة أم الغصب) وفي صورة تلف المال، لكان ضامناً لبدله الواقعي (المثل أو القيمة). أمّا لو قُبل قول المتصرِّف، لكانت يده «يداً أمانيّة» وفي صورة تلف المال من دون تعدٍّ وتفريط، لما كان ضامناً.
المثال الثاني: ضمان المعاوضة
صورة المسألة: يتناول هذا المثال النزاع في ماهيّة معاملة ما. فيدّعي المالك (البائع): «لقد بعتك هذه السلعة». وفي المقابل، يدّعي الطرف الآخر (المشتري): «كلّا، لقد وهبتني إيّاها». وهذه من المسائل التي تكثر في العلاقات الاجتماعيّة.
التحليل الحقوقي: لو ثبت ادّعاء المالك بالـ«بيع»، لثبت بتلف المال في يد المشتري ضمان معاوضيّ على عهدته ووجب عليه دفع البدل الجعلي (أي الثمن المقرّر في المعاملة). أمّا لو ثبت ادّعاء الطرف المقابل بالـ«هبة»، لما كان عليه ضمان.
القول الأوّل: الضمان
في مواجهة هذين المثالين المعقّدين اللذين لا يوجد فيهما شاهد عادةً، ما هو الحلّ؟
فالقول المشهور والقاطع للفقهاء، الذي ادّعى المحقّق النائيني(قدسسره) في «فوائد الأصول»[12] التسالم عليه وفي «أجود التقريرات»[13] الشهرة عليه، هو أنّه في كلتا الصورتين، يُقدَّم قول المالك ويُصدر حكم بالضمان على الشخص الثاني (المتصرِّف). وهذه الفتوى، التي قد تبدو لبعضهم خلاف المتوقّع في النظرة الأولى، ترتكز على مبانٍ استدلاليّة دقيقة نشير إلى أربعة وجوه منها في ما يلي.
وجوه أربعة للقول بالضمان
الوجه الأوّل
أوّل وأبسط وجه يمكن تصوّره لإثبات الضمان هو أنّ هذا الحكم مبنيّ على القول بحجّيّة الأصل المثبت. ففي هذا الاستدلال، نتمسّك بـ«أصالة عدم إذن المالك»؛ أي عندما نشكّ فيما إذا كان المالك قد أذن بتصرّف غير ضمانيّ (كالأمانة أو الهبة) أم لا، فالأصل هو عدم إذنه. ولهذا الاستصحاب لازم عاديّ وخارجيّ وهو أنّه عندما لا يكون هناك إذن، فإنّ يد المتصرِّف هي «يد عاديّة» أو بعبارة أخرى، يد عدوانيّة وغاصبة. وإثبات «كون اليد عدوانيّة» من خلال «استصحاب عدم الإذن» هو مصداق بارز للأصل المثبت، لأنّنا نثبت بأصل أمراً خارجيّاً آخر (وهو لازم عادي للمستصحَب) حتى نتمكّن من ترتيب حكم الضمان الشرعي عليه. وعليه، فهذا الوجه معتبر فقط لمن قبل بالمبنى الخاصّ لحجّيّة الأصل المثبت.
الوجه الثاني
تبيين الوجه: يرتكز هذا الوجه على أنّ الضمان مبنيّ على قاعدة «المقتضي والمانع» الكلاميّة والأصوليّة. يحلّل الوجه الثاني الضمان بناءً على قاعدة «المقتضي والمانع» الكلاميّة والأصوليّة. ففي هذه النظرة، إنّ نفس الاستيلاء ووقوع مال الغير في يد الإنسان (اليد) هو بذاته مقتضٍ وعلّة أصليّة للضمان. أمّا «إذن المالك» بتصرّف غير ضمانيّ، فيؤدّي دور المانع والرادع الذي يمنع تأثير ذلك المقتضي. وفي مسألتنا مورد البحث، فإنّ وجود المقتضي وهو «اليد» أمر وجدانيّ وقطعيّ. وشكّنا بالكامل هو في وجود «المانع» أي إذن المالك. وفي مثل هذه الظروف، تجري قاعدة «أصالة عدم المانع». وبجريان هذا الأصل، يُفترض المانع منتفياً، ويفعِّل المقتضي (اليد) من دون أيّ رادع تأثيره الذي هو «الضمان»، ونتيجة لذلك، يُعتبر الشخص ضامناً.
الوجه الثالث
يأخذنا هذا الاستدلال إلى أحد المباحث العميقة في أصول الفقه، أي بحث العامّ والخاصّ. فلدينا هنا قانون كلّيّ وعامّ وهو عموم الرواية النبويّة «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي»[14] [15] التي تعتبر كلّ يد ضامنة كفرض مسبق. وفي المقابل، لدينا خاصّ ومخصِّص يشمل الأدلّة التي تُخرج «اليد المأذونة» (كاليد الأمينة) من دائرة شمول هذا القانون الكلّيّ. ومسألتنا هي تماماً من مصاديق «الشبهة المصداقيّة»؛ أي إنّنا نواجه مورداً لا نعلم فيه ما إذا كانت هذه اليد مصداقاً لذلك القانون العامّ ويجب أن تكون ضامنة، أم مصداقاً لذلك العنوان الخاصّ والمخصِّص وليست بضامنة. والقول المشهور للأصوليّين، الذي يصحّحه المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره) أيضاً، هو أنّه لا يمكن التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة. لأنّ العامّ بعد التخصيص كأنّه قد قُيِّد بـ«العامّ غير العنوان الخاصّ» ولم تعد له القدرة على شمول الفرد المشكوك.
ولكن في المقابل، يوجد قول غير مشهور قال به أعلام كصاحب العروة(قدسسره) [16] وهو جواز التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة. فبناءً على هذا المبنى غير المشهور، يمكن التمسّك بعموم «على اليد» والحكم بالضمان. بناءً عليه، فهذا الوجه أيضاً دليل آخر لقول الضمان، وإن كان متوقّفاً على قبول مبنى خاصّ وغير مشهور في علم الأصول.
الوجه الرابع
آخر وجه، وهو تحقيق ورأي المحقّق النائيني(قدسسره) المختار، هو حلّ دقيق وذكيّ جدّاً يتجاوز المشاكل السابقة، خصوصاً مشكلة الأصل المثبت، بتحليل موضوع الحكم. يقول(قدسسره):
«إنّ الموضوع للضمان مركب من الید و عدم إذن صاحب المال و هما عرضان لمحلّین: أحدهما صاحب الید و ثانیهما صاحب المال.
و قد تقدّم أنّه لا جامع بین العرضین لمحلّین إلا الاجتماع في الزمان، فیكفي إحراز أحدهما بالأصل و الآخر بالوجدان كما في المثال، فإنّ الید محرزة بالوجدان و عدم الإذن محرز بالأصل، فیتحقّق موضوع الضمان»[17] [18] .
يعتقد(قدسسره) أنّ موضوع الضمان ليس أمراً بسيطاً، بل هو «مركّب من اليد وعدم إذن صاحب المال». وهذان عرضان يعرضان على محلّين مختلفين: «اليد» على الشخص المتصرِّف، و«عدم الإذن» على الشخص المالك. وبهذا التحليل، يصبح إثبات الضمان سهلاً جدّاً. فلثبوت الحكم، يجب ثبوت كلا جزأي الموضوع.
• الجزء الأوّل (اليد)، مُحرَز وقطعيّ بالعلم الوجداني.
• الجزء الثاني (عدم الإذن) الذي هو مشكوك، يُحرَز بالأصل العملي أي «استصحاب عدم الإذن». وفي هذه الصورة، يثبت الاستصحاب مباشرةً أحد جزأي الموضوع ولم يعد أصلاً مثبتاً. وبإحراز جزء بالوجدان وجزء آخر بالأصل، يتحقّق الموضوع المركّب للضمان بالكامل ويترتّب عليه حكم الضمان.


