46/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه السابع؛ المطلب الثالث؛ مناقشة المحقق الإصفهاني(قدس سره) في الموردین الثاني و الثالث صغرویاً/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
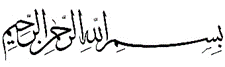
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه السابع؛ المطلب الثالث؛ مناقشة المحقق الإصفهاني(قدس سره) في الموردین الثاني و الثالث صغرویاً
الملاحظة الثانية
بعد أن بيّنا في الجلسة السابقة الملاحظة الأولى على مناقشة المحقّق الأصفهاني(قدسسره) في باب المتضايفين بالتفصيل، ننتقل الآن إلى الملاحظة الثانية. وهذه الملاحظة ناظرة مباشرةً إلى القسم الثاني من نقده، أي تحليله لمثال «العلّة والمعلول». ونحن في هذه الملاحظة، نعتزم أن نبيّن أنّ نقد المحقّق الأصفهاني(قدسسره) على القسم الثاني (العلّة الناقصة) ناشئ من عدم التفكيك بين فرضين مهمّين جدّاً، ولو تمّ هذا التفكيك، لاتّضح أنّ كلام صاحب الكفاية(قدسسره) صحيح تماماً وأنّ نقد المحقّق الأصفهاني(قدسسره) ناظر إلى فرض لم يكن أساساً مورد ادّعاء صاحب الكفاية(قدسسره).
الخطوة الأولى: إعادة قراءة النقد ونقطة الاتّفاق في باب العلّة التامّة
للدخول في البحث، من الضروري أوّلاً أن نذكّر بنقد المرحوم الأصفهاني(قدسسره) في هذا القسم بشكل مختصر. فقد قال إنّه لو كان المراد من العلّة هو العلّة التامّة، لكان خارجاً عن محلّ البحث؛ لأنّك لو كنت على يقين بالعلّة التامّة، لكنت حتماً على يقين بمعلولها أيضاً. «فلماذا تستصحب العلّة ثم تقول إنّ المعلول قد ثبت لي تعبّداً؟! فاستصحب نفس المعلول». ونحن نوافق تماماً على هذا القسم من كلامه. فإنّ «اليقين بالعلّة التامّة بلا يقين بمعلولها غير ممكن» هو قول تامّ ومتين وغير قابل للمناقشة. فوجود العلّة التامّة لا ينفكّ عقلاً وواقعاً عن وجود معلولها، وتبعاً لذلك، فإنّ اليقين بأحدهما ملازم لليقين بالآخر. فلا كلام في هذا المورد، وهو نقطة اتّفاقنا معه.
الخطوة الثانية: بؤرة البحث الرئيسيّة؛ التحليل الدقيق لفرض العلّة الناقصة
كلّ البحث والنزاع هو في فرض العلّة الناقصة. فالسيناريو الذي هو محلّ بحثنا، والذي كان في نظر صاحب الكفاية(قدسسره)، هو أنّ العلّة التامّة لظاهرة ما تتكوّن من جزأين (أو أكثر). فنحن لدينا حالة سابقة يقينيّة بالنسبة لأحد جزئيها (الجزء “ألف”)، ولكن ليس لدينا مثل هذه الحالة بالنسبة للجزء الآخر (الجزء “باء”)، بل قد أحرزنا وجوده في زمن الشكّ بالعلم الوجداني والقطعي. والمثال الواضح جدّاً لذلك هو نفس «استصحاب عدم الحاجب» في الوضوء أو الغسل الذي قرّره المحقّق الأصفهاني(قدسسره) نفسه ثم ردّه:
• الجزء «ألف» (الذي له حالة سابقة ويُستصحب): «عدم وجود المانع أو الحاجب» على عضو الوضوء.
• الجزء «باء» (المُحرَز بالعلم الوجداني): «صبّ الماء» على نفس ذلك العضو.
• المعلول (الذي نريد إثباته): «وصول الماء إلى البشرة» (تحقّق الغَسل) وبالتالي، أثره الشرعي أي «رفع الحدث».
وهنا قال المحقّق الأصفهاني(قدسسره) إنّه ليس لدينا تعبّد بالمعلول (رفع الحدث) وهذا أصل مثبت باطل. ولكنّ جوابنا الدقيق هو: «العرف يرى التعبّد بالجزء المستصحَب من أجزاء العلّة التامّة عين التعبّد بالمعلول في تلك الحالة التي أُحرز الجزء الآخر بالوجدان». وبلغة أبسط، إنّ النظرة العرفيّة والعقلائيّة هي نظرة تركيبيّة وكلّيّة. فالعرف، عندما يرى أنّ جزءاً من العلّة قد ثبت بالاستصحاب وأنّ الجزء الآخر موجود بالوجدان وبشكل قطعيّ، يرى هذا التركيب بمنزلة التحقّق التعبّدي للعلّة التامّة. وفي الواقع، إنّ ذلك الجزء المستصحَب (عدم المانع) هو «الجزء الأخير من العلّة التامّة»؛ أي هو القطعة الأخيرة من أحجيّة العلّة التامّة التي تكتمل الأحجيّة بإحرازها (وإن كان بأصل تعبّديّ). وعندما تكتمل العلّة التامّة، بأيّ نحو (سواء وجدانيّاً أم تعبّديّاً)، لا يرى العرف بعد ذلك انفصالاً بينها وبين معلولها ويعتبر التعبّد بوجود المعلول نتيجة قطعيّة لذلك. «إذن فقد تحقّقت هذه العلّة التامّة ويتحقّق معلولها أيضاً».
الخطوة الثالثة: الجواب على الإشكال الرئيسي وتحديد محلّ النزاع
والآن نعود إلى الإشكال الرئيسي للمحقّق الأصفهاني(قدسسره) الذي قال: «لا ملازمة بين التعبّد بالعلّة الناقصة والتعبّد بالمعلول عرفاً». وجوابنا هو: إنّ عدم الملازمة هذا يتعلّق بالحالة التي «لم يُحرز فيها الجزء الآخر بالوجدان». نعم، لو استصحبنا عدم المانع فقط ولكن لم نعلم ما إذا كان قد صُبّ ماء أم لا، لكان هذا الاستصحاب قطعاً لا يثبت وصول الماء إلى البشرة بمفرده. فكلامكم صحيح تماماً في هذا الفرض، ولكنّ هذا الفرض «خارج عن المبحوث عنه». فمحلّ بحثنا وادّعاء صاحب الكفاية(قدسسره) هو تماماً في الفرض الأوّل، أي حيث يكون الجزء الآخر مُحرَزاً بالوجدان. فمناقشتكم تستهدف الفرض الثاني الذي هو خارج عن محلّ نزاعنا.
الخطوة الرابعة: لماذا لا يمكننا استصحاب نفس المعلول مباشرةً؟
قد يتكرّر نفس الإشكال السابق مرّة أخرى وهو: حسناً، لو تحقّقت العلّة التامّة تعبّداً، فلماذا لا نستصحب نفس المعلول (وصول الماء إلى البشرة) مباشرةً؟ الجواب هو أنّ المعلول هنا فاقد للحالة السابقة. فالعلّة التامّة التي تشكّلت الآن بتركيب «استصحاب عدم المانع» و«العلم الوجداني بصبّ الماء» هي أمر آنيّ وجديد وحادث. فقبل صبّ الماء، لم يكن المعلول (أي وصول الماء إلى البشرة) موجوداً أصلاً حتى نريد أن نستصحب بقاءه. «هذا الجزء من العلّة لم تكن له سابقة، لذا فالاستصحاب يجري فقط في طرف العلّة ولا يمكننا أن نجري الاستصحاب في طرف المعلول».
بناءً عليه، فالسبيل الوحيد الممكن هو جريان الاستصحاب في نفس ذلك الجزء من العلّة الناقصة (عدم المانع) الذي كانت له حالة سابقة. وعندما استصحبناه، «فلأنّه نُزِّل منزلة العلّة التامّة، فالنتيجة هي أنّه سيكون حجّة في لازمه ومعلوله أيضاً».
الاستنتاج من الملاحظة الثانية وارتباطها بموارد الاستثناء:
بناءً عليه، فقد أحرزنا العلّة التامّة تعبّداً بتركيب استصحاب جزء وإحراز وجدانيّ لجزء آخر. وبما أنّ هذه العلّة التامّة التعبّديّة هي نفسها أمر حادث، فلا يمكننا استصحاب معلولها مباشرةً. ولكن بسبب الملازمة الشديدة وغير القابلة للإنكار عرفيّاً، فإنّ التعبّد بهذه العلّة التامّة التركيبيّة هو عين التعبّد بمعلولها، وهذا هو المصداق البارز للمورد الثاني من كلام صاحب الكفاية(قدسسره) (الملازمة في التعبّد).
وكذلك، فإنّ هذا المورد هو مصداق للمورد الثالث له (الوحدة في الأثر) أيضاً. أي «أثر المعلول قد يُعدّ أثراً للعلّة الناقصة التي أُحرزت بالأصل». فبسبب شدّة الارتباط بين العلّة والمعلول، يرى العرف هنا أثر المعلول (كرفع الحدث مثلاً) عيناً أثر تلك العلّة التركيبيّة التي ثبت أحد جزئيها بالاستصحاب. وأحياناً تكون شدّة هذا الارتباط إلى درجة أنّ العرف ينسب الأثر إلى علّة العلّة؛ فمثلاً، في العرف العامّ، عندما يأمر الملك بإعدام شخص، يقولون «قتله الملك»، لا الجلّاد الذي باشر القتل. وهنا أيضاً ينسب العرف الأثر (رفع الحدث) إلى نفس ذلك التركيب المكوِّن للعلّة ويعتبره حجّة.
الملاحظة الثالثة
بعد أن بيّنا في الملاحظة الثانية أنّه يمكن إيجاد مصداق لكلام صاحب الكفاية(قدسسره) في الفرض الخاصّ للعلّة الناقصة (أي حيث يكون الجزء الآخر من العلّة مُحرَزاً بالوجدان)، نصل الآن إلى آخر وأهمّ جزء ربّما من نقد المحقّق الأصفهاني وتلميذه المحقّق الخوئي(قدسسرهما). وهذا القسم، الذي طُرح كإشكال بنيويّ، هو أنّه لو قبلنا بحجّيّة الأصل المثبت في باب العلّة الناقصة، لكان هذا الأمر مستلزماً لحجّيّة جميع الأصول المثبتة، وهذا يعني زوال قاعدة أصوليّة مسلَّمة ولزوم «تخصيص الأكثر» الذي هو أمر قبيح وغير عقلائيّ.
ونحن في هذه الملاحظة الثالثة، نعتزم أن نبيّن أنّ هذا الإشكال الكبير أيضاً ناشئ من خلط مفهوميّ بين «الملازمة العقليّة» و«الملازمة العرفيّة»، وبفكّ الارتباط بينهما، يتّضح أنّ مثل هذه المفسدة لن تلزم أبداً.
الخطوة الأولى: صياغة إشكال المحقّق الخوئي(قدسسره)
إشكاله، الذي يبدو استدلالاً منطقيّاً، يمكن تقريره على هذا النحو:
١. المقدّمة الأولى (الملازمة من المعلول إلى العلّة): أنتم تقولون إنّ التعبّد بالمعلول يستلزم التعبّد بعلّته الناقصة (لأنّ الملازمة طرفينيّة).
٢. المقدّمة الثانية (الملازمة من العلّة إلى المعاليل الأخرى): التعبّد بعلّة ناقصة واحدة يستلزم أيضاً التعبّد بجميع لوازم ومعاليل تلك العلّة الأخرى.
إذن، التعبّد بلازم واحد (معلول واحد) سيستلزم التعبّد بجميع اللوازم والمعاليل الموازية له. ولو فُتح هذا الباب، لما بقي أيّ أصل مثبت غير حجّة.
الخطوة الثانية: الجواب الأصلي والتفكيك بين نطاق العقل والعرف
جوابنا على هذا الإشكال الكبير هو جواب قاطع وواضح: «ما قاله المحقّق الخوئي(قدسسره)… ممنوع». فاستدلالكم هذا ممنوع؛ لأنّ بنية وأساس استدلالكم مبنيّ على فرض مسبق خاطئ. «أنتم تعتبرون جميع اللوازم لازمة عقليّة» والحال أنّ كلّ بحثنا ومبنى صاحب الكفاية(قدسسره) يرتكز على أساس الملازمة العرفيّة.
«والجواب عن ذلك يظهر بالتفاوت بين الملازمة العرفيّة والملازمة العقليّة». فما قاله المرحوم السيّد الخوئي تبعاً لأستاذه(قدسسرهما) يرتكز على نظرة عقليّة دقيقة وتحليليّة. نعم، من وجهة نظر فيلسوف أو منطقيّ جالس في غرفته ويتعامل مع البراهين العقليّة، فإنّ وجود علّة يستلزم وجود جميع معاليلها، والعلم بالعلّة يستتبع العلم بجميع المعاليل. وهذه هي «الملازمة العقليّة».
ولكنّ بحثنا هنا ليس بحثاً فلسفيّاً محضاً. فبحثنا هو في فهم العرف للأدلّة الشرعيّة. فهل عندما يقول الشارع إنّه يجب الالتزام بشيء (المستصحَب) تعبّداً، يستنتج العرف من هذا الكلام سلسلة استنتاجات عقليّة معقّدة؟ قطعاً لا. فنطاق إدراك وفهم العرف أضيق وفي الوقت نفسه ملموس أكثر بكثير.
أفق رؤية العرف محدود ومركَّز: «العرف يرى التعبّد باللازم هو التعبّد بالملزوم فقط عندما يكون اللازم والملزوم متّصلين ببعضهما». فعندما يتعبّد العرف، بالاستصحاب، بـ«عدم وجود المانع» ويرى بوجدانه «صبّ الماء»، فإنّه يدرك علاقة مباشرة وقريبة وفوريّة بين هذين الأمرين و«وصول الماء إلى البشرة». «لا يلتفت العرف إلى اللوازم الأخرى، ولا يهتمّ ببقيّة اللوازم أصلاً». فذهن العرف، بعد إثبات هذا المعلول، لا يبحث عن «حسناً، الآن بعد أن تحقّقت هذه العلّة (تركيب عدم المانع وصبّ الماء)، فما هي اللوازم العقليّة الأخرى المترتّبة عليها؟». فهذا عمل الفيلسوف، لا عمل العرف السوقي والعادي.
وبعبارة أخرى، «العرف يكتفي من التعبّد الشرعي بهذا المقدار من التعبّد»، وكلّ ما يتجاوز هذه العلاقة المباشرة هو «خارج عن حيطة درك العرف». فالعرف يستدلّ من المعلول (الأثر) على علّته القريبة والمباشرة (دليل إنّي)، ولكنّه لا يقفز من تلك العلّة إلى جميع معاليلها الأخرى. فهذه السلسلة من المراتب والشبكات العلّيّة والمعلوليّة خارجة عن أفق رؤيته.
الخطوة الثالثة: إضافة نكتة تكميليّة
يمكن حتّى أن نخطو خطوة أبعد ونقول: «بل أحياناً لا يكون التعبّد بالعلّة الناقصة تعبّداً بمعلولها حتّى في فرض إحرازنا لسائر أجزاء العلّة التامّة بالوجدان». ومتى؟ عندما تكون نفس العلّيّة بينهما أمراً معقّداً وتخصّصيّاً و«لا يدرك العرف العلّيّة بين اللازم والملزوم وتكون العلّيّة بعيدة عن أذهان العرف». وتبيّن هذه النكتة جيّداً أنّ الملاك النهائي والمحور الأصلي للبحث هو إدراك وفهم العرف، لا مجرّد وجود ملازمة عقليّة في عالم الواقع.
النتيجة النهائيّة للبحث
بالنظر إلى جميع الملاحظات الثلاث التي طُرحت، نصل إلى هذه النتيجة الواضحة:
١. المورد الأوّل (خفاء واسطة الشيخ الأنصاري(قدسسره)): نحن لا نقبل هذا المورد بنفس البيان الذي قاله المرحوم النائيني والخوئي(قدسسرهما). فتغيير موضوع الحكم الشرعي بحجّة خفاء الواسطة أمر غير مقبول. وطبعاً قلنا إنّ بعض أمثلة هذا المورد هي في الواقع مصداق للواسطة الجليّة ويمكن أن تندرج تحت الموردين التاليين.
٢. الموردان الثاني والثالث (مباني صاحب الكفاية(قدسسره)): نحن نعتقد أنّ هذين المبنيين، أي «التعبّد باللازم عند التعبّد بالملزوم للملازمة العرفيّة بينهما» (المورد الثاني) و«التعبّد بآثار اللازم فيما إذا عُدّت آثارها من آثار الملزوم عرفاً» (المورد الثالث)، هما «صحيحان وتامّان ولا نقاش فيهما» تماماً.
إذن، نحن لا نُورد إيرادات المحقّق الأصفهاني والمحقّق الخوئي(قدسسرهما) على هذين الموردين ونلتزم بحجّيّة الأصل المثبت في هذين الموردين الخاصّين.[1]
المطلب الرابع: الفروع التي تمسّك القدماء فیها بالأصل المثبت
بعد أن بحثنا بالتفصيل في المطالب الثلاثة السابقة الجوانب المختلفة لنظريّة الأصل المثبت واستثناءاتها والمناقشات الواردة عليها، ننتقل الآن إلى المطلب الرابع الذي له جانب تطبيقيّ وتاريخيّ. ففي هذا المطلب، نبحث الفروع والمسائل التي تمسّك فيها في آثار الفقهاء المتقدّمين (قدماء الأصحاب) باستصحابات هي في نظرنا مصداق بارز للأصل المثبت غير الحجّة. ويساعدنا هذا البحث على فهم لماذا وبأيّ مبنى أفتى هؤلاء الأعلام بمثل هذه الاستصحابات.
مقدّمة: تبيين الوجوه المحتملة لتمسّك القدماء بالأصل المثبت
قبل الدخول في نفس الفروع، يجب أن نجيب على هذا السؤال الأساسي: لماذا تمسّك فقهاء كبار كالشيخ الطوسي(قدسسره) في المبسوط باستصحابات لازمها حجّيّة الأصل المثبت؟ يمكن تصوّر ثلاثة وجوه واحتمالات رئيسيّة لهذا الأمر:
١. الالتزام بحجّيّة الأصل المثبت مطلقاً: أوّل وأبسط احتمال هو أنّ هؤلاء الأعلام لم يقبلوا أساساً بقاعدة «عدم حجّيّة الأصل المثبت» وكانوا يعتبرون أيّ نوع من الاستصحاب حجّة بشكل عامّ، سواء كان بوافطة أم بلا واسطة.
٢. اعتبار الاستصحاب أمارة: الاحتمال الثاني، الذي يبدو أدقّ وأكثر احتمالاً، هو أنّهم لم يعتبروا الاستصحاب أصلاً عمليّاً صرفاً، بل اعتبروه نوعاً من الأمارة الظنّيّة. ومبنى هذا الرأي هو أنّ دليل حجّيّة الاستصحاب (أخبار لا تنقض…) هو من باب إفادة الظنّ النوعي ببقاء الحالة السابقة، وقد جعل الشارع هذا الطريق الظنّيّ حجّة كغيره من الأمارات (مثل خبر الواحد). وكما نعلم، فإنّ مثبتات الأمارات (اللوازم العقليّة والعاديّة لخبر الواحد) حجّة. فلو اعتبرنا الاستصحاب أمارة أيضاً، لكانت مثبتاته حجّة أيضاً.
٣. الاشتباه في التطبيق: الاحتمال الثالث هو أنّ هؤلاء الأعلام قد وقعوا، في مقام تطبيق الكبرى على الصغرى، في نوع من المسامحة أو عدم الالتفات إلى الواسطة. أي إنّهم بسبب شدّة الاتّصال بين اللازم والملزوم، «تخيّلوا أنّ الحكم الشرعي هو مترتّب على المستصحَب، لا على لازمه»؛ فظنّوا أنّ الأثر الشرعي يترتّب مباشرةً على نفس المستصحَب، والحال أنّه في الواقع كان يترتّب على لازمه العقلي أو العادي، وغفلوا عن وجود الواسطة.
بحث الفروع الخمسة
والآن، مع الأخذ بالاعتبار لهذه الاحتمالات الثلاثة، ننتقل إلى الفروع التي تمسّك فيها بالأصل المثبت في كتب القدماء. والفروع الثلاثة الأولى هي تماماً نفس الأمثلة التي طرحها المرحوم الشيخ الأنصاري(قدسسره) في بحث الاستثناءات وقد بحثناها بالتفصيل سابقاً، لذا نمرّ عليها باختصار:
الفرع الأوّل: استصحاب رطوبة شيء فیما إذا لاقی متنجّساً
و یترتّب علیه إثبات سرایة النجاسة إلى الملاقي و كونه متنجّساً، كما تقدّم في المثال الأوّل الذي ذكره العلامة الأنصاري(قدسسره).
الفرع الثاني: استصحاب عدم دخول شهر شوّال
و یترتّب على ذلك إثبات أنّ یوم الغد یوم العید و تجري أحكام یوم العيد كما في المثال الثاني الذي أفاده الشیخ الأنصاري(قدسسره).
الفرع الثالث: استصحاب عدم الحاجب
و یترتّب علیه وصول الماء إلى البشرة و تحقّق الغسل و أثره الشرعي هو صحّة الوضوء و الغسل؛ كما في المثال الثالث الذي أفاده الشیخ الأعظم الأنصاري(قدسسره).
الفرع الرابع: استصحاب عدم السرایة و استصحاب الحیاة
حكی الشیخ الأعظم الأنصاري(قدسسره) عن الشرائع[2] و التحریر[3] [4] تبعاً للمحكي عن المبسوط[5] مثالين في باب الجنايات هما كلاهما مصداق واضح للتمسّك بالأصل المثبت:
المورد الأوّل: النزاع حول سبب الموت (استصحاب عدم السراية)
«لو ادّعی الجاني أنّ المجنيّ علیه شرب سمّاً فمات بالسمّ، و ادّعی الوليّ أنّه مات بالسرایة [أي بسرایة الجراحة، فالسبب لموته الجراحة التي أوردها الجاني علیه] فالاحتمالان فیه سواء»[6] .
شخص (جاني) جرح شخصاً آخر. وبعد مدّة، يتوفّى الشخص المجروح. فيقع نزاع بين الجاني وأولياء الدم:
• ادّعاء الجاني: يدّعي الجاني أنّ الشخص المجروح قد شرب سمّاً بنفسه ومات بسبب ذلك السمّ (أي انتحر) وأنّ جرحه لم يكن سبب موته.
• ادّعاء أولياء الدم: يدّعون أنّ ادّعاء السمّ كذب وأنّ الموت كان بسبب سراية تلك الجراحة نفسها. أي إنّ السبب الرئيسي للموت هو نفس الجناية التي ارتكبها الجاني. وقد قال الفقهاء إنّه لو لم تكن بيّنة، لكان هذان الاحتمالان متساويين.
• كيفيّة التمسّك بالأصل المثبت: هنا، لتبرئة الجاني، يمكن إجراء «استصحاب عدم سراية الجراحة». أي إنّ الأصل هو أنّ تلك الجراحة لم تؤدِّ إلى الموت. واللازم العقلي لهذا الاستصحاب هو أنّه إذن لا بدّ أنّ سبباً آخر (أي شرب السمّ) قد سبّب الموت. وبهذا الاستصحاب المثبت، يُبرَّأ الجاني من قصاص أو ديّة القتل.
المورد الثاني: النزاع حول كون المقتول حيّاً (استصحاب الحياة)
«و کذا الملفوف في الكساء إذا قدّه نصفین فادّعی الولي أنّه كان حیّاً [قبل القدّ و مات بالقدّ] و الجاني أنّه كان میتاً فالاحتمالان متساویان»[7] .
شخص ملفوف في كساء ومُلقى على الأرض. فيأتي الجاني ويقدّه نصفين بضربة سيف. ويقع النزاع مرّة أخرى:
• ادّعاء الجاني: يقول الجاني إنّ هذا الشخص كان ميّتاً قبل أن أضربه، وقد قددتُ جثّة نصفين.
• ادّعاء أولياء الدم: يدّعون أنّه كان حيّاً وقُتل بضربة سيفك هذه.
• كيفيّة التمسّك بالأصل المثبت: هنا، خلافاً للمثال السابق، يمكن إجراء «استصحاب الحياة» لصالح أولياء الدم. أي إنّ الأصل هو أنّ ذلك الشخص كان حيّاً إلى لحظة ما قبل الضربة. واللازم العقلي لهذا الاستصحاب هو أنّ سبب الموت إذن هو ضربة السيف هذه. وبهذا الاستصحاب المثبت، يثبت «تحقّق القتل بالقدّ المذكور» ويكون الجاني ضامناً لقصاص أو ديّة المقتول. ويبيّن هذان المثالان جيّداً كيف أنّ الفقهاء الأعلام المتقدّمين قد تمسّكوا، في مسائل حسّاسة ومهمّة جدّاً كالقتل والديات، باستصحابات هي من وجهة نظرنا مصداق بارز للأصل المثبت. وهذا الأمر، كما قيل في المقدّمة، ربّما ناشئ من مبناهم في اعتبار الاستصحاب أمارة أو من نوع من المسامحة في التطبيق.


