46/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه السابع؛ المطلب الثالث؛ مناقشة المحقق الإصفهاني(قدس سره) في الموردین الثاني و الثالث صغرویاً/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
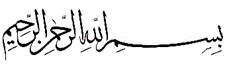
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه السابع؛ المطلب الثالث؛ مناقشة المحقق الإصفهاني(قدس سره) في الموردین الثاني و الثالث صغرویاً
مناقشة المحقّق الإصفهاني(قدسسره) في الموردين الثاني و الثالث صغرویاً
بعد أن نقدنا في الجلسات السابقة مباني نظريّة الشيخ الأنصاري(قدسسره) في باب «خفاء الواسطة»، وبيّنا كبديل لها المبنيين الراسخين والمتقنين «الملازمة في التعبّد» و«الوحدة في الأثريّة» اللذين هما من الابتكارات الدقيقة للمحقّق الكبير صاحب الكفاية(قدسسره)، نصل الآن إلى ذروة البحث وبحث مناقشة عميقة ومزلزلة. وهذه المناقشة، التي أوردها أحد الأعمدة التي لا نظير لها في علم الأصول، أي المحقّق الأصفهاني(قدسسره)، على هذين المبنيين نفسيهما لصاحب الكفاية(قدسسره)، هي من القوّة والدقّة إلى درجة أنّ تلميذه البارز، المحقّق الخوئي(قدسسره)، قد قبلها بالكامل وعكسها في آثاره. وفي الحقيقة، نحن في هذا القسم لا نواجه نقد المحقّق الخوئي لصاحب الكفاية(قدسسرهما)، بل نواجه نقده تبعاً كاملاً لأستاذه المحقّق الأصفهاني(قدسسره)؛ كما كان في نقد مبحث خفاء الواسطة تابعاً لأستاذه الآخر، الميرزا النائيني(قدسسره).
يقول المحقّق الخوئي(قدسسره):
«أمّا ما ذكره صاحب الكفایة(قدسسره) من حجّیة الأصل المثبت فیما إذا لمیمكن التفكیك في التعبّد بین المستصحب و لازمه عرفاً، أو كانت الواسطة بنحو یعدّ أثرها أثراً للمستصحب لشدّة الملازمة بینهما فصحیح من حیث الكبری، فإنّه لو ثبتت الملازمة في التعبّد في مورد، فلا إشكال في الأخذ بها، إلا أنّ الإشكال في الصغری لعدم ثبوت هذه الملازمة في مورد من الموارد.
و ما ذكره في المتضایفات من الملازمة في التعبّد مسلّم إلا أنّه خارج عن محلّ الكلام، إذ الكلام فیما إذا كان الملزوم فقط مورداً للتعبّد و متعلّقاً للیقین و الشك؛ كما ذكرنا في أوّل هذا التنبیه و المتضایفان كلاهما مورد للتعبّد الاستصحابي، فإنّه لایمكن الیقین بأبوة زید لعمرو بلا یقین ببنوّة عمرو لزید، و كذا سائر المتضایفات فیجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتیاج إلى القول بالأصل المثبت هذا إن كان مراده عنوان المتضایفین كما هو الظاهر.
و إن كان مراده ذات المتضایفین، بأن كان ذات زید و هو الأب مورداً للتعبّد الاستصحابي؛ كما إذا كان وجوده متیقّناً فشك في بقائه و أردنا أن نرتّب على بقائه وجود الابن مثلاً، بدعوی الملازمة بین بقائه إلى الآن و تولّد الابن منه، فهذا من أوضح مصادیق الأصل المثبت، و لاتصحّ دعوی الملازمة العرفیة بین التعبّد ببقاء زید و التعبّد بوجود ولده؛ فإنّ التعبّد ببقاء زید و ترتیب آثاره الشرعیة كحرمة تزویج زوجته مثلاً، و عدم التعبّد بوجود الولد له بمكان من الإمكان عرفاً، فإنّه لا ملازمة بین بقائه الواقعي و وجود الولد، فضلاً عن البقاء التعبّدي.
و أمّا ما ذكره من عدم إمكان التفكیك في التعبّد بین العلّة و المعلول فإن كان مراده من العلّة هي العلّة التامّة؛ ففیه: ما ذكرنا في المتضایفین من الخروج عن محلّ الكلام، لعدم إمكان الیقین بالعلّة التامّة بلایقین بمعلولها، فتكون العلّة و المعلول كلاهما متعلقاً للیقین و الشك و مورداً للتعبّد بلا احتیاج إلى القول بالأصل المثبت.
و إن كان مراده العلّة الناقصة (أي جزء العلّة) بأن یراد بالاستصحاب إثبات جزء العلّة مع ثبوت الجزء الآخر بالوجدان، فبضمّ الوجدان إلى الأصل یثبت وجود المعلول و یحكم بترتب الأثر، كما في استصحاب عدم الحاجب، فإنّه بضمّ صبّ الماء بالوجدان إلى الأصل المذكور یثبت وجود الغسل في الخارج و یحكم برفع الحدث، ففیه: إنّه لا ملازمة بین التعبّد بالعلّة الناقصة و التعبّد بالمعلول عرفاً، كیف و لو استثني من الأصل المثبت هذا، لما بقي في المستثنی منه شيء، و یلزم الحكم بحجّیة جمیع الأصول المثبتة، فإنّ الملزوم و لازمه إمّا أن یكونا من العلّة الناقصة و معلولها، و إمّا أن یكونا معلولین لعلّة ثالثة، و على كلا التقدیرین یكون استصحاب الملزوم موجباً لإثبات اللازم بناءً على الالتزام بهذه الملازمة، فلایبقی مورد لعدم حجّیة الأصل المثبت»[1] [2] [3] [4] [5] .
مقدّمة: طرح الإشكال والتفكيك بين الكبرى والصغرى
إنّ الكبرى الكلّيّة التي طرحها صاحب الكفاية(قدسسره)، أي «لو كان التفكيك التعبّدي بين اللازم والملزوم في مورد ما قبيحاً وغير ممكن عرفاً، أو كان أثر اللازم يُعدّ عيناً أثر الملزوم، لكان الأصل المثبت فيه حجّة»، هي كبرى صحيحة ومنطقيّة وعقلائيّة تماماً. فلو ثبتت حقّاً في مورد ما مثل هذه الملازمة في مقام التعبّد أو الوحدة في مقام الأثر، بالشكل الذي وصفه، فلا شكّ ولا تردّد في لزوم الأخذ بها وحجّيّة الاستصحاب المثبت في ذلك المورد الخاصّ.
ولكنّ كلّ إشكالنا ومناقشتنا هو إشكال صغرويّ. فنحن نعتقد أنّه لا يوجد لهذه الكبرى الكلّيّة مصداق وصغرى مقبولة في الخارج. فجميع الأمثلة التي ذُكرت لهذين الموردين، بعد التحليل الدقيق، إمّا هي خارجة تخصّصاً عن محلّ بحثنا، وإمّا هي من المصاديق الواضحة للأصل المثبت غير الحجّة. وبعبارة أخرى، هذه الكبرى سيف جميل في غمده لا يجد أبداً ميداناً ليعمل فيه.
ولإثبات هذا المدّعى الكبير، يتوجّه المحقّق الخوئي(قدسسره) إلى تشريح وتحليل نفس الأمثلة المفصليّة التي ذكرها صاحب الكفاية(قدسسره) كمصاديق: أي «المتضايفين» و«العلّة والمعلول».
النقد الأوّل: تشريح وتحليل مثال المتضايفين
يقسّم المحقّق الخوئي(قدسسره) في تحليل مثال المتضايفين (كالأبوّة والبنوّة) البحث بدقّة إلى فرضين ممكنين حتى لا يبقى أيّ مفرّ للمدّعى:
الفرض الأوّل: لو كان المراد «حيثيّة التضايف»
في هذا الفرض، نقبل بوجود ملازمة في اليقين والتعبّد بين هاتين الحيثيّتين. ولكنّ هذا المورد خارج تخصّصاً عن محلّ نزاعنا في باب الأصل المثبت؛ لأنّ محلّ بحثنا في الأصل المثبت هو حيث يكون الملزوم فقط متعلَّقاً لليقين السابق والشكّ اللاحق ويقع مورداً للتعبّد الاستصحابي، ونريد أن نرتّب عليه حكم اللازم. والحال أنّ مثل هذا الأمر غير ممكن أساساً في المتضايفين. «لا يمكن اليقين بأبوّة زيد لعمرو بلا يقين ببنوّة عمرو لزيد». فأساساً في عالم الذهن والمعرفة، لا يمكن أن يكون لديك يقين بـ«أبوّة زيد لعمرو» ولكن في الوقت نفسه لا يكون لديك يقين بـ«بنوّة عمرو لزيد». فهذان العلمان وهذان اليقينان متلازمان وغير قابلين للانفكاك. بناءً عليه، فلو تمّت أركان الاستصحاب (اليقين السابق والشكّ اللاحق) للملزوم (الأبوّة)، لكانت قد تمّت قطعاً وضرورةً ومن دون أيّ تردّد للازم (البنوّة) أيضاً. فما الحاجة إذن إلى التمسّك باستصحاب الأبوّة لإثبات البنوّة وطرح البحث المعقّد للأصل المثبت واستثناءاته؟ فيمكننا مباشرةً استصحاب نفس البنوّة التي لها جميع الأركان. فهذا لم يعد إثباتاً للازم باستصحاب الملزوم، بل هو جريان استصحابين مستقلّين في موضوعين يقينُهما متلازم. إذن، هذا الفرض خارج عن محلّ كلامنا.
الفرض الثاني: لو كان المراد «ذات المتضايفين»
في هذا الفرض، نضع حيثيّة التضايف جانباً ونستصحب ذات أحد الطرفين لنثبت له وصف التضايف. فمثلاً، نستصحب وجود وحياة زيد التي كانت متيقَّنة في الماضي، لنستنتج منها «كونه أباً» و«وجود الولد». وهذا الفرض هو «من أوضح مصاديق الأصل المثبت». فأين في العالم، وأيّ عرف سليم يرى ملازمة بين «التعبّد ببقاء حياة زيد» و«التعبّد بوجود ولد له»؟ فهذان قابلان للتفكيك تماماً أحدهما عن الآخر. فيمكننا أن نلتزم تعبّداً ببقاء حياة زيد ونرتّب آثاره الشرعيّة المباشرة (كحرمة زواج زوجته)، ولكن في الوقت نفسه لا يكون لدينا أيّ تعبّد بوجود ولد له. فقد يكون حيّاً ولكن لم يرزق بولد أبداً، أو قد توفّي ولده قبله. إذن، لا توجد ملازمة في التعبّد العرفي فحسب، بل إنّ الملازمة في عالم الواقع أيضاً منتفية. وهذا تماماً كمثال استصحاب حياة زيد لإثبات نبات لحيته الذي يعتبره الجميع أصلاً مثبتاً باطلاً.
نتيجة تحليل مثال المتضايفين:
هذا المثال إمّا هو خارج عن محلّ البحث (الفرض الأوّل)، وإمّا هو مصداق بارز للأصل المثبت الباطل (الفرض الثاني)، ولا يمكن بأيّ صورة أن يكون صغرى صحيحة لكبرى صاحب الكفاية(قدسسره).
النقد الثاني: تشريح وتحليل مثال العلّة والمعلول
هذا المثال أيضاً، الذي طُرح كمصداق ثانٍ، يُقسَّم ويُنقد بنفس التحليل الدقيق والمنهجيّ إلى فرضين:
الفرض الأوّل: لو كان المراد «العلّة التامّة»
هذا الفرض أيضاً، تماماً كالفرض الأوّل للمتضايفين، خارج عن محلّ كلامنا. لأنّه «لا يمكن اليقين بالعلّة التامّة بلا يقين بمعلولها». فمحال أن نتيقّن بتحقّق العلّة التامّة (أي مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع) ولكن لا نتيقّن بوجود معلولها. فالعلم بالعلّة التامّة هو عيناً العلم بالمعلول. بناءً عليه، فهنا أيضاً كلا الطرفين (العلّة والمعلول) متعلَّق لليقين والشكّ، ويمكن استصحاب نفس المعلول مباشرةً ولا حاجة إلى التوسّل ببحث الأصل المثبت واستثناءاته.
الفرض الثاني: لو كان المراد «العلّة الناقصة» (جزء العلّة)
هذا الفرض هو أهمّ وأدقّ وأحسّ جزء في مناقشة المحقّق الخوئي(قدسسره). فنحن هنا نثبت بالاستصحاب جزءاً من العلّة (مثلاً «عدم المانع» في مثال الوضوء) ولدينا سائر الأجزاء (مثلاً «وجود المقتضي» أي صبّ الماء، و«وجود الشرط») بالوجدان، ونريد بضمّ هذا الأصل التعبّدي إلى الأمور الوجدانيّة أن نستنتج وجود المعلول (أي «تحقّق الغَسل» و«رفع الحدث»). وهنا يطرح المحقّق الأصفهاني إشكالاً قويّاً ومزلزلاً جدّاً يوجّه في الواقع الضربة القاضية لهذا المبنى: «لا ملازمة بين التعبّد بالعلّة الناقصة والتعبّد بالمعلول عرفاً، كيف ولو استُثني من الأصل المثبت هذا، لما بقي في المستثنى منه شيء، ويلزم الحكم بحجّيّة جميع الأصول المثبتة». فهو يقول، أوّلاً لا توجد مثل هذه الملازمة في نظر العرف، وثانياً (وهو الإشكال الأهمّ)، لو قبلنا بأنّ التعبّد بجزء من العلّة ملازم للتعبّد بالمعلول، لكان هذا يعني فتح باب نتيجته هي حجّيّة جميع الأصول المثبتة وزوال قاعدة عدم الحجّيّة بالكامل.
بيان استلزام المفسدة الكبرى (لزوم تخصيص الأكثر):
كيف تلزم مثل هذه المفسدة؟ بيان ذلك هو: إنّ العلاقة بين أيّ ملزوم ولازم في العالم لا تخرج عن حالين: إمّا هي من نوع علاقة «العلّة الناقصة ومعلولها»، وإمّا هي من نوع «معلولين لعلّة ثالثة». والآن لو قلتم في القسم الأوّل (العلّة الناقصة والمعلول) بحجّيّة الأصل المثبت، لكان هذا يعني الحجّيّة في جميع الموارد تقريباً؛ لأنّ الملازمة علاقة طرفينيّة. فلو كان التعبّد بالعلّة الناقصة ملازماً للتعبّد بمعلولها، لكان التعبّد بالمعلول ملازماً للتعبّد بعلّته الناقصة أيضاً. والآن لننظر إلى هذه السلسلة:
١. نتعبّد بأصل ما بـ«لازم» (وهو معلول لـ"ألف").
٢. وبما أنّ التعبّد بالمعلول ملازم للتعبّد بـ«علّته الناقصة»، إذن نتعبّد بالعلّة الناقصة أيضاً.
٣. وهذه العلّة الناقصة قد يكون لها مئات اللوازم والمعاليل الأخرى (معلول “باء” و"جيم" و"دال" و…).
٤. وبما أنّ التعبّد بالعلّة الناقصة، حسب الفرض، ملازم للتعبّد بجميع معاليلها، إذن يجب أن نتعبّد بجميع تلك اللوازم الأخرى أيضاً.
النتيجة: إنّ التعبّد بلازم واحد يستلزم التعبّد بجميع اللوازم الأخرى لتلك العلّة الناقصة! وهذا يعني أنّنا كلّما أثبتنا لازماً باستصحاب، أمكننا إثبات جميع اللوازم الموازية له أيضاً. ومثل هذا الأمر لا يترك تقريباً أيّ مورد لعدم حجّيّة الأصل المثبت، وهذا يستلزم «تخصيص الأكثر» الذي هو قبيح ومستهجن عند العقلاء.
بناءً عليه، فإنّ قبول الملازمة في التعبّد بين العلّة الناقصة والمعلول ينتهي إلى مفسدة كبرى وغير قابلة للالتزام (أي زوال قاعدة عدم حجّيّة الأصل المثبت)، وهذا نفسه هو أفضل دليل على عدم وجود مثل هذه الملازمة في نظر العرف والعقلاء.
ملاحظات ثلاث علی هذه المناقشة
بعد أن بيّنا في الجلسة السابقة المناقشة الدقيقة والعميقة والمزلزلة للمحقّق الكبير المرحوم الأصفهاني والمحقّق الخوئي(قدسسرهما) على المبنيين الاستثنائيين لصاحب الكفاية(قدسسره)، تصل النوبة الآن إلى بحث ونقد هذه المناقشة نفسها. وسنطرح هنا ثلاث ملاحظات وإيرادات أساسيّة على كلام ذلك المحقّق الكبير، الذي تبعه فيه بالكامل تلميذه البارز المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره). وسنتناول بالتفصيل في هذه الجلسة الملاحظة الأولى والأساسيّة.
الملاحظة الأولى:
إنّ أوّل وأهمّ ملاحظة لدينا تتوجّه مباشرةً إلى قلب نقد المحقّق الأصفهاني(قدسسره)، أي إشكاله الصغروي في باب «المتضايفين». فقد قال إنّه يقبل بكبرى صاحب الكفاية(قدسسره) (أي لو كان التفكيك التعبّدي بين اللازم والملزوم قبيحاً، لكان الأصل المثبت حجّة)، ولكنّ هذه الكبرى لا صغرى ولا مصداق خارجيّ لها. فهو بتحليله لمثال «الأبوّة والبنوّة»، استنتج أنّه إمّا أن يكون كلا طرفي التضايف حائزين لأركان الاستصحاب وبالتالي لا حاجة إلى أصل مثبت (والبحث خارج تخصّصاً)، وإمّا أن يكون إثبات أحدهما باستصحاب الآخر أصلاً مثبتاً واضحاً وباطلاً.
ونحن نعتقد أنّ هذا الإشكال الصغروي، الذي يشكّل أساس وبنية نقده، ليس صحيحاً في جميع موارد وأقسام المتضايفين، ويمكن بسهولة تصوير صغرى دقيقة لكلام صاحب الكفاية تسلم من نصله النقدي.
تبيين النقد والإيراد على منهجيّة المحقّق الأصفهاني(قدسسره):
أوّلاً، يُورَد إيراد أساسيّ على منهجيّة هذا النقد. والإيراد هو: «لا يمكنك بإيرادك على مثال واحد أن تستنتج أنّ جميع المتضايفين هكذا». فالمحقّق الأصفهاني(قدسسره)، بالتركيز على مثال خاصّ، أي أبسط وأوضح نوع من التضايف (الأبوّة والبنوّة بين شخصين معيّنين) وبردّه، قد عمّم الحكم على جميع أقسام المتضايفين. والحال أنّ مقولة التضايف لها أقسام وصور وتعقيدات متنوّعة. فيمكننا تصوير حالة يكون فيها أحد طرفي التضايف، كعنوان كلّيّ، له حالة سابقة وقابل للاستصحاب، أمّا الطرف الآخر، الذي يشمل أفراداً متعدّدين، فبعض أفراده جديد وحادث وفاقد للحالة السابقة. وهذه تماماً هي النقطة التي يدخل فيها بحث الاستصحاب المثبت، وهي نفس الصغرى التي نبحث عنها.
تقديم مثال نقض (المولويّة والعبوديّة) لإيجاد الصغرى:
ولكي نُخرج هذا الادّعاء من الإطار الكلّي ونظهره بشكل ملموس، نبحث بدقّة مثال «المولويّة والعبوديّة» أو «القيوميّة». فهذا المثال يبيّن جيّداً كيف يمكن إيجاد صغرى لا نقص فيها لكبرى صاحب الكفاية.
لنتصوّر على هذا النحو: لقد جعل الشارع المقدّس أو حاكم شرع لشخص (كزيد مثلاً) مولويّة أو قيوميّة بالنسبة لعنوان كلّيّ (لا لفرد خاصّ). فمثلاً قال: «زيد هو مولى جميع عبيد قبيلة بني تميم» أو «زيد هو قيّم جميع أولاد عمرو». فلدينا هنا طرفان للتضايف: «المولى» (وهو زيد) و«العبد» (وهو عنوان كلّيّ يشمل أفراداً متعدّدين). والآن، بعد مرور زمن، يولد فرد جديد هو مصداق تامّ لذلك العنوان الكلّيّ. فمثلاً، يولد في قبيلة بني تميم عبد جديد، أو يرزق عمرو بولد آخر. والآن يطرأ علينا هذا السؤال الفقهي الدقيق: هل تثبت مولويّة وولاية زيد على هذا الفرد الحادث والمولود حديثاً أيضاً أم لا؟ لِنُحلّل وضع أركان الاستصحاب لكلا طرفي التضايف:
١. الطرف الأوّل (مولويّة زيد): هل لمولويّة زيد حالة سابقة يقينيّة؟ نعم. «لنفس المولويّة يقين سابق، فهي إذن قابلة للاستصحاب». كنّا على يقين بأنّ لزيد مولويّة على «العنوان الكلّيّ لعبيد بني تميم». ونشكّ الآن فيما إذا كانت هذه المولويّة باقية لتشمل هذا الفرد الجديد أم لا. إذن، أركان استصحاب «بقاء مولويّة زيد على ذلك العنوان الكلّيّ» تامّة بالكامل.
٢. الطرف الثاني (عبوديّة الفرد الحادث): هل لعبوديّة هذا الفرد المولود حديثاً حالة سابقة يمكننا استصحابها بشكل مستقلّ؟ كلّا، بأيّ وجه. فهو موجود جديد، وقبل ولادته لم يكن له وجود حتى تُتصوَّر له حالة. إذن، لا يمكننا استصحاب «عبوديّته» مباشرةً.
الاستنتاج من المثال: هذه تماماً هي نفس الصغرى التي اعتبرها المحقّق الأصفهاني(قدسسره) مستحيلة. ففي هذا المثال:
لا يمكننا إجراء الاستصحاب مباشرةً في اللازم (عبوديّة الفرد الحادث)، لأنّه لا حالة سابقة له.
ولكن يمكننا إجراء الاستصحاب في الملزوم (مولويّة زيد على العنوان الكلّيّ)، لأنّه حائز لجميع الأركان.
ومن وجهة نظر العرف، من المعقول تماماً أن نقول إنّه لو استُصحبت مولويّة المولى على عنوان كلّيّ، لوجب أن تسري هذه المولويّة على جميع مصاديق ذلك العنوان، حتّى المصاديق الجديدة والحادثة.
وهنا لم يعد بالإمكان القول: «منذ الوقت الذي تيقّنّا فيه بأبوّة زيد، تيقّنّا إذن ببنوّة عمرو أيضاً». فهذا القول، كما قلنا، لا يصدق إلّا على أوّل فرد في طرف التضايف، ولكن عندما يكون أحد الطرفين عنواناً كلّيّاً ذا أفراد متعدّدة وحادثة، لم يعد الأمر كذلك. إذن، نجري الاستصحاب في المولويّة، وتبعاً له، نلتزم بعبوديّة الفرد الحادث التي هي لازمه العرفيّ. وهذا استصحاب مثبت يبدو حجّة بسبب الملازمة العرفيّة الشديدة، وهو صغرى تامّة وكاملة لكبرى صاحب الكفاية(قدسسره).
تحليل أعمق: الفرق بين التضايف في التعقّل وفي الوجود
قد يطرأ هذا السؤال: لماذا يكون كلام المحقّق الأصفهاني(قدسسره) صحيحاً في مثال الأب والابن، ولكن يكون كلامنا صحيحاً في مثال المولى والعبد (في سيناريونا)؟ يكمن الجواب في نكتة فلسفيّة ومنطقيّة دقيقة ترجع إلى أنواع «الإضافة». «المتضايفان متلازمان في التعقّل ولكنّهما ليسا متكافئين دائماً قوّةً وفعلاً». فيجب التفكيك بين مقامين:
١. الإضافة المقوليّة: هذا النوع من الإضافة هو علاقة بين أمرين وجوديّين مستقلّين ومتكافئين. كالعلاقة بين الأب والابن، أو الفوق والتحت. وهنا تحكم القاعدة العقليّة «المتضايفان متكافئان قوّةً وفعلاً وخارجاً وعلماً». أي لو كان أحدهما موجوداً بالفعل في الخارج، لوجب أن يكون الآخر موجوداً بالفعل بالضرورة. ونقد المحقّق الأصفهاني(قدسسره) ينطبق تماماً على هذا القسم من التضايف، وفي هذا المورد، كلامه صحيح.
٢. الإضافة الإشراقيّة: ولكن يوجد قسم ثانٍ من الإضافة لا يكون فيه طرفا العلاقة أمرين متكافئين ومتساويين في الرتبة. بل يكون أحد الطرفين (كالمخلوق أو المعلول) هو عين الربط والفقر والتعلّق بالطرف الآخر (كالخالق أو العلّة). فالمخلوق هو تجلّي الخالق و«نفس الإضافة»، لا وجود مستقلّ في عرضه. ولهذا السبب ورد في المعارف الإسلاميّة العميقة وروايات أهل البيت(علیهمالسلام) التعبير المدهش «خَالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ»[6] [7] أو الروايات التي وردت في باب تفسير الله أكبر [8] [9] [10] . وهذا يعني أنّ الخالقيّة، كصفة وشأن، قائمة بذات الحقّ تعالى، حتّى قبل أن يصل المصداق الخارجي للمخلوقيّة إلى الفعليّة. فهنا، «التضايف في التعقّل دون الوجود الخارجي». أي لتصوّر الخالقيّة، يجب تصوّر المخلوقيّة أيضاً، ولكنّ وجود الخالق الخارجي لا يستلزم وجود المخلوق الخارجي بالفعل في جميع الأزمان. ويبيّن هذا التحليل أنّ «وجود المولويّة لا يتوقّف على وجود العبوديّة»، خصوصاً عندما تُجعل المولويّة لعنوان كلّيّ. فيمكن اعتبار مولويّة لعنوان كلّيّ تكون هذه المولويّة، كشأن وحكم كلّيّ، موجودة حتّى قبل وجود جميع أفراد ومصاديق ذلك العنوان.
بناءً عليه، فإنّ استصحاب تلك المولويّة لإثبات الحكم على الفرد الحادث هو صغرى معقولة ودقيقة وقابلة للدفاع تماماً لكبرى صاحب الكفاية(قدسسره)، ومناقشة المحقّق الأصفهاني(قدسسره) في هذا القسم، بسبب عدم الالتفات إلى جميع أقسام المتضايفين والخلط بين التضايف في مقام التعقّل والتضايف في مقام الوجود، ليست كاملة وقابلة للخدش.


