46/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه السابع؛المطلب الثالث؛ نظریة المحقق النائیني و المحقق الخوئي(قدس سرهما)/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
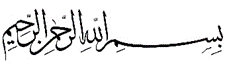
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه السابع؛المطلب الثالث؛ نظریة المحقق النائیني و المحقق الخوئي(قدس سرهما)
الجمع النهائي وتقديم إطار بديل:
بالنظر إلى هذا النقد القويّ، يجب القول إنّ نظريّة «خفاء الواسطة» بالمعنى الذي طرحه الشيخ(قدسسره) والذي يؤدّي إلى التسامح في تطبيق موضوع الحكم، غير قابلة للدفاع. ولكنّ هذا لا يعني ردّ جميع المصاديق التي قصدها. فنحن لا نزاع لدينا في التسمية؛ فلو أصرّ أحد على تسمية هذه الموارد بـ«الواسطة الخفيّة»، فلا مشكلة؛ «لا مشاحّة في الاصطلاح». فالنزاع الرئيسي هو في الفتوى والنتيجة العمليّة. فنحن نخالف نظريّة الشيخ(قدسسره) في مثال السراية، لأنّها تؤدّي إلى فتوى خاطئة و«خلاف ما أنزل الله». فهناك تحكمون بالنجاسة باستصحاب مجرّد الرطوبة، والحال أنّ موضوعها (السراية) لم يتحقّق.
بناءً عليه، فالمنهج الصحيح هو إعادة النظر في هذه المصاديق وإدراجها تحت عناوين أدقّ وأكثر قابليّة للدفاع، أي «الواسطة الجليّة» التي ستأتي في القسمين التاليين. وفي الحقيقة، إنّ بعض هذه الوسائط التي سمّاها الشيخ خفيّة، هي على العكس جليّة جدّاً، ولكنّها بسبب شدّة ارتباطها الوجودي بالملزوم، لا تُفكَّك عنه عرفاً.
التحليل المجدّد للأمثلة الثلاثة للشيخ الأنصاري في ضوء نقد النائيني(قدسسرهما): حاصل الكلام هو أنّ مجرّد «خفاء الواسطة» وعدم التفات العرف إليها، بعد أن قبلنا بأنّ تلك الواسطة في لسان الأدلّة هي جزء مقوِّم لموضوع الحكم، لا أثر شرعيّ له. ويتّضح هذا المطلب بالبحث الدقيق في أمثلة الشيخ(قدسسره):
في المثال الأوّل (السراية): المستفاد من الأدلّة هو أنّ موضوع تنجيس شيء ما إثر ملاقاة النجس ليس مجرّد الملاقاة أو مجرّد الرطوبة، بل هو «سراية الرطوبة» من الشيء النجس إلى الشيء الطاهر. واستصحاب «مجرّد وجود الرطوبة» يُحرز فقط جزءاً من هذا الموضوع المركّب (وذلك أيضاً لو أخذنا الرطوبة بمعنى أعمّ). أمّا الجزء الآخر الذي هو الركن الأساسي، أي «كون الرطوبة سارية وتحقّق نفس السراية»، فيجب إحرازه بطريق آخر. وترتيب حكم التنجيس من دون إحراز هذا الجزء هو أصل مثبت واضح ومخالف للشرع.
في المثال الثالث (عدم الحاجب): هنا أيضاً موضوع صحّة الوضوء والغسل في الروايات هو «إيصال الماء إلى البشرة» أو «غَسل البشرة». فمن دون إحراز هذا الموضوع، لا يمكن ترتّب حكم الصحّة. والحال أنّ عنوان «عدم الحاجب» أو «عدم المانع» الذي نستصحبه، لا ينطبق على نفس عنوان «الإيصال» و«الغَسل».
الفرق الدقيق بين المثال الأوّل والثالث: توجد هنا نكتة بنيويّة مهمّة تعمّق التحليل. «الفرق بين المثال الأوّل والثالث هو أنّ المستصحَب في المثال الأوّل هو جزء آخر للموضوع غير الواسطة التي هي أيضاً جزء للموضوع… أمّا المستصحَب في المثال الثالث فليس جزءاً من أجزاء الموضوع». أي إنّه في المثال الأوّل، كلّ من المستصحَب (الرطوبة) والواسطة (السراية) هما جزءان حقيقيّان لموضوع مركّب. أمّا في المثال الثالث، فالمستصحَب (عدم الحاجب) ليس جزءاً من الموضوع أصلاً، بل هو «ملزوم» لتحقّق الموضوع، ونفس الموضوع («إيصال الماء») يُعدّ «لازماً» له.
في المثال الثاني (يوم الشكّ): يشبه هذا المثال أيضاً المثال الثالث من حيث البنية. فموضوع أحكام العيد هو «كون ذلك اليوم هو الأوّل من شوّال». والاستصحاب الذي نجريه يثبت أنّ «يوم الشكّ هو من شهر رمضان». وهذا المستصحَب ليس موضوعاً لحكم العيد. والارتباط بينهما يتمّ من خلال «تلازم بين إحرازين» يتشكّل بقرينة عقليّة قطعيّة هي «تعاقب الأيّام». فعندما يُحرز أنّ اليوم هو آخر رمضان، يُحرز أنّ غداً هو أوّل شوّال أيضاً. وهنا أيضاً لا تجدي النكتة التي طرحها الشيخ(قدسسره) من باب المسامحة العرفيّة نفعاً. لأنّه لا يمكن إسناد أحكام يوم العيد، لا حقيقةً ولا مسامحةً، إلى المستصحَب (أي كون اليوم السابق آخر رمضان). بل إنّ أحكام العيد مستندة إلى لازم المستصحَب وهو «إحراز أوّل شوّال».
النتيجة النهائيّة لهذا القسم: إنّ أمثلة الشيخ(قدسسره) الثلاثة كلّها إمّا مصداق خاطئ لخفاء الواسطة (كالمثال الأوّل الذي يؤدّي إلى فتوى باطلة) أو يجب بحثها تحت عناوين أدقّ هي نفس الموردين الثاني والثالث للاستثناء (أي الواسطة الجليّة). بناءً عليه، تسقط نظريّة خفاء الواسطة كاستثناء مستقلّ ومبنيّ على التسامح العرفيّ عن درجة الاعتبار.[1]
دفاع صاحب الكفایة(قدسسره) عن نظریة الشیخ الأعظم الأنصاري(قدسسره)[2]
بعد أن بُيّنت مباني نظريّة «خفاء الواسطة» والإشكالات الأساسيّة الواردة عليها من وجهة نظر المحقّق النائيني والمحقّق الخوئي(قدسسرهما)، تصل النوبة إلى بحث الدفاع الذي قدّمه أحد أكبر المدافعين عن نظريّة الشيخ(قدسسره)، أي صاحب الكفاية (المرحوم الآخوند الخراساني(قدسسره)). فهو يسعى، بتقديم تفسير دقيق وتنقيح، إلى حماية نظريّة أستاذه من الإشكالات البنيويّة، لا سيّما إشكال «الاعتماد على المسامحات العرفيّة».
تبيين دفاع صاحب الكفاية عن نظريّة الشيخ الأنصاري(قدسسرهما)
المرحوم الآخوند الخراساني(قدسسره)، بذكاء تامّ، يفصل خطّه أوّلاً عن الذين يعطون اعتباراً مطلقاً لـ«مسامحات العرف التطبيقيّة». فهو أيضاً يعتقد أنّ تهاون وعدم دقّة العرف في تطبيق المفاهيم على المصاديق الخارجيّة لا اعتبار له. ولكنّ مدّعاه هو أنّ مسألة «خفاء الواسطة» خارجة أساساً عن هذه المقولة.
فهو في دفاعه عن الشيخ(قدسسره) لا يقول إنّنا بسبب «خفاء» الواسطة نتغاضى عنها ونرتّب حكمها مسامحةً على ذي الواسطة. فهذا تطبيق خاطئ. بل يخطو خطوة إلى الأمام ويدّعي أنّ «خفاء الواسطة يوجب عدّ آثاره وأحكامه من آثار نفس المستصحَب وأحكامه». أي إنّ شدّة خفاء الواسطة وعدم إحساس العرف بها توجب أن يعتبر العرف أساساً «آثار وأحكام تلك الواسطة هي عين آثار وأحكام نفس المستصحَب (الملزوم)». وبعبارة أخرى، هذه ليست مسامحة في التطبيق، بل هي «رؤية وحدويّة في مقام الأثريّة». فأدلّة الاستصحاب التي تجعل الآثار الشرعيّة للمستصحَب حجّة، تشمل حقيقةً لا مسامحةً، بحسب الفهم العرفي، الآثار المترتّبة عقلاً على الواسطة الخفيّة أيضاً؛ لأنّ العرف لا يفرّق بين هاتين المجموعتين من الآثار ويعتبرها جميعاً من آثار نفس المستصحَب. إذن، أدلّة الاستصحاب تشمل بعمومها هذه الموارد أيضاً.
بناءً عليه، لا يرى المرحوم الآخوند(قدسسره) وجه الحجّيّة في مجرّد «الخفاء» الذي يكون مبرّراً للتسامح، بل يرى وجه الحجّيّة في هذه النكتة العرفيّة الدقيقة وهي أنّ «العرف يرى أثر اللازم هو أثر نفس الملزوم». وهو بهذا البيان، يوجّه في الحقيقة روح نظريّة «خفاء الواسطة» نحو مبنى الموردين الثاني والثالث للاستثناء اللذين سيطرحهما هو نفسه لاحقاً.
يلاحظ عليه
على الرغم من أنّ هذا الدفاع ذكيّ ودقيق، إلّا أنّه يعاني من إشكال بنيويّ. فيجب هنا أن يكون أصل أساسيّ نصب أعيننا دائماً وهو: «إنّ المدار في تعيين موضوع الأحكام الشرعيّة إنّما هو جعل الشارع». فالمرجع النهائي لتشخيص ما هو موضوع حكم ما هو إرادة وجعل الشارع المقدّس، لا رأي العرف. والآن في محلّ بحثنا، الفرض هو أنّ الشارع قد وضع الحكم على «اللازم» (كالسراية أو إيصال الماء) لا على «الملزوم» (الرطوبة أو عدم الحاجب).
فاللازم والملزوم أمران متمايزان؛ عقلاً وشرعاً وفي النظر العرفيّ الدقيق أيضاً. فالعقل يحكم بتغايرهما. والشارع أيضاً، بوضعه الحكم على أحدهما دون الآخر، قد أمضى هذا التغاير. والآن لو رأى العرف، بسبب خفاء الواسطة وعدم الالتفات، أنّهما واحد أو اعتبر أثر أحدهما أثر الآخر، فهذه رؤية مسامحة لا يمكن أن تكون ملاكاً للعمل. فواجبنا كفقهاء ومبلّغين للأحكام، عند مواجهة مثل هذا عدم الالتفات من قبل العرف، ليس هو أن نفتي بناءً عليه. بل واجبنا هو تنبيه وإيقاظ العرف. فيجب أن نقول للعرف: «أيّها العرف! ليس هذا مقام التسامح. فموضوع حكم الله الدقيق هو «السراية»، لا مجرّد الرطوبة. فانتبه إلى هذه الواسطة التي خفيت عن نظرك!».
فيجب علينا أن نجعل هذه الواسطة الخفيّة «جليّة» للعرف، لا أن نصادق على خفائها. إنّ حدّ وصلاحيّة العرف هو في تعيين مفهوم موضوع ما وسعته وضيقه، ولكن ليس للعرف صلاحيّة جعل موضوع أو تغيير موضوع لحكم شرعيّ. فلو أراد العرف أن يستبدل موضوعاً عيّنه الشارع بموضوع آخر، لكان هذا العمل تدخّلاً في أمر التشريع وغير مقبول. بناءً عليه، فالرأي العرفيّ الذي يريد أن يرتّب أحكام اللازم على الملزوم لا أثر له، وما قاله الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية(قدسسرهما) في هذا الباب يبدو «مخدوشاً».[3] [4] [5] [6] [7] [8]
التوجيه وإعادة التفسير النهائي لنظريّة الشيخ الأنصاري(قدسسره)
مع كلّ هذا، يمكن تقديم توجيه وتفسير نهائيّ لنظريّة الشيخ الأنصاري(قدسسره) يخلّصها من الإشكالات المذكورة ويلحقها بالموارد التالية للاستثناء. فيمكن القول: قد يكون مقصود الشيخ(قدسسره) هو أنّ «خفاء الواسطة» وعدم التفات العرف إلى اللازم يكون أحياناً بسبب «شدّة الارتباط الوجودي» بين اللازم والملزوم؛ ارتباط وثيق إلى درجة أنّ العرف يرى وجود الملزوم والتعبّد به غير قابل للتفكيك عن وجود اللازم والتعبّد به. وبهذه النظرة، فكأنّ «إحراز الملزوم هو عين إحراز اللازم»، من دون حاجة إلى إحراز مستقلّ وجديد يتعلّق بنفس اللازم. فلو كان المقصود هذا، أي لو رأى العرف بسبب شدّة التلازم أثر هذا أثر ذاك أو اعتبر التعبّد بهذا عين التعبّد بذاك، فنعم، «فبها ونعمت». وهذا هو نفس ما سنتناوله في الموردين الثاني والثالث للاستثناء، ولم يعد له علاقة بالتسامح وتجاهل موضوع الحكم.
المورد الثاني: الواسطة الجلیة التي بینها و بین الملزوم ملازمة في التعبّد عرفاً
بعد أن نُقد وخُدش مبنى «خفاء الواسطة» كاستثناء مستقلّ، نصل الآن إلى أوّل إطار صحيح وقابل للدفاع لحجّيّة الأصل المثبت في موارد خاصّة. وهذا المورد، الذي هو من ابتكار المحقّق الكبير صاحب الكفاية(قدسسره) في تعليقته الثمينة على فرائد الأصول، يرتكز على محوريّة «الواسطة الجليّة»؛ واسطة ليست خفيّة ومستترة فحسب، بل إنّها بسبب وضوحها وشدّة ارتباطها بملزومها، توجب ترتّب الأثر.
والعنوان الدقيق لهذا المورد هو «الواسطة الجليّة التي يوجد بينها وبين الملزوم ملازمة في مقام التعبّد العرفي». وجوهر هذه النظريّة يكمن في هذا القيد «الملازمة في التعبّد العرفي». فالكلام هنا ليس عن أنّ العرف لا يرى الواسطة بسبب الغفلة؛ بل على العكس، الواسطة جليّة وواضحة تماماً، ولكنّ وضوحها وجلاءها بمثابة توجب في نظر العرف الدقيق «ملازمة في مقام التنزيل والتعبّد». بمعنى أنّ دليل اعتبار وحجّيّة وتنزيل أحد الطرفين (الملزوم) يُعدّ عيناً ومن دون حاجة إلى دليل جديد، دليلاً على اعتبار وتنزيل الطرف الآخر (اللازم) أيضاً. فالتفكيك في مقام التعبّد والحجّيّة بينهما أمر قبيح وغير معقول وغير مقبول في نظر العرف.
يقول صاحب الكفاية(قدسسره) في تبيين هذا المبنى الدقيق:
«و یلحق بذلك أي خفاء الواسطة جلاؤها و وضوحها فیما كان وضوحه بمثابة یورث الملازمة بینهما في مقام التنزیل عرفاً [أي التعبّد عرفاً] بحیث كان دلیل تنزیل أحدهما دلیلاً على تنزیل الآخر؛ كما هو كذلك في المتضایفین؛ لأنّ الظاهر أنّ تنزیل أبوة زید لعمرو مثلاً یلازم تنزیل بنوّة عمرو له، فیدلّ تنزیل أحدهما على تنزیل الآخر و لزوم ترتیب ما له من الأثر»[9] .
الشارع المقدّس عندما يعبّدنا من خلال أصل عمليّ كالاستصحاب ببقاء أمر ما، لا يمكننا بمجرّد الدقّة العقليّة أن نعتبر جميع لوازمه العاديّة والعقليّة ثابتة أيضاً؛ وهذا هو نفس معنى عدم حجّيّة الأصل المثبت. ولكنّ هذه القاعدة الكلّيّة تفقد فاعليّتها عند مواجهة بعض اللوازم الخاصّة التي لها ارتباط لا ينفصم بملزومها. ففي هذه الموارد، لو أردنا أن نفرّق بين التعبّد بالملزوم والتعبّد باللازم، لكنّا قد ارتكبنا أمراً قبيحاً ومستهجناً من وجهة نظر العرف.
المصداق البارز: المتضايفان
أفضل وأوضح مثال لهذا المورد هو العلاقة بين الأمور المتضايفة كـ«الأبوّة والبنوّة». لنفرض أنّنا أثبتنا باستصحاب «أبوّة زيد لعمرو». فهل يمكننا في محكمة العرف أن ندّعي: «نعم، لقد قبلنا تعبّداً بأنّ زيداً هو أبو عمرو، ولكن بما أنّ إثبات «بنوّة عمرو لزيد» هو لازم عقليّ وأصل مثبت، إذن فعمرو هو ابن بلا أب»؟! قطعاً لا يُقبل مثل هذا القول. فالعرف يضحك من مثل هذا التفكيك الدقيانوسيّ العديم الروح ويسخر من قائله. وهنا نقول إنّ تنزيل الأبوّة هو عيناً وملازماً تنزيل البنوّة. فهذان لا ينفكّان تعبّديّاً أحدهما عن الآخر. ويجب الالتفات إلى أنّه عندما تثبت البنوّة، يجب ترتيب جميع آثارها أيضاً. فليس الأمر أن نقول إنّ بعض آثار الأبويّة تثبت أمّا آثار البنويّة فلا. كلّا؛ فإذا ثبتت الأبويّة، وجب ترتيب جميع آثار البنويّة، من وجوب الإنفاق والإرث إلى المحرميّة وسائر الأحكام، بشكل كامل.
مصداق آخر: العلّة والمعلول
إنّ العلاقة بين العلّة التامّة ومعلولها هي من هذا القبيل أيضاً. فالتفكيك التعبّديّ بين العلّة والمعلول، كالتفكيك في عالم الواقع، أمر محال وغير ممكن. فلا يمكن القول إنّنا متعبّدون بوجود العلّة، ولكن ليس لدينا أيّ تعهّد بوجود معلولها. فالمعلول قائم بعلّته، والتعبّد بأحدهما من دون قبول الآخر أمر لا معنى له ولغو. فاستصحاب علّيّة أمر ما لشيء آخر يستلزم عرفاً قبول معلوليّة ذلك الشيء لذلك الأمر.
بناءً عليه، فالمورد الثاني هو إطار متقن وراسخ يرتكز على الفهم العرفيّ الدقيق، ويبيّن أنّه في الموارد التي يستلزم فيها الانفكاك التعبّديّ بين اللازم والملزوم قبحاً واستهجاناً عرفيّاً، يكون الأصل المثبت حجّة.
المورد الثالث: الواسطة الجلیة التي یُعدّ أثرها أثراً للملزوم
نصل الآن إلى الإطار المتقن والراسخ الثاني لحجّيّة الأصل المثبت، وهذا المورد أيضاً من الابتكارات الدقيقة للمحقّق الكبير صاحب الكفاية(قدسسره)[10] فنحن هنا نواجه تحليلاً عرفيّاً مختلفاً ومكمِّلاً في الوقت نفسه للمورد السابق. فلو كانت المحوريّة في المورد الثاني لـ«التلازم في مقام التعبّد»، فإنّ بؤرة البحث في هذا المورد الثالث تتركّز على «الوحدة في مقام الأثريّة».
وبعبارة أخرى، لا نقول هنا إنّ التعبّد بالملزوم هو عين التعبّد باللازم؛ بل نطرح ادّعاءً أعمق: ففي نظر العرف، «يُرى أثر اللازم هو عين أثر الملزوم». فكأنّ الدائرة المفهوميّة والأثريّة للملزوم، في الفهم العرفي، واسعة وشاملة إلى درجة أنّها تشمل آثار لازمها البيّن وغير المنفكّ عنها أيضاً وتعتبرها جزءاً من منظومة آثارها. وفي مثل هذه الظروف، فعندما نرتّب أثر اللازم، فإنّنا في الحقيقة نرتّب أثراً يراه العرف من شؤون نفس المستصحَب؛ وعليه، لم يعد هذا أصلاً مثبتاً مستهجناً وذا واسطة عقليّة صرفة.
تبيين وتفصيل المبنى بذكر المصاديق:
يُبيَّن هذا المبنى الدقيق بمصداقين واضحين يتمتّعان كلاهما بوضوح عالٍ:
المصداق الأوّل (اللازم الذاتي): نور الشمس بالنسبة للشمس
هذا المثال هو بيت القصيد في تبيين هذا المورد. لنفرض أنّنا شككنا في بقاء الشمس في أفق السماء واستصحبناها. فهل يمكننا الآن في محكمة العرف أن ندّعي: «نحن ملتزمون تعبّداً بوجود نفس جرم الشمس، ولكن ليس لدينا أيّ تعهّد بوجود النور الذي هو لازمها الذاتي وغير المنفكّ عنها»؟ وهل يمكن القول «الشمس موجودة ولكن لا نور لها»؟ إنّ مثل هذا التفكيك بعيد عن الفهم العرفي والعقلائي إلى درجة أنّه يوجب الاستهزاء والسخرية. سيقول العرف في مواجهة مثل هذا الفقيه: «لقد غرق هؤلاء في الدقائق العقليّة وبحث اللازم والملزوم إلى درجة أنّهم نسوا البديهيّات العرفيّة (قرأوا كثيراً عن اللازم والملزوم واختلط عليهم الأمر)!». بناءً عليه، فعندما نستصحب بقاء الشمس، يثبت لازمها البيّن أي «إضاءة نور الشمس» تبعاً له أيضاً. والآن لو ترتّب أثر شرعيّ خاصّ، كطهارة الأرض (التطهير بإشراق الشمس)، على هذا اللازم، لترتّب ذلك الأثر أيضاً. وطبعاً يجب الالتفات إلى أنّ هذا المثال يُطرح بفرض وجود سائر شروط المطهِّريّة (كعدم وجود السحاب، وجفاف الأرض، و…). فالبحث الأصولي هنا يتركّز فقط على التلازم الوجودي والأثري بين «الشمس والنور»، لا على عمليّة التطهير بأكملها. والفرق بين هذا المورد والأمثلة الضعيفة كاستصحاب حياة زيد لإثبات نبات لحيته واضح تماماً. فهناك، لا يدرك العرف أيّ تلازم ووحدة أثريّة من هذا القبيل.
المصداق الثاني (الملازم): المتضايفان من منظور الأثريّة
باب التضايف، الذي كان مصداقاً بارزاً للمورد الثاني، قابل للتحليل من هذا المنظور أيضاً. فمثلاً، لنأخذ علاقة الأخوّة والأختيّة في الاعتبار. فالأثر الشرعي المترتّب على أخوّة رجل لامرأة هو «المحرميّة وحرمة الزواج». وهذا الأثر هو تماماً نفس الأثر الذي يترتّب على أختيّة تلك المرأة لذلك الرجل أيضاً. فهنا الأثر واحد. بناءً عليه، فعندما نثبت الأخوّة بالاستصحاب، فإنّنا في الحقيقة نرتّب أثراً (المحرميّة) يكون هذا الأثر هو أثر الأخوّة وأثر الأختيّة معاً. «يُعدّ أثرها أثر الأختيّة لمكان التضايف». وبسبب هذه الوحدة في الأثر، لم يعد للتفكيك بينهما في مقام ترتّب الحكم معنى، والاستصحاب وإن كان مثبتاً بالدقّة العقليّة، إلّا أنّه يُعدّ من الموارد المستثناة المقبولة.
الاستنتاج والتطبيق على الموارد الخلافيّة:
بناءً عليه، ففي الموارد التي يكون فيها اللازم والملزوم، وإن كانا متمايزين بالدقّة العقليّة، إلّا أنّهما في النظر العرفي إمّا غير قابلين للتفكيك في التعبّد بهما (المورد الثاني) وإمّا يُعتبر أثرهما واحداً (المورد الثالث)، يكون الأصل المثبت حجّة. وهذا هو نفس المبنى القابل للدفاع الذي يمكن إرجاع كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية(قدسسرهما) إليه وتنقيحه من الإشكالات الواردة. وبهذا المعيار، يمكن التوجّه إلى الموارد الخلافيّة كـ«استصحاب عدم المانع» لإثبات «وصول الماء إلى البشرة». فيجب هنا سؤال العرف: هل ترون «عدم وجود المانع» و«وصول الماء» أمرين ذوي أثرين مختلفين، أم أنّكم تعتبرون معنى وأثر «لا يوجد مانع» هو عيناً «إذن فالماء قد وصل»؟ فلو قبل العرف بالثاني ورأى أثر هذين واحداً، لكان هذا المورد يندرج تحت هذا القسم الثالث نفسه ويكون استصحاب عدم المانع مثبتاً لصحّة الوضوء والغسل، من دون أن نقع في فخّ الأصل المثبت غير الحجّة.


