47/04/05
بسم الله الرحمن الرحیم
رجوع القیود إلی الهیئة أو المادّة/الأوامر /مباحث الألفاظ
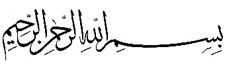
الموضوع: مباحث الألفاظ/الأوامر /رجوع القیود إلی الهیئة أو المادّة
ملخص الجلسة السابقة:
تناولت الجلسة السابقة البحث في مسألة «مقدمة الواجب»، و تمّ طرح مباحث حول: هل القيود قيد الهيئة أم قيد المادّة؟ أي: تلك القيود الواردة في لسان الشارع، هل تتعلّق بالوجوب (قيد الوجوب/قيد الهيئة) أم ترجع إلى الواجب (قيد الواجب/قيد المادة)؟
ثمرة البحث:
ثمرة هذا البحث واضحة:
• إذا كان القيد للوجوب: فلا يجب تحصيل مقدّماته؛ أي إنّ الوجوب مشروط، و ليس على المكلّف أن يهيّئ تلك المقدّمات قبل تحقّق الشرط.
• أما إذا كان القيد للواجب: فيجب تحصيل مقدماته؛ أي إنّه لتحقيق الواجب يجب أن تكون المقدّمات مهيّأةً مسبقاً (مثل الوضوء و الغسل في الصلاة).
تمييز «الإرادة التكوينية» من «الإرادة التشريعية»
لتوضيح المطلب، لا بدّ من التمييز بين نوعين من الإرادة:
١. الإرادة التكوينيّة:
هي التي يقوم بها الإنسان أو الله تعالى بالفعل بنفسه؛ كمثال بسيط عندما يقوم الإنسان و يشرب الماء بنفسه. و كذلك الله- تعالى- في مقام التكوين قد خلق العالم – و هذه هي «الإرادة التكوينية».
٢. الإرادة التشريعيّة:
هي صدور أمر من المولى إلى غيره: «يا بني، احضر لي الماء». و في الشريعة، فإنّ أحكام الله- تعالى- من نوع الإرادة التشريعية: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[1] ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[2] و ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] ، فلله- تعالی- و للإنسان نوعان من الإرادة: الإرادة التكوينية (التحقيق الخارجي) والإرادة التشريعية (صدور الحكم).
الاستدلال الأول:
في الإرادة التشريعية يتمّ تحديد مطلوب و تُدرس المصالح و المفاسد؛ و هذا المطلوب يكون على هيئة قضيّة حقيقيّة: مثلاً ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[4] ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[5] و غيرها، هي أحكام كلية حقيقيّة تُعلن مصلحة جماعة المؤمنين في إقامة الصلاة، و إيتاء الزكاة، و الصوم و غير ذلك.
أما عندما يريد الإنسان تحقيق ذلك الحكم في الخارج، فقد يواجه موانع و مشاكل (كالمرض أو عدم وجود الماء أو عدم القدرة على الوقوف و ما شابها). هذه الموانع تتعلّق بالقضية الفعلية، أو بما يسمّى «التحقيق الخارجي». القيود و الشروط التي وردت في الروايات تتعلّق بهذا التحقيق الخارجي و رفع الموانع: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[6] أو إذا لم يكن الوقوف ممكناً فَصَلّوا جالسین؛ لذا فإنّ هذه القيود هي قيود واجبة.
لذا تنقسم القضايا الى نوعين:
• القضية الحقيقية – و هي الوجوب الكلّي / المطلق (مصالح المولى).
• القضية الفعلية- و هي ما تتعلق بتحقيق ذلك في الخارج، اي موانع و قیود للتحقيق (اللحظية و العينية).
• ففي الحقيقة، المصلحة التي يقصدها المولى هي على صورة قضيّة حقيقيّة؛ أمّا في مقام التحقيق الخارجي، فإنّ الانسان يواجه مشكلات و موانع. و القیود الواردة في الروايات إنّما تشير الى هذا المقام، اي مقام التحقيق الخارجي.
• مثال على ذلك: أن يقال: «اذا كنت مريضاً فصلِّ و أنت مضطجع» أو «صلِّ جالساً»، أو «اذا لم تجد ماءاً فتيمّم». جميع هذه تمثّل شروطاً و رفعاً للموانع في مقام التحقيق الخارجي.
لذلك، إذا رأيتم شروطاً أو قيوداً في الآيات و الروايات، فإنّها تتعلّق بمقام التحقيق الخارجي؛ لأنّ ظروف تحقيق الحكم مختلفة: فقد يوجد الماء أحياناً و قد يعدم، و قد تكون القدرة موجودةً أحياناً و قد تنعدم، و قد يكون المكلّف في سفر أحياناً أو مريضاً.
الاستنتاج: هذه الشروط و الموانع تتعلّق بالواجب لا بالوجوب.
فالوجوب يتعلّق بالقضيّة الحقيقيّة؛ فالقضيّة الحقيقيّة تثبت الوجوب لنوع الانسان، كما في قوله تعالى: «يا ايها الناس صلوا». فهنا يتحقّق أصل الوجوب. أمّا امتثال الواجب في مقام الخارج فتابع لشروط متنوعة: فهذا مريض و آخر صحيح، و هذا عنده ماء و آخر ليس عنده.
۱) مرأی الشیخ الأعظم الأنصاري (رحمهالله): القیود تتعلّق بالمادّة (أي الواجب) [7] [8]
قال الشیخ الأعظم الأنصاري (رحمة الله علیه): «لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلّق بالفعل حتّى يصحّ القول بتقييده بالزمان أو نحوه فكلّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.» [9]
القيود و الشروط التي نراها تتعلّق بالتحقّق الخارجي، و بالتالي تتعلّق بالواجب، لا بأصل الوجوب. وفق هذا القول، «الوجوب مطلق و الواجب يتقيّد بالشروط في مقام التحقّق». إذن، فالقيود ناظرة إلى المادّة (الواجب) و ليست ناظرةً إلى هيئة الوجوب.
الاستدلال الثاني: «المادّة مطلقة و الهیئة جزئیّة»- النقد و الدراسة
بیان الاستدلال:
«الضَّرْب» كُلّي، يشمل ضرب زيد، و يشمل ضرب عمرو، و يشمل ضرب بكر… و عليه؛ فمادّة (ضَرْب) مطلقة، لكنّ الهيئة (اضرِبْ) جزئيّة و المخاطَب بها شخصٌ خاص. المادّة مطلقة في الغالب و هيئة الخطاب (كـ «اضرِبْ» مثلًا) جزئيّة؛ و لهذا، فإنّ القيود تلحق بالمادّة.
إشکال علی الاستدلال:
لكن يرد على هذا الاستدلال إشكال: صحيحٌ أنّ المادّة مطلقة و أنّ الهيئة جزئية، و لكنّ الجزئيّ أيضاً يمكن أن يكون مقيَّداً. يمكن إيراد القيد في مقام الزمان و في مقام المكان؛ فنقول مثلاً: «اضرِبْ مَرَّةً»، «اضرِبْ زيداً في المسجد ساعةً معيّنةً». إذن، يمكن أن تكون مقيّدةً. و بناءً على ذلك، فإنّ مجرّد القول بأنّ «المادّة مطلقة و الهيئة جزئيّة» لا يكفي لإثبات تعلّق القيد بالمادّة؛ لأنّ الهيئة الجزئيّة أيضاً يمكن أن تتقيّد. و حاصل ذلك أنّه قد يتعلّق القيد إمّا بالمادّة أو بالهيئة، و هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة الأدلّة و ظواهر الخطابات.
خلاصة النقد: هذا إشكالٌ نُورده على الاستدلال القائل بأنّ المادّة كُلّية و الهيئة جزئية. هذا القول جيّد و لكنّه غير كافٍ؛ لأنّ الجزئيّ أيضاً قابلٌ للتقييد من ناحية الزمان و من ناحية المكان.
۲) مرأی المحقّق الخراساني و المحقّق الخوئي (القیود متعلّقة بالهیئة) [10] [11] [12]
يرى المحقّق الخوئي و صاحب الكفاية (الآخوند) أنّ القيود و الشروط ترجع غالباً إلى الهيئة، لا إلى المادّة. و بناءً على هذا، فإنّ الوجوب المتحقّق لا يتحقّق إلّا في الوقت المعيّن، وليس على المكلّف أن يُهيّئ المقدّمات مسبقاً قبل حلول ذلك الوقت. و المثال البارز على هذا القول هو أنّه لو كان لديك ماء قبل الوقت و علمتَ أنّه سينقطع لاحقاً، فلا يلزمك مع ذلك أن تغتسل من ساعةٍ سابقة؛ بل متى ما حَلَّ الوقت، فإن كان الماء موجودًا فاغتسِلْ و إلّا فتَيَمَّمْ. و عليه، يجب اعتبار قيد «لدلوك الشمس» قيدًا للهيئة: فالوجوب يتحقّق في هيئته و وقته الظاهري، و ليس من زمنٍ سابق.
و للمحقّق الخوئي عبارةٌ قريبةٌ من هذا المعنى، حيث يُرجِعُ فيها قيدَ الشرطيّة و الخطابَ التعليقيَّ إلى مفاد الهيئة (الواجب)، لا إلى المادّة (الوجوب).
قال المحقّق الخوئي:
«إنّ ظاهر الجملة الشرطية و الخطاب التعليقي كون الاشتراط راجعاً إلى مفاد الهيئة و هو الوجوب، لا إلى المادّة، و هو الواجب، فإنّ مفاد قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه، بحسب المتفاهم العرفي أنّ وجوب الإكرام مشروط بالمجيء، لا أنّ الوجوب فعليّ متعلّق بالإكرام على تقدير المجيء.»[13]
(المعنی العرفي لهذه الجملة هو:) وجوبُ الإكرامِ مشروطٌ بالقدومِ، فالوجوبُ مشروطٌ لا الواجبُ. لا أنْ يكونَ الوجوبُ قد تقدّمَ ثمّ يأتي الواجبُ.
النتيجةُ الأوليّةُ و إشكالٌ على رأيِ المحقّقِ الخوئي:
من ظاهرِ بعضِ الخطاباتِ في القرآنِ و الرواياتِ، يبدو أنّ تقييدَ المادّةِ مُتصوَّرٌ أيضاً؛ و لكنَّ المحقّقَ الخوئيَّ يرى أنّ القيودَ يجبُ أنْ ترجعَ إلى الهيئةِ. و في مُقابلةِ هذا القولِ، يمكنُ أنْ يُقالَ: إنّ ظاهرَ العديدِ من الآياتِ و الألفاظِ العامّةِ (كـ «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ») يُشيرُ إلى وجوبٍ مُطلقٍ، و هذه التقييداتُ لا ترتبطُ بذلك الوجوبِ الحقيقيِّ المطلقِ، بل ترتبطُ بالتحقّقِ الخارجيِّ للواجبِ. بعبارةٍ أخرى: إنّ تبيينَ علاقةِ الوجوبِ و الواجبِ و القيودِ يحتاجُ إلى عملٍ كلاميٍّ و استدلاليٍّ أعمقَ و لا يكفي الاستدلالُ اللفظيُّ المجردُ.


