46/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات الاستصحاب؛ التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
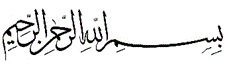
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تنبیهات الاستصحاب؛ التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره
المناقشة الثانية:
«إنّ الأمر في اتصال زمان الشك بالیقین أوسع من ذلك، و أنه لایجب اتّصال زمان المتیقّن بما هو متیقّن بزمان المشكوك بما هو مشكوك»[1] .
يبيّن المحقق الأصفهاني(قدسسره) في مناقشته الثانية أن مسألة اتصال زمان اليقين والشك لم تُطرح بشكل صحيح. كان صاحب الكفاية(قدسسره) قد بيّن في أركان الاستصحاب أنه يجب إحراز اتصال زمان اليقين بالشك. وينقد المحقق الأصفهاني(قدسسره) هذه النقطة ويقول إن اتصال زمان اليقين بالشك لا يعني أنه يجب علينا إحراز عدم نقض اليقين ذاك، بل يكفي ألا يكون اليقين السابق قد كُسر بيقين آخر. فإذا لم يُنقض اليقين السابق بيقين آخر، يُعتبر الزمان التالي زمان الشك. (إحراز عدم نقض اليقين ليس لازمًا، بل عدم إحراز النقض كافٍ). وفي شرح هذا المطلب يقول:
«التحقیق أنّ ثبوت الشيء واقعاً لیس ملاكاً للحكم الاستصحابي و لا ارتفاعه واقعاً ملاكاً لعدمه، بل ثبوته العنواني المقوّم للیقین ملاك جریانه، و ثبوت خلافه العنواني المقوّم للیقین بخلافه ملاك عدم جریانه، و انتقاض الیقین بالیقین.
و المفروض الیقین بالطهارة سابقاً و الشك في بقائها فعلاً، لا في حدوثها، و كذلك بالإضافة إلى الحدث.
و مع الیقین بالطهارة و الشك في بقائها و عدم تخلّل الناقض للیقین، لا معنی لدعوی عدم كون الجري العملي على وفقها إبقاءً.
و لزوم كون الطهارة موجودة تحقیقاً في زمان معیّن و موجودة تعبّداً في زمان معیّن آخر متّصل بذلك الزمان -حتّی یكون وجودها التعبّدي بقاءً لوجودها التحقیقي و یرتّب الأثر علیها في الزمان الثاني إبقاءً لها عملاً- بلا ملزم بعد عدم تخلّل الیقین الناقض»[2] .
يوضح سماحته أنه عندما يُقال يوم الجمعة إنه لا يوجد اتصال بين زمان اليقين والشك، فهذا بسبب احتمال وقوع موت المورث أو إسلام الوارث في ذلك الزمان. ولكن مجرد عدم وجود يقين بوقوع هاتين الحادثتين يوم الجمعة، يجعلهما مشكوكين. ففي العلم الإجمالي، نعلم أن إحدى هاتين الحادثتين قد وقعت، ولكن بشكل منفرد، وقوع كل منهما مشكوك. وعليه، فإن اتصال زمان اليقين بالشك قائم.
المشكلة الرئيسية في يوم الجمعة هي أن استصحاب عدم إسلام الوارث لا يمكن أن يجري. فإذا كان موت المورث قد وقع يوم الجمعة، فمن المسلم به أن إسلام الوارث قد وقع يوم الخميس. وفي هذه الحالة، سيكون جريان استصحاب عدم إسلام الوارث بعد وقوع موت المورث عديم الفائدة. فإذا كان موت المورث يوم الجمعة، فإن إسلام الوارث قد وقع قبله (الخميس) ولا يمكن إجراء استصحاب عدم إسلام الوارث.
يوضح المحقق الأصفهاني(قدسسره) أن اليقين بوقوع موت المورث يوم الجمعة هو قدر متيقن. ولكن يوم الخميس، لا نعلم هل وقع إسلام الوارث أم لا. ومن هذه الجهة، يوجد شك ويمكن إجراء استصحاب عدم إسلام الوارث. وعليه، من جهة اتصال زمان اليقين بالشك، لا توجد مشكلة. المشكلة الرئيسية يوم الجمعة هي أن كلتا الواقعتين، أي إسلام الوارث وموت المورث، قد وقعتا قطعًا في هذا اليوم. في هذه الحالة، لم يعد لاستصحاب عدم إسلام الوارث مكان، لأنه يكتسب القطعية في نفس زمن الوقوع. وبعبارة أخرى، يوم الجمعة، إما أن يكون إسلام الوارث قد وقع قبل موت المورث أو أن كليهما قد وقع في نفس اليوم. ولكن في كلتا الحالتين، سيكون استصحاب عدم إسلام الوارث في هذا الزمان عديم المعنى.
يبيّن المحقق الأصفهاني(قدسسره) في النهاية أن ملاك اتصال زمان اليقين بالشك يجب أن يُنظر إليه بشكل أعم. ويقول إن ملاك اتصال زمان الشك باليقين هو ألا يكون قد حدث نقض لليقين بيقين آخر. وبعبارة أخرى، طالما لم يُنقض اليقين السابق بيقين آخر، فإن اتصال زمان اليقين والشك قائم ولا حاجة لإحراز خاص في هذا الصدد.
ويؤكد أن الاستصحاب هو إبقاء ما كان، وملاكه هو عدم تخلل اليقين الناقض. لا حاجة لإحراز الاتصال الواقعي لزمان اليقين بالشك. فمجرد عدم وجود يقين بنقض اليقين، يجري الاستصحاب. وعليه، في المثال قيد البحث، بما أنه لا يوجد يقين بوقوع إسلام الوارث يوم الخميس، يجري استصحاب عدم إسلام الوارث.
يقول المحقق النائيني(قدسسره) في هذا الصدد:
«لا معنی لاتّصال الیقین بالشك إلا بأن لا یتخلل بینهما یقین آخر بالخلاف.»[3]
وبعبارة أخرى، طالما لم يُنقض اليقين السابق بيقين آخر، فإن اتصال زمان اليقين بالشك قائم ويجري الاستصحاب. ويؤكد أن اليقين السابق لا يُنقض إلا إذا جاء يقين آخر على خلافه. وعليه، فطالما لم يأتِ اليقين الناقض، فإن اتصال زمان اليقين بالشك قائم.
المناقشة الثالثة:
متعلق اليقين السابق يوم الأربعاء هو العدم الأزلي. هذا العدم الأزلي ليس مجرد عدم الإسلام، بل هو عدم الإسلام حين موت المورث. فموت المورث لم يقع بعد. هذا البحث يشبه مثال المرأة القرشية. كانوا يقولون هناك: هذه المرأة عندما لم تكن قد ولدت بعد، في الأزل، لم تكن قرشية. كان أصحابنا في الأصول يقولون: هذه المرأة في ذلك الزمان الذي لم تكن قد ولدت فيه بعد، لم تكن قرشية. لا يمكن القول إنها قرشية عندما لم تكن قد ولدت بعد. لم تكن لديها هذه القرشية. وصف القرشية في الزمن الذي لم يكن فيه هذا الموضوع، لم يكن لهذا الموضوع أيضًا. في ذلك الزمان الذي لم تكن فيه هذه المرأة قد ولدت بعد، في الأزل، لم يكن البشر قد خُلقوا بعد. في ذلك الزمان، لم تكن هذه المرأة قرشية، أي لم يكن وصف القرشية موجودًا لهذه المرأة. من جهة عدم وجود موضوع، لأنه لم تكن هناك امرأة أساسًا لتحمل وصف القرشية.
في ذلك الزمان الذي لم يكن فيه هذا الأب الكريم قد مات، حين عدم موت المورث، لم يكن الوارث مسلمًا. يوم الأربعاء، كان عدم إسلام الوارث حين موت المورث موجودًا. هذه القضية التي نقولها تعني أنه لا يوجد موضوع. عدم إسلام الوارث حين موت المورث صحيح. موت المورث لم يقع بعد، ولكن هذه القضية القائلة بوجود وارث مسلم حين موت المورث، معدومة. لأنه لا يوجد موضوع. الوارث المسلم حين موت المورث غير موجود، لأنه لا يوجد موت مورث. نريد أن نستصحب هذه القضية التي لا موضوع لها. مثلما كنا نستصحب قرشية المرأة التي لا موضوع لها. هنا الأمر كذلك.
توضيح ذلك هو أن متعلق اليقين السابق هو العدم الأزلي. وهذا العدم الأزلي يعني عدم الإسلام حين موت المورث يوم الأربعاء. والمفروض أن الموضوع، أي موت المورث، لم يتحقق. إذن، القضية التي كنا على يقين منها، أي عدم إسلام الوارث حين موت المورث، كانت بسبب عدم وجود موضوع.
الآن ننتقل إلى القضية المشكوكة. الموضوع فيها ليس منتفيًا، بل الموضوع، أي موت المورث في الزمان الثاني، مشكوك فيه. سابقًا لم يكن الموضوع موجودًا، ولكن الآن في القضية المشكوكة، أصبح محل شك. سابقًا لم يكن موت المورث موجودًا، أي كان معدومًا قطعًا. يوم الأربعاء، كان المورث حيًا قطعًا. في ذلك الزمان كنا نقول: عدم إسلام الوارث حين موت المورث، قضية صحيحة، لأنه لم يكن هناك موضوع. الآن يوم الخميس، نريد أن نستصحب هذا نفسه. موت المورث لم يكن موجودًا يوم الأربعاء، أي كان معدومًا قطعًا. الآن حيث يوجد احتمال لوجوده، فهو مشكوك. إذن استصحبه. كنتم سابقًا على يقين من عدم هذا الموضوع، والآن تشكون في هذا الموضوع. وعليه، أجروا استصحابه.
إذا قلنا إن اليقين بعدم الموضوع لا يضر بالقضية التي كنا على يقين منها، فإن الشك في الموضوع لا يضر بالقضية المشكوكة أيضًا. إذن، أجروا الاستصحاب. قول المحقق الأصفهاني(قدسسره) هو أننا استصحبنا عدم إسلام الوارث في زمن موت المورث.
لاحظوا قول المحقق الأصفهاني(قدسسره):
«إنّ مبنی الیقین المفروض وجوده هنا، لفرض حصر الإشكال في الاتّصال، على الیقین بالعدم في زمان الحادث الآخر و لو بعدم الحادث الآخر، كما هو لازم العدم المحمولي، و لولاه لما كان هناك یقین.
فإن كان هذا المعنی كافیاً في طرف الیقین، فلم لایكفي في طرف الشك، إذ لایزید الثبوت التعبّدي على الثبوت الحقیقي، و علیه فعدم كون الزمان الثاني واقعاً زمان الحادث الآخر، غیر ضائر بالشك في بقاء مثل هذا المتیقّن فتدبر جیّداً» [4] .
يقول سماحته: مبنى اليقين المفروض وجوده هنا، لفرض حصر الإشكال في مسألة الاتصال. لأنكم تحصرون الإشكال فقط في مسألة اتصال زمان اليقين والشك. وصاحب الكفاية(قدسسره) أيضًا حصر الإشكال في مسألة اتصال زمان اليقين والشك. ذلك اليقين المفروض هنا، مبناه على اليقين بالعدم في زمان الحادث الآخر. نحن نقول إن لدينا هذا اليقين بالعدم في زمان الحادث الآخر. اليقين بعدم ماذا في زمان الحادث الآخر؟ اليقين بعدم إسلام الوارث في زمان الحادث الآخر، أي زمان موت المورث، حتى لو لم يكن موت المورث قد وقع بعد. نحن على يقين من أن موت المورث لم يقع بعد.
تفحصوا عبارة المحقق الأصفهاني(قدسسره) بدقة. يقول: عدم إسلام الوارث في زمان موت المورث صحيح، حتى لو لم يكن موت المورث قد وقع بعد. أي أننا نستصحب عدم إسلام الوارث في زمان موت المورث، حتى لو لم يكن موت المورث قد وقع بعد وكان الموضوع منتفيًا. هذا هو ما يسمى بالسالبة بانتفاء الموضوع. إذا لم نقل هكذا، فلن يكون لدينا يقين بعد. اليقين بعدم إسلام الوارث في زمان الحادث الآخر، أي في زمان موت المورث، لن يكون موجودًا.
يقول سماحته: عندما يكون هذا المعنى كافيًا لليقين، فلماذا لا يكون كافيًا للشك؟ يوم الخميس، غاية الأمر أننا بدل اليقين بموت المورث، لدينا شك في موت المورث. يوم الأربعاء، حيث كنا على يقين من عدم وقوع موت المورث، كانت قضية عدم إسلام الوارث في زمان موت المورث صحيحة. الآن يوم الخميس، حيث لدينا شك في موت المورث، لماذا لا تكون هذه القضية صحيحة؟ يوم الأربعاء كنا على يقين من عدم موت المورث وكانت قضيتنا المتيقنة صحيحة. الآن يوم الخميس، بدل اليقين بعدم موت المورث، لدينا شك هل وقع موت المورث أم لا. إذن الاستصحاب جارٍ.
ويتابع المحقق الأصفهاني(قدسسره) قائلاً: نحن نريد ثبوتًا تعبديًا ليوم الخميس. هذا الثبوت التعبدي ليس زائدًا على الثبوت الحقيقي. فيوم الأربعاء، كان عدم إسلام الوارث في زمان موت المورث ثابتًا بالثبوت الحقيقي. فيوم الأربعاء، كان لدينا يقين وجداني بأن موت المورث لم يقع وكانت قضيتنا المتيقنة صحيحة. الآن يوم الخميس، نريد ثبوتًا تعبديًا، أي بدل اليقين الوجداني، لدينا شك. ولكن هذا الشك لا يضر بجريان الاستصحاب.
إن عدم كون الزمان الثاني (الخميس) هو واقعًا زمان الحادث الآخر (موت المورث)، لا يضر بشكنا. متيقننا هو عدم إسلام الوارث في زمان موت المورث، ومشكوكنا هو أيضًا أن يكون يوم الخميس عدم إسلام الوارث في زمان موت المورث. الفرق بين القضية المتيقنة والمشكوكة هو أنه في القضية المتيقنة، كنا على يقين من عدم وقوع موت المورث، أما في القضية المشكوكة، فنشك هل وقع موت المورث أم لا. وعليه، فالاستصحاب جارٍ.[5]
نتيجة البحث الأول
نتيجة البحث هي أن قول المحقق الأصفهاني(قدسسره) دقيق للغاية. ولكن لاستخلاص هذا المطلب من المناقشة الثالثة، نحتاج إلى دقة كبيرة. فقد بيّن المحقق الأصفهاني(قدسسره) المطلب بشكل إجمالي. مطلبه صحيح، ولكن لفهمه يجب قضاء وقت طويل. إذا أرجعتم جميع الضمائر إلى هذا البيان الذي عرضته، يصبح المطلب بسيطًا وواضحًا للغاية. نتيجة البحث كانت أن الاستصحاب يجري في جميع الأقسام الأربعة لمجهولي التاريخ.[6]
فقط في القسم الرابع يقع التعارض، لا أن الاستصحاب لا يجري. الاستصحاب يجري، ولكن مع التعارض. ويجب إضافة هذه النقطة أيضًا أنه في القسم الرابع، يقع التعارض بين استصحابين، كما قال الشيخ الأنصاري(قدسسره). خلافًا لصاحب الكفاية(قدسسره)، الذي قال بجريان الاستصحاب في القسم الأول فقط. يعتقد صاحب الكفاية(قدسسره) أن الاستصحاب لا يجري إلا حيث يترتب الأثر على الوجود، بمفاد كان التامة. أما في القسمين الثاني والثالث، فقد قال بعدم جريان الاستصحاب لعدم وجود حالة سابقة. ويعتقد أيضًا في القسم الرابع أن الاستصحاب لا يجري، لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
هذا في حين أن كلاً من المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني(قدسسرهما) قد رفضا هذا الرأي ويعتقدان أن اتصال زمان الشك بزمان اليقين قائم.[7]
البحث الثاني: في ما كان أحدهما معلوم التاریخ و الآخر مجهول التاریخ
إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، يتغير البحث. حتى الآن قيل إن زمان موت المورث معلوم وزمان إسلام الوارث مجهول. ولكن الفرض هنا هو أن زمان أحدهما معلوم، مثلاً وقع موت المورث يوم الجمعة الساعة الثانية عشرة ودقيقتين وهذا الزمان محدد، ولكن الزمان الآخر مجهول. ولأن الزمان الثاني مجهول، لا نعلم هل كان قبل هذا أم بعده، ويقع الشك في التقدم والتأخر مرة أخرى. الفرق الوحيد هو أن أحدهما ليس مجهول التاريخ بل معلوم التاريخ.
هنا أيضًا يجب البحث في نفس الأقسام الأربعة التي طُرحت في مجهولي التاريخ. لأن الحكم والأثر الشرعي إما أن يترتب على الوجود أو على العدم. وما يترتب على الوجود، يكون أحيانًا بنحو الوجود المحمولي بمفاد كان التامة، وأحيانًا بنحو الوجود النعتي بمفاد كان الناقصة. ومن ناحية أخرى، ما يترتب على العدم، يكون أحيانًا بنحو العدم المحمولي بمفاد ليس التامة، وأحيانًا بنحو العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة.
الفرق بين ليس الناقصة والعدم النعتي
الفرق بين ليس الناقصة والعدم النعتي[8] هو من النقاط المهمة في هذا البحث. الفرق بينهما هو أنه عندما نقول ليس الناقصة، فالمعنى هو نفي الارتباط. أي أننا ننفي الربط. ولكن عندما نقول العدم النعتي، يُحمل هذا العدم على المحمول وتصبح القضية معدولة المحمول. في هذه الحالة، لم يعد نفي ارتباط، بل هو، بتعبيرهم، ربط السلب. أي تُحمل قضية محمولها معدول المحمول. وعليه، تختلف ليس الناقصة عن العدم النعتي.
في العدم النعتي، النعت هو المحمول. لدينا موضوع ومحمول. من المفترض أن يكون المحمول نعتًا. عندما نقول العدم النعتي، يُحمل هذا العدم على المحمول وتصبح القضية معدولة المحمول. الاستظهار من العدم النعتي هو أن لدينا موضوعًا وهذا النعت له عدم. يتبادر إلى الذهن أن قضية النفي قد ذهبت إلى المحمول وأصبحت القضية معدولة المحمول. أي أصبحت ربط السلب. ولأن بحثنا في العدم النعتي هو عن المحمول، على الرغم من أنه قيل ألا يُستخدم مصطلح العدم المحمولي بعد الآن. أما في ليس الناقصة، فالبحث عن سلب الربط.
في القضية التي نقول فيها العدم النعتي، يكون هذا العدم بحيث يُتصور نعتًا للموضوع. في هذه الحالة، تكون القضية موجبة ولكنها معدولة المحمول. لأن المحمول العدمي أصبح في الواقع نعتًا للموضوع. هذا المحمول العدمي أصبح نعت الموضوع. وعليه، فالقضية موجبة ولكنها معدولة المحمول. يقول المرحوم المحقق الأصفهاني(قدسسره): القضية الموجبة التي هي معدولة المحمول تشتمل على موضوع ومحمولها سلبي. وعليه، ليس لها نعت لنريد تفسيره. البحث هنا هو هل مفادها سلب الربط أم ربط السلب. ولا فرق أن يكون المحمول بنحو الخبر أم بنحو الوصف. لأنه قيل: «إنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف و الأوصاف قبل العلم بها أخبار»[9] .
الأخبار بعد العلم بها تصبح أوصافًا والأوصاف قبل العلم بها أخبار. وعليه، لا فرق أن يكون المحمول بنحو الخبر أم بنحو الوصف. الأخبار بعد أن نعلم بها لم تعد نعتًا وتتحول إلى أوصاف. في هذه الحالة، نأتي بالموضوع ونجعله محمولاً. أما الأوصاف قبل العلم بها، فكانت أخبارًا. هذه قاعدة طُرحت سابقًا أيضًا.


