46/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره؛ مثال للمقام الثاني/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
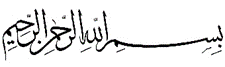
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره؛ مثال للمقام الثاني
المقام الثاني: الشك في التقدم والتأخر بين حادثين
بعد أن استعرضنا المقام الأول الذي كان يعالج الشك في تاريخ وقوع حادثةٍ ما بالنسبة إلى أجزاء الزمان، نصل الآن إلى المقام الثاني الذي يحظى بأهمية تطبيقية وعملية أكبر في الفقه. في هذا المقام، يُفترض أننا نعلم بوقوع حادثتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى، ولكننا نشك في ترتيبهما الزماني، أي في تقدم إحداهما على الأخرى وتأخرها عنها.
طرح المثال المحوري: الشك في تقدم إسلام الوارث على موت المورِّث
لتوضيح محل البحث، نتخذ المثال المشهور المطروح في كلمات الفقهاء أساسًا للتحليل:
صورة المسألة: توفي شخص (المورِّث)، وله وارث (ابنه مثلاً) كان في الماضي كافرًا وقد أسلم الآن. ومن جهة أخرى، نعلم أن شرط إرث الوارث الكافر من المورِّث المسلم هو أن يكون الوارث مسلمًا حين موت المورِّث. الآن، نحن على يقين من وقوع كلا الحادثتين (موت الأب وإسلام الابن)، ولكننا نشك في ترتيبهما الزماني، وتُتصوّر ثلاثة احتمالات:
١. تقدم الإسلام على الموت: أسلم الابن أولاً ثم توفي أبوه. (في هذه الحالة يرث)
٢. تقدم الموت على الإسلام: توفي الأب أولاً ثم أسلم الابن. (في هذه الحالة لا يرث)
٣. تقارن الموت والإسلام: وقعت الحادثتان في آنٍ واحد. (في هذه الحالة يرث أيضًا)
فما هي الوظيفة العملية في حالة الشك هذه؟ هل يمكن تحديد حكم المسألة بالتمسك بالاستصحاب؟[1]
تبيين رأي المحقق النائينـي(قدسسره) والأقوال المختلفة في المسألة
يشير المرحوم المحقق النائيني(قدسسره) في تحليله لهذه المسألة، أولاً إلى الأقوال والوجوه المختلفة التي طُرحت في هذا الباب.
بيان المحقق النائيني(قدسسره):
«إذا كان [الشك] بالإضافة إلى حادث آخر ... ففي جریان الاستصحاب في كل منهما أو عدم جریانه كذلك [أي في كل منهما] أو التفصیل بین ما إذا علم تاریخ أحدهما – فلایجري الاستصحاب فیه و یجري في مجهول التاریخ فیحكم بعدم تحقق موضوع الإرث عند معلومیة تاریخ الموت و الشك في تقدّم الإسلام علیه و تأخّره و تحقّقه [أي تحقق موضوع الإرث] في ما إذا علم تاریخ الإسلام و شك في تقدّم الموت علیه- و بین ما إذا جهل تاریخهما معاً – فلایجري الاستصحاب فيهما [لا في طرف إسلام الوارث و لا موت المورّث] بالتعارض- وجوه، و الحقّ هو التفصیل وفاقاً لشیخنا العلامة الأنصاري(قدسسره)[2] ».[3] [4]
يقول إنه في مثل هذه الحالات التي يوجد فيها شك في تقدم حادثة على أخرى وتأخرها عنها، يمكن طرح ثلاثة آراء رئيسية:
القول الأول: جريان الاستصحاب في كلا الطرفين (أي في طرف الموت وطرف الإسلام).
القول الثاني: عدم جريان الاستصحاب في أي من الطرفين.
القول الثالث (التفصيل): التفصيل بين الحالة التي يكون فيها تاريخ إحدى الحادثتين معلومًا، والحالة التي يكون فيها تاريخ كلتيهما مجهولاً.
يختار المرحوم النائيني(قدسسره)، تبعًا للشيخ الأعظم الأنصاري(قدسسره)، القول بالتفصيل باعتباره الرأي الحق. ولهذا التفصيل شقّان، لكل منهما حكم مختلف:
الشق الأول: الجهل بتاريخ كلتا الحادثتين
إذا كان تاريخ وقوع كلتا الحادثتين (موت الأب وإسلام الابن) مجهولاً لدينا، ففي هذه الحالة لا يجري الاستصحاب في أي من الطرفين. لماذا؟ بسبب التعارض.
فمن جهة، يمكننا استصحاب “عدم إسلام الابن إلى زمان موت الأب” (ونتيجته عدم الإرث). ومن جهة أخرى، يمكننا استصحاب “عدم موت الأب إلى زمان إسلام الابن” (ونتيجته الإرث). ولما كان هذان الاستصحابان يتعارضان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإنهما يتساقطان، ويجب الرجوع إلى أصول عملية أخرى (مثل قاعدة المقتضي والمانع أو أصول أخرى).
الشق الثاني: العلم بتاريخ إحدى الحادثتين والجهل بتاريخ الأخرى
هذا الشق هو محل البحث الرئيسي، وهو ينقسم بدوره إلى صورتين:
الصورة (أ): تاريخ الموت معلوم وتاريخ الإسلام مجهول:
لنفترض أننا نعلم على وجه الدقة أن الأب توفي في الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت. ولكننا لا نعلم هل أسلم ابنه قبل الساعة العاشرة أم بعدها. هنا، بما أن تاريخ الموت معلوم، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب في ناحية الموت (لأن الشك، وهو ركن الاستصحاب، غير موجود). إنما يجري الاستصحاب في الطرف الذي تاريخه مجهول فقط، أي في ناحية “إسلام الابن”. فنحن نأخذ الحالة السابقة اليقينية للابن، وهي “كفره”، ونستصحب “عدم إسلامه” إلى زمان موت الأب (الساعة العاشرة صباحًا).
النتيجة: باستصحاب عدم الإسلام، يثبت تعبدًا أن الابن لم يكن مسلمًا حين موت أبيه. وعليه، لم يتحقق شرط الإرث، فهو لا يرث.
الصورة (ب): تاريخ الإسلام معلوم وتاريخ الموت مجهول:
لنفترض أننا نعلم على وجه الدقة أن الابن قد نطق بالشهادتين وأسلم في الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت وأقاموا لذلك احتفالاً. ولكننا لا نعلم هل توفي أبوه قبل الساعة العاشرة أم بعدها. هنا أيضًا، لا يجري الاستصحاب في الطرف المعلوم التاريخ (الإسلام)، بل يجري في الطرف المجهول التاريخ (الموت). فنحن نأخذ الحالة السابقة اليقينية للأب، وهي “حياته”، ونستصحب “حياته” (أو بتعبير آخر، عدم موته) إلى زمان إسلام الابن (الساعة العاشرة صباحًا). النتيجة: باستصحاب حياة الأب، يثبت تعبدًا أن الأب كان حيًا في لحظة إسلام ابنه. واللازم العقلي لذلك هو أن موت الأب كان متأخرًا عن إسلام الابن (أصل تأخر الحادث). وعليه، تحقق شرط الإرث، والابن يرث.
خلاصة النظرية التفصيلية:
• إذا كان كلا التاريخين مجهولين: تعارض وتساقط.
• إذا كان تاريخ الموت معلومًا: يجري استصحاب عدم الإسلام ← عدم الإرث.
• إذا كان تاريخ الإسلام معلومًا: يجري استصحاب حياة المورِّث ← ثبوت الإرث.
هذا هو مجمل الرأي التفصيلي الذي قبله المرحوم النائيني تبعًا للشيخ الأنصاري. وبالطبع، فإن هذا التحليل، كما أُشير إليه في المقام الأول أيضًا، مبني على قبول “أصل تأخر الحادث” وعدم وجود إشكال “الأصل المثبت”، وهي مسألة سيتم بحثها بعمق أكبر لاحقًا عند طرح مقدمة المرحوم النائيني(قدسسره).
مقدّمة
قبل أن نشرع في التحليل الدقيق للمقامين الرئيسيين في البحث (الشك في تقدم الحادثة بالنسبة إلى الزمان، والشك في تقدم الحادثة بالنسبة إلى حادثة أخرى)، من الضروري أن ندرس مقدمة هامة وأساسية بيّنها المرحوم المحقق النائيني(قدسسره). وتكمن أهمية هذه المقدمة في أنها تقدم إطارًا من خلال تحليل فلسفي وعقلي دقيق لأقسام الموضوعات المركبة، وهو إطار له تأثير مباشر على كيفية جريان الاستصحاب وإمكانية أو عدم إمكانية إثبات هذه الموضوعات عبر القاعدة المشهورة “ضم الوجدان إلى الأصل”.
يبدأ المرحوم النائيني(قدسسره) بحثه بالتأكيد على الأثر البالغ للمقدمات العقلية في علم الأصول، فيقول:
بيان المحقق النائيني(قدسسره)
«إنّ الموضوع المركب من جزءین إمّا أن یكون مركباً من العرض و محلّه أو من عرضین لمحلّ واحد أو لمحلّین، أو من جوهرین، أو من جوهر و عرض غیر قائم به.
أمّا في الصورة الأولى [أي الموضوع المركب من العرض و محلّه] فحیث أنّ وجود العرض في نفسه عین وجوده لموضوعه، فلامحالة یكون أحد الجزءین مأخوذاً نعتاً للآخر، إمّا بنحو مفاد كان الناقصة أو بنحو مفاد لیس الناقصة.
و العرض بنفسه و إن كان من الموجودات الخارجیة و یمكن اعتبار وجوده النفسي موضوعاً لحكم إلا أنّه إذا أخذ جزءاً للموضوع كان جزؤه الآخر ما هو محلّ العرض، فلابدّ و أن یؤخذ العرض في الموضوع بوجوده النعتي لیس إلا.
مثلاً إذا أخذ العالم و عدالته موضوعاً لوجوب الاقتداء به فلامحالة یكون اتّصاف العالم بالعدالة هو الدخیل في الموضوع، لا نفس العدالة بوجودها النفسي؛ إذ لو كانت نفس العدالة دخیلة في الموضوع، فجزؤه الآخر و هو محلّها حیت إنّه في نفسه ینقسم إلى العادل و الفاسق -و قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أنّ كلّ موضوع ینقسم إلى قسمین في مرتبة سابقة على ورود الحكم علیه- فلابدّ و أن یكون أخذه موضوعاً لذلك الحكم في مقام الجعل و الثبوت بنحو الإطلاق أو بنحو التقیید؛ إذ لایعقل الإهمال في الواقعیات من الملتفت إلى الانقسام إمّا أن یؤخذ مقیداً بكونه عادلاً أو مقیداً بضدّه أو مطلقاً بالإضافة إلیهما و الأوّل هو المطلوب من أنّ لازم أخذ العرض جزءاً للموضوع هو أخذه بنحو مفاد كان الناقصة إذا كان الجزء الآخر هو محلّه، و الثاني و الثالث غیر معقولین، و منافیان لأخذ العدالة في الموضو
و أمّا في بقیة الصور فأخذ أحد الجزءین نعتاً للآخر غیر متصوّر إذ لا معنی لكون جوهرٍ نعتاً لجوهرٍ آخر، أو العرض نعتاً لعرضٍ آخر حتّی فیما إذا كانا عرضین لمحلٍّ واحد فضلاً عمّا إذا كانا في محلّین، فأخذ شيء بنحو مفاد كان أو لیس الناقصتین ینحصر في العرض و محلّه، و أمّا في غیر ذلك فلا.
نعم، یمكن أن یكون ما هو الموضوع للحكم عنواناً بسیطاً منتزعاً من الجزءین»[5] [6] .
إذا كان الموضوع المعتبر لحكم شرعي مركبًا من جزأين (كمثالنا حيث كان موضوع الإرث مركبًا من “موت المورِّث” و"إسلام الوارث")، فيجب الانتباه إلى أن هذين الجزأين يحتاجان إلى تقارن زمني لتحقق الموضوع. فموضوع الإرث ليس مجرد “موت المورِّث”، بل إن تقارنه مع “إسلام الوارث” كجزء آخر داخل في تحقق الموضوع. ويُطلق على مثل هذا الموضوع “الموضوع المركب”.
أقسام التركيب في الموضوعات من منظور المحقق النائيني(قدسسره)
يقسّم سماحته الموضوعات المركبة من جزأين، من حيث ماهية الأجزاء وكيفية العلاقة بينها، إلى خمسة أقسام رئيسية. ويكتسب هذا التقسيم أهميته من كون حكم جريان الاستصحاب يختلف في كل قسم:
١. مركب من العَرَض ومحلِّه: أي أن الموضوع يتكون من جوهر (محل) وعَرَض قائم بذلك الجوهر. (مثال: الجدار الأسود)
٢. مركب من عَرَضين لمحلٍّ واحد: أي أن الموضوع يتكون من عَرَضين مختلفين كلاهما عارض على جوهر واحد (محل).
٣. مركب من عَرَضين لمحلَّين: أي أن الموضوع يتكون من عَرَضين كل منهما عارض على محل منفصل ومستقل.
٤. مركب من جوهرين: أي أن الموضوع يتكون من جوهرين مستقلين.
٥. مركب من جوهرٍ وعَرَضٍ غيرِ قائمٍ به: أي أن الموضوع يتكون من جوهر وعَرَض، ولكن ذلك العَرَض قائم بجوهر آخر، لا بجوهر هو جزء من الموضوع.
التحليل الدقيق للأقسام وتبيين المفهوم الرئيسي “الوجود النعتي”
١. القسم الأول: التركيب من العَرَض والمحل (العلاقة الوصفية)
هذا القسم هو النقطة المحورية في تحليل المرحوم النائيني(قدسسره). فهو يرى أنه في هذه الحالة، وبسبب الطبيعة الوجودية للعَرَض وهي أن “وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه”، فإن العلاقة بين الجزأين (الجوهر والعَرَض) هي بالضرورة علاقة وصفية ونعتية. وبعبارة أخرى، يعتبر أحد الجزأين صفة ونعتًا للآخر.
مثال الجدار الأسود: هنا، “الجدار” هو الجوهر و"السواد" هو العَرَض القائم به. العلاقة بينهما هي علاقة “موصوف وصفة”. فنحن نقول للجدار “الجدار الأسود”. في هذه الحالة، يكون للعَرَض (السواد) “وجود نعتي” لمحلّه (الجدار). وتتحقق هذه العلاقة الوصفية بنحو “مفاد كان الناقصة” (الجدارُ أسودٌ) أو “مفاد ليس الناقصة” (ليس الجدارُ بأسودَ).
مثال العالم العادل: في موضوع “وجوب الاقتداء بإمام الجماعة”، إذا كان الموضوع هو “العالم العادل”، فإن “العدالة” (العَرَض) قد أُخذت كوصف ونعت لـ “العالم” (المحل). فالذي له دخل في موضوع الحكم هو “اتصاف العالم بالعدالة”، لا مجرد “وجود العدالة” في العالم الخارجي بشكل مستقل (بمفاد كان التامة). فلو كان الوجود المستقل للعدالة كافيًا، لأمكن أن يكون إمام الجماعة عالمًا وأحد المأمومين عادلاً، ويُحكم بصحة الاقتداء بتبرير أن جزأي العلم والعدالة موجودان في صلاة الجماعة هذه؛ بينما هذا باطل قطعًا.
توضيح تكميلي: عندما يأخذ الشارع “العالم” في موضوع حكم ما، فإن هذا الموضوع قابل للانقسام من حيث اتصافه بالعدالة والفسق. وبما أن الإهمال في الواقعيات لا يُعقل من الشارع الملتفت، فلا بد من النظر في كيفية لحاظ الموضوع: هل أُخذ “العالم” بشكل مطلق (سواء كان عادلاً أم فاسقًا)؟ أم قُيِّد بـ “الفسق”؟ أم قُيِّد بـ “العدالة”؟ الفرضان الأولان باطلان قطعًا ومنافيان لأخذ العدالة في الموضوع. إذن، لا بد لنا من القول بأن الموضوع هو “العالم المتصف بالعدالة”. وهذا يعني أن العدالة قد أُخذت بنحو “الوجود النعتي” للعالم.
أهمية “الوجود النعتي” في الاستصحاب: النقطة الرئيسية هي أن الاستصحاب يثبت مجرد وجود شيء بمفاد “كان التامة”، ولكنه لا يستطيع إثبات “وجوده النعتي” لموصوف آخر. فإثبات اتصاف موصوف بصفة ما هو من اللوازم العقلية لمجرد وجود تلك الصفة، والاستصحاب ليس حجة في إثبات لوازمه العقلية (الأصل المثبت). وعليه، في الموضوعات المركبة من العَرَض والمحل، لا يمكن باستصحاب وجود العَرَض استنتاج اتصاف المحل به.
٢. الأقسام الأخرى: التركيب من أجزاء مستقلة (العلاقة غير الوصفية)
في الأقسام الأربعة المتبقية، تكون لأجزاء الموضوع وجودات مستقلة عن بعضها البعض، ولا تقوم بينها علاقة وصفية ونعتية:
• عرضان: اللون الأخضر ليس صفة للون الأحمر. فكلاهما له وجود مستقل، سواء كانا في محل واحد (كخضرة وحلاوة تفاحة) أو في محلين مختلفين (كخضرة جدار وبُنية باب).
• جوهران: الجدار ليس صفة للباب. فلا يمكن القول “جدارٌ بابيٌّ”.
• جوهر وعرض غير قائم به: لون الباب لا يُعد صفة للجدار.
نتيجة تحليل هذه الأقسام: في هذه الأقسام الأربعة، بما أن الأجزاء لها وجودات مستقلة وليس هناك اتصاف لأحدها بالآخر، يمكن النظر إلى كل منها على حدة. وفي مثل هذه الحالات، يتجلى معنى قاعدة “ضم الوجدان إلى الأصل” بشكل صحيح. أي يمكننا أن نأخذ أحد الأجزاء الثابت لدينا بالوجدان، ونثبت الجزء الآخر المشكوك فيه باستصحاب وجوده المستقل (بمفاد كان التامة)، وبهذه الطريقة نحرز الموضوع المركب تعبدًا.
خلاصة ونتيجة نهائية للمقدمة
النتيجة التي يستخلصها المرحوم النائيني(قدسسره) من هذه المقدمة العقلية الدقيقة مهمة جدًا وتفتح آفاقًا، وتحدد الموقف في ثلاث حالات عامة:
١. في الموضوعات المركبة من العَرَض والمحل: بما أن العَرَض قد أُخذ في الموضوع بنحو “الوجود النعتي” (مفاد كان الناقصة)، فلا يمكن إثبات الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. ذلك أن استصحاب مجرد وجود العَرَض لا يثبت “اتصاف المحل بذلك العَرَض”، وهو أمر وصفي ولازم عقلي، وهذا الأمر مصداق بارز للأصل المثبت.
٢. في سائر أقسام الموضوعات المركبة (الأجزاء المستقلة): بما أن الأجزاء لها وجودات مستقلة ولا توجد علاقة وصفية، يمكن إثبات الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. ففي هذه الحالات، يكون إحراز جزء بالوجدان وإحراز الجزء الآخر تعبدًا باستصحاب وجوده المستقل كافيًا لإثبات الموضوع المركب، وهو مصون من إشكال الأصل المثبت.
٣. الحالة الخاصة (العنوان البسيط الانتزاعي): يشير المرحوم النائيني(قدسسره) إلى حالة ثالثة أيضًا بعبارة “نعم يمكن…”، وهي حيث يبدو الموضوع مركبًا في الظاهر، ولكنه في التحليل الدقيق عنوان بسيط منتزع من هذين الجزأين. وهو يرى أنه في هذه الحالة أيضًا لا يمكن إثبات الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. ذلك أن النسبة بين الجزأين (وهما منشأ الانتزاع) وبين ذلك العنوان البسيط هي نسبة “الملزوم” إلى “اللازم”. ورغم أنه يمكن إثبات الجزأين (الملزوم) بضم الوجدان إلى الأصل، إلا أن الاستصحاب في الملزوم لإثبات اللازم هو أصل مثبت وليس بحجة. (طبعًا يجب الانتباه إلى أن رأيه هذا حول علاقة منشأ الانتزاع بالأمر الانتزاعي يختلف عن رأي المرحوم الآخوند(قدسسره) الذي يراهما متحدين عرفًا ويعدّه من اللوازم الخفية).
تُوفّر هذه المقدمة الإطار التحليلي اللازم للدخول في البحث الأصلي وتقييم المناقشات، خاصة مناقشة المرحوم الحائري.
الاستنتاج من مقدمة المحقق النائيني(قدسسره)[7]
بعد التحليل الدقيق لأقسام الموضوعات المركبة، يصل المرحوم المحقق النائيني(قدسسره) إلى خلاصة مهمة وعملية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
١. حكم الموضوعات المركبة من أجزاء مستقلة: يقول إنه في جميع الأقسام الأربعة التي تكون فيها أجزاء الموضوع ذات وجودات مستقلة عن بعضها البعض (أي جوهران، أو عرضان لمحل واحد، أو عرضان لمحلين، أو جوهر وعرض غير قائم به)، بما أنه لا توجد علاقة وصفية ونعتية بين الأجزاء، فإن الطريق مفتوح لإثبات الموضوع من خلال “ضم الوجدان إلى الأصل”. بمعنى أنه إذا كان أحد هذه الأجزاء المستقلة محرزًا لدينا بالوجدان (بالعلم واليقين)، وشككنا في وجود الجزء الآخر، يمكننا بإجراء الاستصحاب إحراز وجود ذلك الجزء الثاني تعبدًا، وبضمّه إلى الجزء المعلوم نثبت الموضوع المركب بأكمله.
٢. حكم الموضوع المركب من العَرَض والمحل: أما في القسم الأول، أي حيث يكون الموضوع مركبًا من العَرَض ومحلّه (والذي لُوحظ بنحو مفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة)، فإن هذه الطريقة لا تنفع. ففي هذا القسم، وبسبب وجود العلاقة الوصفية والنعتية، لا يمكن باستصحاب مجرد وجود العَرَض إثبات اتصاف المحل به. مثل هذا الاستنتاج يستلزم قبول حجية “الأصل المثبت”، وهو ليس بحجة بناءً على مبناه ومبنى مشهور المحققين. وعليه، فإن قاعدة “ضم الوجدان إلى الأصل” لا تجري في هذا القسم.
٣. حكم الموضوع البسيط المنتزع من أمر مركب: فيما يتعلق بالحالة الثالثة التي طرحها، أي حيث يكون الموضوع عنوانًا بسيطًا منتزعًا من أمرين مركبين، فإنه يرى أيضًا أن طريق “ضم الوجدان إلى الأصل” مغلق. واستدلاله هو: رغم أنه قد يمكننا إثبات جزأي منشأ الانتزاع بضم الوجدان إلى الأصل، إلا أن نسبة هذين الأمرين (منشأ الانتزاع) إلى ذلك العنوان البسيط (الأمر الانتزاعي) هي نسبة “الملزوم” إلى “اللازم العقلي”. وبما أن الاستصحاب في الملزوم لإثبات اللازم العقلي يُعد “أصلاً مثبتًا”، فلا يمكن من خلاله إثبات موضوع الحكم الذي هو العنوان البسيط نفسه.
ملاحظة وفارق مبنائي: تجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل الأخير للمرحوم النائيني(قدسسره) مبني على رأيه الخاص في علاقة منشأ الانتزاع بالأمر الانتزاعي. وفي المقابل، يرى المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) أنهما متحدان عرفًا، وأن مثل هذه العلاقة من سنخ اللوازم الخفية التي تكون مثبتاتها حجة. وعليه، بناءً على مبنى صاحب الكفاية(قدسسره)، يمكن في هذا القسم الثالث أيضًا إثبات الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.
مناقشات خمس في هذه المقدّمة
المناقشة الأولی: منسوبة إلى المحقق الحائري(قدسسره)
بعد تبيين المقدمة والاستنتاج منها، يشير المرحوم المحقق النائيني(قدسسره) بنفسه إلى إشكال ومناقشة هامة قد ترد على هذا المبنى. ويطرح هذا الإشكال بعبارة “إن قلت” [8] [9] [10] [11] ، والتي تُستخدم عادة في كتب الأصول لطرح إشكال مُقدّر، وتُنسب هذه المناقشة إلى المرحوم المحقق الحائري اليزدي(قدسسره).
تقرير وتوضيح المناقشة:
توضيح الإشكال كما يلي: موضوع الإرث في المثال قيد البحث هو “إسلام الوارث مع حياة المورِّث”. الآن، لو افترضنا أن تاريخ إسلام الوارث معلوم، لكن تاريخ موت المورِّث مجهول، وشككنا في تقدم الموت على الإسلام أو تأخره عنه، فإننا نعمل وفقًا للمبنى المذكور آنفًا:
• في الطرف الذي تاريخه معلوم (إسلام الوارث)، لا يجري الاستصحاب؛ لأن الشك، وهو الركن الأساسي للاستصحاب، غير موجود فيه.
• إنما يجري الاستصحاب في الطرف الذي تاريخه مجهول فقط، أي “موت المورِّث”. وفي هذا الطرف، يمكن إجراء “استصحاب عدم تحقق الموت إلى زمان إسلام الوارث” أو بتعبير آخر “استصحاب حياة المورِّث إلى زمان إسلام الوارث”.
بإجراء هذا الاستصحاب في الجزء المجهول، وضمّه إلى الجزء المعلوم بالوجدان (إسلام الوارث)، يتحقق موضوع الإرث المركب، أي “إسلام الوارث مع تحقق حياة مورِّثه”، بنحو تعبّدي، ويجب الحكم بإرث الوارث.
ولكن الإشكال يُطرح هنا: هذا الاستصحاب الجاري في الجزء (استصحاب حياة المورِّث)، يعارضه استصحاب آخر يجري في كلِّ الموضوع المركب. وبيان هذا الاستصحاب المعارض هو: رغم أن الاستصحاب لا يجري بمفرده في خصوص “إسلام الوارث” لأن تاريخه معلوم، إلا أن “المجموع المركب من الجزأين”، أي “إسلام الوارث المقارن لحياة المورِّث”، هو أمر كان يقينًا غير متحقق في الزمان السابق (قبل إسلام الوارث)، ونحن الآن نشك في تحققه. وعليه، فإن أركان الاستصحاب مكتملة بالنسبة لهذا العنوان المركب نفسه، ويمكن إجراء “استصحاب عدم تحقق الموضوع المركب”.
ونتيجة لذلك، نواجه استصحابين:
١. استصحاب حياة المورِّث إلى زمان إسلام الوارث: ونتيجته إثبات موضوع الإرث.
٢. استصحاب عدم تحقق الموضوع المركب (الإسلام المقارن للحياة): ونتيجته نفي موضوع الإرث.
هذان الاستصحابان يتعارضان. فالاستصحاب الأول (الجاري في الجزء) يريد إثبات الموضوع، والاستصحاب الثاني (الجاري في الكل) يريد نفي الموضوع نفسه. وبوقوع هذا التعارض، يتساقط كلا الاستصحابين، ولا يمكن بعد ذلك التمسك بالاستصحاب الجاري في الجزء لإثبات الإرث.


