46/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ ثلاثة موارد لا تكون من الأصل المثبت؛ الكلام في المورد الثالث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
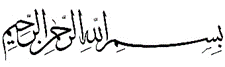
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ ثلاثة موارد لا تكون من الأصل المثبت؛ الكلام في المورد الثالث
بحث القسم الثاني من الوضعيّات: تحليل عميق لإيرادات المحقّق الأصفهاني(قدسسره)
بعد أن رأينا أنّ الاستصحاب في القسم الأوّل من الوضعيّات (الأمور المتعلّقة بنفس التكليف) قد واجه تحدّيات جادّة من قبل صاحب الكفاية والمحقّق الأصفهاني(قدسسرهما)، ننتقل الآن إلى القسم الثاني؛ أي حيث نتعامل مع عناوين كالـ«جزئيّة» و«الشرطيّة» و«المانعيّة» و«القاطعيّة» لـ«المكلّف به» (متعلَّق التكليف). وفي هذا القسم، كان صاحب الكفاية(قدسسره) يعتقد بجريان الاستصحاب، ولكنّ المحقّق الأصفهاني(قدسسره)، بدقّة نظره الخاصّة، قد أورد إيرادات حتّى في هذا القسم واعتبر جريان الاستصحاب «مشكلاً». وفي هذا القسم، نتناول التحليل الدقيق لهذين الإيرادين الأساسيّين والردود المتقابلة التي قُدِّمت لهما.
المانعان الأساسيّان من وجهة نظر المحقّق الأصفهاني(قدسسره)
يطرح المرحوم الأصفهاني(قدسسره)، لإثبات مدّعاه القائم على الإشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم، دليلين أو مانعين رئيسيّين:
المانع الأوّل: عدم كون الجزئيّة الانتزاعيّة تشريعيّة
أوّل إيراد للمحقّق الأصفهاني(قدسسره) هو إيراد ماهويّ وبنيويّ. فيقول: إنّ العناوين كالـ«جزئيّة» التي تُنتزَع من المركّبات ليست من لوازم المجعول التشريعي بما هو مجعول تشريعيّ، بل هي من لوازمه بما هو مجعول تكوينيّ.
توضيح وبسط الإيراد: لفهم هذه العبارة الدقيقة، يجب أن نتذكّر أنّ كلّ أمر تشريعيّ (كالصلاة) له بُعد تكوينيّ أيضاً. فالصلاة خارج الذهن تتكوّن من سلسلة من الحركات والسكنات والأذكار وهي جميعها أمور تكوينيّة. ويعتقد المحقّق الأصفهاني(قدسسره) أنّ «الجزئيّة» (كجزئيّة الركوع للصلاة) هي مفهوم عامّ يوجد في كلّ من المركّبات التكوينيّة (كجزئيّة اليد لبدن الإنسان) وفي المركّبات التشريعيّة. ولكنّ هذه الجزئيّة هي ذاتاً وصف تكوينيّ يُحصَّل من تحليل «كلّ» إلى «أجزاء». فليس الأمر أنّ الشارع قد اخترع «جزئيّة تشريعيّة» خاصّة ومختلفة عن «الجزئيّة التكوينيّة». بناءً عليه، فبما أنّ الجزئيّة مفهوم ذو جذر تكوينيّ، فلا يمكن اعتبارها مجعولاً شرعيّاً خالصاً حتى يجري فيها الاستصحاب كأصل شرعيّ. ولهذا، لن يكون الاستصحاب فيها مفيداً.
المانع الثاني: عدم فائدة استصحاب المجعول بالعرض
إيراده الثاني ناظر إلى الفائدة العمليّة لجريان الاستصحاب. فيقول: وإن فرضنا أنّ هذه العناوين الانتزاعيّة هي مجعولات بالعرض - بمعنى أنّها تُجعل تبعاً لجعل الأمر الأصلي - إلّا أنّ هذا الأمر في مقام إثبات الأثر لن يحلّ مشكلة؛ لأنّه لو كان المجعول الانتزاعيّ مجعولاً بالعرض، فلن يترتّب الأثر الحقيقي في مقام الوضع والرفع إلّا على وضع ورفع منشئه، الذي هو مجعول بالذات. بناءً على هذا، فإنّ استصحاب نفس العنوان التبعي والعرضي لا ثمرة له في مقام الإثبات، بل يجب أن يتوجّه الاستصحاب إلى نفس المنشأ وأصل المجعول بالذات.
فمثلاً، لو شُكّ في آخر الوقت في جزئيّة السورة للصلاة، فمحلّ الاستصحاب ليس هو نفس الجزئيّة، بل يجب إجراء الاستصحاب بالنسبة لنفس الصلاة المأمور بها التي كانت واجبة في أوّل الوقت، ليتّضح ما إذا كانت نفس تلك الصلاة الكلّيّة بكلّ خصوصيّاتها ثابتة إلى آخر الوقت بنفس النحو أم لا. وبعبارة أخرى، فالمجرى الصحيح للاستصحاب هو نفس الأصل والمنشأ، والعناوين الانتزاعيّة التبعيّة بمفردها لن تكون محلّاً للجريان.
النقد والجواب على إيرادات المحقّق الأصفهاني(قدسسره)
في مقابل هذين الإيرادين الدقيقين، يمكن تقديم أجوبة محكمة تمهّد الطريق لجريان الاستصحاب في هذا القسم:
الجواب على المانع الأوّل (كون الجزئيّة في الماهيّات المخترَعة تشريعيّة):
لقد غفل الإيراد الأوّل للمحقّق الأصفهاني(قدسسره) عن نكتة مفصليّة وهي الفرق بين الماهيّات الحقيقيّة والماهيّات المخترَعة الشرعيّة.
الجزئيّة في الأمور التكوينيّة: نعم، في المركّبات التكوينيّة كبدن الإنسان، «الجزئيّة» أمر تحليليّ وتكوينيّ.
الجزئيّة في الماهيّات المخترَعة: ولكن عندما نواجه ماهيّة كـ«الصلاة»، فإنّنا نواجه «اختراعاً» محضاً من قبل الشارع. فالصلاة لم تكن ماهيّة خارجيّة موجودة مسبقاً حتى يرتّب الشارع عليها حكماً فقط. بل إنّ الشارع قد خلق مجموعة من الأفعال والأذكار بتركيب خاصّ كـ«وحدة اعتباريّة جديدة» باسم «الصلاة». ففي مثل هذه الماهيّة المخترَعة، لم تعد «جزئيّة» كلّ جزء أمراً تكوينيّاً صرفاً، بل هي تشريعيّة واعتباريّة تماماً. فالشارع هو الذي اعتبر بجعله أنّ «الركوع» هو جزء من هذه الماهيّة المخترَعة. وهذه الجزئيّة تستمدّ كلّ هويّتها واعتبارها من ذلك الجعل التشريعي نفسه.
بناءً عليه، وخلافاً لرأي المحقّق الأصفهاني(قدسسره)، فإنّ الجزئيّة في أمثال الصلاة هي مجعول تشريعيّ بكلّ معنى الكلمة، والاستصحاب، كأصل شرعيّ، يمكن أن يجري فيها تماماً.
الجواب على المانع الثاني (فائدة استصحاب الأمر الجزئي):
الإيراد الثاني أيضاً قابل للجواب بالنظر إلى واقع عمليّة الاجتهاد. فالقول بوجوب التوجّه إلى استصحاب المجعول بالذات (كلّ الصلاة)، وإن كان طريقاً ممكناً، إلّا أنّه ليس دائماً أفضل وأدقّ طريق.
ففي كثير من الموارد، لا يكون شكّ المجتهد في كلّ وجوب الصلاة، بل يتركّز تماماً على جزء أو شرط خاصّ. فمثلاً، في آخر الوقت، نحن على يقين بأنّ أصل الصلاة واجب؛ وشكّنا تحديداً هو في ما إذا كانت «جزئيّة السورة» التي كانت موجودة سابقاً قد سقطت في حالة التزاحم هذه مع الوقت أم لا؟
فائدة الاستصحاب الجزئي: في مثل هذه الظروف، يكون استصحاب نفس «جزئيّة السورة» أدقّ وأوضح وأكثر انطباقاً على نقطة النزاع بكثير. فباستصحاب بقاء الجزئيّة، نصل مباشرةً إلى جواب سؤالنا ونحدّد تكليفنا. فلو كان هذا الاستصحاب جارياً، لكانت النتيجة أنّه يجب أن نصلّي مع السورة ولن يكون هذا العمل تشريعاً حراماً. أمّا لو لم يكن الاستصحاب جارياً وكان لدينا دليل على سقوط الجزئيّة، لكانت قراءة السورة مصداقاً للتشريع والعمل الحرام.
والقول بأنّه بما أنّ طريق استصحاب الكلّ موجود، فطريق استصحاب الجزء مسدود، ليس استدلالاً محكماً. فيمكن أن يكون كلاهما طريقين معتبرين للوصول إلى الحكم الشرعي، وأحياناً يكون استصحاب الجزء، بسبب تركيزه على محلّ الشكّ، طريقاً أكثر فاعليّة.
الاستنتاج النهائي: بالبحث الدقيق للمانعين المطروحين من قبل المحقّق الأصفهاني(قدسسره) وتقديم الأجوبة المتقابلة، يبدو أنّ جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الوضعيّات (الأمور المتعلّقة بالمكلّف به) لا يواجه إشكالاً جادّاً. فيمكن اعتبار الجزئيّة في الماهيّات المخترَعة أمراً تشريعيّاً، ويمكن تصوّر فائدة عمليّة واجتهاديّة واضحة لاستصحابها. بناءً عليه، يمكننا في هذا القسم أيضاً، كصاحب الكفاية(قدسسره)، القول بجريان الاستصحاب.
توضيح المحقّق الخوئي[1] (قدسسره) لما أفاده المحقق الإصفهاني(قدسسره)
بعد أن بحثنا رأي المحقّق الأصفهاني(قدسسره) القائم على الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الوضعيّات، نصل الآن إلى قسمين أخيرين ومهمّين جدّاً من هذا المبحث. فنشير أوّلاً مروراً سريعاً إلى موقفه في القسم الثالث[2] ثم ننتقل إلى التحليل العميق والبحث في التبيين المهمّ جدّاً للمرحوم المحقّق الخوئي(قدسسره) لكلام أستاذه المحقّق الأصفهاني(قدسسره)، وفي النهاية نطرح مناقشات الأستاذ على هذا التبيين.
بيان المحقّق الخوئي(قدسسره):
«إنّ الشرطیة لیست من آثار وجود الشرط في الخارج كي تترتّب على استصحاب الشرط، بل هي منتزعة في مرحلة الجعل من أمر المولى بشيء مقیداً بشيء آخر، بحیث یكون التقیید داخلاً و القید خارجاً، فشرطیة الاستقبال للصلاة تابعة لكون الأمر بالصلاة مقیداً بالاستقبال، سواء وجد الاستقبال في الخارج أم لا، فكما أنّ أصل وجوب الصلاة لیس من آثار الصلاة الموجودة في الخارج، فإنّ الصلاة واجبة أتی بها المكلف في الخارج أم لمیأت بها، فكذا اشتراط الصلاة بالاستقبال لیس من آثار وجود الاستقبال في الخارج، فإنّ الاستقبال شرط للصلاة وجد في الخارج أم لا و علیه فلاتترتّب الشرطیة على جریان الاستصحاب في ذات الشرط.
و هذا بخلاف الحرمة و الملكیة و نحوهما من الأحكام التكلیفیة أو الوضعیة المترتّبة على الوجودات الخارجیة، فإذا كان في الخارج خمر و شككنا في انقلابه خلاً، نجري الاستصحاب في خمریته، فنحكم بحرمته و نجاسته بلا إشكال.
و ظهر بما ذكرناه أنّه لایجري الاستصحاب في نفس الشرطیة أیضاً، إذا شك في بقائها لاحتمال النسخ، أو لتبدل حالة من حالات المكلّف، فإنّ الشرطیة كما عرفت منتزعة من الأمر بالمقید، فیجري الاستصحاب في منشأ الانتزاع و تنتزع منه الشرطیة، فلاتصل النوبة إلى جریان الاستصحاب في نفس الشرطیة»[3] [4] .
موقف المحقّق الأصفهاني(قدسسره) في القسم الثالث
أمّا في القسم الثالث من الأحكام الوضعيّة، وهو عبارة عن العناوين ذات الجعل الشرعي المستقلّ - كالملكيّة والزوجيّة والولاية والحجّيّة ونظائرها - فلم يكن للمرحوم المحقّق الأصفهاني(قدسسره) أيّ مانع من جريان الاستصحاب وقبله بالكامل. ووجه ذلك واضح؛ لأنّ المستصحَب في هذا القسم هو نفس الحكم الوضعي المجعول بالذات الذي اعتبره الشارع بشكل مستقلّ وهو حائز لجميع أركان الاستصحاب. إذن، فكلّما شُكّ في بقاء الملكيّة أو الزوجيّة، يجري الاستصحاب بالنسبة لنفس ذلك الحكم الوضعي المجعول والمستقلّ، من دون حاجة إلى واسطة في الإثبات أو خوف من الابتلاء بالأصل المثبت.
نعم، خلافاً لمسلك المحقّق الأصفهاني وصاحب الكفاية(قدسسرهما) اللذين حصرا جريان الاستصحاب في بعض أقسام الوضعيّات، فإنّ المبنى المختار في هذا البحث هو أنّه بناءً على التحليل الذي ذُكر، للاستصحاب قابليّة الجريان والتماميّة في جميع أقسام الوضعيّات الثلاثة.
يرتكز أساس إشكال المحقّق الأصفهاني(قدسسره)، كما يقول المحقّق الخوئي(قدسسره)، على تفكيك بنيويّ ومهمّ جدّاً: التفكيك بين «عالم التشريع والجعل» من جهة، و«عالم الوجود الخارجي والتكوين» من جهة أخرى.
يقول(قدسسره): إنّ عنوان «الشرطيّة» (كشرطيّة الاستقبال للصلاة مثلاً) ليس من آثار ولوازم الوجود الخارجي والتكويني للشرط حتى نتمكّن باستصحاب الوجود الخارجي لذلك الشرط من ترتيب هذا العنوان عليه. بل إنّ «الشرطيّة» عنوان انتزاعيّ يُنتزَع في مرحلة الجعل والتشريع من «أمر المولى بشيء مقيَّد بشيء آخر».
منشأ «الشرطيّة»: إنّ محلّ ولادة ومنشأ وجود عنوان «الشرطيّة» هو عالم تشريع الشارع المقدّس وقانون وضعه، لا عالم التكوين والواقعيّات الخارجيّة. وبعبارة أخرى، فعندما يقول الشارع في مقام الجعل والتشريع: «صلِّ مستقبلاً القبلة»، ينتزع العقل والعرف من هذا الأمر المقيَّد عنواناً باسم «شرطيّة الاستقبال للصلاة». وهذا العنوان «الشرطيّة» موجود في عالم الاعتبار والجعل الشرعي بشكل مستقلّ وقبل تحقّق العمل الخارجي.
ولتوضيح أكثر، استند المحقّق الخوئي(قدسسره) إلى القاعدة الفلسفيّة المعروفة «التقييد جزءٌ والقيدُ أمرٌ خارج». وتقريرها هو أنّ في متعلَّق الأمر المقيَّد - كـ«الصلاة المستقبَلة» - يكون نفس «التقييد» (أي حيثيّة كونه مقيَّداً) جزءاً من المأمور به الاعتباري وحيثيّة تشريعيّة وداخليّة، بينما يكون «القيد» (كالاستقبال نحو الكعبة) أمراً عينيّاً وخارجاً عن ذات المأمور به وله وجود تكوينيّ.
وكما أنّ وجوب الصلاة لا يتوقّف على التحقّق الخارجي للصلاة (بل هو ثابت بجعل الشارع، سواء أتى به المكلّف أم تركه)، فإنّ شرطيّة الاستقبال أيضاً قائمة بجعل الشارع ولا تتوقّف على التحقّق الخارجي لنفس الاستقبال؛ فسواء كان المكلّف مستقبلاً للقبلة بالفعل أم لا. فهذا العنوان جزء من ماهيّة الصلاة الصحيحة في عالم التشريع.
وبناءً على هذا البيان، فالنتيجة هي أنّ استصحاب الوجود الخارجي للشرط (كبقاء الاستقبال فعلاً) لن يكون نافذاً في إثبات «شرطيّته» الشرعيّة؛ لأنّ هذين يتعلّقان بسنخين وعالمين مختلفين: فوجود الشرط أمر خارجيّ وتكوينيّ، والشرطيّة أمر اعتباريّ وشرعيّ. وترتّب أحدهما على الآخر هو من قبيل ترتّب الأثر على اللازم العقلي أو العادي الذي يُعدّ في مصطلح الأصول «أصلاً مثبتاً»، والأصول المثبتة ليست بحجّة بناءً على الاتّفاق. وعليه، فإنّ إثبات الشرطيّة عن طريق استصحاب ذات الشرط هو من وجهة نظر الصناعة الأصوليّة غير تامّ ومردود.
ويواصل المرحوم المحقّق الخوئي(قدسسره) في تقرير مبناه، لمزيد من الوضوح، فيقارن مورد البحث بالقسم الثالث من الأحكام الوضعيّة، ثم يسدّ طريق جريان الاستصحاب في نفس الشرطيّة أيضاً:
الفرق مع القسم الثالث:
يقول(قدسسره): إنّ هذا المورد يختلف جوهريّاً عن القسم الثالث من الوضعيّات؛ لأنّه هناك - كما إذا شُكّ في بقاء الخمريّة - يمكن بسهولة استصحاب نفس «الخمريّة» التي هي موضوع شرعيّ خارجيّ، وترتيب الآثار الشرعيّة المجعولة المترتّبة عليها بلا واسطة، كحرمة الشرب والنجاسة. أمّا في محلّ البحث، فـ«الشرطيّة» ليست أثراً شرعيّاً مباشراً للوجود الخارجي للشرط حتى يؤدّي إثباته الخارجي إلى إثباتها.
سدّ طريق استصحاب نفس الشرطيّة:
ثمّ يُطرح هذا التساؤل: ألا يمكن ابتداءً استصحاب نفس عنوان «الشرطيّة»؟ کما إذا شُكّ في بقائها لتبدّل حال المکلّف من العلم إلى الجهل ونحو ذلك.
فالجواب بالنفي؛ ووجهه أنّه بناءً على المبنى المتقدّم، فإنّ «الشرطيّة» حیثیّة انتزاعیّة مأخوذة من «الأمر بالمقیَّد»، وهي مجعولة بالعرض تبعاً لجعل ذلك الأمر. وفي مثل هذا الفرض، يكون المجرى الصحیح للاستصحاب هو منشأ الانتزاع نفسه، أي «الأمر بالمقیَّد»، وبعد إثباته، یترتّب علیه عنوان الشرطيّة.
وحيث إنّ استصحاب الأمر الأصيل والمنشأ قابل للجریان، فلا تصل النوبة أصولاً إلى استصحاب الأمر الفرعي والانتزاعي؛ إذ لا مورد لجریان الأصل في الفرع مع إمکان إجرائه في الأصل.
مناقشة الأستاذ على تبيين المحقّق الخوئي(قدسسره)
الإيراد الأوّل: عدم تطابق محلّ النزاع مع تصوير المحقّق الخوئي(قدسسره)
يُناقش الأستاذ، كأوّل إشكال، أساس تقرير المرحوم الخوئي(قدسسره) ويعتقد أنّ التصوير المقدَّم لمحلّ النزاع لا ينطبق على مدّعى الأصوليّين في هذا الباب. وبعبارة أخرى، فإنّ ظاهر كلامه(قدسسره) يحكي أنّه قد صوّر محلّ البحث بنحو يمكن ردّه بسهولة، والحال أنّ مثل هذه الصورة لم تكن أساساً مقصودة للقائلين بجريان الاستصحاب في مقامنا.
الاستصحاب مورد نقد المرحوم الخوئي(قدسسره): يعرّف الاستصحاب كأنّ المكلّف يريد استصحاب «الوجود الخارجي والتكويني» للشرط - كنفس الاستقبال الفيزيائي نحو القبلة - ويستنتج بناءً عليه أثراً تشريعيّاً. ومن البديهي أنّ مثل هذا التقرير للاستصحاب في مثل هذه الفروع لا يتوافق مع مبنى الفقهاء، ولم يبنِ أحد منهم إثبات حكم شرعيّ على مجرّد إبقاء أمر خارجيّ محض.
الاستصحاب الصحيح في محلّ البحث: إنّ ما هو في الواقع محلّ ابتلاء وبحث هو الاستصحاب في عالم التشريع وبهدف إثبات بقاء عنوان أو حكم وضعيّ شرعيّ.
وتوضيح هذا المطلب: لو كان المكلّف - مثلاً - في الصحراء وعجز عن تحديد جهة القبلة، لسأل: «هل يبقى شرط الاستقبال في حال الجهل، أو أنّه يسقط للعجز عن إحرازه؟». فيجري المجتهد، بناءً على يقينه السابق بثبوت شرطيّة الاستقبال في حال العلم، وشكّه اللاحق في بقائها في حال الجهل، استصحاب نفس ذلك العنوان الشرعي للشرطيّة. وبما أنّه لا دليل لديه على ارتفاعها في حال الجهل، يحكم ببقائها.
وبناءً على هذا، تكون الفتوى العمليّة هي: بما أنّ شرطيّة الاستقبال باقية، فيجب العمل بنحو يُحرَز تحقّقه، كالصلاة إلى أربع جهات مثلاً حتى يتحقّق الاستقبال أيّاً كانت القبلة.
بناءً عليه، فالإيراد الوارد على كلام المرحوم الخوئي(قدسسره) هو أنّه قد طبّق محلّ البحث على «استصحاب الوجود الخارجي للشرط» ونقده، والحال أنّ المجرى الحقيقي للاستصحاب في هذه المسألة هو إبقاء الحكم الوضعي الشرعي أي نفس الشرطيّة. وفي هذه الصورة، سيكون المانع والإشكال المتقدّم له سالبة بانتفاء الموضوع.
الإيراد الثاني: عدم وجود مانع لـ«استصحاب نفس الشرطيّة»
الإيراد الثاني للأستاذ ناظر إلى ذلك القسم من كلام المحقّق الخوئي(قدسسره) الذي أغلق فيه طريق الاستصحاب المباشر لنفس الشرطيّة بحجّة إمكان استصحاب منشأ الانتزاع.
ادّعاء المحقّق الخوئي(قدسسره): قال(قدسسره) إنّه بما أنّه يمكن استصحاب منشأ الانتزاع (أي «الأمر بالمقيَّد»)، فلا تصل النوبة إلى استصحاب نفس الأمر الانتزاعي (أي «الشرطيّة»). لکنّ لا يقبل الأستاذ هذا الادّعاء ويعتبره فاقداً للدليل المقنع.
عدم الانحصار والأولويّة: لا يوجد أيّ دليل منطقيّ يقول إنّه لو وجد طريقان للاستصحاب (طريق استصحاب الأمر الأصيل وطريق استصحاب الأمر الانتزاعي)، لكان لأحدهما أولويّة على الآخر بشكل كلّيّ ولأغلق الطريق الثاني. فهذان الطريقان يقعان جنباً إلى جنب وفي «صفّ» الخيارات الممكنة للاستصحاب، ويمكن للمجتهد أن يختار أيّاً منهما يراه أنسب وأوضح للوصول إلى الجواب.
دقّة استصحاب الأمر الانتزاعي أكثر: بل إنّ استصحاب نفس الأمر الانتزاعي (كالشرطيّة) في كثير من الموارد يكون أدقّ وأكثر فاعليّة. لأنّ شكّنا يتركّز تماماً على هذا الأمر. ففي مثالنا، ليس شكّ المجتهد في وجوب أصل الصلاة؛ فهو على يقين بأنّ الصلاة واجبة. وشكّه تماماً في بقاء أو سقوط «شرطيّة الاستقبال». فأيّ طريق أفضل وأكثر منطقيّة من أن نستصحب مباشرةً نفس ما هو محلّ نزاع وشكّ، أي نفس «الشرطيّة»؟
عدم وجود مانع لاستصحاب الأمر الانتزاعي: ما دام لأمر انتزاعيّ (كالشرطيّة) أثر شرعيّ (وأثره هو لزوم الإتيان بالقيد في ضمن العمل)، وكانت أركان الاستصحاب جارية فيه، فلا يوجد أيّ مانع لجريان الاستصحاب فيه.
بناءً عليه، فمن وجهة نظر الأستاذ، كلا الطريقين (استصحاب الأمر بالمقيَّد كمنشأ، واستصحاب نفس الشرطيّة كأمر انتزاعيّ) مفتوحان، وليس لأحدهما أولويّة حصريّة على الآخر. بل إنّ استصحاب نفس الشرطيّة في بعض الموارد، بسبب تركيزه المباشر على محلّ الشكّ، هو طريق أدقّ وأوضح للوصول إلى الحكم الشرعي.
الإشكال على جريان الاستصحاب في نفس الشرط
بعد أن اتّضح مبنى الأستاذ في عموميّة جريان الاستصحاب في جميع أقسام الأحكام الوضعيّة الثلاثة - خلافاً للمحقّق الإصفهاني وصاحب الكفاية(قدسسرهما) - يُطرح الآن مبحثان مهمّان ومترابطان. أوّلاً، بحث اختلاف دقيق بين مدرسة صاحب الكفاية ومدرسة المرحوم المحقّق الأصفهاني والمرحوم المحقّق الخوئي في باب منشأ انتزاع الشرطيّة؛ وثانياً، طرح إشكال أساسيّ على جريان الاستصحاب في نفس الشرط.
المقام الأوّل: اختلاف الرأي في منشأ انتزاع «الشرطيّة»
محلّ البحث هو أنّه عندما نقول «الاستقبال شرط للصلاة»، فمن أين يُنتزَع هذا العنوان «الشرطيّة»؟
رأي صاحب الكفاية(قدسسره) (النظرة البسيطة والمباشرة): المرحوم الآخوند الخراساني(قدسسره)، بنظرة عرفيّة ومباشرة، يرى أنّ الشرطيّة تُنتزَع من نفس الشرط. فكما أنّ «الأبوّة» تُنتزَع من ذات «الأب» و«الفوقيّة» من ذات «الفوق» (ما يقع في الأعلى). وبناءً على هذا، فلو استصحبنا الشرط، لثبتت الشرطيّة تبعاً له، ولن يكون هذا الترتّب من قبيل الأصل المثبت.
رأي المحقّق الأصفهاني والمحقّق الخوئي(قدسسرهما) (النظرة التحليليّة والمركّبة): هذان العلمان(قدسسرهما)، بنظرة أدقّ وتحليليّة، يعتقدان أنّ الشرطيّة تُنتزَع من «الصلاة المقيَّدة بالشرط»؛ أي إنّ منشأ الانتزاع هو تلك الماهيّة المركّبة التي تعلّق بها أمر الشارع، كـ«الصلاة مع الاستقبال»، لا نفس الشرط بمفرده.
تحليل الأستاذ: عودة الرأيين إلى نقطة واحدة
يُرجع الأستاذ، بالدقّة في مباني الطرفين، هذا الاختلاف إلى فرق في كيفيّة البيان، لا إلى فرق ماهويّ. لأنّ:
• أوّلاً، من الواضح أنّ الشرطيّة لا تُنتزَع من ذات «الصلاة» بمفردها ومن دون أخذ القيد في الاعتبار.
• ثانياً، مقصود المحقّق الأصفهاني والخوئي(قدسسرهما) بـ«الصلاة المقيَّدة» هو في الواقع نفس «تقيُّد الصلاة بالشرط»؛ أي حيثيّة وحالة كونها مقيَّدة، لا جميع أجزاء المركّب.
• ثالثاً، بناءً على القاعدة الفلسفيّة المعروفة بأنّ «التقييد جزء الماهيّة والقيد أمر خارجيّ»، فإنّ هذا «التقيُّد» نفسه (حالة كونه مقيَّداً) هو جزء من حقيقة المأمور به وهو في الواقع نفس الشرط بالمعنى الأصولي الدقيق. أمّا «القيد» (كالعمل الخارجي للاستقبال) فيُعدّ أمراً خارجيّاً.
النتيجة: بناءً عليه، فعلى الرغم من أنّ بيان المحقّقی الأصفهاني والخوئي(قدسسرهما) يبدأ من «الصلاة المقيَّدة»، إلّا أنّه في التحليل النهائي يرجع إلى انتزاع الشرطيّة من «التقيُّد» الذي هو نفس «الشرط». إذن، فمحصَّل كلامهما سيتّحد مع مبنى المرحوم الآخوند(قدسسره). وفي النهاية، الفرق هو أنّ بيان صاحب الكفاية(قدسسره) بسيط ومباشر، وبيان هذين العلمين(قدسسرهما) تحليليّ ومركّب؛ ولكن كلاهما يصل إلى نقطة واحدة. ولهذا، يمكن باطمئنان جعل بيان صاحب الكفاية(قدسسره) الواضح أساساً.
المقام الثاني: الإشكال الأساسي على جريان الاستصحاب في نَفسِ الشرط
بعد تمهيد البحث، نصل إلى إشكال أساسيّ ومتين يُناقش أساس جريان الاستصحاب في نفس الشرط مناقشة جادّة. وهذا الإشكال، الذي تعرّض له صاحب الكفاية(قدسسره) نفسه وكان بصدد الجواب عليه، يحتاج بسبب دقّته وعمقه إلى تأمّل كثير.
تقرير الإشكال في ثلاث مقدّمات:
المقدّمة الأولى: كون ذات الشرط تكوينيّة
يقول المستشكِل: إنّ الشرط - كـ«الاستقبال إلى الكعبة» - هو ماهيّةً أمر تكوينيّ، لا اعتباريّ وتشريعيّ. وبعبارة أخرى، فذات هذا العمل لها وجود خارجيّ وعينيّ وليست مجعولة للشارع المقدّس؛ بل هي مجرّد عمل يتحقّق في وعاء الخارج.
المقدّمة الثانية: عدم ترتّب أثر شرعيّ مباشر على ذات الشرط
إنّ هذا الأمر التكويني بذاته فاقد للأثر الشرعي المباشر. فمثلاً، «جواز الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام» المترتّب على الاستقبال ليس أثراً شرعيّاً ومجعولاً لذات هذا العمل التكويني، بل هو حكم عقليّ. فالعقل يحكم بأنّه لامتثال الأمر بـ«الصلاة المقيَّدة بالاستقبال»، يجب مقدّمةً تحصيل الاستقبال حتى يمكن الدخول في الصلاة. وهذه علاقة لزوم عقليّ، لا ترتّب حكم شرعيّ على موضوعه.
المقدّمة الثالثة: كون «التقيُّد» تشريعيّاً لا «القيد»
بناءً على القاعدة الفلسفيّة المعروفة، فإنّ ما يتعلّق به الجعل التشريعي هو «تقيُّد الصلاة بالاستقبال» الذي هو حيثيّة داخليّة وجزئيّة للمأمور به. أمّا نفس «القيد» - أي الاستقبال الخارجي - فهو أمر خارجيّ ومجرّد محقِّق وطريق لإيجاد ذلك التقيُّد.[5]
نتيجة الإشكال: بناءً عليه، فـ«الشرط» (بمعنى القيد الخارجي) هو أمر تكوينيّ ليس بمجعول شرعيّ ولا له أثر شرعيّ مباشر. ومن جهة أخرى، فإنّ الاستصحاب أصل عمليّ شرعيّ مجراه إمّا حكم شرعيّ وإمّا موضوع ذو أثر شرعيّ. فكيف يمكن إجراؤه في مثل هذا الأمر التكويني الفاقد للأثر الشرعي؟ فهذا الأمر، ظاهراً، خروج عن نطاق حجّيّة الاستصحاب وتمسّك بالأصل في غير مجراه.
وهذا الإشكال المتين يضع تحدّياً جادّاً أمام القائلين بجريان الاستصحاب في الشرط، ويحتاج الجواب عليه إلى تحليل دقيق. ولدفع هذا الإشكال، قُدِّم جوابان من قبل صاحب الكفاية والمحقّق الخوئي(قدسسرهما) سيأتي بيانهما.
جوابان على هذا الإشكال
الجواب الأوّل من صاحب الكفاية(قدسسره)
بعد أن طُرح الإشكال الأساسي على جريان الاستصحاب في «نفس الشرط» - بناءً على أنّ الشرط أمر تكوينيّ وفاقد للأثر الشرعي المباشر - تصدّى المرحوم الآخوند الخراساني(قدسسره) نفسه للجواب، وبتحليل دقيق، مهّد الطريق لجريان الاستصحاب.
كشف الواسطة وتعيين الموضوع الحقيقي للأثر
يرتكز أساس جواب المرحوم الآخوند(قدسسره) على هذه النكتة وهي أنّه على الرغم من أنّ الأثر الشرعي المطلوب لنا (كجواز الدخول في الصلاة) لا يترتّب مباشرةً على ذات الأمر التكويني (كعمل الاستقبال)، إلّا أنّ هذا لا يعني وجود طريق مسدود وعدم جريان الاستصحاب. فهو، بتقديمه لواسطة مفصليّة، أي العنوان الانتزاعي «الشرطيّة»، يحلّ هذه العقدة.
تقرير الاستدلال في ثلاث خطوات منطقيّة:
الخطوة الأولى: موضوع الأثر هو «الشرطيّة» لا نفس الشرط
يقول المرحوم الآخوند(قدسسره) إنّ الأثر الشرعي الذي نحن بصدده، أي «جواز الدخول في الصلاة»، يترتّب على العنوان الوضعي والاعتباري «الشرطيّة». وبعبارة أخرى، فقد رتّب الشارع المقدّس جواز تكبيرة الإحرام على «كون الاستقبال شرطاً للصلاة»، لا على نفس «العمل الخارجي والتكويني للاستقبال». إذن، فالموضوع الحقيقي للأثر هو أمر شرعيّ واعتباريّ.
الخطوة الثانية: «الشرطيّة» منتزَعة من «الشرط»
والآن السؤال هو: من أين يُحصَّل هذا العنوان «الشرطيّة»؟ هو، بناءً على مبناه، يعتقد أنّ عنوان «الشرطيّة» يُنتزَع من نفس «الشرط». فلهذين علاقة تحليليّة وغير قابلة للانفكاك، كالذات والوصف الذاتي لها. فكلّما ثبت «الشرط» على نحو حقيقيّ أو تعبّديّ، تُنتزَع منه «الشرطيّة» أيضاً.
الخطوة الثالثة: إكمال سلسلة الاستدلال ونفي الأصل المثبت
بوضع الخطوتين السابقتين جنباً إلى جنب، يكتمل الاستدلال:
• نُحرز باستصحاب بقاء «الشرط» (الأمر التكويني للاستقبال) على نحو تعبّديّ.
• تبعاً لهذا الإحراز التعبّدي، ومن دون حاجة إلى واسطة مغايرة توجب أصلاً مثبتاً، يثبت عنوان «الشرطيّة» أيضاً، الذي يُنتزَع منه، على نحو تعبّديّ.
• وبما أنّ «الشرطيّة» هي الموضوع المباشر للأثر الشرعي، فبثبوتها التعبّدي، يترتّب ذلك الأثر الشرعي (جواز الدخول في الصلاة) أيضاً.
وفي هذه العمليّة، يوصلنا استصحاب الشرط مباشرةً إلى الشرطيّة، والشرطيّة توصلنا إلى الأثر الشرعي. وبما أنّ العلاقة بين الشرط والشرطيّة هي علاقة تحليليّة وانتزاعيّة، فهذه الواسطة عقليّة غير مستقلّة ولا توجب أصلاً مثبتاً.
ملاحظة الأستاذ:
يعمّق الأستاذ، بدقّة إضافيّة، بيان صاحب الكفاية(قدسسره) على هذا النحو: الصحيح هو أن نقول إنّ الشرطيّة «منتزَعة من الشرط»، لا «أثر» له. لأنّ «الأثر» يُطلق عادةً على وجود مستقلّ. والآن لو دقّقنا أكثر، فما هو المنشأ الحقيقي لهذا الانتزاع؟ المنشأ ليس مجرّد العمل الخارجي، بل هو «تقيُّد الواجب بالشرط» (كون الصلاة مقيَّدة بشرط الاستقبال). وهذا «التقيُّد» هو نفس الشرط الحقيقي والأمر التشريعي الذي يُعدّ جزءاً من المأمور به. والأمر التكويني للاستقبال هو مجرّد مظهر ومحقِّق خارجيّ لذلك التقيُّد التشريعي. وعليه، فعندما نستصحب الأمر التكويني، فإنّنا في الواقع قد أحرزنا منشأ انتزاع أمر شرعيّ على نحو تعبّديّ، وبإحراز المنشأ، يمكننا ترتيب عنوان «الشرطيّة» ثم أثره الشرعي.
وبهذا، يجري الاستصحاب في أمر تكوينيّ هو جذر وأساس لوضع شرعيّ بالكامل، ولهذا السبب هو معتبر وذو أثر تماماً.


