46/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ الکلام في المورد الثاني/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
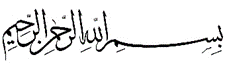
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه الثامن؛ المطلب الأول؛ الکلام في المورد الثاني
إیراد المحقّق الإصفهاني(قدسسره) علیه
يقول(قدسسره):
«إنّ موضوع الحكم بالإضافة إلى المستصحب تارة یكون طبیعیاً بالنسبة إلى فرده، كالإنسان بالإضافة إلى زید و عمرو، و كالماء و التراب بالإضافة إلى مصادیقهما و أخری یكون عنواناً بالإضافة إلى معنونه، كالعالم بالنسبة إلى العالم بالحمل الشائ
و ربّما یعبّر عن الأوّل بالعنوان المنتزع عن مرتبة الذات، نظراً إلى تقرر حصّة من الطبیعي في مرتبة ذات فرده، فالعنوان المقابل للطبیعي حقیقة هو العنوان الذي یكون مبدؤه خارجاً عن مرتبة الذات و لیس ذاتیاً بمعنی ما یأتلف منه الذات بل یكون قائماً بها، إمّا بقیام انتزاعي، كالفوقیة بالنسبة إلى السقف، أو بقیام انضمامي كالبیاض بالإضافة إلى الجسم.
و ما یكون قائماً بقیام انتزاعي ربّما یكون ذاتیاً في كتاب البرهان، أي یكفي وضع الذات في انتزاعه؛ كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان مثلاً، و لایكون إلا في الحیثیات اللازمة للذات، كالإمكان لذات الممكن و كالزوجیة للأربعة، و ربما یكون عرضیاً بقول مطلق كالأبوّة لزید و الفوقیة للجسم.
و أمّا ما یكون له قیام انضمامي فهو عرضي بقول مطلق دائماً.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ العنوان الملحق بالطبیعي، إن كان هو العنوان الوصفي الاشتقاقي بلحاظ قیام مبدئه بالذات، فلا فرق بین العنوان الذي كان مبدؤه قائماً بقیام انتزاعي أو بقیام انضمامي؛ إذ كما أنّ الفوق عنوان متّحد الوجود مع السقف، كذلك عنوان الأبیض متّحد مع الجسم، فیصحّ استصحاب العنوان الموجود في الخارج بوجود معنونه، و ترتیب الأثر المترتّب على العنوان الكلّي، فلا مقابلة حینئذٍ بین الخارج المحمول و المحمول بالضمیمة من هذه الحیثیة [فنستصحب بقاء حیاة المجتهد عند الشك في عروض الموت علیه، مع أنّ عنوان المجتهد هو المحمول بالضمیمة، فیترتّب علیه بقاء وكالاته و نفوذ أحكامه و حكم جواز التقلید عنه و أمثالها].
و إن كان المراد نفس المبدأ القائم بالذات تارة بقیام انتزاعي و أخری بقیام انضمامي، فلتوهّم الفرق مجال، نظراً إلى أنّ وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشئه، بخلاف الضمیمة المتأصّلة في الوجود، فإنّها مباینة في الوجود مع ما تقوم به، فاستصحاب ذات منشأ الانتزاع و ترتیب أثر الموجود بوجوده، كترتیب أثر الطبیعي على فرده المستصحب، بخلاف استصحاب ذات الجسم، و ترتیب أثر البیاض فإنّهما متباینان في الوجود.
و صدر العبارة في المتن یقتضي إرادة الشقّ الأوّل [أي العنوان الوصفي الاشتقاقي] و ذیلها ظاهر في إرادة الشقّ الثاني [أي نفس المبدأ القائم بالذات].
و التحقیق بناء على إرادة الشقّ الثاني أنّ الأمر الانتزاعي:
إن كان من الحیثیات اللازمة للذات و هو الذاتي في كتاب البرهان فهو متیقّن و مشكوك، كمنشأ انتزاعه، فهو المستصحب و هو الموضوع للأثر، لا أنّهما متّحدان في الوجود.
و إن كان عرضیاً بقول مطلق فكما أنّ استصحاب ذات الجسم و ترتیب أثر البیاض مثبت، كذلك استصحاب ذات زید و ترتیب أثر الأبوّة علیه مثبت، و مجرد اتّحادهما في الوجود بقاء لایجدي شیئاً.
فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ نسبة المستصحب إلى موضوع الأثر إن كانت نسبة الفرد إلى الطبیعي صحّ الاستصحاب، و كذا إن كانت نسبته إلیه نسبة المعنون إلى عنوانه، سواء كان مبدأ العنوان قائماً بذات المعنون بقیام انتزاعي أم بقیام انضمامي.
و أمّا إن كانت نسبته إلیه نسبة المنشأ إلى الأمر الانتزاعي المصطلح فلایصحّ الاستصحاب، إذ لیس ذات المنشأ موضوعاً للأثر.
نعم إن كان الأمر الانتزاعي ذاتیاً للمنشأ، بالمعنی المصطلح علیه في كتاب البرهان، صحّ استصحاب الأمر الانتزاعي الموجود بوجود منشئه، لا نفس المنشأ و ترتیب أثر الأمر الانتزاعي علیه»[1] .
نظرتان مختلفتان إلى «الأمر الانتزاعي» وتأثيرهما في الاستصحاب
تكمن ذروة دقّة كلام المحقّق الأصفهاني(قدسسره) في أنّه يقول إنّ كلّ البحث يرجع إلى ما ننظر إليه؟ هل نظرتنا إلى نفس «العنوان الوصفي الاشتقاقي» أم إلى «المبدأ القائم بالذات»؟ فنتيجة البحث في هاتين النظرتين ستكون مختلفة تماماً.
النظرة الأولى: النظر إلى «العنوان الوصفي الاشتقاقي»
لو نظرنا إلى نفس «العنوان» كوصف اشتقاقيّ يُحمل على الذات باعتبار قيام مبدئه بها، لما كان هناك أيّ فرق بين الأقسام المختلفة للعناوين (خارج المحمول والمحمول بالضميمة).
يقول المرحوم الأصفهاني(قدسسره): «فلا فرق بين العنوان الذي كان مبدؤه قائماً بقيام انتزاعيّ أو بقيام انضماميّ». لأنّه من هذا المنظور، فكما أنّ عنوان «فوق» متّحد في الوجود مع «السقف»، كذلك عنوان «أبيض» متّحد في الوجود مع «الجسم». فكلاهما عنوانان ليس لهما في الخارج وجود منفصل عن معنونهما. بناءً عليه، فلو كانت نظرتنا إلى «العنوان»، لأمكننا استصحاب نفس «العنوان» الذي كان موجوداً في الخارج بوجود معنونه، وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه. وفي هذه الصورة، لم تعد هناك مقابلة بين خارج المحمول والمحمول بالضميمة، ويمكن إجراء الاستصحاب في كليهما. فمثلاً، عنوان «مجتهد» هو محمول بالضميمة (يحتاج إلى ضمّ ملكة الاجتهاد إلى الذات). ومع ذلك، يمكننا باستصحاب بقاء حياة الشخص، استصحاب عنوان «كونه مجتهداً» وترتيب آثار كبقاء الوكالات ونفوذ الأحكام وجواز التقليد عنه. وهذا يبيّن أنّه لو كان النظر إلى «العنوان»، لكان الاستصحاب جارياً حتّى في المحمول بالضميمة.
النظرة الثانية: النظر إلى «المبدأ القائم بالذات»
أمّا لو تحوّلت نظرتنا من «العنوان» إلى «مبدئه»، أي لو أردنا استصحاب نفس المبدأ لنرتّب أثر الأمر الانتزاعي، فهنا «فلتوهّم الفرق مجال»؛ أي يُفتح المجال للقول بالتفصيل والتفريق؛ لأنّ الفرق بين القيام الانتزاعي والانضمامي يتجلّى هنا:
في القيام الانتزاعي (خارج المحمول): وجود الأمر الانتزاعي هو بعين وجود منشأ انتزاعه وليس له وجود منفصل عنه. وعليه، فاستصحاب «المنشأ» هو بمنزلة استصحاب نفس الأمر الانتزاعي (كاستصحاب الفرد لترتيب حكم الطبيعي).
في القيام الانضمامي (المحمول بالضميمة): هنا لـ«الضميمة» (المبدأ) وجود متأصّل ومستقلّ عن ذات المعروض. فوجود «البياض» غير وجود «الجسم»، وإن كان قائماً به. بناءً عليه، فهما متباينان وجوداً، واستصحاب «ذات الجسم» لا يمكنه إثبات وجود «البياض» الذي هو أمر آخر. وهذا العمل هو المصداق البارز للأصل المثبت. إذن، لو كانت نظرتنا إلى «المبدأ»، لبدا تفصيل صاحب الكفاية(قدسسره) (الجواز في خارج المحمول وعدم الجواز في المحمول بالضميمة) صحيحاً.
الإبهام في كلام صاحب الكفاية والتحقيق النهائي للمحقّق الأصفهاني(قدسسرهما)
يواصل المرحوم الأصفهاني(قدسسره) فيقول إنّ كلام صاحب الكفاية(قدسسره) في الكفاية يعتريه نوع من الإبهام. فصدر كلامه يتوافق أكثر مع النظرة الأولى (النظر إلى العنوان)، أمّا ذيله فيشبه أكثر النظرة الثانية (النظر إلى المبدأ). والآن، ما هو «التحقيق» والرأي النهائي لنفس المحقّق الأصفهاني(قدسسره)؟ هو، بفرض أنّ المراد هو النظرة الثانية (النظر إلى المبدأ)، ينهي البحث على هذا النحو:
لو كان الأمر الانتزاعي ذاتيّ باب البرهان: (كالإمكان للإنسان). ففي هذه الصورة، بما أنّ هذا الأمر من الحيثيّات اللازمة للذات، فهو نفسه أيضاً، كمنشأ انتزاعه، متيقَّن ومشكوك. فلم تعد هناك حاجة إلى استصحاب المنشأ لنرتّب أثر الأمر الانتزاعي! بل يمكننا استصحاب نفس الأمر الانتزاعي (كالإمكان مثلاً) مباشرةً وترتيب الحكم عليه.
لو كان الأمر الانتزاعي عرضيّاً (سواء من صميمه أم بالضميمة): فهنا لن يكون استصحاب «المنشأ» لإثبات «أثر الأمر الانتزاعي» مفيداً. وهنا يخطو المحقّق الأصفهاني(قدسسره) خطوة أبعد من صاحب الكفاية(قدسسره) فيقول: فكما أنّ استصحاب «ذات الجسم» لترتيب أثر «البياض» هو أصل مثبت،
«كذلك استصحاب ذات زيد وترتيب أثر الأبوّة عليه مثبت»! وهذه نكتة مهمّة جدّاً. فـ«الأبوّة» هي أمر خارج محمول من صميمه (لها قيام انتزاعيّ عرضيّ)، لا بالضميمة. ومع ذلك، يعتقد المحقّق الأصفهاني(قدسسره) أنّه حتّى في هذا المورد لو أردنا استصحاب «ذات زيد» (المنشأ) لنرتّب أثر «الأبوّة» (الأمر الانتزاعي)، لكان هذا العمل أصلاً مثبتاً. فمجرّد الاتّحاد في الوجود بقاءً لا يجدي شيئاً.
الخلاصة والنتيجة النهائيّة
إنّ كلام المحقّق الأصفهاني(قدسسره) الدقيق، الذي تبعه فيه المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره) أيضاً([2] )، يوصلنا إلى هذه النتيجة:
لو كانت نظرتنا إلى «العنوان»: لكان الاستصحاب جارياً في جميع أقسام العناوين (سواء بالقيام الانتزاعي أم الانضمامي) وليس بأصل مثبت. (توسعة باب الاستصحاب)
لو كانت نظرتنا إلى «المبدأ»: لما صحّ استصحاب «المنشأ» لإثبات «أثر الأمر الانتزاعي» إلّا في صورة كون ذلك الأمر الانتزاعي «ذاتيّ باب البرهان» للمنشأ، وفي هذه الصورة أيضاً من الأفضل استصحاب نفس الأمر الانتزاعي مباشرةً. أمّا في سائر الموارد، أي في كلّ من «خارج المحمول من صميمه العرضيّ» (كالأبوّة) و«المحمول بالضميمة» (كالبياض)، لكان هذا العمل أصلاً مثبتاً وغير حجّة. (تضييق باب الاستصحاب حتّى أكثر من رأي صاحب الكفاية(قدسسره))
بناءً عليه، يبيّن المحقّق الأصفهاني(قدسسره) بتحليله الدقيق أنّ تفكيك صاحب الكفاية(قدسسره) بين خارج المحمول والمحمول بالضميمة لا وجه له لو كان النظر إلى «العنوان»، وهو ناقص لو كان النظر إلى «المبدأ» ويجب إخراج خارج المحمول العرضي أيضاً من دائرة الجواز.[3] [4] [5] [6] [7]
الكلام في المورد الثالث
بعد بحث الموردين الأوّلين، نصل الآن إلى المورد الثالث والأخير الذي يعتقد المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) أنّ الاستصحاب فيه لا يُعدّ أصلاً مثبتاً. ويُخصَّص هذا المورد لبحث «الجزء» و«الشرط» و«المانع» التطبيقيّ جدّاً في المركّبات الشرعيّة، كالصلاة.
نظريّة صاحب الكفاية(قدسسره): جواز الاستصحاب وعدم المثبتيّة
إنّ المدّعى الرئيسي للمرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) هو أنّه يمكننا استصحاب وجود «جزء» (كالسورة) أو «شرط» (كالطهارة) وتبعاً له ترتيب الأثر الشرعي لـ«الجزئيّة» أو «الشرطيّة» عليه، من دون أن يكون هذا العمل مصداقاً للأصل المثبت.
وتكمن فلسفة هذه النظريّة في نظرة صاحب الكفاية(قدسسره) الخاصّة لماهيّة «الجعل الشرعي». فهو يعتقد أنّه لصحّة جريان الاستصحاب، المهمّ هو أن يكون الأثر الذي نقصده تحت قدرة وإرادة الشارع التشريعيّة بنحو من الأنحاء، وأن يكون أمره وضعاً ورفعاً بيده. ومن هذا المنظور، لا فرق بين نوعين من الجعل:
المجعول بالاستقلال (أو بنفسه): الأثر الذي وضعه الشارع مباشرةً وبجعل مستقلّ. كالأحكام التكليفيّة نفسها (الوجوب، الحرمة) أو بعض الأحكام الوضعيّة (كالملكيّة التي تُنشأ بجعل سببها استقلالاً).
المجعول بالتبع (أو بمنشأ انتزاعه): الأثر الذي ليس له جعل مستقلّ، ولكنّه يُنتزَع ويُعتبر تبعاً لجعل أمر آخر. فالعناوين كـ«الجزئيّة» و«الشرطيّة» و«المانعيّة» هي من هذا القبيل. فالشارع لا يقول مباشرةً: «لقد جعلتُ الجزئيّة للسورة»، بل بأمره بالمركّب (الصلاة المشتملة على السورة)، تُجعل جزئيّة السورة وتُعتبر تبعاً له.
ومن وجهة نظر صاحب الكفاية(قدسسره)، فإنّ كلا القسمين يمتلكان الملاك اللازم لجريان الاستصحاب؛ أي إنّ كليهما يرجعان في النهاية إلى يد جعل الشارع. فالشارع كما يمكنه وضع أو رفع حكم مباشرةً، يمكنه أيضاً بوضع أو رفع منشأ الانتزاع (أي نفس الجزء أو الشرط)، أن يضع أو يرفع الجزئيّة والشرطيّة بشكل غير مباشر.
النتيجة: بناءً عليه، فعندما نشكّ في بقاء الطهارة (التي هي شرط للصلاة)، يمكننا استصحاب وجود الطهارة. وأثر هذا الاستصحاب، أي «الشرطيّة»، الذي هو مجعول تبعيّ، يترتّب عليه مباشرةً ومن دون حاجة إلى واسطة، وهذا العمل لن يكون أصلاً مثبتاً.
نظريّة الشيخ الأعظم الأنصاري(قدسسره): مخالفة المبنى وعدم الجعليّة
في مقابل هذا الرأي، تقع نظريّة الشيخ الأعظم الأنصاري(قدسسره) الدقيقة والبنيويّة. فهو يخالف مبنى صاحب الكفاية(قدسسره) ولا يقبل أساساً بـ«الجعليّة» (حتّى على نحو التبع) للعناوين كالجزئيّة والشرطيّة. فمن وجهة نظر الشيخ(قدسسره)، هذه العناوين ليست مجعولة شرعيّة أصلاً وأبداً، بل هي مجرّد عناوين «منتزَعة» من نفس الحكم التكليفي الأصلي.
يقول الشيخ الأعظم(قدسسره) في عبارته المشهورة:
«شرطیة الطهارة للصلاة لیست مجعولة بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة و كذا مانعیة النجاسة لیست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس و كذا الجزئیة منتزعة من الأمر بالمركب»[8] .
ولفهم عمق كلام الشيخ(قدسسره)، يجب الالتفات إلى تحليله لهذه العناوين:
الشرطيّة: من أين نفهم أنّ الطهارة شرط للصلاة؟ ليس من أنّ للشارع جعلاً منفصلاً لـ«شرطيّة الطهارة»، بل من أنّ أمر الشارع الأصلي قد تعلّق بـ«الصلاة المقيَّدة بالطهارة» (صلِّ حال الطهارة). فذهننا، بعد تحليل هذا الأمر بالمركّب المقيَّد، ينتزع عنوان «الشرطيّة» لذلك القيد (الطهارة).
المانعيّة: من أين نفهم مانعيّة النجاسة في لباس المصلّي؟ ليس من جعل مستقلّ، بل من نهي الشارع عن الصلاة في الثوب النجس (لا تصلِّ في النجس). فـ«المانعيّة» هي مجرّد اسم نطلقه على أثر هذا النهي التكليفي.
الجزئيّة: من أين ندرك جزئيّة السورة للصلاة؟ ليس من أنّ الشارع قد جعل «الجزء» وتبعاً له حصلت «الجزئيّة». فهذه النظرة ليست صحيحة من وجهة نظر الشيخ(قدسسره). بل إنّ الشارع قد أمر بـ«المركّب» (الصلاة الكاملة). فعندما نحلّل هذا المركّب المأمور به، نطلق على كلّ واحد من أجزائه المكوِّنة له (كالسورة) العنوان الانتزاعي «جزء».
بناءً عليه، فمن وجهة نظر الشيخ الأنصاري(قدسسره)، ترجع جميع هذه العناوين إلى جعل أصليّ واحد، أي نفس جعل الحكم التكليفي، وليس لها هي نفسها أيّ نوع من الجعل، لا استقلاليّاً ولا تبعيّاً. وهذه النظرة لها فرق مبنائيّ عميق مع رأي صاحب الكفاية(قدسسره)، وطبعاً ستستتبع نتائج مختلفة في تحليل جريان الاستصحاب وكونه مثبتاً أم لا.
إيراد المحقّق الإصفهاني(قدسسره) علیه
بعد أن بحثنا رأي صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري(قدسسرهما) في المورد الثالث (الجزء والشرط)، ننتقل الآن إلى التحليل الدقيق والمتعدّد الأوجه للمحقّق الأصفهاني(قدسسره). فهو بنظرة موشّحة، يفصل طريقه أوّلاً عن الشيخ الأنصاري(قدسسره) ثم باستناده إلى كلام نفس صاحب الكفاية(قدسسره) في المباحث السابقة، يتحدّى نظريّته تحدّياً جادّاً.
أوّلاً: نقد نظريّة الشيخ الأنصاري(قدسسره) وإثبات «المجعوليّة بالعرض»
المحقّق الأصفهاني، خلافاً للشيخ الأنصاري(قدسسرهما) الذي سلب أيّ نوع من «الجعليّة» عن العناوين كالشرطيّة والجزئيّة واعتبرها مجرّد «منتزَعة» من الحكم التكليفي، يعتقد أنّ هذه العناوين تمتلك نوعاً من «الجعليّة». فيقول في بيانه الدقيق:
إنّ الشرطیة و شبهها من اللوازم التكوینیة للمجعول التشریعي، و إنّها مجعولة بالعرض لا بالتبع، و إنّ المجعولیة بالعرض غیر الانتزاعیة المقابلة للمجعولیة، كما تقدّم ما یتعلّق بشرط التكلیف و المكلف به، من حیث معقولیة الجعل بالعرض فیهما معاً.[9]
ولفهم هذه العبارة، يجب أن نفرّق بين ثلاثة مصطلحات:
الانتزاعيّ (رأي الشيخ(قدسسره)): في هذا الرأي، ليس لـ«الشرطيّة» أيّ حظّ من الجعل وهي مجرّد مفهوم ذهنيّ ننتزعه من تحليل الأمر بالمركّب المقيَّد.
المجعول بالتبع (رأي صاحب الكفاية(قدسسره)): في هذا الرأي، ليس لـ«الشرطيّة» جعل مستقلّ، ولكنّها تُجعل وتُعتبر تبعاً لجعل منشأ انتزاعها (أي نفس الشرط).
المجعول بالعرض (رأي المحقّق الأصفهاني(قدسسره)): هذه النظرة هي حدّ وسط وأدقّ. فـ«المجعول بالعرض» يعني أنّ «الشرطيّة» هي لازم تكوينيّ وغير منفصل عن نفس «المجعول التشريعي» (أي الحكم الأصلي). وبعبارة أخرى، فعندما يجعل الشارع الأمر بـ«الصلاة مع الطهارة»، فإنّ «شرطيّة الطهارة» أيضاً توجد وتُعتبر على نحو عرضيّ كأثر لا ينفكّ مع ذلك الجعل.
بناءً عليه، فإنّ المحقّق الأصفهاني(قدسسره)، بإثبات «المجعوليّة بالعرض»، يغلق الباب أمام نظريّة الشيخ الأنصاري(قدسسره) الذي أنكر بالكلّيّة أيّ نوع من الجعل، ويعتقد أنّ هذا المقدار من الجعليّة كافٍ للدخول في بحث الاستصحاب.
ثانياً: نقد نظريّة صاحب الكفاية(قدسسره)
هذا القسم هو ذروة وضربة إيراد المحقّق الأصفهاني(قدسسره) الرئيسيّة. فهو لنقد كلام صاحب الكفاية(قدسسره)، بدلاً من البحث المباشر، يذكّر المخاطب بأنّ نفس صاحب الكفاية(قدسسره) في أوائل بحث الاستصحاب، عندما كان يعدّد أقسام الأحكام الوضعيّة، قد قسّمها إلى ثلاثة أقسام مهمّة جدّاً:
القسم الأوّل: الأمور المتعلّقة بنفس «التكليف»: تشمل السببيّة، والشرطيّة، والمانعيّة، والرافعيّة لحكم تكليفيّ. (كالبلوغ الذي هو شرط لأصل التكليف). وفي هذا القسم، لا معنى لـ«الجزئيّة»، لأنّ نفس الحكم التكليفي بسيط وليس له جزء.
القسم الثاني: الأمور المتعلّقة بـ«المكلّف به» (متعلَّق التكليف): تشمل الجزئيّة، والشرطيّة، والمانعيّة، والقاطعيّة لعمل وفعل خارجيّ. (كالجزئيّة للسورة بالنسبة للصلاة، أو الشرطيّة للطهارة بالنسبة للصلاة التي هي «المكلّف به»).
القسم الثالث: الأمور الوضعيّة ذات الجعل الاستقلالي: تشمل الحجّيّة، والولاية، والزوجيّة، والملكيّة، وأمثالها التي يعتبرها الشارع بجعل مستقلّ. النقطة المفصليّة ومحلّ الإشكال: النكتة المهمّة والحاسمة جدّاً هي أنّ نفس صاحب الكفاية(قدسسره) في ذلك البحث الأوّلي، قد أفتى بصراحة بأنّ الاستصحاب لا يجري في القسم الأوّل، ولكنّه يجري في القسم الثاني والثالث([10] ).والآن، يتّضح الإيراد النقضي للمحقّق الأصفهاني(قدسسره) بوضوح: كيف يقول صاحب الكفاية(قدسسره) هنا (التنبيه الثامن) بشكل مطلق ومن دون أيّ تفصيل إنّ الاستصحاب يجري في الشرط والجزء لإثبات الشرطيّة والجزئيّة وليس بأصل مثبت، والحال أنّه هو نفسه قد فرّق سابقاً بين «الشرطيّة للتكليف» (القسم الأوّل) و«الشرطيّة للمكلّف به» (القسم الثاني) ولم يعتبر الاستصحاب جارياً في القسم الأوّل؟ وهذا الإبهام والتعارض الظاهري في كلام صاحب الكفاية(قدسسره) يبيّن أنّ حكم المسألة ليس بهذه البساطة والإطلاق ويحتاج إلى تحليل أدقّ سيتناوله المحقّق الأصفهاني(قدسسره) في ما يلي.


