46/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه السابع؛ المطلب الرابع؛ الفرع الخامس؛ القول الثاني/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
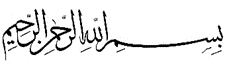
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / التنبیه السابع؛ المطلب الرابع؛ الفرع الخامس؛ القول الثاني
القول الثاني: التفصیل بین المثال الأوّل و الثاني
المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره)، خلافاً للقول المشهور الذي حكم بالضمان في كلا المثالين، قال بالتفصيل. فهو يعتقد أنّه يجب التفكيك بين المثال الأوّل (ضمان اليد) والمثال الثاني (ضمان المعاوضة). فهو يقبل بالقول بالضمان في المثال الأوّل ولكنّه يرفضه في المثال الثاني. وترتكز هذه النظريّة الدقيقة على تحليل دقيق لأركان وموضوعات كلّ واحد من هذين المثالين.
يقول(قدسسره):
«هذا الذي ذكره [المحقّق النائیني(قدسسره)] متین في المثال الأوّل، فإنّ موضوع الضمان لیس هو الید العادیة، بل الید مع عدم الرضا من المالك، و الید محرزة بالوجدان و عدم الرضا محرز بالأصل، فیحكم بالضمان.
لكنّه لایتمّ في المثال الثاني، فإنّ الرضا فیه محقّق إجمالاً: إمّا في ضمن البیع أو الهبة، فلایمكن الرجوع إلى أصالة عدمه، بل لابدّ من الرجوع إلى أصل آخر، و لایمكن التمسّك بأصالة عدم الهبة لإثبات الضمان، ضرورة أنّه غیر مترتّب على عدم الهبة، بل مترتّب على وجود البیع و هي [أي أصالة عدم الهبة] لاتثبته [أي لاتثبت البیع] و لو قلنا بحجّیة الأصل المثبت، لمعارضتها بأصالة عدم البیع، فإنّ كلاً من الهبة و البیع مسبوق بالعدم.
و أمّا قاعدة المقتضي و المانع، فهي ممّا لا أساس له، كما أنّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقیة ممّا لا وجه له على ما حقّق في محله([1] ).
و علیه فلابدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مورد بلحاظ نفسه و هو في المقام[2] أصالة عدم الضمان.
هذا فیما إذا لمیكن نصّ بالخصوص، و إلا فالمتعیّن الأخذ به كما في مسألة اختلاف المتبایعین في مقدار الثمن، كما إذا قال البائع: بعتك بعشرة دنانیر، و قال المشتري: اشتریت بخمسة دنانیر؛ ففي المقدار المتنازع فیه یرجع إلى النصّ الصحیح([3] ) الدال على تقدیم قول البائع إن كانت العین موجودة و تقدیم قول المشتري إن كانت العین تالفة»[4] .
قبول الضمان في المثال الأوّل (ضمان اليد)
يرى المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره) استدلال المحقّق النائيني(قدسسره) في المثال الأوّل متيناً وصحيحاً تماماً ويقول: «هذا الذي ذكره [المحقّق النائيني(قدسسره)] متين في المثال الأوّل». فهو أيضاً، كالمحقّق النائيني(قدسسره)، يعتقد أنّ موضوع الضمان هنا ليس مجرّد عنوان «اليد العادية»، بل الموضوع أمر مركّب هو «اليد مع عدم الرضا من المالك».
ولتوضيح المطلب، يجب أن نضع المثال الذي طرحه السيّد الخوئي(قدسسره) نفسه أساساً. ففي مثاله، يدّعي المالك أنّ المتصرّف قد أخذ المال من دون إذنه. وفي هذا السيناريو، نُحرز كلا جزئي موضوع الضمان المركّب بسهولة:
• الجزء الأوّل (اليد): هذا الجزء مُحرَز بالعلم الوجداني. أي لا شكّ في أنّ المال كان في تصرّف الشخص الثاني.
• الجزء الثاني (عدم الرضا): هذا الجزء يثبت بالأصل العملي. لأنّنا نشكّ فيما إذا كان المالك، الذي لم يكن راضياً بهذا التصرّف سابقاً، قد رضي به لاحقاً أم لا. فالحالة السابقة هي عدم الإذن وعدم الرضا. لذا يجري «استصحاب عدم الرضا» بسهولة. فعندما يثبت كلا جزئي الموضوع (أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل)، يتحقّق موضوع الضمان بالكامل و«فيُحكم بالضمان». بناءً عليه، فلو أخذ أحد مالك وادّعى لاحقاً أنّك أعطيته إيّاه أمانة، ولكنّك رددت هذا الادّعاء، فبناءً على هذا المبنى، يُقدَّم قولك ويكون هو ضامناً، لأنّ الأصل هو عدم إذنك، وعليه أن يثبت إذنك.
عدم قبول الضمان في المثال الثاني (ضمان المعاوضة) ونقد الوجوه الأربعة
تتجلّى النقطة الرئيسيّة في نظريّة السيّد الخوئي(قدسسره) التفصيليّة هنا. فهو يعتقد أنّ الاستدلال الذي كان يجدي نفعاً بسهولة في المثال الأوّل، «لا يتمّ في المثال الثاني». ولماذا؟ ففي المثال الثاني، كان النزاع حول البيع أو الهبة. وهنا لم يعد بالإمكان التمسّك بـ«استصحاب عدم الرضا». والعلّة في ذلك هي أنّ «الرضا فيه محقَّق إجمالاً». أي إنّ لدينا علماً إجماليّاً بأنّ المالك قد رضي بنحو من الأنحاء بخروج المال عن ملكه؛ إمّا أنّه رضي في ضمن عقد البيع وإمّا في ضمن عقد الهبة. وعندما يكون الرضا مُحرَزاً بصورة إجماليّة، لم يعد هناك مجال لجريان أصل عدم الرضا.
والآن بعد أن سُدّ الطريق الرئيسي، فهل يمكن إثبات الضمان بطرق أخرى؟ يبحث السيّد الخوئي(قدسسره) الوجوه الأخرى ويردّها واحداً تلو الآخر:
١. التمسّك بـ«أصالة عدم الهبة» لإثبات البيع: هل يمكننا القول إنّ الأصل هو عدم وجود هبة، فنستنتج إذن أنّ المعاملة كانت بيعاً؟ كلّا. أوّلاً، الضمان لا يترتّب مباشرةً على «عدم الهبة»، بل يترتّب على «وجود البيع»، وأصل عدم الهبة لا يثبت وجود البيع (أصل مثبت). وثانياً، حتّى لو اعتبرنا الأصل المثبت حجّة، فإنّ لهذا الأصل معارضاً. فكما يجري «أصالة عدم الهبة»، يجري «أصالة عدم البيع» أيضاً، لأنّ كلا العقدين مسبوق بالعدم. فهذان الأصلان يتعارضان ويتساقطان.
٢. التمسّك بـ«قاعدة المقتضي والمانع»: هل يمكننا القول إنّ اليد مقتضٍ للضمان والرضا مانع والأصل هو عدم المانع؟ يرفض السيّد الخوئي(قدسسره) هذا الطريق أيضاً بقطعيّة ويقول: «فهي ممّا لا أساس له». فهو يرى هذه القاعدة أساساً بلا مبنى وغير قابلة للاستناد.
٣. التمسّك بـ«العامّ في الشبهة المصداقيّة»: هل يمكن التمسّك بعموم «على اليد»؟ يبطل هذا الطريق أيضاً ويقول: «ممّا لا وجه له على ما حُقّق في محلّه». فكما حُقّق في محلّه (بحث العامّ والخاصّ)، فإنّ التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة غير صحيح.
الاستنتاج في المثال الثاني: الرجوع إلى الأصل العملي
عندما تُسدّ جميع الطرق الاستدلاليّة لإثبات الضمان في المثال الثاني، لا يبقى خيار إلّا الرجوع إلى الأصل العملي. «فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مورد بلحاظ نفسه، وهو في المقام أصالة عدم الضمان». فنحن نشكّ فيما إذا كانت ذمّة الشخص الثاني قد اشتغلت بدفع الثمن أم لا. فالحالة السابقة هي براءة الذمّة وعدم ضمانه. لذا يجري أصل عدم الضمان، وفي هذا المورد الخاصّ، يُقبل قول الشخص الثاني (الذي يدّعي الهبة).
وجود نصّ خاصّ واستثناء من القاعدة
يشير المرحوم السيّد الخوئي(قدسسره) في نهاية هذا البحث إلى نكتة مهمّة جدّاً. فيقول إنّ جميع هذه التحليلات والرجوع إلى أصل عدم الضمان هو في حالة «لم يكن نصّ بالخصوص». فلو وجد في مورد ما نصّ ورواية خاصّة، لما وصلت النوبة إلى الأصول العمليّة ووجب العمل طبقاً للنصّ. ويشير كمثال إلى مسألة «اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن» التي تشبه بحثنا كثيراً. فلو قال البائع إنّه باع السلعة بعشرة دنانير وقال المشتري إنّه اشتراها بخمسة دنانير، فهنا يوجد نصّ خاصّ. فالرواية الصحيحة التي نقلها المشايخ الثلاثة (الكليني، والصدوق[5] ، والطوسي(قدسسرهما)[6] [7] ) قد حدّدت حكم المسألة.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسلام) فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأقَلِّ مَا قَالَ الْبَائِعُ، قَالَ(علیهالسلام): «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِه»[8] .
يقول الإمام الصادق(علیهالسلام): «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ». أي لو كانت نفس السلعة موجودة، لَقُبل قول البائع مع يمينه، ولكنّ مفهومه المخالف هو أنّه لو تلفت السلعة، لَقُدِّم قول المشتري مع يمينه. وهذه الرواية، التي سندها تامّ ومعتبر بنظره أيضاً، تقدّم حلّاً تعبّديّاً وخاصّاً يُقدَّم على جميع تلك التحليلات الأصوليّة.
جمع الأستاذ الدقيق وتحليله النهائي للمثالين
يلزم هنا جمع دقيق. فيجب الالتفات إلى أنّ قبول الضمان في المثال الأوّل يعتمد على كيفيّة تقرير المثال.
• طبقاً لتقرير السيّد الخوئي(قدسسره) نفسه: حيث يدّعي المالك «التصرّف من دون إذن»، فإنّ تحليله صحيح تماماً والقول بالضمان (نفس فتوى السيّد النائيني(قدسسره)) صحيح. لأنّ اليد مُحرَزة بالوجدان وعدم الإذن ثابت بالأصل.
• طبقاً لتقرير السيّد النائيني(قدسسره) نفسه: حيث يدّعي المالك «الإجارة» ويدّعي المتصرّف «العارية»، يبدو هنا تحليل السيّد الخوئي(قدسسره) (أي عدم الضمان) أصحّ! لأنّه في هذه الحالة أيضاً كالمثال الثاني، رضا المالك الإجمالي مُحرَز؛ فسواء كان في ضمن الإجارة أم في ضمن العارية، فقد رضي المالك بأصل التصرّف. إذن، لم يعد بالإمكان إجراء «استصحاب عدم الرضا» ويجب الرجوع إلى أصل عدم الضمان. بناءً عليه، يمكن القول باختصار: إنّ فتوى السيّد النائيني(قدسسره) (الضمان) صحيحة بناءً على تقرير السيّد الخوئي(قدسسره) للمثال، وفتوى السيّد الخوئي(قدسسره) (عدم الضمان) تبدو أصحّ بناءً على تقرير السيّد النائيني(قدسسره) نفسه للمثال!
الاستنتاج النهائي للتنبيه السابع وجمع المباحث
بإتمام هذا الفرع، ينتهي بحثنا في التنبيه السابع. والآن حان الوقت لتقديم جمع كلّيّ لجميع المباحث المطروحة في هذا التنبيه المهمّ:
١. حجّيّة مثبتات الأمارات والأصول: النتيجة الرئيسيّة والنهائيّة لهذا التنبيه هي أنّ «مثبتات الأمارات حجّة أمّا مثبتات الأصول العمليّة فليست بحجّة».
٢. الاستثناءات من عدم حجّيّة مثبتات الاستصحاب: طُرحت من هذه القاعدة الكلّيّة ثلاثة موارد استثناء:
• المورد الأوّل: خفاء الواسطة: الذي أشكلنا فيه وقلنا إنّ الأصل المثبت ليس بحجّة حتّى في هذا المورد.
• المورد الثاني: الواسطة الجليّة مع الملازمة العرفيّة: حيث يرى العرف التعبّد بالملزوم مساوقاً للتعبّد باللازم.
• المورد الثالث: الواسطة الجليّة مع الوحدة الأثريّة العرفيّة: حيث يرى العرف أثر اللازم هو نفس أثر الملزوم.
• نظريّتنا النهائيّة: التحقيق النهائي هو أنّ الأصل المثبت حجّة في الموردين الأخيرين (المورد الثاني والثالث).
٣. مبنى حجّيّة الأمارات والأصول: في النهاية، بُيّن القول الحقّ في مبنى الحجّيّة أيضاً:
حجّيّة خبر الواحد: الحجّيّة في باب خبر الواحد لها معنى جامع يشمل كلاً من «تتميم الكشف» و«جعل حكم مماثل»، لأنّ الأدلّة المختلفة تشير كلّ منها إلى أحد هذين المعنيين. وضمن ذلك، فإنّ السيرة العقلائيّة أيضاً تعتبر الحجّيّة بمعنى التنجيز والتعذير.
حجّيّة الاستصحاب: أمّا الحجّيّة في باب الاستصحاب، فهي بمجرّد معنى «جعل حكم مماثل» بيّنه الشارع بلسان «إبقاء الكاشف التامّ» (أي اليقين). وهذه الخلاصة هي عصارة جميع المباحث الفنّيّة والدقيقة التي طُرحت في التنبيه السابع حول الأصل المثبت وآثاره واستثناءاته.[9]
التنبیه الثامن: الواسطة التي هي عین المستصحب و تعمیم المستصحب وجوداً و عدماً
(فیه مطلبان)
المطلب الأوّل: الواسطة التي هي عین المستصحب
المطلب الثاني: تعمیم المستصحب وجوداً و عدماً
الواسطة التي هي عین المستصحب و تعمیم المستصحب وجوداً و عدماً
بعد أن بحثنا بالتفصيل في التنبيه السابع حول «الأصل المثبت» وموارد الاستثناء من عدم حجّيّته، ندخل الآن في التنبيه الثامن. ولهذا التنبيه فرق بنيويّ مع التنبيه السابق. ففي التنبيه السابع، كنّا نبحث موارد نقبل فيها بأنّ الاستصحاب يثبت لازماً وأثراً خارجيّاً (أي واسطة)، ولكنّ البحث كان يدور حول ما إذا كان هذا الإثبات وهذا النوع من «الأصل المثبت» حجّة في موارد خاصّة أم لا.
أمّا في التنبيه الثامن، فيريد المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) أن يرجع خطوة إلى الوراء ويقول إنّه توجد أساساً موارد تظنّون خطأً أنّ الاستصحاب فيها «مثبت»[10] ، ويثبت لازماً خارجيّاً، والحال أنّ ما تتوهّمونه «واسطة» أو «لازماً» ليس في الحقيقة إلّا «عين المستصحَب».
بناءً عليه، فهذا التنبيه بصدد دفع توهّم؛ توهّم من يظنّون أنّ الاستصحاب في هذه الموارد الخاصّة هو من نوع الأصل المثبت. وفي الحقيقة، يشير هذا التنبيه إلى موارد تقع في مقابل الأصل المثبت وليست من مصاديقه أساساً حتى نريد أن نبحثها من المستثنيات.
ويشمل هذا التنبيه مطلبين أساسيّين:
• المطلب الأوّل: تبيين الموارد التي تكون فيها «الواسطة» هي عين المستصحَب.
• المطلب الثاني: بحث وتعميم المستصحَب من حيث كونه وجوديّاً أو عدميّاً. وننتقل الآن إلى تبيين المطلب الأوّل.
المطلب الأوّل: الواسطة التي هي عین المستصحب
للدخول في هذا البحث العميق، نحتاج إلى مقدّمة منطقيّة مهمّة وتطبيقيّة جدّاً يكون فهمها مفتاح حلّ لكثير من المسائل الأخرى في علم الأصول أيضاً. وتتناول هذه المقدّمة تحليل الأقسام الثلاثة لـ«المحمولات».
مقدّمة منطقیة: المحمولات علی أقسام ثلاثة
كلّ محمول يُحمل على موضوع لا يخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثة:
القسم الأوّل: المحمول الذاتي (ذاتيّ باب إيساغوجي)
يشمل هذا القسم المحمولات التي هي عين ذات وحقيقة الموضوع وتُعدّ مقوِّمة له؛ أي جنس وفصل الموضوع. فعندما نقول «الإنسان حيوانٌ ناطقٌ»، يكون المحمولان «حيوان» و«ناطق» هما الأجزاء المكوِّنة لماهيّة الإنسان. وهذا هو نفس المحمول الذي يُسمّى في المنطق بـ«ذاتيّ باب إيساغوجي» أو «ذاتيّ باب الكلّيّات الخمس».
القسم الثاني: المحمول المنتزَع من حاقّ الذات (بلا ضميمة)
هذا القسم، الذي ينقسم هو نفسه إلى شعبتين، هو أهمّ جزء في مقدّمتنا. فهنا، المحمول هو عنوان يُنتزَع مباشرةً من داخل و«حاقّ ذات» الموضوع، من دون الحاجة إلى ضمّ أمر خارجيّ إلى الذات. وبعبارة أخرى، تكفي نفس الذات لانتزاع هذا العنوان.
الشعبة الأولى: المنتزَع الذاتي (ذاتيّ باب البرهان):
في هذه الحالة، لا يكون العنوان المنتزَع من حاقّ الذات فقط، بل يُعدّ أمراً ذاتيّاً وغير منفصل عن تلك الذات أيضاً. وأفضل مثال لهذا المورد هو عنوان «الإمكان» للماهيّات. فعندما نقول «الإنسان ممكنٌ»، فصفة «ممكن» المشتقّة من «الإمكان»، من أين أتت؟ لقد أدرك المناطقة، بتحليل ذات وماهيّة الإنسان (الحيوان الناطق)، أنّ هذه الماهيّة لها حالة تساوي بالنسبة للوجود والعدم؛ أي إنّها ذاتاً لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. وهذه الحالة من التساوي هي نفس «الإمكان» الذي انتُزع من عمق وصميم ذات الإنسان وهو أمر ذاتيّ ولا ينفكّ عنها. ومثال آخر هو عنوان «الأربعة زوجٌ». فالزوجيّة تُنتزَع من نفس ذات عدد أربعة، من دون حاجة إلى أيّ ضميمة. وتُسمّى هذه الأنواع من المحمولات، التي هي من لوازم الماهيّة الذاتيّة، بـ«ذاتيّ باب البرهان».
نكتة تكميليّة: «ذاتيّ باب البرهان» أعمّ من «ذاتيّ باب إيساغوجي». فكلّ ذاتيّ باب إيساغوجي (كالناطقيّة للإنسان) هو ذاتيّ باب البرهان أيضاً، ولكن ليس كلّ ذاتيّ باب البرهان (كالإمكان للإنسان) هو بالضرورة ذاتيّ باب إيساغوجي.
الشعبة الثانية: المنتزَع العرضي (خارج المحمول من صميمه):
في هذه الحالة أيضاً، يُنتزَع العنوان من حاقّ الذات ومن دون أيّ ضميمة، ولكنّ هذا العنوان هو أمر «عرضيّ» للذات، لا ذاتيّ. وأفضل مثال لهذا المورد هو «الوجود» و«الوحدة» و«التشخّص». فعندما توجد ماهيّة الإنسان، يُنتزَع عنوان «موجود» من صميم هذه الماهيّة الموجودة نفسها، ولكنّ «الوجود» ليس عين الماهيّة، بل هو أمر خارج عنها وعارض عليها. ولهذا السبب يُسمّى بـ«خارج المحمول»؛ أي المحمول الذي هو خارج عن الذات، ولكن «من صميمه» أي انتُزع من صميم وداخل نفس الذات، لا من أمر خارجيّ مُنضمّ.
القسم الثالث: المحمول بالضميمة
يقع هذا القسم في مقابل القسم الثاني. فهنا، المحمول هو عنوان لا يُنتزَع من نفس الذات بمفردها، بل يُحمل عليها باعتبار انضمام أمر خارجيّ إلى الذات. فعندما نقول «الجسمُ أسودٌ»، لم تُنتزَع صفة «أسود» من نفس ذات الجسم، بل نُسبت إليه باعتبار ضمّ عرض «السواد» (السواد) إلى الجسم. والعناوين كالكاتب، والقائم، والضارب، وجميع الأعراض الخارجيّة الأخرى هي من هذا القبيل.
نظريّة صاحب الكفاية(قدسسره)
والآن، بالنظر إلى هذه المقدّمة الدقيقة، نعود إلى نظريّة صاحب الكفاية(قدسسره) الأصليّة. فهو يقول: إنّ جميع المحمولات التي هي من القسم الأوّل (ذاتيّ باب إيساغوجي) والقسم الثاني (المنتزَع من حاقّ الذات، سواء كان ذاتيّاً أم عرضيّاً) «تُعدّ عين الشيء»؛ أي تُعتبر عين الموضوع والمستصحَب وليست أمراً مغايراً ولازماً خارجيّاً حتى يُعتبر استصحابها أصلاً مثبتاً. وبعبارة أخرى، فعندما نستصحب مثلاً «حياة» زيد ثم نحكم بأنّ «زيدٌ حيٌّ»، فإنّ عنوان «حيّ» المنتزَع من حاقّ ذات «الحياة» (القسم الثاني) هو عين تلك الحياة نفسها، لا لازم خارجيّ.
أمّا محمولات القسم الثالث، أي المحمولات بالضميمة، فهي مستثناة من هذه القاعدة. ففي هذه الموارد، يكون المحمول واقعاً أمراً مغايراً للموضوع نُسب إليه بواسطة أمر خارجيّ. وعليه، فلو أردنا أن نثبت باستصحاب شيء ما محمولاً يُنتزَع منه على نحو «بالضميمة»، لكان استصحابنا هنا «أصلاً مثبتاً».
بناءً عليه، فإنّ المرحوم الآخوند(قدسسره)، بهذا التحليل المنطقي الدقيق، يضيّق بشدّة دائرة الموارد التي قد تُظنّ خطأً أنّها أصل مثبت، ويبيّن أنّه في كثير من الموارد، لا توجد واسطة، وأنّ ما نتوهّمه واسطة ليس إلّا «عين المستصحَب» بعنوان انتزاعيّ آخر.[11] [12]


