1403/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
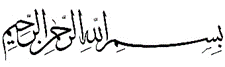
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت
ملاحظه دوم
پس از آنکه در جلسه گذشته، ملاحظه اول را بر مناقشه محقق اصفهانی(قدسسره) در باب متضایفین به تفصیل بیان کردیم، اکنون به ملاحظه دوم میپردازیم. این ملاحظه، مستقیماً ناظر به بخش دوم نقد ایشان، یعنی تحلیلشان از مثال «علت و معلول» است. ما در این ملاحظه، قصد داریم نشان دهیم که نقد محقق اصفهانی(قدسسره) بر قسم دوم (علت ناقصه)، ناشی از عدم تفکیک میان دو فرض بسیار مهم است و اگر این تفکیک صورت گیرد، مشخص میشود که کلام صاحب کفایه(قدسسره) کاملاً صحیح و نقد محقق اصفهانی(قدسسره)، ناظر به فرضی است که اساساً مورد ادعای صاحب کفایه(قدسسره) نبوده است.
گام اول: بازخوانی نقد و نقطه توافق در باب علت تامه
برای ورود به بحث، لازم است ابتدا نقد مرحوم اصفهانی(قدسسره) را در این بخش به طور خلاصه یادآوری کنیم. ایشان فرمودند اگر مراد از علت، علت تامه است، از محل بحث خارج است؛ چون اگر شما به علت تامه یقین داشته باشید، حتماً به معلول آن نیز یقین دارید. «چرا علت را استصحاب میکنید بعد بگویید معلول برای من تعبّداً ثابت شد؟! خود معلول را استصحاب کنید». ما با این بخش از فرمایش ایشان کاملاً موافقیم. اینکه «یقین به علت تامه بلایقین به معلول آن، امکان ندارد»، یک سخن تام، متین و غیرقابل مناقشه است. وجود علت تامه، عقلاً و واقعاً از وجود معلولش انفکاکناپذیر است و به تبع، یقین به یکی نیز ملازم با یقین به دیگری است. در این مورد، حرفی نیست و نقطه توافق ما با ایشان است.
گام دوم: کانون اصلی بحث؛ تحلیل دقیق فرض علت ناقصه
تمام بحث و نزاع، در فرض علت ناقصه است. سناریویی که محل بحث ماست، و توسط صاحب کفایه(قدسسره) مد نظر بوده، این است که علت تامه برای یک پدیده، از دو جزء (یا بیشتر) تشکیل شده است. ما نسبت به یک جزء آن (جزء الف) حالت سابقه یقینی داریم، اما نسبت به جزء دیگر (جزء ب)، چنین حالتی نداریم، بلکه وجود آن را در زمان شک، با علم وجدانی و قطعی احراز کردهایم. مثال بسیار روشن آن، همان «استصحاب عدم حاجب» در وضو یا غسل است که محقق اصفهانی(قدسسره) خودشان آن را تقریر کرده و سپس رد میکنند:
• جزء «الف» (که دارای حالت سابقه است و استصحاب میشود): «عدم وجود مانع یا حاجب» بر روی عضو وضو.
• جزء «ب» (که با علم وجدانی محرز است): «ریختن آب» (صبّ الماء) بر روی همان عضو.
• معلول (که میخواهیم آن را ثابت کنیم): «رسیدن آب به پوست» (تحقق غَسل) و در نتیجه، اثر شرعی آن یعنی «رفع حدث».
در اینجا محقق اصفهانی(قدسسره) فرمودند ما تعبدی به معلول (رفع حدث) نداریم و این یک اصل مثبت باطل است. اما پاسخ دقیق ما این است: «العرف یری التعبّد بالجزء المستصحب من أجزاء العلّة التامّة عین التعبّد بالمعلول في تلك الحالة التي أحرز الجزء الآخر بالوجدان». به زبان ساده، نگاه عرفی و عقلائی، یک نگاه ترکیبی و کلنگر است. عرف، وقتی میبیند که یک جزء از علت با استصحاب ثابت شده و جزء دیگر هم بالوجدان و به طور قطعی موجود است، این ترکیب را به منزله تحقق تعبّدی علت تامه میبیند. در واقع، آن جزء مستصحب (عدم مانع)، «الجزء الأخیر من العلّة التامّة» است؛ یعنی آخرین قطعه از پازل علت تامه است که با احراز آن (هرچند با یک اصل تعبدی)، پازل کامل میشود. و وقتی علت تامه، به هر نحوی (چه وجدانی و چه تعبدی) کامل شد، عرف دیگر میان آن و معلولش جدایی نمیبیند و تعبد به وجود معلول را نتیجه قطعی آن میداند. «پس این علت تامه محقق شد و معلول آن هم محقق میشود».
گام سوم: پاسخ به اشکال اصلی و تعیین محل نزاع
حال به اشکال اصلی محقق اصفهانی(قدسسره) بازگردیم که فرمودند: «لا ملازمة بین التعبّد بالعلّة الناقصة و التعبّد بالمعلول عرفاً». پاسخ ما این است: این عدم ملازمه، مربوط به جایی است که «جزء دیگر بالوجدان احراز نشده باشد». بله، اگر ما فقط استصحاب عدم مانع کنیم، اما ندانیم آبی ریخته شده یا نه، قطعاً این استصحاب به تنهایی رسیدن آب به پوست را ثابت نمیکند. سخن شما در این فرض کاملاً صحیح است، اما این فرض، «خارج عن المبحوث عنه» است. محل بحث ما و ادعای صاحب کفایه(قدسسره)، دقیقاً در فرض اول است، یعنی جایی که جزء دیگر بالوجدان محرز است. مناقشه شما فرض دوم را هدف گرفته که از محل نزاع ما خارج است.
گام چهارم: چرا نمیتوانیم خود معلول را مستقیماً استصحاب کنیم؟
ممکن است همان اشکال سابق دوباره تکرار شود که بسیار خوب، اگر علت تامه تعبداً محقق شد، چرا خود معلول (رسیدن آب به پوست) را مستقیماً استصحاب نمیکنیم؟ پاسخ این است که معلول در اینجا، فاقد حالت سابقه است. علت تامهای که الان با ترکیب «استصحاب عدم مانع» و «علم وجدانی به ریختن آب» درست شد، یک امر آنی، جدید و حادث است. قبل از ریختن آب، معلول (یعنی رسیدن آب به پوست) اصلاً وجود نداشته است که بخواهیم بقای آن را استصحاب کنیم. «این جزء علت سابقه نداشت لذا استصحاب فقط در طرف علت جاری میشود در طرف معلول نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم». بنابراین، تنها راه ممکن، جریان استصحاب در همان جزء علت ناقصه (عدم مانع) است که دارای حالت سابقه بوده است. وقتی آن را استصحاب کردیم، «چون نازل منزله علت تامه شد پس در نتیجه در لازم و معلول آن هم حجت خواهد بود».
نتیجهگیری از ملاحظه دوم و ارتباط آن با موارد استثناء:
بنابراین، ما با ترکیب استصحاب یک جزء و احراز وجدانی جزء دیگر، به صورت تعبّدی علت تامه را احراز کردهایم. از آنجا که این علت تامه تعبّدی، خود امری حادث است، نمیتوانیم معلول آن را مستقیماً استصحاب کنیم. اما به دلیل ملازمه شدید و غیرقابل انکار عرفی، تعبد به این علت تامه ترکیبی، عیناً تعبد به معلول آن است و این مصداق بارز مورد دوم از کلام صاحب کفایه(قدسسره) (ملازمه در تعبد) است.
و همچنین، این مورد، مصداق مورد سوم ایشان (وحدت در اثر) نیز میباشد. یعنی «اثر المعلول قد یُعدّ أثراً للعلّة الناقصة التي أحرزت بالأصل». به دلیل شدت ارتباط میان علت و معلول، عرف در اینجا اثر معلول (مثلاً رفع حدث) را عیناً اثر همان علت ترکیبی میبیند که یک جزء آن با استصحاب ثابت شده است. گاهی شدت این ارتباط به حدی است که عرف، اثر را به علّة العلة (علتِ علت) نسبت میدهد؛ مثلاً در عرف عام، وقتی شاه دستور اعدام فردی را میدهد، میگویند «شاه او را کشت»، نه جلادی که مباشر قتل بوده است. در اینجا نیز عرف، اثر (رفع حدث) را به همان ترکیب علتساز نسبت میدهد و آن را حجت میداند.
ملاحظه سوم:
پس از آنکه در ملاحظه دوم، نشان دادیم که میتوان در فرض خاص علت ناقصه (یعنی جایی که جزء دیگر علت بالوجدان محرز است)، برای کلام صاحب کفایه(قدسسره) مصداق پیدا کرد، اکنون به آخرین و شاید مهمترین بخش از نقد محقق اصفهانی و شاگرد ایشان، محقق خویی(قدسسرهما)، میرسیم. این بخش، که به عنوان یک اشکال بنیانکن مطرح شده، این است که اگر ما حجیت اصل مثبت را در باب علت ناقصه بپذیریم، این امر مستلزم حجیت تمام اصول مثبته خواهد شد و این یعنی از بین رفتن یک قاعده مسلم اصولی و لزوم «تخصیص اکثر» که امری قبیح و غیرعقلائی است.
ما در این ملاحظه سوم، قصد داریم نشان دهیم که این اشکال بزرگ نیز ناشی از یک خلط مفهومی میان «ملازمه عقلیه» و «ملازمه عرفیه» است و با تفکیک این دو، مشخص میشود که چنین مفسدهای هرگز لازم نخواهد آمد.
گام اول: صورتبندی اشکال محقق خویی(قدسسره)
اشکال ایشان، که یک استدلال منطقی به نظر میرسد، به این صورت قابل تقریر است:
1. مقدمه اول (ملازمه از معلول به علت): شما میگویید تعبد به معلول، مستلزم تعبد به علت ناقصهاش است (چون ملازمه طرفینی است).
2. مقدمه دوم (ملازمه از علت به معالیل دیگر): تعبد به یک علت ناقصه نیز مستلزم تعبد به تمام لوازم و معالیل دیگر آن علت است.
پس، تعبد به یک لازم (یک معلول)، مستلزم تعبد به تمام لوازم و معالیل همعرض آن خواهد بود. و اگر این باب باز شود، دیگر هیچ اصل مثبتی غیرحجت باقی نمیماند.
گام دوم: پاسخ اصلی و تفکیک میان حیطه عقل و عرف
پاسخ ما به این اشکال بزرگ، یک پاسخ قاطع و روشن است: «ما قاله المحقّق الخوئي(قدسسره)… ممنوع». این استدلال شما ممنوع است؛ زیرا شالوده و اساس استدلال شما بر یک پیشفرض اشتباه بنا شده است. «شما همه لازمهها را لازمه عقلی در نظر میگیرید» در حالی که تمام بحث ما و مبنای صاحب کفایه(قدسسره)، بر پایه ملازمه عرفیه استوار است.
«و الجواب عن ذلك یظهر بالتفاوت بین الملازمة العرفیة و الملازمة العقلیة». آنچه مرحوم آقای خویی به تبع استادشان(قدسسرهما) فرمودهاند، مبتنی بر یک نگاه دقیق و تحلیلی عقلی است. بله، از دیدگاه یک فیلسوف یا یک منطقی که در اتاق خود نشسته و با براهین عقلی سروکار دارد، وجود یک علت، مستلزم وجود تمام معالیل آن است و علم به علت، علم به تمام معالیل را به دنبال دارد. این «الملازمة العقلیة» است.
اما بحث ما در اینجا، یک بحث فلسفی محض نیست. بحث ما، در فهم عرف از ادله شرعی است. آیا وقتی شارع میگوید به یک چیزی (مستصحب) تعبداً پایبند باش، عرف از این کلام، یک سلسله استنتاجات پیچیده عقلی را نتیجه میگیرد؟ قطعاً خیر. حیطه درک و فهم عرف، محدودتر و در عین حال، بسیار ملموستر است.
افق دید عرف، محدود و متمرکز است: «عرف زمانی تعبّد به لازم را تعبّد به ملزوم میداند که لازم و ملزوم به هم متصل باشند». وقتی عرف، با استصحاب، متعبد به «عدم وجود مانع» میشود و با وجدانش «ریختن آب» را میبیند، یک رابطه مستقیم، نزدیک و فوری را میان این دو و «رسیدن آب به پوست» درک میکند. «حواس عرف به لوازم دیگر نیست، به بقیه لوازم اصلا توجهی ندارد». ذهن عرف، پس از اثبات این معلول، به دنبال این نمیرود که «خب، حالا که این علت (ترکیب عدم مانع و ریختن آب) محقق شد، پس چه لوازم عقلی دیگری بر آن مترتب است؟» این کار، کار فیلسوف است، نه کار عرف بازاری و عادی.
به بیان دیگر، «عرف از تعبّد شرعی به همین مقدار از تعبّد اکتفاء میکند» و هر چیزی فراتر از این رابطه مستقیم، خارج از حیطه درک عرف است. عرف از معلول (اثر) به علت قریب و مستقیم آن پی میبرد (دلیل إنّی)، اما از آن علت، به تمام معالیل دیگرش پل نمیزند. این سلسله مراتب و شبکههای علی و معلولی، از افق دید او خارج است.
گام سوم: افزودن یک نکته تکمیلی
حتی میتوان پا را فراتر گذاشت و گفت: «بلکه گاهی وقتها تعبّد به علت ناقصه تعبّد به معلول آن نیست حتی در فرضی که احراز سایر اجزاء علت تامه را بالوجدان کرده باشیم». زمانی که خود علیت میان آن دو، یک امر پیچیده و تخصصی باشد و «عرف علّیت بین لازم و ملزوم را درک نکند و علّیت بعید از اذهان عرف باشد». این نکته به خوبی نشان میدهد که ملاک نهایی و محور اصلی بحث، درک و فهم عرف است، نه صرف وجود یک ملازمه عقلی در عالم واقع.
نتیجه نهایی بحث
با توجه به تمام ملاحظات سهگانهای که مطرح شد، به این نتیجه روشن میرسیم:
1. مورد اول (خفاء واسطه شیخ انصاری(قدسسره)): ما این مورد را به همان بیانی که مرحوم نائینی و خویی(قدسسرهما) فرمودند، قبول نداریم. تغییر دادن موضوع حکم شرعی به بهانه خفاء واسطه، امری غیرقابل پذیرش است. البته گفتیم برخی از مثالهای این مورد، در واقع مصداق واسطه جلیه هستند و میتوانند تحت دو مورد بعدی قرار گیرند.
2. مورد دوم و سوم (مبانی صاحب کفایه(قدسسره)): ما معتقدیم این دو مبنا، یعنی «التعبّد باللازم عند التعبّد بالملزوم للملازمة العرفیة بینهما» (مورد دوم) و «التعبّد بآثار اللازم فیما إذا عدّ آثارها من آثار الملزوم عرفاً» (مورد سوم)، کاملاً «صحیح و تامّ و لانقاش فیه» هستند.
پس ما ایرادات محقق اصفهانی و محقق خویی(قدسسرهما) را بر این دو مورد وارد ندانسته و به حجیت اصل مثبت در این دو مورد خاص، ملتزم میشویم.[1]
مطلب چهارم: فروعی که قدماء در آن به اصل مثبت تمسک کردهاند
پس از آنکه در سه مطلب گذشته، جوانب مختلف نظریه اصل مثبت، استثنائات آن و مناقشات وارد بر آن را به تفصیل بررسی کردیم، اکنون به سراغ مطلب چهارم میرویم که جنبهای کاربردی و تاریخی دارد. در این مطلب، به بررسی فروعات و مسائلی میپردازیم که در آثار فقهای متقدم (قدماء اصحاب)، به استصحابهایی تمسک شده است که در نگاه ما، مصداق بارز اصل مثبتِ غیرحجت هستند. این بررسی به ما کمک میکند تا بفهمیم که چرا و با چه مبنایی، این بزرگان به چنین استصحابهایی فتوا دادهاند.
مقدمه: تبیین وجوه احتمالی برای تمسک قدما به اصل مثبت
قبل از ورود به خود فروع، باید این سؤال اساسی را پاسخ دهیم که چرا فقهای بزرگی همچون شیخ طوسی(قدسسره) در مبسوط، به استصحابهایی تمسک کردهاند که لازمهاش حجیت اصل مثبت است؟ سه وجه و احتمال اصلی برای این امر قابل تصور است:
1. التزام به حجیت مطلق اصل مثبت: اولین و سادهترین احتمال این است که این بزرگان، اساساً قاعده «عدم حجیت اصل مثبت» را قبول نداشته و به طور کلی، هرگونه استصحابی را، چه با واسطه و چه بیواسطه، حجت میدانستهاند.
2. اماره دانستن استصحاب: احتمال دوم، که دقیقتر و محتملتر به نظر میرسد، این است که ایشان، استصحاب را یک اصل عملی صرف نمیدانستهاند، بلکه آن را نوعی اماره ظنیه به حساب میآوردهاند. مبنای این دیدگاه آن است که دلیل حجیت استصحاب (اخبار لاتنقض…)، از باب افاده ظن نوعی به بقاء حالت سابقه است و شارع این طریق ظنی را، همانند سایر امارات (مثل خبر واحد)، حجت کرده است. و همانطور که میدانیم، مثبتات امارات (لوازم عقلی و عادی خبر واحد) حجت هستند. پس اگر استصحاب را هم اماره بدانیم، مثبتات آن نیز حجت خواهد بود.
3. اشتباه در تطبیق: احتمال سوم این است که این بزرگان، در مقام تطبیق کبری بر صغرا، دچار نوعی مسامحه یا عدم التفات به واسطه شدهاند. یعنی به دلیل شدت اتصال میان لازم و ملزوم، «تخیّلوا أنّ الحكم الشرعي هو مترتّب على المستصحب، لا على لازمه»؛ گمان کردهاند که اثر شرعی، مستقیماً بر خود مستصحب بار میشود، در حالی که در واقع، اثر بر لازمه عقلی یا عادی آن مترتب بوده است و از وجود واسطه غفلت کردهاند.
بررسی فروع پنجگانه
اکنون با در نظر داشتن این سه احتمال، به سراغ فروعی میرویم که در کتب قدما به اصل مثبت در آنها تمسک شده است. سه فرع اول، دقیقاً همان مثالهایی هستند که مرحوم شیخ انصاری(قدسسره) در بحث استثنائات مطرح کردند و ما نیز پیش از این به تفصیل آنها را بررسی نمودهایم، لذا به صورت مختصر از آنها عبور میکنیم:
فرع اول: استصحاب رطوبت
استصحاب بقاء رطوبت در یک شیء، برای اثبات سرایت نجاست به شیء دیگری که با آن ملاقات کرده است. در اینجا «سرایت» واسطه و لازمه عادی «رطوبت» است.
فرع دوم: استصحاب عدم دخول شوال:
استصحاب بقاء ماه رمضان، برای اثبات اینکه فردا، روز آخر ماه رمضان نیست، بلکه اول شوال و روز عید است. در اینجا «عید بودن فردا» واسطه و لازمه عقلی «تمام شدن ماه رمضان» است.
فرع سوم: استصحاب عدم حاجب:
استصحاب عدم وجود مانع بر پوست، برای اثبات وصول آب به بشره (تحقق غَسل) و در نتیجه، حکم به صحت وضو یا غسل. در اینجا «وصول آب» واسطه و لازمه «عدم حاجب» است.
این سه فرع، همانطور که گذشت، به طور کامل تحلیل شدند. اما اکنون به سراغ فرع چهارم میرویم که شامل دو مثال جدید و بسیار جالب از کتب فقهی قدماست.
فرع چهارم: استصحاب عدم سرایت و استصحاب حیات
مرحوم شیخ انصاری(قدسسره)، از کتب معتبری همچون شرایع[2] ، تحریر[3] و به تبعیت از آنها، از کتاب مبسوط شیخ طوسی(قدسسره)[4] ، دو مثال را در باب جنایات نقل میکنند که هر دو، مصداق روشنی از تمسک به اصل مثبت هستند:
مورد اول: نزاع بر سر علت مرگ (استصحاب عدم سرایت)
«لو ادّعی الجاني أنّ المجنيّ علیه شرب سمّاً فمات بالسمّ، و ادّعی الوليّ أنّه مات بالسرایة [أي بسرایة الجراحة، فالسبب لموته الجراحة التي أوردها الجاني علیه] فالاحتمالان فیه سواء»[5] .
شخصی (جانی)، فرد دیگری را مجروح کرده است. پس از مدتی، فرد مجروح از دنیا میرود. نزاعی میان جانی و اولیای دم درمیگیرد:
ادعای جانی: جانی ادعا میکند که فرد مجروح، خودش سم خورده و بر اثر آن سم مرده است (یعنی خودکشی کرده) و جراحت من، علت مرگ او نبوده است.
ادعای اولیای دم: آنها ادعا میکنند که ادعای سم دروغ است و مرگ، در اثر سرایت همان جراحت بوده است. یعنی سبب اصلی مرگ، همان جنایتی است که جانی مرتکب شده است.
فقها فرمودهاند که اگر بینهای در کار نباشد، این دو احتمال با هم مساوی هستند.
نحوه تمسک به اصل مثبت: در اینجا، برای تبرئه جانی، میتوان «استصحاب عدم سرایت جراحت» را جاری کرد. یعنی اصل بر این است که آن جراحت، به مرگ منجر نشده است. لازمه عقلی این استصحاب این است که پس حتماً علت دیگری (یعنی شرب سم) باعث مرگ شده است. با این استصحاب مثبت، جانی از قصاص یا دیه قتل، تبرئه میشود.
مورد دوم: نزاع بر سر زنده بودن مقتول (استصحاب حیات)
«و کذا الملفوف في الكساء إذا قدّه نصفین فادّعی الولي أنّه كان حیّاً [قبل القدّ و مات بالقدّ] و الجاني أنّه كان میتاً فالاحتمالان متساویان»[6] .
شخصی در پارچهای پیچیده شده و روی زمین افتاده است. جانی میآید و با یک ضربه شمشیر، او را دو نیم میکند («قدّه نصفین»). باز هم نزاع درمیگیرد:
ادعای جانی: جانی میگوید این شخص، قبل از اینکه من او را بزنم، مرده بود و من یک جسد را دو نیم کردهام.
ادعای اولیای دم: آنها ادعا میکنند که او زنده بود و با همین ضربه شمشیر شما کشته شد.
نحوه تمسک به اصل مثبت: در اینجا، بر خلاف مثال قبل، به نفع اولیای دم، میتوان «استصحاب حیات» را جاری کرد. یعنی اصل بر این است که آن شخص، تا لحظه قبل از ضربه، زنده بوده است. لازمه عقلی این استصحاب این است که پس علت مرگ، همین ضربه شمشیر بوده است. با این استصحاب مثبت، «تحقّق القتل بالقدّ المذكور» ثابت شده و جانی، ضامن قصاص یا دیه مقتول خواهد بود.
این دو مثال به خوبی نشان میدهد که چگونه فقهای بزرگ متقدم، در مسائل بسیار حساس و مهمی همچون قتل و دیات، به استصحابهایی تمسک میکردهاند که از دیدگاه ما، مصداق بارز اصل مثبت هستند. این امر، همانطور که در مقدمه گفته شد، احتمالاً ناشی از مبنای ایشان در اماره دانستن استصحاب و یا نوعی مسامحه در تطبیق بوده است.


