47/04/05
مَن كان له وطنان.../فصل في أقسام الحجّ /كتاب الحجّ
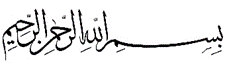
الموضوع: كتاب الحجّ/فصل في أقسام الحجّ /مَن كان له وطنان...
الثانية: إذا تساوى الوطنان في السكنى والإقامة، فإن كان مستطيعاً للحجّ من كلا الوطنين يتخيّر بين الوظيفتين (حجّ التمتّع أو حجّ القران والإفراد)، ولكنّ التمتّع أفضل، وإن كان مستطيعاً للحجّ من أحدهما دون الآخر لزمه الحجّ من وطن الاستطاعة.
وقد استدلّ صاحب الجواهر (قده) على القول بالتخيير بوجهين:
الأوّل: إذا كانت الاستطاعة من أحد الوطنين توجب نوعاً معيّناً من الحجّ (فمثلاً استطاعته من بغداد توجب حجّ التمتّع)، والاستطاعة من الوطن الآخر توجب نوعاً آخر (فمثلاً استطاعته من مكّة توجب حجّ القران أو الإفراد)، فإنّ فرض تعدّد الاستطاعة لا يقتضي تعدّد الحجّ؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة أنّ الحجّ الواجب بالاستطاعة لا يجب على المكلّف إلّا مرّة واحدة في العمر. وعليه، فإنّ المكلّف مع تحقّق الاستطاعة من كلا الوطنين يتخيّر بين الوظيفتين، ولا يتعيّن عليه أحدهما.
الثاني: إنّ أدلّة تعيين نوع الحجّ، سواء تلك الأدلّة التي توجب حجّ التمتّع على البعيد، أو التي توجب حجّ القران أو الإفراد على القريب، لا تشمل المكلّف الذي له وطنان متساويان في السكنى والإقامة؛ وذلك لأنّ الأدلّة الموجبة لحجّ التمتّع ـ كقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[1] ـ إنّما تختصّ بمَن له وطن واحد خارج عن دون ثمانية وأربعين ميلاً، وأمّا ذو الوطنين فلا تنطبق عليه هذه الأدلّة أو تنصرف عنه. وكذلك الحال في الأدلّة الموجبة لحجّ القران أو الإفراد، فإنّها تختصّ بمَن كان أهله حاضري المسجد الحرام فقط، وهذا المكلّف خارج عنها أيضاً.
وعليه، فإنّ المقام خارج عن مورد هذه الأدلّة، فيتعيّن الرجوع إلى العام الفوقاني، أو يتمسّك بإطلاق دليل وجوب الحجّ من غير تقييده بنوع خاص، كقوله تعالى: ﴿وَلِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾، ونتيجة ذلك ثبوت التخيير بين الوظيفتين.
ويمكن تقريب المطلب ببيان آخر، وهو أنّ المكلّف إذا صدق عليه كلا العنوانين معاً، أي: عنوان البعيد الموجب لتعيّن التمتّع، وعنوان القريب الموجب لتعيّن القران والإفراد، فإنّ مقتضى ذلك تعارض الوجوبين وتساقطهما، فيرجع لا محالة إلى إطلاق أدلّة وجوب الحجّ، كما يمكن أن يقال: إنّ الأدلّة تشمل هذا المكلّف (الذي كلّف بطبيعي الحجّ)، ولكنّه خرج عن التعيين، فلا يتعيّن عليه التمتّع، ولا القران والإفراد، وإنّما يجب عليه الإتيان بطبيعي الحجّ، فيكون مخيّراً بين الأقسام الثلاثة للحجّ.
وقد ناقش المحقّق الخوئي (قده) ما ذكره المصنّف (قده) من القول بالتخيير عند تحقّق الاستطاعة من كلا الوطنين، بل قال بوجوب القران أو الإفراد؛ وذلك لأنّ موضوع التمتّع سلبي، وموضوع القران أو الإفراد إيجابي، وكلّ من الدليلين مطلق من ناحية إتّخاذ وطن آخر أم لا، وحينئذ إذا صدق عليه عنوان الحاضر (الموضوع الإيجابي) فلا يصدق عليه العنوان السلبي؛ لأنّه جمع بين المتناقضين، إذن يتعيّن عليه القران أو الإفراد، ولا أقلّ أنّه أحوط.
ثمّ قال بأنّ الالتزام بالتخيير لا يخلو من إشكال بل منع؛ وذلك لأنّ مقتضى الأدلّة وجوب التمتّع على مَن لم يكن حاضر المسجد الحرام ولم يكن من أهالي مكّة، ووجوب الإفراد والقران على مَن كان حاضراً وكان من أهالي مكّة، فموضوع أحد الواجبين إيجابي، وموضوع الآخر سلبي، ولا يمكن التخيير في مثل ذلك.
نعم، إذا كان موضوع كلّ واحد منهما إيجابياً، وكان المورد مجمعاً بين العنوانين لأمكن التخيير بينهما، بخلاف ما إذا كان موضوع أحدهما سلبياً، وموضوع الآخر إيجابياً، فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما، فلا مورد للتخيير بين الأمرين[2] .
ويُلاحظ عليه بأمور ثلاثة:
الأوّل: إنّ ما ذكره المحقّق الخوئي (قده) من كون موضوع حجّ القران أو الإفراد أمراً إيجابيّاً، بحيث إذا صدق عنوان الحاضر امتنع صدق عنوان السلبي؛ لاستحالة الجمع بين النقيضين، غير تامّ؛ إذ لو كان الأمر كذلك، لما نصّت صحيحة زرارة على أنّ ذا الوطنين إذا غلب سكنه في أحد وطنيه لزمه حكم ذاك الوطن الذي يغلب فيه سكنه.
ومن هنا يظهر أنّ الصحيحة تعني أنّ ذا الوطنين خارج عن مدلول الآية الشريفة: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[3] ، فمَن استطاع من كلا الوطنين ـ وهو المفروض ـ وتساوى سكنه في كلّ منهما، تعيّن عليه الإتيان بطبيعي الحجّ، فيتخيّر بين الأقسام الثلاثة للحجّ، وأمّا إذا غلب سكنه في أحدهما دون الآخر، فإنّه يتعيّن عليه حكم ذاك البلد.
وعليه، يظهر أنّ ذا الوطنين خارج عن مدلول الآية، ولا يُستدلّ عليه بالآية القرآنية حتّى يقال بأنّ موضوع حجّ القران أو الإفراد إيجابي، وموضوع حجّ التمتّع سلبي، وإنّما يُستدلّ على حكمه بالرواية (صحيحة زرارة) إذا غلب سكنه في أحد الوطنين، وبما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده) من الأدلّة الدالّة على التخيير إذا تساوى سكنه في الوطنين، كما أنّ أدلّة حجّ التمتّع لا تشمل ذا الوطنين؛ لأنّ هذه الأدلّة تنظر إلى مَن كان له وطن واحد خارج عن الحدّ (الثمانية وأربعون ميلاً)، وكذلك أدلّة حجّ القران والإفراد لا تشمله أيضاً؛ لأنّها ناظرة إلى مَن كان أهله حاضري المسجد الحرام فقط. إذن يُرجع في المقام (حكم ذي الوطنين) إلى العموم الفوقاني، كقوله تعالى: ﴿وَلِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[4] .
الثاني: إنّ الأدلّة المتكفّلة لبيان قسم خاص من الحجّ منصرفة عن هذا المكلّف الذي تحقّقت استطاعته من البلدين؛ لعدم استقراره في بلد خاص، فلا تشمله أدلّة وجوب حجّ القران والإفراد أيضاً، ولا يتعيّن عليه ذلك، فيكون حكم هذا المكلّف داخلاً تحت العموم الفوقاني من دون تعيين، أو يتمسّك في حقّه بإطلاق أدلّة وجوب الحجّ، ونتيجة ذلك ثبوت التخيير بين الأقسام الثلاثة للحجّ.
الثالث: إنّ القول بالتخيير بين حجّ التمتّع أو حجّ القران والإفراد لا يستلزم التناقض؛ لأنّ التناقض إنّما يتحقّق إذا اجتمع عنوان الحاضر وغير الحاضر على شخص في زمان واحد، وهذا ما لا ندّعيه، فإنّ المدّعى أنّ لهذا المكلّف أهلاً حاضرين في المسجد الحرام، وأهلاً آخرين خارجين عنه، كما إذا كان له أهل في مكّة، وأهل آخرون في بغداد، وهذا أمر ممكن ولا مانع فيه.
وبذلك، يتّضح أنّ ذا الوطنين لا تشمله أدلّة وجوب التمتّع، كما لا تشمله أدلّة وجوب القران والإفراد، ولا يتعيّن عليه ذلك، بل يُستدلّ عليه بالعموم الفوقاني أو بإطلاق أدلّة الوجوب من دون تعيين نوع خاص.
إذن، ما ذهب إليه المصنّف (قده) من القول بالتخيير هو الصحيح.


