47/03/28
فصل في أقسام الحجّ وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار.../فصل في أقسام الحجّ /كتاب الحجّ
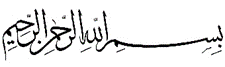
الموضوع: كتاب الحجّ/فصل في أقسام الحجّ /فصل في أقسام الحجّ وهي ثلاثة بالإجماع والأخبار...
القول الرابع: إنّ حدّ البعد هو ثمانية عشر ميلاً، ويدلّ على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في قول الله عزّ وجلّ ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، قال: مَن كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها، وثمانية عشر ميلاً من خلفها، وثمانية عشر ميلاً عن يمينها، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها، فلا متعة له مثل مرّ وأشباهه»[1] .
وفيه: لم يقل بمضمون هذه الصحيحة أحد من الفقهاء لا من الشيعة ولا من السنّة، ولم يعمل بها أحد، فهي رواية مهجورة، وبذلك تسقط عن الحجّية.
القول الخامس: إنّ الحاضر هو مَن كان منزله دون الميقات، فالبعيد مَن كان أبعد من ذلك الحدّ، واستُدلّ عليه بصحيحتين: الأُولى: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكّة، فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة»[2] ، والثانية: صحيحة حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الأوقات إلى مكّة»[3] .
وفيه: لم يقل أحد بمضمون هاتين الروايتين أيضاً، مضافاً إلى أنّهما تخالفان ما هو المتسالم عليه بين الفقهاء من العمل برواية الثمانية والأربعين ميلاً، فتكونان بذلك روايتين مهجورتين.
نعم، ذهب بعض أهل السنّة ـ كمكحول وأصحاب الرأي ـ إلى هذا القول، بدعوى أنّ الميقات موضع شُرّع فيه النسك، وهو الإحرام، فيكون كالحرم، ولكنّه قياس ظنّي لا يقول به أحد من العلماء الإماميّة.
ويُلاحظ على هذا القول أيضاً أنّه لو أُريد من القريب مَن كان دون المواقيت، للزم منه اختلاف حدّ القرب باختلاف المواقيت وبُعدها عن مكّة؛ إذ ليست المواقيت على مسافة واحدة من المسجد الحرام، فبعضها يبعد عن مكّة نحو سبعين كيلومتراً، وبعضها الآخر يبعد عنها ما يقارب أربعمائة كيلومتراً. وعليه، يجب حجّ القران أو الإفراد على مَن كان دون السبعين، كما يجب ذلك على مَن كان دون الأربعمائة، وهذا يستلزم الاختلاف في تفسير القرب والبعد، إلّا أن يُراد من الحاضر الذي يكون حكمه التخيير بين حجّ الإفراد أو القران هو مَن كان أقرب إلى مكّة من جميع المواقيت، كأهل طائف مثلاً، ولكن هذا التوجيه لا ينسجم مع الروايات، حيث دلّت على أنّ الحاضر هو «مَن كان دون المواقيت إلى مكّة»، ولم تدلّ على أنّه «مَن كان أقرب من جميع المواقيت إلى مكّة».
والحاصل ممّا تقدّم أنّ الصحيح ما دلّت عليه صحيحة زرارة من أنّ حدّ البعد هو ثمانية وأربعون ميلاً من كلّ جانب، وحدّ القرب ما دون ذلك، فمَن كان أهله وسكنه دون هذا الحدّ فهو من حاضري المسجد الحرام، وفرضه حجّ القران أو الإفراد، وأمّا مَن كان أهله وسكنه على هذا الحدّ أو أكثر فهو ممّن لم يكن حاضري المسجد الحرام، وفرضه حجّ التمتّع، ولا عبرة بكونه مسافراً أو حاضراً.
المقام الثالث: في بيان مبدأ الحدّ المذكور هل هو المسجد الحرام أو مكّة؟ فيه قولان، وقد وقع الخلاف في كلمات الأصحاب، كما أشار السيّد الحكيم (قده) إلى ذلك، حيث عبّر بعضهم بلفظ «المسجد الحرام»، وآخرون بلفظ «مكّة».
ولكنّ الظاهر أنّ العبرة بالمسجد الحرام نفسه، لا بالبلد؛ وذلك تمسّكاً بظاهر الآية، بل بصريحها: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، فإنّ مدلولها ظاهر في أنّ التحديد يكون بالنسبة إلى المسجد.
وقد يقال بأنّ المسجد الحرام ليس محلاً للسكنى والإقامة، فلا يصدق على أحد أن يكون من أهل المسجد الحرام؛ لأنّه محلّ للعبادة، لا للسكونة، وإنّما يُحتمل أن يكون مبدأ التحديد بالنسبة إلى البلد، باعتبار أنّ المسجد في البلد، فيكون المراد منها حاضري البلد الذي فيه المسجد الحرام، أي: مكّة، كما يقال بأنّ الصلاة عند علي (عليه السلام) تعدل كذا من الثواب، فإنّ معنى ذلك أنّ الصلاة في النجف الأشرف لها كذا من الثواب، لا خصوص الصلاة في الحرم الشريف.
ولكنّه يقال: إنّ ظاهر الآية صريح في أنّ التحديد بالنسبة إلى المسجد، لا البلد، فلا يُؤخذ بالاحتمال في مقابل الصريح، وعلى فرض احتمال أنّ المراد هو البلد، فإنّ الآية تكون مجملة ومردّدة بين الأقل والأكثر، وحيئنذ يُقتصر على القدر المتيقّن في الخروج عن العمومات المقتضية لوجوب حجّ التمتّع على البعيد، وهو نفس المسجد الحرام.
وعليه، مَن كان بعيداً عن المسجد الحرام بمقدار ثمانية وأربعين ميلاً أو أكثر فوظيفته حجّ التمتّع، وأمّا مَن كان دون ذلك فوظيفته حجّ القران أو الإفراد.
المقام الرابع: مَن كان منزله على نفس الحدّ المذكور من المسجد الحرام، فهل وظيفته حجّ التمتّع، أم حجّ الإفراد؟
الظاهر أنّ وظيفته هي حجّ التمتّع؛ وذلك لأنّ المستفاد من صحيحة زرارة أنّ وجوب حجّ الإفراد أو القران معلّق على مَن كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً، وأمّا مَن كان على نفس الحدّ أو أبعد منه فإنّ وظيفته حجّ التمتّع؛ إذ يشمله عموم «كلّ مَن كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة» حسب صحيحة زرارة.
وقد ذهب بعض إلى أنّ مَن كان دون الحدّ المذكور فوظيفته حجّ القران أو الإفراد، ومَن كان أبعد من ذلك فوظيفته حجّ التمتّع، وأمّا مَن كان على نفس الحدّ فإنّه لا يصدق عليه عنوان «الدون»، كما لا يصدق علىه عنوان «الأبعد»، فلا تشمله العمومات الدالّة على وجوب التمتّع.
إلّا أنّ هذا القول غير صحيح؛ وذلك لأنّ ظاهر الرواية أنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان الحكم لجميع المكلّفين دون استثناء، فلا يُعقل أن يترك فئة منهم بلا بيان. وعليه، فلا يُقال أنّ حكم مَن كان على نفس الحدّ لم يُبيّن، بل إنّ قوله (عليه السلام): «كلّ مَن كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة» يشمل مَن كان أبعد من الدون أيضاً، فكلّ مَن لم يكن داخلاً في عنوان «الدون» فوظيفته التمتّع، سواء كان على نفس الحدّ، أو أبعد منه.
وإذا شكّ أنّ عليه التمتّع أو الإفراد والقران فبما أنّ المخصّص مجمل مردّد بين الأقل والأكثر فنقتصر على المتيقّن، فلا يُلحق مَن كان على الحدّ بمَن كان أهله حاضري المسجد الحرام.
ملحوظة: المراد بمنزله: بلدة نزوله (لا بيته الخاص)، فالبلدة بأجمعها إذا كانت على نفس الحدّ حكمها واحد للبيت الذي في أوّل البلدة أو في آخرها، فلا يختلف حكم سكّان بلدة واحدة باعتبار اختلاف منازلهم قُرباً أو بُعداً؛ وذلك لأنّ الظاهر جعل الحدّ بين المكلّف (الذي يختلف في أرجاء بلده) وبين المسجد الحرام، ولا خصوصيّة للدار أو الدكّان أو المعمل.


