46/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات الاستصحاب؛ التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
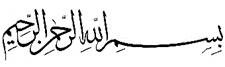
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تنبیهات الاستصحاب؛ التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره
القسم الثالث: عندما يكون الأثر مترتبًا على العدم بمفاد «ليس ناقصة»
نظرية صاحب الكفاية(قدسسره)
يطرح المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) في بحثه عن القسم الثالث من جريان الاستصحاب، نفس رأيه بشأن عدم جريان استصحاب كان الناقصة.
«[و إن] كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر، فالتحقیق أنّه أیضاً لیس بمورد للاستصحاب فیما كان الأثر المهمّ مترتّباً على ثبوته المتّصف بالعدم في زمان حدوث الآخر، لعدم الیقین بحدوثه كذلك في زمان».[1]
يوضح سماحته في شرح هذا القسم أن الأثر هنا يترتب على العدم، ولكن هذا العدم هو بمفاد ليس الناقصة. وفي هذه الحالة أيضًا، يعتقد أن الاستصحاب لا يجري ويقول: إن أحد أركان الاستصحاب غير موجود هنا. ويوضح سبب ذلك بأن جريان الاستصحاب يتوقف على وجود يقين سابق بحادث كان معدومًا وقت وقوع الحادث الآخر. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون هناك يقين سابق بأن حادثًا لم يكن موجودًا وقت وقوع حادث آخر.
يبيّن أن الأثر هو لعدم أحدهما في زمن وقوع الآخر، ولكن هذا العدم هو بنحو ليس الناقصة. ثم يضيف أن هذه المسألة ليست موردًا للاستصحاب، لأن الأثر مترتب على شيء اتصف بالعدم في زمن الحادث الآخر. بعبارة أخرى، حادث كان معدومًا وقت وقوع الحادث الآخر. وهذا المطلب لم يكن موجودًا في السابق.
عبارة المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) في هذا القسم فيها بعض الصعوبات، ولكن معناها باختصار هو أن الاستصحاب في مثل هذه الحالات لا يجري لعدم وجود يقين سابق بعدم أحد الحوادث في زمن وقوع الآخر.
لتوضيح أكثر، يتم دراسة مثالين من هذا الموضوع:
المثال الأول: موت الوارث بعد موت المورث
إن إرث الوارث متوقف على “ليس ناقصة”. وموضوع هذه “الليس الناقصة” هو أنه على الرغم من وفاة كل من الوارث والمورث، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن هذه الحقيقة تُعتبر “ليس ناقصة”. وهذه “الليس الناقصة” تعني أن موت الوارث لم يكن في زمن موت المورث، بل وقع بعده. هنا، كان موت الوارث بعد موت المورث.
في هذا المثال، يقع موت المورث عندما لم يكن موت الوارث قد وقع، أي أن موت المورث منسوب إلى عدم بمفاد ليس الناقصة، وهو ربط موت المورث بالنسبة لموت الوارث. موت الأب موجود وقد وقع، لأننا في فرض وقع فيه حدثان وكلاهما مجهول التاريخ، إذن موت الأب قد وقع، ولكن موت الأب هذا لم يكن موجودًا في زمن موت الابن، وهذا هو موضوع إرث الابن، وفي هذه الحالة يرث الابن من الأب لأن موت الوارث وقع بعد موت المورث.
المثال الثاني: إسلام الوارث بعد موت المورث
في مسألة إسلام الوارث، إذا أسلم الوارث قبل موت المورث، فإنه يرث، ولكن إذا أسلم بعد موت المورث، فإنه لا يرث. وعليه، فإن “ليس ناقصة” هنا تعني أن موت المورث لم يكن قبل إسلام الوارث، بل كان بعده. وبعبارة أخرى، إذا أسلم الابن بعد وفاة الأب، فلا يمكنه أن يرث، أما إذا أسلم قبل وفاة الأب، فإنه يرث.
في هذا الصدد، يقول المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره): “أحد ركني الاستصحاب مفقود”، لأن جريان الاستصحاب متوقف على وجود يقين سابق بحدوث شيء متصف بالعدم في زمن حدوث الآخر. وهنا، اليقين المذكور غير موجود، لأنه عندما نريد أن نعتبر عدم موت المورث بالنسبة لإسلام الوارث بشكل “ليس ناقصة”، يجب أن نقبل أن مثل هذه الحالة لا سابقة لها. فعلى الرغم من أن موت المورث قد وقع، إلا أن عدمه في زمن إسلام الوارث لا سابقة له وهذه الحالة غير قابلة للإثبات بالاستصحاب.
تقرير المحقق الخوئي من صاحب الكفاية(قدسسرهما)
يقرر المرحوم المحقق الخوئي رأي صاحب الكفاية(قدسسرهما) فيقول:
«إن كان الأثر للعدم النعتي لایجري الاستصحاب فیه على مسلك صاحب الكفایة(قدسسره) لعدم الیقین بوجود هذا الحادث متّصفاً بالعدم في زمان حدوث الآخر، و من الظاهر أنّ القضیة إذا كانت معدولة، فلابدّ فیها من فرض وجود الموضوع بخلاف القضیة السالبة، كقولنا "زید لیس بقائم" فإنّ صدقها غیر متوقّف على وجود الموضوع، لأنّ مفاد القضیة السالبة سلب الربط فلایحتاج إلى وجود الموضو
و أمّا معدولة المحمول، فبما أنّ مفادها ربط السلب لزم فیه وجود الموضوع لامحالة»[2] .
يبيّن أنه إذا كان الأثر مترتبًا على العدم النعتي (كان الناقصة)، فلا يجري الاستصحاب على مسلك صاحب الكفاية(قدسسره). والسبب هو عدم يقيننا بوجود هذا الحادث متصفًا بالعدم في زمن حدوث الحادث الآخر. فلكي يجري الاستصحاب، يجب أن يكون هناك يقين سابق بأن هذا الحادث، في زمن معين، كان متصفًا بالعدم، ولكن هنا لا توجد مثل هذه الحالة السابقة. والظاهر أنه في الحالات التي تكون فيها القضية معدولة، لا بد من فرض وجود الموضوع، بخلاف القضية السالبة.
١. القضية السالبة:
في القضية السالبة، مثل «زيدٌ ليس بقائمٍ»، لا يتوقف صدق القضية على وجود الموضوع. فمفاد هذا النوع من القضايا هو سلب الربط؛ أي نفي علاقة بين الموضوع والمحمول، دون أن يكون وجود الموضوع في العالم الخارجي شرطًا. وعليه، في القضية السالبة لا حاجة لفرض وجود الموضوع ويمكن اعتبارها صادقة حتى لو لم يكن للموضوع وجود خارجي.
٢. قضية معدولة المحمول:
في قضية معدولة المحمول، مثل «زيدٌ غير قائمٍ»، يكون وجود الموضوع ضروريًا لصدق القضية. فمفاد هذا النوع من القضايا هو ربط السلب؛ أي يُنسب محمول إلى الموضوع يأتي فيه المحمول بصورة معدولة. وهنا، لكي يكون صدق القضية ممكنًا، لا بد أن يكون للموضوع وجود في العالم الخارجي. وبعبارة أخرى، خلافًا للقضية السالبة التي هي مجرد نفي علاقة، فإن وجود الموضوع في قضية معدولة المحمول شرط لازم للارتباط بين الموضوع والمحمول.
مناقشة المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما) في نظرية صاحب الكفاية(قدسسره)
ناقش المرحوم المحقق الأصفهاني[3] والمحقق الخوئي(قدسسرهما) في كلام صاحب الكفاية(قدسسره) وقالا بجريان الاستصحاب في القسم الثالث. يعتقد صاحب الكفاية(قدسسره) أنه في هذا القسم، حيث يترتب الأثر على العدم النعتي، لا يجري الاستصحاب. وسببه أن جريان الاستصحاب يتوقف على وجود يقين سابق بوجود موضوع متصف بالعدم. وفي هذه الحالات، لا يوجد مثل هذا اليقين؛ لأنه لا يمكن تصور حالة سابقة للاتصاف بعدم الوصف في زمن وقوع الحادث الآخر.
يقول المحقق الخوئي(قدسسره):
«الإنصاف أنّه لا مانع من جریان الاستصحاب في هذا القسم أیضاً، فإنّه و إن لمیمكن ترتیب آثار الاتصاف بعدم وصف[4] باستصحاب عدم ذلك الوصف؛ لأنّه لایثبت به العدم المأخوذ نعتاً إلا أنّه یمكن ترتیب عدم الاتصاف بذلك الوصف[5] بإجراء الاستصحاب في عدم الاتصاف، فإنّ الاتصاف مسبوق بالعدم كما مرّ، فحال القسم الثالث حال القسم الثاني في جریان الاستصحاب»[6] .
لم يقبل المحقق الخوئي تبعًا للمحقق الأصفهاني(قدسسرهما) رأي صاحب الكفاية(قدسسره)، ويعتقد أنه لا مانع من جريان الاستصحاب حتى في هذه الحالات. فعلى الرغم من أن ترتيب آثار الاتصاف بعدم الوصف باستصحاب عدم ذلك الوصف غير ممكن - لأن العدم المأخوذ بصورة نعتية لا يمكن إثباته بالاستصحاب - إلا أنه يمكن ترتيب آثار عدم الاتصاف بالوصف بإجراء الاستصحاب.
على سبيل المثال، في فرض الموتين، لا يمكن إثبات العدم النعتي لموت الوارث، كما أنه في مثال إسلام الوارث وموت المورث، لا يمكن إثبات العدم النعتي لموت المورث أيضًا. ولكن يمكن عن طريق الاستصحاب افتراض عدم القضية بأكملها، حتى لو كان سبب ذلك عدم وجود الموضوع. فلأن الاتصاف بالوصف المذكور مسبوق بالعدم، يمكن إجراء استصحاب عدم الاتصاف. ونتيجة لذلك، فإن القسم الثالث من حيث إن الاتصاف مسبوق بالعدم، يشبه القسم الثاني.
وعليه، يعتقد المحقق الخوئي والمحقق الأصفهاني(قدسسره) أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في هذه الحالات، على الرغم من أن العدم النعتي لا يثبت بشكل مباشر.
توضيح ذلك أنه في هذه الحالات، لدينا حادثان تاريخ وقوع كليهما مجهول، والحكم الشرعي مترتب على عدم وقوع أحدهما في زمن وقوع الآخر.
أمثلة
• موت الوارث وموت المورث: في هذا المثال، يتوقف حكم الإرث على تقدم أو تأخر موت الوارث والمورث. توفي كل من الوارث والمورث ولا نعلم أيهما وقع أولاً. والأثر الشرعي - أي إرث الوارث من المورث - متوقف على عدم نعتي؛ أي عدم اتصاف موت الوارث بكونه في زمن موت المورث. (يرث الأب في حالة اتصاف وفاته بعدم حدوثها في زمن حدوث وفاة الابن)
• إسلام الوارث وموت المورث: في هذا المثال، إذا أسلم الوارث قبل موت المورث، فإنه يرث منه. أما إذا كان إسلام الوارث بعد موت المورث، فلا يصل إليه الإرث. وعليه، فإن إرث الوارث يكون في حالة اتصاف إسلام الوارث بعدم الحدوث في زمن وفاة المورث.
• ملاقاة شيء متنجس وحدوث قلة في ماء الحوض: هذا المثال جديد وتوضيحه كما يلي: لنفترض أن ملاقاة قد حدثت بين شيء متنجس وماء حوض، وفي الوقت نفسه، وقع حادث آخر وهو حدوث قلة لماء الحوض. ولكننا لا نعلم أي الحادثين وقع أولاً. الحكم بالطهارة (الأثر الشرعي) متوقف على عدم الملاقاة في زمن حدوث قلة ماء الحوض. وعليه، فإن موضوع الحكم هنا هو عدم نعتي؛ أي عدم اتصاف الملاقاة - الحادث الأول - بكونها في زمن الحادث الثاني، أي قلة ماء الحوض.
هذا المثال الثالث، الذي قدمه المرحوم المحقق الخوئي(قدسسره) أيضًا، يوضح أن حادثين متناوبين يمكن أن يكون لهما دور أساسي في ترتيب أثرهما. هذا التنوع في الأمثلة يساعد على فهم الموضوع بشكل أفضل ويوضح الفرق بين الحالات المختلفة. يقول سماحته إن الحكم بطهارة هذا الشيء المتنجس متوقف على ألا تكون الملاقاة قد وقعت في زمن حدوث قلة الماء. فإذا لم تقع الملاقاة في زمن حدوث القلة، فهذا يعني أن هذه الملاقاة قد وقعت في زمن كان الماء فيه لا يزال كرًا. ونتيجة لذلك، يُطهّر الشيء المتنجس.
للحكم بالطهارة، نحتاج إلى “ليس ناقصة”؛ لأن كلا الحادثين (الملاقاة وحدوث القلة) قد وقعا، ولكن “ليس الناقصة” المطلوبة هي للملاقاة بالنسبة لحدوث القلة. وهذا يعني أنه على الرغم من ثبوت كلا الحادثين، فإن “ليس الناقصة” تعني أن الملاقاة (الحادث الأول) لم تقع في زمن حدوث القلة (الحادث الثاني). بناءً على هذا، فإن موضوع الحكم بالطهارة هو عدم نعتي؛ بمعنى أن “ليس الناقصة” للملاقاة في زمن حدوث القلة لماء الحوض معتبرة. وبعبارة أخرى، هذه “الليس الناقصة” هي نفسها العدم النعتي للملاقاة في زمن وقوع الحادث الثاني (حدوث القلة) وهو شرط الحكم بالطهارة.
كان المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) قد قرر هذا الموضوع بنحو قضية معدولة المحمول. فالطهارة المترتبة على وجود الحادث الأول، أي طهارة الملاقاة، يجب أن تكون متصفة بعدم حدوثها في زمن الحادث الآخر (حدوث القلة). وقد طُرحت هذه القضية بنحو موجبة معدولة المحمول وتؤكد على لزوم فرض وجود الموضوع. موضوع لم يكن موجودًا سابقًا.
القضية الموجبة المعدولة التي هي معدولة المحمول، مفادها ربط السلب؛ وعليه، لن تكون لها حالة سابقة. فالطهارة التي وصفها العدم، هي عدم رابطي مرتبط بحادثة قلة الماء، ولكن ليس لدينا حالة سابقة لهذه الحالة. المشكلة هنا تدور حول ليس الناقصة والربط، وكل مشكلة المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) تدور حول هذا الربط نفسه. لأن الربط بهذه الكيفية لم يكن موجودًا في الماضي لنريد استصحابه. فاستصحاب الطهارة بمعنى أنها لم تكن متصفة بالقبلية بالنسبة لقلة الماء غير ممكن.
قرر المرحوم المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما) القضية بنحو قضية سالبة محصلة مفادها سلب الربط، لا سالبة محصلة مفادها سلب المحمول، ولا قضية موجبة معدولة المحمول. فعندما تُطرح القضية بنحو سلب الربط، لا تعود بحاجة إلى موضوع. وكما قال المحقق الأصفهاني(قدسسره) في الجلسة السابقة وبيّنه الخوئي(قدسسره) أيضًا، فإن نفي شيء عن شيء لا يحتاج إلى وجود المنفي عنه؛ أي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، أما نفي شيء عن شيء فلا يحتاج إلى وجود المنفي عنه. وعلى حد تعبيرهم: “إن القضية السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع”، وعليه، خذوا هذه القضية بنحو سلب الربط، لأنه عندما يكون سلب ربط، فلا حاجة لوجود الموضوع.
بناءً على هذا، فإن موضوع الطهارة هو ألا يكون حدوث الحادث الأول (ملاقاة شيء بماء الحوض) في زمن حدوث الحادث الثاني (قلة الماء)، أي عدمه. الملاقاة قد حصلت، ولكننا نلحظ عدمها؛ بصورة أن الملاقاة متصفة بكونها “لم تكن الملاقاة” في زمن حدوث القلة، الذي كان الحادث الثاني. وبعبارة أخرى، تترتب الطهارة على ألا يتصف الحادث الأول بكونه في زمن الحادث الثاني. إذن، الحادث موجود، والأمر ثابت، ولكنه غير متصف بكونه قد وقع في زمن الحادث الثاني.
هذا الجمع بين النفي والإثبات يعني أن الحادثة موجودة واقعًا، ولكنها لا توجد في زمن وقوع الحادثة الثانية؛ أي أن لها ليس ناقصة وإلا لكانت كان تامة. الحادثة لا تزال موجودة، ولكن هذه الملاقاة لا تقع في زمن الحادثة الثانية.
وعليه، فإننا هنا نحل المشكلة باستصحاب سلب الربط. في الواقع نقول إن هذا الربط لم يكن موجودًا منذ البداية. في هذه الحالة، يمكن تصور أن الأثر يترتب على عدم رابطي لأحد الحوادث، أو أن الأثر يترتب على عدم رابطي لكلا الحادثين، وهذا لا يخلق اشتباكًا أو تعارضًا. يُطرح هذا البحث في القسم الثالث ولا ندخل في البحوث التالية، لأن هذا الموضوع بحد ذاته يتسم بالتعقيد والدقة الشديدة.[7]


