46/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات الاستصحاب؛ التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
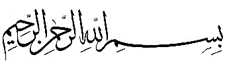
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / تنبیهات الاستصحاب؛ التنبیه العاشر: الشك في تقدم الحادث و تأخره
القسم الثاني: الأثر المترتب على الوجود بمفاد كان الناقصة
ننتقل هنا إلى القسم الثاني حيث يكون الأثر مترتبًا على الوجود بمفاد كان الناقصة. لمفاد كان الناقصة هذا أهمية كبيرة. ومثاله في موضوع الإرث حيث يُنظر إلى موضوع الإرث في ارتباط موت المورث بموت الوارث، لا كأمرين مستقلين. مفاد كان الناقصة هو أن “الوارث يرث من المورث في حالة كون موت المورث قبل موت الوارث”، حيث يُعتبر هنا وجود رابطي بين الحادثين.
يوجد هنا اختلاف في الرأي بين العلماء. فقد أكد صاحب الكفاية(قدسسره) على عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم. وفي المقابل، يرى بعض المحققين مثل المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما) جريان الاستصحاب في هذه الحالة. وفيما يلي، يجب أن ندرس ما إذا كنا سنقبل رأي السيد صاحب الكفاية(قدسسره) أم رأي المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما).
النظرية الأولى من صاحب الكفاية(قدسسره)
يقول صاحب الكفاية(قدسسره):
«و أمّا إن كان [الأثر الشرعي] مترتّباً على ما إذا كان متّصفاً بالتقدّم، أو بأحد ضدّیه [و هما التأخّر و التقارن] الذي كان مفاد كان الناقصة، فلا مورد ههنا للاستصحاب، لعدم الیقین السابق فیه، بلا ارتیاب»[1] .
وبعبارة أخرى، يعتقد سماحته أنه إذا ترتب الأثر الشرعي على حالة تتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن (وهذه هي مفاد كان الناقصة)، فلن يجري الاستصحاب هنا؛ لأنه في هذه الحالات، لا يوجد أي يقين سابق. على سبيل المثال، في مسألة موت المورث والوارث، إذا كان موت المورث متقدمًا على موت الوارث، فلا توجد له حالة سابقة حتى يمكن إجراء الاستصحاب على أساسها. فالموت لا حالة سابقة له والإنسان يموت مرة واحدة فقط؛ وعليه، لا يمكن القول إنه كان هكذا سابقًا وقد تغير الآن.
هنا، موت المورث، الذي هو بمفاد كان الناقصة، يجب أن يرتبط بموت الوارث؛ أي أننا نربط الموتين ببعضهما البعض. ويقول سماحته: هذه الحالة لا سابقة لها.
مثال مرتبط بالبحث: المرأة القرشية
طُرح مثال مثل المرأة القرشية. في هذا المثال، إذا كانت المرأة قرشية، فإنها تيأس في سن الستين، وإذا كانت غير قرشية، فإنها تيأس في سن الخمسين. كان البحث هنا أنه لا يمكن استصحاب القرشية؛ بل يجب استصحاب عدم القرشية. بالنسبة لهذه المرأة، نعتبر مجرد عدم القرشية، لأن القرشية غير موجودة.
على سبيل المثال، تقول: هذه المرأة لم تكن قرشية سابقًا والآن أيضًا ليست قرشية. هنا يجب أن تنسب القرشية إلى هذه المرأة، وهذا هو مفاد كان الناقصة. الآن عندما تقوم باستصحاب عدم القرشية لهذه المرأة، يجب الانتباه إلى عدم وجود حالة سابقة. فنحن لا علم لدينا بقرشية أو عدم قرشية هذه المرأة ولا نعلم ما هي حالتها السابقة. مفاد كان الناقصة هنا يفتقر إلى حالة سابقة، وعليه لن يكون الاستصحاب ممكنًا.
توضيح هذا المطلب هو أن وجه عدم جريان الاستصحاب هنا ليس بسبب مثبتيته ولا بسبب تعارضه مع استصحاب آخر، بل لأن المستصحب لا حالة سابقة له واليقين السابق مفقود هنا. وعليه، لا يمكن إجراء استصحاب بقائه. لأن موت المورث متقدم على موت الوارث، واتصاف موت المورث بكونه متقدمًا على موت الوارث لم تكن له حالة سابقة. هذا الحدث لم يقع أكثر من مرة واحدة؛ لأن هذا العبد لله لم يمت أكثر من مرة واحدة. ونتيجة لذلك، لا يوجد يقين بالسابق حتى يمكن استصحاب بقائه.
هنا، موت المورث، المتصف بالتقدم على موت الوارث، هو حالة لا نعلم هل وقعت أم لا. وكذلك، لا توجد حالة سابقة أيضًا؛ لأن كلاً من الوارث والمورث قد ماتا مرة واحدة فقط. وعليه، لا يمكننا أن نستصحب هنا؛ لنقول: سابقًا عندما مات الوارث، كان موت المورث متقدمًا عليه.
لو كانا قد ماتا مرتين وحدث الأمر هكذا في المرة السابقة، لكنا استصحبنا؛ لكن هؤلاء العباد لا يموتون أكثر من مرة واحدة. لهذا السبب، لا توجد حالة سابقة. هذا قول المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره).
مناقشة الأستاذ
في باب العموم والخصوص، قدم المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) حلاً وقال: أجروا استصحاب العدم الأزلي. لكن هنا، لم يذكر هذا الحل واكتفى بالقول إنه لا توجد حالة سابقة.
مناقشتان على النظرية الأولى
المناقشة الأولى من المحقق الأصفهاني(قدسسره)
يقول سماحته:
«إن كان هذا الخاص[2] بوجوده الرابط أي كون الشيء متقدّماً، رتّب علیه أثر فظاهر المتن أنّه لا حالة سابقة لعدمه.
و هو إنّما یصحّ إذا أرید التعبّد بعدمه إمّا بنحو العدم و الملكة بنحو الموجبة المعدولة المحمول أي كونه غیر متقدّم، و إمّا بنحو السلب و الإیجاب بنحو السالبة المحصّلة ولكن بانتفاء المحمول.[3]
و أمّا إذا أرید مجرد عدم كونه متقدّما أي نفي المأخوذ على وجه الربط، حیث لا موجب لأزید من نفي موضوع الأثر، و هو متحقّق بسلب الربط و لو بسلب موضوعه، فاستصحاب عدم الرابط جارٍ في نفسه، فإنّ نقیض الوجود الرابط عدم الرابط، لا العدم الرابط؛ لئلا یكون له حالة سابقة»[4] .
إذا كان موضوع الحكم أمرًا وجوديًا خاصًا، خُصص بوجوده الرابطي - أي كونه متقدمًا - وصار ذا أثر، فظاهر متن صاحب الكفاية(قدسسره) أنه لا حالة سابقة لعدمه.
يقول سماحته إن رأي صاحب الكفاية(قدسسره) لا يصح إلا إذا تصورنا الاستصحاب في قضية «عدم موت المورث متصفًا بالتقدم على موت وارثه» بصورتين:
الصورة الأولى: في هذه الحالة، تريد أن تتعبد بعدم هذه القضية وتصرح بأن مثل هذا الموضوع لم يكن موجودًا سابقًا. تستصحب عدم موت المورث وتتعبد به؛ ولكنك تأخذ هذا العدم بنحو «العدم والملكة». ثم تطرح القضية بصورة «موجبة معدولة المحمول»؛ فتقول: «موت المورث غير متصف بالتقدم على موت الوارث». إذا أخذت القضية بصورة «معدولة المحمول»، فلن تكون لمثل هذه القضية حالة سابقة. لأنه في الحالة السابقة التي لدينا، لم يكن مثل هذا الوصف موجودًا. وعليه، إذا اتخذت هذه الحالة أساسًا، فسيكون رأي صاحب الكفاية(قدسسره) صحيحًا؛ لعدم وجود حالة سابقة.
الصورة الثانية: في هذه الصورة، تأخذ القضية بنحو «سالبة محصلة» ولكن «بانتفاء المحمول». بمعنى أنك تدرس موت الوارث بصورة سلبية وإيجابية، ولكن عن طريق نفي المحمول. مثلاً تقول: «موت المورث ليس متصفًا بالتقدم على موت الوارث». في هذه الحالة تأخذ القضية بصورة «سالبة بانتفاء المحمول». إذا أقدمت على انتفاء المحمول هكذا، فلن تكون للقضية حالة سابقة أيضًا. في هذين الفرضين، تكون قد أخذت القضية إما بنحو «معدولة المحمول» أو «بانتفاء المحمول»، وفي هذه العملية، تعتبر موضوعًا وتنتفي محموله. على سبيل المثال، تُطرح عبارات مثل «غير متصف»، «ليس بمتصف» أو «ليس متصفًا بالتقدم». وبالمثل، إذا قلنا «موت المورث غير متصف بالتقدم» أو «موت المورث ليس متصفًا بالتقدم»، فلن تكون لمثل هذه الحالة حالة سابقة أيضًا. لأنه في الماضي أيضًا، الموت الذي وقع لم يكن متصفًا بالتقدم. وعليه، في كلا الفرضين المذكورين، لن تكون هناك حالة سابقة، ونتيجتها أن رأي صاحب الكفاية(قدسسره) في هذه الحالات سيكون صحيحًا.
إذا اتُخذ نهج آخر، وبدلاً من الحالات السابقة، تم الاكتفاء بالنظر إلى عدم التقدم، يمكن تبيين الموضوع بطريقة أخرى. يجب أن نرى هنا ما هو موضوع الأدلة. موضوع الأدلة هو أن يكون “موت المورث، متصفًا بالتقدم على موت الوارث”. الآن، إذا عبرنا عن “كان الناقصة” هذه بصورة سلبية، أي وضعنا “ما كان” أو “ليس” في بدايتها ونفيناها، فلن تحدث مشكلة. وبعبارة أخرى، إذا كان المقصود مجرد عدم كونه متقدمًا - أي نفي الارتباط - فهذا الأمر مقبول منطقيًا. لأنه في هذه الحالة، لا يُطلب شيء أكثر من نفي موضوع الأثر.
لتوضيح الموضوع أكثر، يمكن القول إن مفاد “كان الناقصة” هو أن يكون موت المورث في الماضي متصفًا بالتقدم على موت الوارث. الآن، إذا نفينا هذا الموضوع وقلنا “لم تكن لدينا مثل هذه الحالة سابقًا”، فسيكون هذا القول صحيحًا. لأنه في الماضي، لم يكن هناك موت متصف بالتقدم على موت الوارث. وكل من يدعي خلاف ذلك، عليه إثباته. وبعبارة أخرى، في الماضي، لم تكن هناك حالة مات فيها المورث قبل الوارث.
يقول المرحوم المحقق الأصفهاني(قدسسره) في هذا الخصوص إنه إذا نظمنا القضية بهذه الطريقة، فستكون المسألة قابلة للحل. وهو يعتقد أن هذا الأمر يتحقق بنفي الارتباط، حتى لو أدى إلى نفي الموضوع. وتوضيح هذه النقطة كالتالي:
في الماضي، لم يمت أي من المورث والوارث حتى يمكن اعتبار موت أحدهما متصفًا بالتقدم على موت الآخر. لهذا السبب، كانت هذه المسألة في الماضي سالبة بانتفاء الموضوع. أي لأنهما كانا كلاهما حيين، لم يكن موت المورث المتصف بالتقدم على موت الوارث موجودًا فحسب، بل لم يقع موت أساسًا. وعليه، يمكن القول إن مثل هذا الموضوع لم يتحقق في الماضي، وبالتالي، يمكن استصحاب هذا العدم.
هنا، استصحاب عدم الرابط قابل للتطبيق. فنقيض الوجود الرابط هو عدم الرابط. وقد استُخرج الوجود الرابط من مفاد “كان الناقصة”، والآن يُستصحب نقيضه، أي عدم الرابط. وبعبارة أخرى، “كان الناقصة” تدل على وجود ارتباط بين موت المورث وموت الوارث بنحو التقدم، والآن، يجري عدم مثل هذا الارتباط.
من هنا، يجري استصحاب عدم الارتباط بشكل صحيح ويمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن موضوع الأثر (تقدم موت المورث على موت الوارث) لم يكن موجودًا في الماضي ولا يمكن قبوله الآن.
الآن، خذ هذا الوجود الرابط في الاعتبار؛ إذا أردت نفيه الآن، يجب أن تذكر «سلب الرابط»؛ أي أن تسلبه. وبعبارة أخرى، نقيض الوجود الرابط هو عدم الرابط. وهذا العدم يعني عدم وجود الرابط، لا أن يُتصور عدم مستقل ويتصف هو بالرابطية. في الحقيقة، عدم الرابط يعني نفي وجود الرابط.
يجب الانتباه هنا إلى أن عدم الرابط يعود إلى المثالين نفسيهما اللذين طُرحا سابقًا: انتفاء المحمول أو معدولة المحمول. ففي هذه الحالات، المفهوم المقصود هو عدم وجود الرابط هذا. الآن إذا وضعت “ما” قبل “كان” هذه، فيمكن القول إن “كان” هذه لم تكن موجودة سابقًا. وبعبارة أخرى، نذكر فقط أن “كان” هذه لم تكن متحققة في الماضي. وهذه النقطة هي بالضبط المطلب الذي طرحه المحقق الأصفهاني(قدسسره) وتتمتع بدقة خاصة.
المناقشة الثانية من المحقق الخوئي(قدسسره)
يقول المرحوم المحقق الخوئي(قدسسره):
«هذا الكلام مخالف لما ذكره في بحث العام و الخاص[5] من أنّه إذا ورد عموم بأنّ النساء تحیض إلى خمسین عاماً إلا القرشیّة، و شككنا في كون امرأة قرشیة، فلایصّح التمسك بالعموم المذكور، لكون الشبهة مصداقیّة، إلا أنّه لا مانع من إدخالها في العموم للاستصحاب، فنقول: الأصل عدم اتّصافها بالقرشیة، لأنّها لمتتّصف بهذه الصفة حین لمتكن موجودة، و نشك في اتّصافها بها الآن، و الأصل عدم اتّصافها بها»[6] .
ثم قال المحقّق الخوئي(قدسسره): «هذا ملخص كلامه في مبحث العامّ و الخاصّ و هو الصحیح على ما شيّدناه في ذلك المبحث[7] خلافاً للمحقّق النائیني(قدسسره) فلا مانع من جریان الاستصحاب في المقام».
بالاتفاق، كان صاحب الكفاية(قدسسره) قد بيّن هذا المطلب وقبله سابقًا في بحث العام والخاص. في مباحث الأصول، وخاصة في بحث العام والخاص، تم تناول هذا الموضوع بالتفصيل؛ فقبله بعض الأعلام وعارضه آخرون. على سبيل المثال، في مسألة «النساء تحيض إلى خمسين عاماً إلا القرشية»، توجد قاعدة عامة مفادها أن النساء عمومًا يحضن حتى سن الخمسين. رأي المحقق الخوئي(قدسسره) في هذا الصدد هو أنه إذا شككنا في كون المرأة قرشية، أي لم نعلم ما إذا كانت هذه المرأة قرشية أم لا، فلا يصح التمسك بالعام هنا. وسبب ذلك وجود المخصص؛ لأن العام عندما يُخصص، لا يعود قابلاً للتمسك به في موارد الشك.
في مثل هذه الحالة، تكون الشبهة التي تنشأ مصداقية، لا مفهومية. والتمسك بالعام في الشبهات المصداقية غير جائز. وبعبارة أخرى، لا يمكن القول بشأن هذه المرأة إنه بما أننا لا نعلم هل هي قرشية أم لا، فإننا ندرجها تحت عموم «النساء تحيض إلى خمسين عاماً». والسبب في ذلك هو أن هذا العموم قد خُصص بواسطة المخصص وشمل النساء غير القرشيات. من هنا، فإن عموم «النساء» هنا لم يعد يشمل كل النساء، بل يشمل فقط «النساء غير القرشيات». والمخصص أيضًا يُخرج النساء القرشيات. وعليه، تُطرح شبهة مصداقية بشأن هذه المرأة التي نشك في كونها قرشية أو غير قرشية.
في مثل هذه الحالات، يكون الفرد المشكوك مترددًا بين حجتين: إما حجية العام (التي تشمل النساء غير القرشيات) أو حجية المخصص (التي تشمل النساء القرشيات). فإذا كانت المرأة غير قرشية، فحكمها حتى سن الخمسين، وإذا كانت قرشية، فحكمها حتى سن الستين. ونتيجة لذلك، يدخل هذا الفرد المشكوك في حجية المخصص.
يقول المرحوم المحقق الخوئي(قدسسره) إنكم هناك حيث لم يكن التمسك بالعموم ممكنًا، بسبب كون الشبهة مصداقية وتردد المسألة بين حجتين، لم تجيزوا التمسك بالعام. ومع ذلك، قلتم: «إلا أنّه لا مانع من إدخالها في العموم للاستصحاب». ذُكر أن الأصل عدم اتصافها بالقرشية؛ لأن هذه المرأة، عندما لم تكن قد ولدت ولم تكن موجودة بعد، لم تكن متصفة بصفة القرشية، لأنها لم تكن امرأة أساسًا. لا توجد حالة سابقة تكون فيها هذه المرأة موجودة ولكن غير متصفة بالقرشية ثم تتصف بالقرشية فجأة.
يشير المحقق الخوئي(قدسسره) إلى كلام صاحب الكفاية(قدسسره) فيقول إن هذه المرأة لم تكن قرشية. في ذلك الوقت الذي لم تكن فيه امرأة، لم تكن قرشية أيضًا.
ويتابع قائلاً إننا نجري استصحاب العدم الأزلي هنا؛ لأنه في الزمن الذي لم تكن فيه هذه المرأة موجودة، لم تكن متصفة بالقرشية. لذا، فالأصل الآن عدم اتصافها بالقرشية. ومفاد استصحاب العدم الأزلي هنا هو نفي كان الناقصة؛ أي أننا ننفي “مرأة قرشية”. وهذا يعني أنه في الأزل، لم يكن هناك ربط بين «امرأة» و«قرشية»؛ لأن هذه المرأة لم تكن موجودة أساسًا. الآن حيث نشك هل اتصفت هذه المرأة بصفة القرشية أم لا، ومع الأخذ في الاعتبار أنه لا شك حاليًا في كونها امرأة، فالمشكلة تكمن فقط في هل هي قرشية أم غير قرشية. ومخصصنا أيضًا هو القرشية.
نأخذ في الاعتبار عموم «النساء تحيض إلى خمسين عاماً إلا القرشية». هنا نشك هل هذه المرأة داخلة في المخصص أم لا. وبما أنها عندما لم تكن موجودة لم تكن متصفة بالقرشية أيضًا، فإننا نجري استصحاب العدم الأزلي ونستنتج أنها ليست قرشية. وعليه، فإن هذه المرأة لا تدخل في المخصص وتكون مشمولة بحكم العام.
هذا المطلب هو نفس وجهة النظر التي بينها المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) هناك. أي أنه اعتبر الاستصحاب جاريًا في مثل هذه الحالات. بالطبع، ما إذا كان هذا الاستصحاب يجري في موارد شبهة المخصص أم لا، فهذا بحث منفصل. بحثنا هنا يتركز على أن المرحوم صاحب الكفاية(قدسسره) اعتبر الاستصحاب جاريًا هناك. في الأصول، المجلد الثالث، في بحث العام والخاص، تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل. وهنا أيضًا نقول: «لأنّها لم تتصف بهذه الصفة حین لم تکن موجودة، و نشک في إتصافها بها الآن، و الأصل عدم اتصافها بها».
يتابع المرحوم المحقق الخوئي(قدسسره) قائلاً: هذا ملخص كلام صاحب الكفاية(قدسسره) في مبحث العام والخاص وهو كلام صحيح. بالطبع، خلافًا لرأي المحقق النائيني(قدسسره) الذي لم يقبل هذا، لكننا نقبله ونؤكد على صحته.
النظرية الثانية: من المحقق الأصفهاني والمحقق الخوئي(قدسسرهما)
رأي المحقق الأصفهاني والمرحوم الخوئي(قدسسرهما) في هذا الصدد هو أنهما يعتقدان بجريان استصحاب العدم الأزلي. في الواقع، فإن أعلامًا مثل صاحب الكفاية، والمحقق الأصفهاني، والمرحوم الخوئي(قدسسرهم) وبعض الأساطين(دامظله) جميعهم قائلون بجريان استصحاب العدم الأزلي[8] . على سبيل المثال، ذُكرت شواهد من صاحب الكفاية(قدسسره) في هذا الصدد. وخلافًا لهذا الرأي، فإن بعض الأعلام الآخرين مثل المحقق النائيني والمحقق البروجردي(قدسسرهما) قالوا بعدم جريان استصحاب العدم الأزلي[9] . كذلك، فإن المرحوم المحقق العراقي(قدسسره) قال بالتفصيل في هذه المسألة وأعطى رأيًا مفصلاً([10] ).
بيان المحقق الخوئي(قدسسره)
يقول المحقق الخوئي(قدسسره) في تقرير نظريته:
«الأصل عدم اتّصاف هذا الحادث بالتقدّم على الحادث الآخر، لأنّه لمیتّصف بالتقدّم حین لمیكن موجوداً، فالآن كما كان، و لایعتبر في استصحاب عدم الاتّصاف بالسبق، وجوده في زمان مع عدم الاتّصاف به[11] ، بل یكفي عدم اتّصافه به حین لمیكن موجوداً، فإنّ اتّصافه به یحتاج إلى وجوده، و أمّا عدم اتصافه به، فلایحتاج إلى وجوده، بل یكفیه عدم وجوده، فإنّ ثبوت شيء لشيء و إن كان فرع ثبوت المثبت له، إلا أنّ نفي شيء عن شيء لایحتاج إلى وجود المنفي عنه، و هذا معنی قولهم: إنّ القضیة السالبة لاتحتاج إلى وجود الموضوع»[12] .
جريان استصحاب أصل عدم اتصاف هذا الحادث بالتقدم على الحادث الآخر معتبر. ويوضح سبب ذلك قائلاً: «لم یتّصف بالتقدّم حین لم یکن موجوداً». أي في الزمن الذي لم يكن فيه موت المورث قد حدث بعد، بينما كان الأب حيًا، لم يكن هذا الموت متصفًا بأي تقدم على موت الابن. في الحقيقة، في ذلك الوقت الذي كان فيه الأب والابن كلاهما حيين، لم يكن أي منهما متصفًا بالتقدم على الآخر. الآن إذا أردت أن تقبل هذا الأمر في الأزل أيضًا، فقد كان الأمر كذلك في ذلك الوقت؛ أي عندما كان الأب حيًا ولم يكن موت الابن قد حدث بعد، لم يكن هناك أي اتصاف بالتقدم على موت الابن. وعليه، فكما لم يكن هناك اتصاف في ذلك الوقت، فالوضع لا يزال كذلك الآن.
ويقول سماحته(قدسسره) إنه ليس من المعتبر أن نقول إنه كان موجودًا في زمن ما ولكنه لم يكن متصفًا بالتقدم، لأن هذا يشبه معدولة المحمول. وبعبارة أخرى، إذا قلت إن موت الأب كان موجودًا سابقًا ولكنه لم يكن متصفًا بالتقدم، فأنت في الواقع قد أدخلت النفي على المحمول، وهذا خطأ. في الحقيقة، يجب أن تقول إن الموضوع كان موجودًا ولكنه لم يكن متصفًا بالتقدم، لا أن تقبل وجوده ولكن تنفي اتصافه بالتقدم. ويقول سماحته إن هذا النوع من الاستصحاب الذي تراه صحيحًا، هو غير صحيح، وهذا هو ما قيل عنه: «الاستصحاب لا حالة سابقة له».
وعليه، في استصحاب عدم الاتصاف بالسبق، ليس من المعتبر أن نفترض وجود موت الأب في زمن معين، ولكنه غير متصف بالتقدم. أو مثلاً، أن تكون المرأة موجودة، ولكن في الزمن الذي هي فيه امرأة، لا تكون متصفة بالقرشية. في الحقيقة، ليس المقصود أن نقول لتكن المرأة موجودة ولكن لا قرشية لها، بل يجب القول ألا تكون المرأة قرشية. وبعبارة أخرى، نقول «ما كانت المرأة القرشية»، حيث يدخل النفي على العبارة بأكملها، لا أن ندخل النفي على المحمول فقط. هنا، يكفي أن يكون عدم الاتصاف بالتقدم ثابتًا في الزمن الذي لم يكن فيه موجودًا، لأن الاتصاف بالتقدم يحتاج إلى وجوده، أما عدم الاتصاف فلا يحتاج إلى وجود. بمعنى أنه عندما نقول «عدم الاتصاف»، فليس المقصود أن يكون هناك شيء موجود، ولكنه متصف بعدم تلك الصفة، بل يكفي ألا تكون تلك الصفة موجودة.
هذه القاعدة عملية جدًا. طرحها المحقق الأصفهاني(قدسسره) وشرحها المرحوم المحقق الخوئي(قدسسره).
القاعدة التي تُطرح هنا هي أنه في الحالات التي تثبت فيها شيئًا لشيء، تحتاج إلى وجود الموضوع، أما في الحالات التي تنفي فيها شيئًا، فوجود الموضوع ليس ضروريًا. هذه القاعدة المنطقية لها تطبيق هنا. والسبب في قولنا باستصحاب العدم الأزلي هو هذه القاعدة نفسها التي تقول: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»؛ وبعبارة أخرى، لإثبات شيء لشيء، يجب أن يكون مُثْبَتُه موجودًا. أما نفي شيء عن شيء فلا يحتاج إلى وجود المنفي عنه. في هذه الحالة، عندما تنفي شيئًا، ليس من الضروري أن يكون المنفي عنه موجودًا.
هذه القاعدة مفيدة جدًا، وهي مفيدة بشكل خاص هنا. في الواقع، لقد أخطأ بعض الأشخاص في فهم هذه القاعدة وظنوا أنه لجريان استصحاب العدم الأزلي، هناك حاجة إلى شيء مثل «موت المورث» (الأب) ليكون متصفًا بالتقدم على موت الوارث (الابن). ولكن في الحقيقة، هذا خطأ؛ يجب أن تضع “غير” على القضية وتقول: «ليس موت المورث متصفًا بالتقدم على موت وارثه»، حتى لو لم يكن موت المورث موجودًا بعد. وبعبارة أخرى، هذا هو معنى قول المناطقة: «إن القضیة السلبیة لاتحتاج إلی وجود الموضوع»، أي أن وجود الموضوع ليس ضروريًا في القضية السلبية.
بناءً على هذه التوضيحات، نستنتج أن الاستصحاب يجري في هذا القسم أيضًا، وكما قيل في القسم الأول، لا توجد له معارضة إلا في حالة وجود علم إجمالي. وعليه، فقد انتهى البحث في هذا القسم أيضًا، لنتناول القسم الثالث إن شاء الله.


